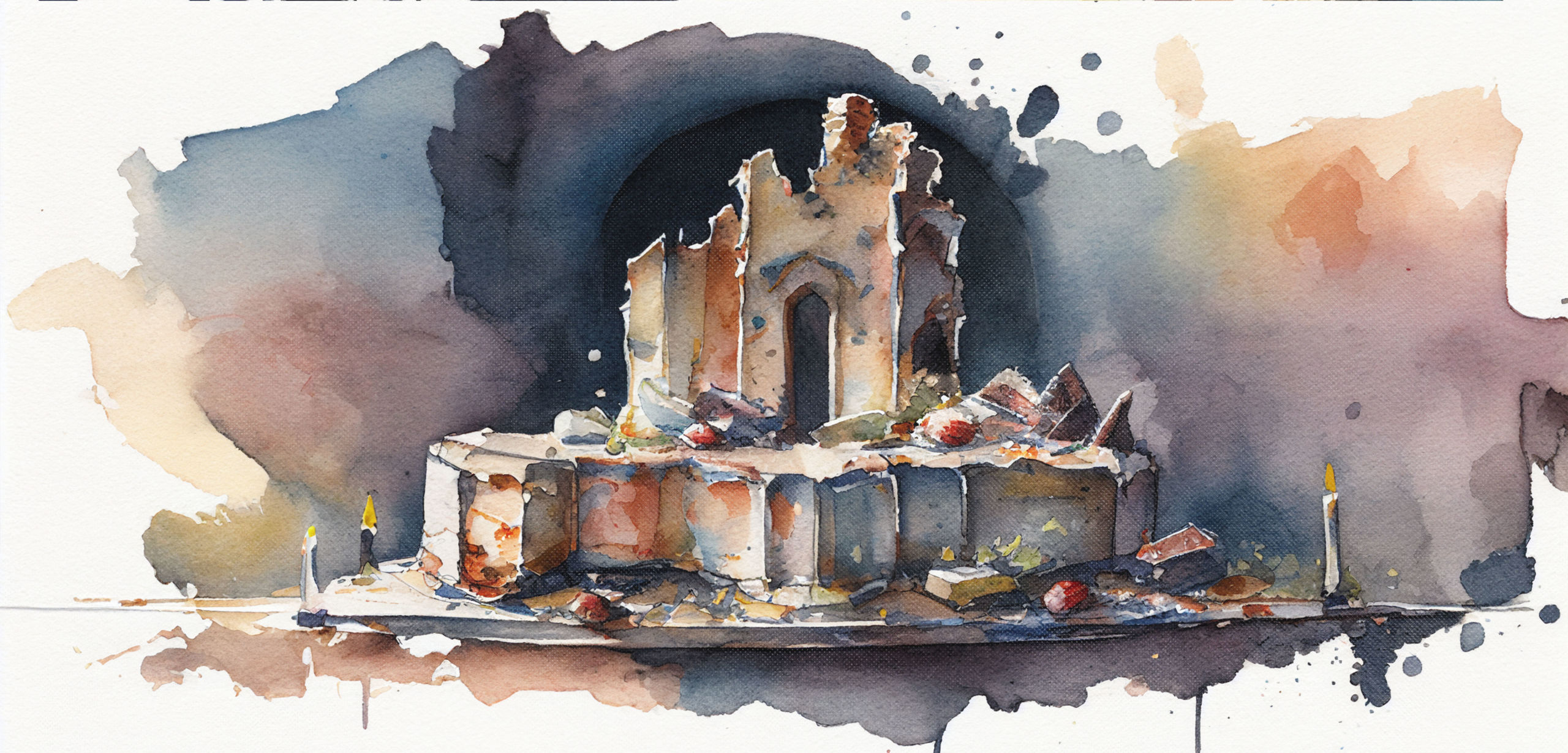يعرف سكّان “البطن السمين” بعضهم جيدًا، مثلما يميزون كل غريب يأتي. ومن سيكون هذا الغريب إلا صحافيًا أو مراسل إحدى المحطات أو مصورًا؟ هؤلاء يلتقطون الصور أو يعدّون تقريرًا ثم يمشون ويأتي غيرهم. بعض الغرباء يأتون أحيانًا في جماعات، فجأة بلا مقدمات، يتحدثون عن نشر الوعي أو عن الصحة الإنجابية ثم قد يوزّعون المسكنات وبعض المراهم. هناك أيضًا غرباء موسميون، هؤلاء قد يأتون بحثًا عن حسنات في رمضان ثم يختفون مع نهاية الشهر.
كنت أنا مثل هؤلاء بالنسبة إليهم، وكان أهل البطن يسألونني ساخرين “جاي تصوري، جاي تشحدي علينا”. استغرقت العلاقة التي تكونت بيننا اليوم؛ بمعنى أن يصير وجودي بينهم عاديًا وأن يتحدثوا إليّ بلا توجّسٍ وأن يطلبوا مني تصوير هذا أو ذاك، زياراتٍ أدرك الآن أنها مستمرة منذ ثماني سنوات. وقت طويل مرّ، أتنبّه إلى ذلك وأنا أعرف أطفالًا كانوا رضعًا حين زرت المكان أول مرة، واليوم ما أن أصل حتى يهرعون إليّ وتركض أصواتهم نحوي: “جاءت سمر”.
حين السماء تمطر قمامة
“البطن السمين” اسمٌ أقل شيوعًا من اسم المنطقة الثاني؛ “نهر البارد“، الواقعة في غرب خان يونس جنوب غزّة، والممتدّة على مسافة كيلو تقريبًا أو أكثر بقليل، حيث تعيش مائة عائلة يُقدّر تعدادها بخمسمائة نسمة. إنه عددٌ قليل، غير أنه حين يتجمّع في مساحة ضيقة وخانقة يصير اكتظاظًا. يعيشون في غرف مبنية من الطوب وصفائح الزينكو والبلاستيك، بعضهم ثبّت مكان الأبواب قطعًا من القماش أو النايلون، تتكدس هذه المساكن وتتقارب جدًا، أما السماء فتمطر قمامة معظم الوقت.
قبل عشرة أعوام، لم يكن “البطن السمين” مكبًا بل كان “سوافي رمل” (تلال رملية صغيرة متفرقة)، كما يخبرني سكانه. وجد الفقراء الذين ضاق بهم الحال، وعجزوا عن تكبد نفقات البيوت المستأجرة، ملجأً في تلك الأرض الخلاء النائية التي تملكها السلطات ولم يبد آنذاك أن ثمة حاجة فيها.
في البدء بنوا فيها خيامًا، ثم أصبح المُعوِزون يفدون إليها، كل فترة تأتي عائلة فقيرة أخرى فتبني خيمتها ثم تطورت الخيمة إلى غرفة حجرية وشيئًا فشيئًا تكوّن مجتمع نهر البارد. لا يفكر هؤلاء في بناء بيوت حقيقية حتى لو كان بمقدورهم أو تبرّع أحدٌ لهم بكلفتها؛ فالسمة الأبرز لوجودهم هي الهشاشة، ما العمل إذا أتت السلطات في أي لحظة وقررت إخلاء المكان منهم لأي سبب كان. وإلى أن يحدث ذلك يستمرون في ما هم فيه. ما زالوا يذكرون حال الأرض التي سكنوها قبل عشرة أعوام، يفتقدون تلال الرمل الصفراء النظيفة حيث كان أطفالهم يلعبون، يعبرون عن ذلك بلغة بسيطة: “كان المكان كتير حلو، صار كتير بشع”.
منذ تسعة أعوام، ورغم وجود ناس فيه، رأت السلطات في هذه الأراضي مساحة مناسبة ترمي فيها النفايات، فتحوّلت إلى مكبٍ لقمامة الجهات المسؤولة. ثم أصبح سكان المناطق القريبة أيضًا يحذون حذو السلطات فيلقون فيها أيًا كان ما يريدون التخلص منه.
ليس غريبًا لو مرّ أحدهم ورمى بجثة حماره النافق أو بقرته الميتة فوقهم ومضى، حتى أنك ستجد حطامًا لهياكل سيارات. لقد جرى تجاهل وجود بشر في “البطن السمين” إلى أن نُسي تمامًا فأخذت النفايات ترتفع من حولهم وتتحول إلى تلال جديدة سرعان ما حلّت محل تلال الرمل.
نار الشتاء والصيف
في الشتاء القارس يمكن تمييز هذا المكان من مسافة، إذ تكاد النار فيه ألا تنطفئ إلا حين يندلع المطر ويُغرق حياتهم الهشة التي بنوها طيلة الصيف. في الصيف تظل النار قائدة أيضًا لتطرد عنهم الحشرات والآفات قدر المستطاع، لا يمنع ذلك من خروج العقارب والثعابين.
في كل زيارة تُروى لي قصة طفل ملدوغ أو نجاة طفل آخر من حيّة، أحيانا ترفع إحداهن وسادة فتوقظ العقرب الذي كان نائمًا تحتها. أما الكلاب الضالة والجائعة فتهجم قطعانها بين فترة وأخرى، وهي أحد أسباب خوفي من البقاء لديهم ليلًا. في الليل يزيد المكان وحشة، في غياب الكهرباء، يستخدمون الشموع وضوء الكاز والنار.
المقلب ليس شرًا وحسب
يطلق الآباء أطفالهم في مهمات دورية، يمشطون القمامة يدويًا ويقومون بعملية إعادة تدوير، ويصنفون الأشياء هذه لبيعها أو هذه للاحتفاظ بها. ينقبون بين الخضروات والفواكه العفنة كأنهم في سوق، يستصلحون ما يسد رمقهم. لذلك ستجد الأطفال معظم الوقت بأيد سوداء ومجرّحة مشغولين بمهمة البحث عن شيء له قيمة بين ما يعده آخرون بلا قيمة،
إذا عثروا على أجنحة الدجاج وأرجله فهي للحساء؛ أذكر أنني وصلت مرة لزيارتهم وهم يأكلون كرشة استخرجوها من جثة خروف نافق؛ أما المعلبات منتهية الصلاحية فسوف يتشاجرون عليها؛ وكذلك يجمعون الملابس لأنفسهم؛ والنايلون لتغطية فتحات في بيوتهم.
إلى جانب الطعام، يبحثون عن الحجارة والحديد والأسلاك، يجمعونها على عربة يجرها حصان هزيل يأخذها الأب عادة ويحاول بيعها إلى الكسارات التي تطحن الصخور وإلى تجار الخردة لقاء 5 (أقل من دولار ونصف) أو 10 (أقل من ثلاثة دولارات) شيكل.
تطهو الأمهات طعامهن خارج المساكن بعد أن أشعلن نارًا من قمامة لم تكن تخلو من البلاستيك، فيتصاعد دخانٌ أسودٌ وكريهٌ وخانق. يقال إن النار تعقم كل شيء، هل ينطبق هذا على هذه النار؟ الأطفال الذين لا يذهب معظمهم إلى المدرسة البعيدة، يلعبون على مقربة من أهاليهم بانتظار أن ينضج الطعام. هذا هو رتم الحياة.
مجتمعات مقالب القمامة
السكن تحت النفايات ليس ظاهرة تقتصر على نهر البارد، كما أن هذه المناطق لا تعدّ أحياء فقيرة ولا يمكن أن توصف بالعشوائية، لكن لها اسمًا بلغة علوم الاجتماع والتخطيط اليوم “مجتمعات مقالب القمامة” Garbage Dump Communities. الفرق بين نهر البارد وأي مكان آخر أن المنطقة لم تكن مكبًا حين استقر الناس فيها، بل إنها أصبحت كذلك بينما هم يعيشون فيها وعلى مرأى ممن حوّلوها إلى مكب متجاهلين وجودهم.
طبعًا لكل “مجتمعات مقالب النفايات” سمات مشتركة، فالمقلب هو المكان الوحيد حيث يمكن لمن أصابته الفاقة العيش مجانًا والعثور على أشياء يمكنه الاحتفاظ بها لعائلته أو بيعها من أجل الربح.
وتشترك هذه المجتمعات في العالم بأسره بأن دخل عائلاتها اليومي لا يتجاوز دولارين، وأنها لا تتمتع بخدمات الكهرباء والماء، وإن هناك إمكانية كبيرة للغرق فيها ليس تحت الفيضانات الشتوية فقط، بل يمكن لإنسان أن يسقط في إحدى تلال القمامة الضخمة وأن تبتلعه النفايات، تمامًا مثلما تقبض دوامات البحر على غريق وتسحبه إلى القعر، وغالبًا ما يصعب انتشاله حيًا.
توفر إعادة تدوير القمامة فرصًا للحصول على أجورٍ صغيرة تسمح للرجال بإبقاء عائلاتهم على قيد الحياة، ولكنها في الوقت نفسه لا تكفي لمغادرة المكان. وهكذا تصبح حياتهم مرتبطة على نحو وثيق بوجود المقلب. تقع الأسر في شرك دائرة الفقر من جيل إلى آخر، إذ لا تستطيع معظم “مجتمعات مقالب النفايات” الوصول إلى المدارس البعيدة إلا قليل منهم ممن يصرون على إرسال أطفالهم أملًا في طاقة نور ما تفتح لهم.
وبدون الوصول إلى التعليم لن يكون هناك وصول إلى وظائف توفر دخلًا لربما يكون سببًا في بدء التخطيط للخروج، ما يعني المزيد من الحصار واستنساخ الأبناء لحياة الآباء بلا أمل كبير في كسر الطوق.
ذكرى حلوة: “سبوع” مولود أم جميل
في البداية كانت زيارتي للمكان بهدف التصوير فقط، أما اليوم فأمرّ بتصوير ومن دون تصوير، أطمئن على أهله الذين عرفت، أم لؤي وأم عبدالله وأم جميل، الأخيرة اتصلت بي حين أنجبت ودعتني إلى حضور “سبوع” المولود. كان يومًا ملؤه الضحك والثرثرة.
ارتدى الجميع أفضل ما لديهم، وتجمع الأطفال حول المولود ثم أُضيئت الشموع تحفّ به وبهم، وغنوا. وُضعت طاولة في الوسط وعليها قالب حلوى، كل طفل أخذ حصة واحتفوا بالطفل الجديد، ثم التقطنا الصور التذكارية… سأطبع بعضها لأم جميل قبل زيارتي لها في المرة القادمة.