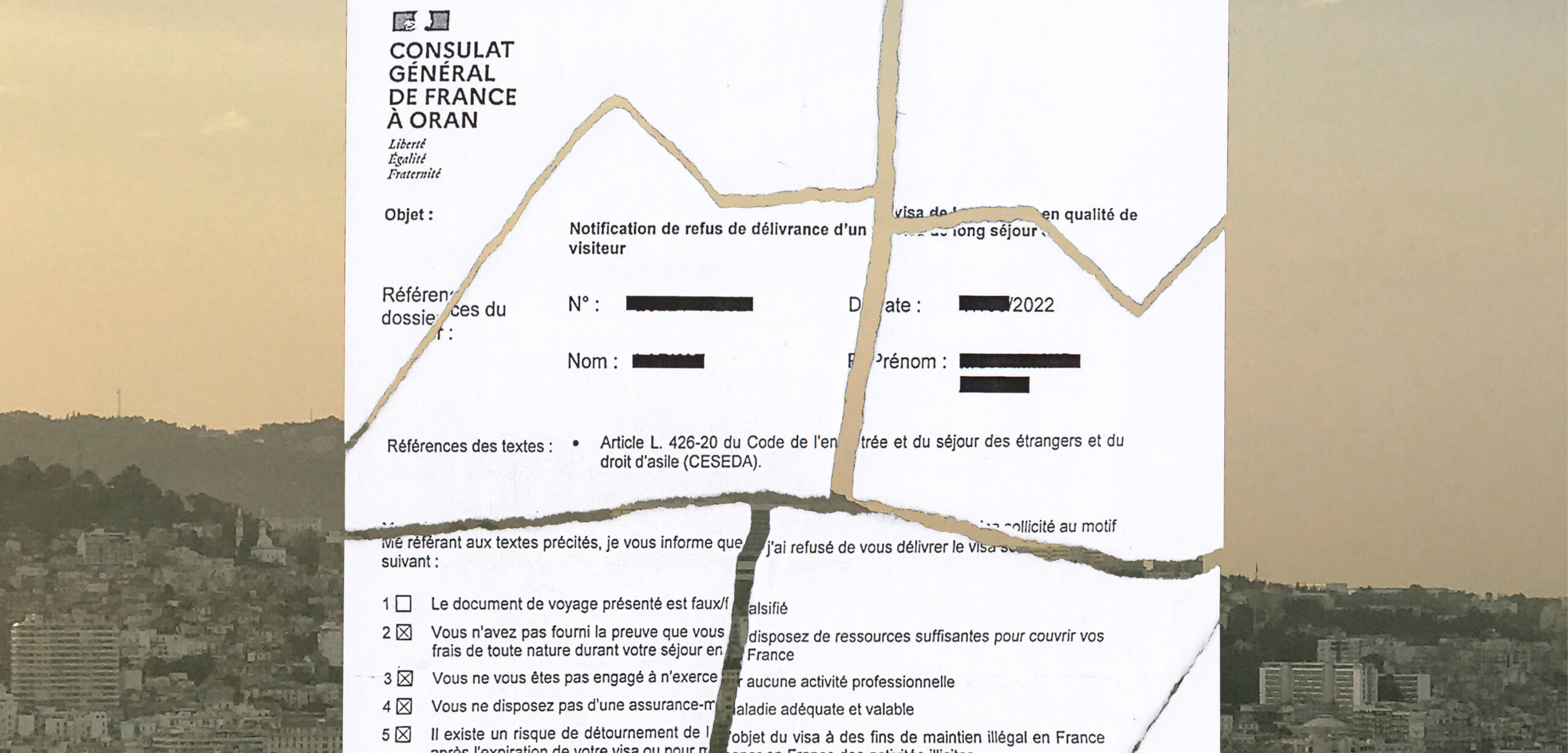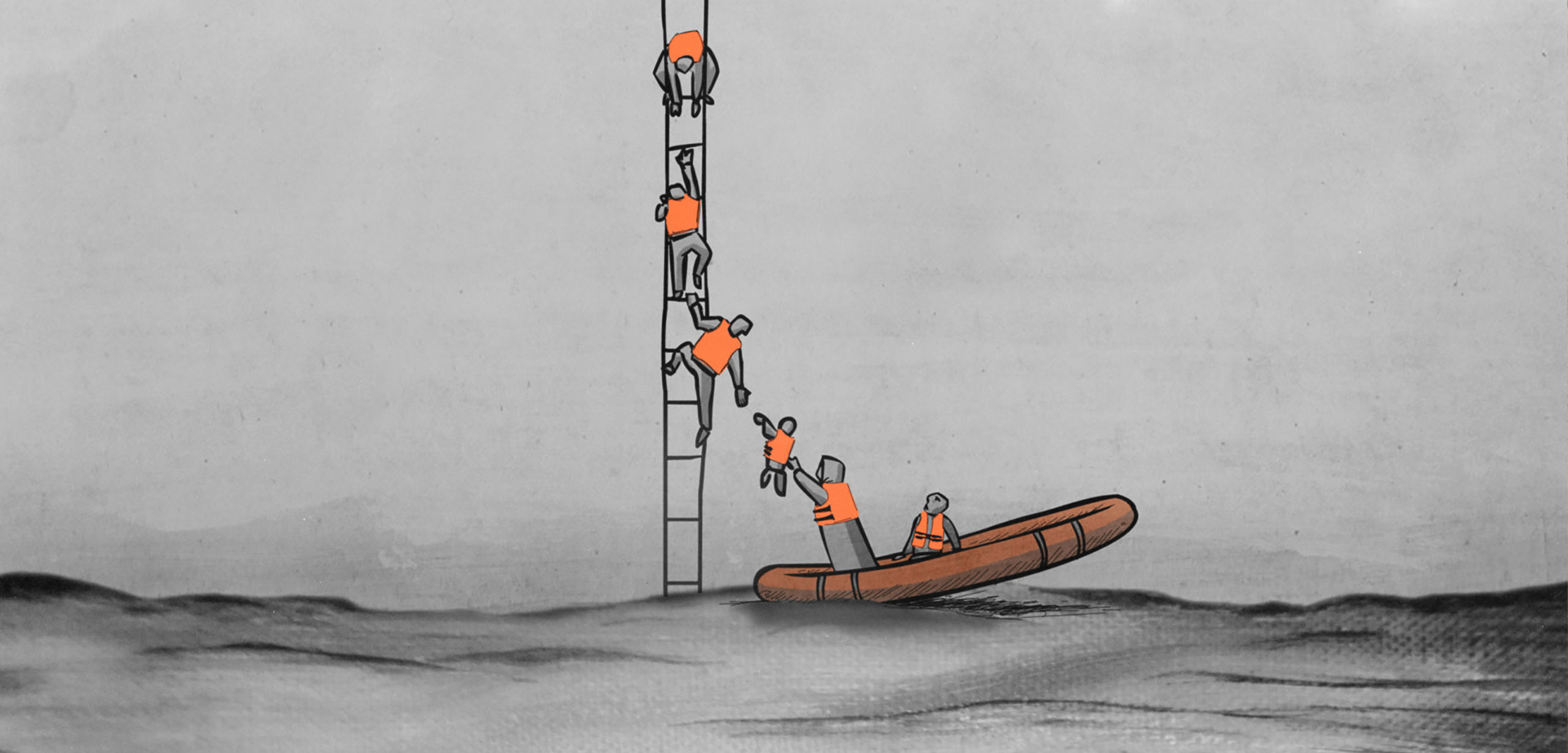تعرفت على أيوب، الطفل السوريّ ذو الثانية عشر عاماً، في الشتاء الماضي، بعد فترة وجيزة من وصولي إلى اسطنبول. لا أعرف ما هو رقمه بين الأولاد المشردين الذين لم أعد قادراً على أن أحصيهم هنا.
جلستُ بالقرب منه لدقائق دون أي سبب، كان قد انزوى إلى جانب الطريق محتمياً من المطر بواجهة إحدى المحال التجارية، والتي ترسل له بوابتها بعض الدفء.
أخذ يتسول وقد وضع إصبعين على شفتيه مدخناً سيجارة خيالية، نافثاً دخاناً أزرق جراء البرد. “سجائر بالمجان”، كان يمازح العابرين، وتطفوا ابتسامة متردّدة على وجهه ثم تتلاشى أمام ازدراء المارة.
فسحة للتجوّل
منذ ما يقارب الثلاثة شهور انتقلتُ لمزاولة عمل ثابت لدى صاحب شركة شحن تربطه معرفة ما بأحد الأصدقاء في دمشق. كان شخصاً ودوداً، شيء شبيه بعود ثقاب في نفق مظلم. لم يختلف الأمر عن سابق الأعمال التي قمتُ بها هنا في اسطنبول، إلا أن الجهد العضلي بات أخفّ قليلاً، إضافة إلى قبول صاحب العمل أن أقيم في ذات المكان الذي أعمل به، بعدما أخبرته أنني لا املك أوراق رسمية ولا إقامة شرعية، وأنني لا أنوي البقاء طويلاً في تركيا، إنما مجرد وقت قصير وأكمل طريقي براً إلى دولة أخرى.
وجودي غير الشرعي في هذا البلد حفّز أحدهم لاستثماري بعمل إضافي. كانت معرفتي بهذا المستثمر عن طريق الصدفة التي تحولت لنوع من المقايضة. لم أفهم في البداية خطورة الأمر، وقد استنتجتها متأخراً. مهمتي كانت بإيجاز، أنه عليّ بعد انتهاء دوامي أن آخذ منه حقيبة بلاستيكية تتضمن بعض المحتويات التي لم أعرفها، وكان يلح بشكل غريب عليّ أن أنزع الكيس الخارجي للحقيبة أثناء حملها وأن استبدله بأخرى، مقابل أجر صغير أحياناً يقدمه لي وأحياناً أخرى أقوم بالعمل بالمجان للحفاظ على أواصر العلاقة المؤقتة، التي تدر عليّ بعض الأجر الزهيد.
كنت أقصد أحد الأماكن سيراً، عبر طريق يحدده لي مؤشر الموقع، أنعطف يميناً بعد مائة متر، ثم يساراً، إلى أن أصل إلى وجهتي، فإحدى متطلبات هذه المهمة أن أقوم بها دون اللجوء لوسيلة نقل، تجنباً لأعين البوليس.
في بعض الأيام كنت أنتظر القيام بهذا الفعل كونه يمنحني فسحة قصيرة للتجول في إسطنبول التي ما زلت أجهلها وأعيش بها متخفياً. كان يطلب مني أن أسلّم الحقيبة لشخص ما دون أن أتحدث إليه أو استفسر عن أي شيء. خلال قيامي بهذا الفعل عدة مرات تكررت بعض الوجوه التي في الغالب ألتقي بها خلسةً، أحياناً أميز أحدهم عن بعد، يومئ لي بيده لأعطيه الحقيبة وأمضي بسرعة.
بتّ أسير في الشارع لا أكترث لأمر البوليس، فلا يكترثون هم أيضاً لأمري. أخذ الأمر بيننا شكل اتفاقية غير معلنة. معظم المرات كان خط سيري يقودني إلى منطقة الفاتح، المكان الذي يعرف بأنه يضم نسبه كبيرة من السوريين، كما أنني لم أجرؤ على الابتعاد عن مكان سكني أكثر من ذلك.
كسور في القدمين
منذ وصولي إلى تركيا قبل أشهر، عابراً الحدود بطريقة غير شرعية، وخلال ما أقوم به، كانت نظرتي الساذجة عن المكان تتحطم تدريجياً. ظننت سابقاً أن من يخرج من سوريا سيكون في البلد الآخر إنساناً آخر، أو على الأقل بالنسبة لي، سأتجنب مشاهدة صور الركام، أنقاض الأبنية وأنقاض البشر، ملامح البؤس التي تكلل الوجوه في الطرقات، لن يوقفني طفل في الطريق يتضرع لأشتري منه منديلاً أو أمنحه بعض النقود، هنا لا ينام أحد في الشارع، الكل ينعم بدفء الشتاء، والمطر ينهمر كقصيدة حب متقدة، المزعج به فقط هو صوته إن انهمر على سطح معدني ما.
لكن لتعلم كيف يسير الأعرج عليك أن تكون قد تعرضت للكسر، حتى وإن لم تتبع ذات آلية سيره. ففي هذه المنطقة حيث أجول يتوزع الأطفال والنساء على الأرصفة حتى في أشد درجات الحرارة انخفاضاً، لا أدري إن كانوا يبيتون على ذات الرصيف أيضاً، وإن كنت قد رأيتهم مراراً مكانهم في ساعات متأخرة من الليل، البعض يبيع أشياء في الغالب لا تشترى، وفي معظم الأحيان لا تتعدى ممتلكات طفل أو امرأة علبة مناديل جيب او قطعة بسكويت، إنما ليمنحوا لتسولهم شكلاً مشروعاً.
تتناثر في منطقة الفاتح أفراد وأُسر من حلب، إدلب، الرقة، ومحافظات سورية أخرى أغلبهم أو كلهم من الأطفال والنساء، يتسولون بلغتهم العربية ولهجاتهم السورية المتنوعة، وعلى ما يبدو، فإن أغلب مخططات هؤلاء بنيت على أساس غريزي وعاطفي
احدى المرات اعترضني أيهم (10 أعوام)، الذي تعرفت عليه فيما بعد، والذي ماتت شقيقته الصغيرة جراء تناولها كمية كبيرة من الحبوب الممنوعة التي يتاجر بها والده. تجاهلي له دفعه لشد الكيس الذي أحمله الأمر الذي تسبب بشرخ في قاعه وبعثر محتوياته على الأرض.
كشف فعل أيهم الانتقامي ما تحتويه حقيبتي، فمشاهدة صغيرة كانت كفيلة بأن أعرف أن ما أقوم بنقله عبارة عن منشطات ذكرية يحظر بيعها. تضاعف خوفي وودت تمزيق الصغير، صرخت به إلا أنه جرى مسرعاً منتصراً. لملمت ما تبعثر وتابعت سيري متمنياً ألا يكون أحد قد لاحظ محتويات الحقيبة.
كحال أيهم، تتناثر في منطقة الفاتح أفراد وأُسر من حلب، إدلب، الرقة، ومحافظات سورية أخرى أغلبهم أو كلهم من الأطفال والنساء، يتسولون بلغتهم العربية ولهجاتهم السورية المتنوعة، وعلى ما يبدو، فإن أغلب مخططات هؤلاء بنيت على أساس غريزي وعاطفي.
فبعد أن تمكن أحدهم من جلب عائلته، زوجة وأطفال على وجه الخصوص بطرق هجرة غير شرعية، ترفض السلطات هنا الاعتراف بهم فينتشرون على أرصفة المدينة وفي أماكن تجمع القمامة كطفح جلدي. يتم في بعض الأيام ترحيل أعداد كبيرة، إلا أنها وبشكل غريب تُعاود الظهور في اليوم الذي يليه.
تصوير: علي الرميض
لقاء مع فارس الأحلام
نجوى (ثلاثين عاماً على الأغلب) واحدة من الذين سيختفون قريباً. عندما التقيتها قالت لي إن فكرة عودتها إلى سوريا لا تبارحها، إلا أنها مترددة، فبيتهم في مدينة أريحا في إدلب بات ركاماً منذ ما يزيد على الخمس سنوات.
قضت أياماً تصفها بالسوداء عند أقاربها مع ولديها الصغار في انتظار أن يؤمن لهم زوجها طريقة للخروج واللحاق به إلى هنا، إلا أن مغامرة الوصول غير الشرعية إلى تركيا تكللت باختفاء الزوج بعد مدة قصيرة. لم يترك من بقاياه سوى هويته الشخصية، إنها الإثبات الوحيد لها على أنها كانت فيما مضى مرتبطة برجل.
خلال النهار كانت تفترش وولديها أحد الأرصفة، تاركة مسافة قصيرة تفصل بينهما دون التفكير بزيادتها خشية إضاعتهما. منظرها كان مألوفاً لأعين الشرطة فلا يعيرونها اهتماماً.
مضت نجوى على هذا الحال ما يقارب التسعة أشهر. منذ أيام لم يعد لها أثر بعد أن أمسك البوليس أحد ولديها. تقول جارتها على الرصيف المقابل، “قد تكون الآن رحلت أو تم إرسالها إلى إحدى القرى الحدودية التركية، أو إحدى المخيمات”.
تضحك أحياناً وهي تضيف أنها قد تلتقي بفارس أحلامها في إحدى المرات بهذه الطريقة، أميرة فقيرة سينتشلها فارس وسيم ويدخلها قصره الفاره الضخم، والذي ستتنقل فيه ليوم كامل بحثاً عن الباب للانتقال من غرفة إلى أخرى
المرأة على الرصيف المقابل والتي تعود لقرية سجّو في ريف حلب الشمالي وتقارب جارتها في السن، متيقنة بأهمية الحيز الذي كانت تشغله نجوى على الرصيف، متمنيّة الانشطار واستغلاله، فغياب نجوى سيكون فرصة سانحة لنساء أو صغار آخرين لفرض سيطرتهم والاستيلاء عليه.
تفاخر جارة نجوى بأنها ما زالت تمارس هذه المهنة دون اللجوء لـ “قلة الأدب”. أتت إلى تركيا مع بعض أقربائها منذ ما يقارب الأربع سنوات، بعد قصف الطائرات لقريتها ووفاة والديها، إلا أن من قدموا معها لحقوا خلاصهم الفردي، تابعوا طريقهم إلى أوروبا دونها.
ذكرت لي في إحدى المرات أنها تحب ما تقوم به ولا تجيد عملاً غيره، تتسول بالعربية أو بلغة تركية ركيكة في بعض الأحيان، وتستطيع شم رائحة فريستها بطرق لا يتقنها أحد سواها، ولا تعتمد بالضرورة على المظهر الخارجي للشخص.
ذكرت لي أيضاً أنها منذ أتت إلى هنا حظيت بوزن زائد، وتشكّل على معصمها ما يشبه السوار من تغضنات لحمية. تضحك أحياناً وهي تضيف أنها قد تلتقي بفارس أحلامها في إحدى المرات بهذه الطريقة، أميرة فقيرة سينتشلها فارس وسيم ويدخلها قصره الفاره الضخم، والذي ستتنقل فيه ليوم كامل بحثاً عن الباب للانتقال من غرفة إلى أخرى، إلا أنني أظنها ستعود للتسول حتى في حال وجد هذا الفارس وقصره. ورغم أنها تبدو شخصية موتورة، غير متزنة عقلياً بعض الشيء، إلا أنها تبدو قوية، ومتشبثة بشيء ما لا تدري ما هو.
بحثاً عن تفاحة
منذ انتقلت إلى عملي هذا ألاحظ وجود رجل سوري في المتوسط من العمر، عينة بشرية أخرى لم أتمكن من التكهن بماهيتها، يقضي النهار يسير بشكل دائري حول البناء الذي أعمل فيه، ورغم مظهره المتأنق دوماً، إلا أنه يبدو وكأنه يعاني من خلل عقلي حديث العهد، يسير مسرعاً ويقف بغته وبشكل متكرر، يحدث نفسه بصوت مرتفع يستقر في آذان تبعد مئات الأمتار، ويتفوه بأقذع الألفاظ البذيئة والسباب ليلقيها على شخص آخر لا يراه غيره.
يدخن بنهم ويبقي نظره للأسفل، كما أنه يبالغ وهو يتحدث بلكنة قاطني ريف حلب جراء تفخيم مخارج حروفها. أراه بشكل شبه يومي، يختفي في المساء ويعود في صباح اليوم التالي. صادفته إحدى المرات يشتم سميرة (28 عاماً)، ويتابع سيره، كانت هذه المرة الأولى التي أراه يتوجه لأحدهم بالسباب بشكل مباشر.
تقضي سميرة معظم الوقت شبه مستقرة على طرف جسر صغير يفصل بين ضفتي الطريق، أراها دائماً أثناء تجاوزي لها للوصول إلى محل الفلافل القريب مني، ومن الصعب تجاهلها إذ كانت تنهال بحرارة على المارة بلهجة سكان محافظة الرقة، متوسلةً بعض المساعدة وفي حضنها فتاة صغيرة لم تتجاوز الثلاث سنوات متسخة وذات شعر متلبد، تبكي بشكل مستمر مصدرةً صوتاً ذا أزيز حاد يتشاجر للخروج، وكأنّه صوتان في نزاعٍ أيّهما يزيح الآخر ليستقر مكانه.
ترتدي الطفلة حذاءً ذا عنق طويل ممزقاً من الأسفل وتقضم إبهامها الأيسر بشكل دائم، أما شقيقها عمر الذي بدا يكبر الفتاة بحوالي ثلاث سنوات أو أكثر فقد غرس رأسه الذي اختفى تماماً في حاوية قمامة مجاورة، مرتدياً معطفاً تتدلى من أحد جانبيه خيوط قطنية مسودّة، ثم يرفع رأسه في النهاية منتشياً بانتصار ما، بعد أن وجد تفاحة متعفنة.
كنت أرى أمه تشاركه عملية البحث في حاوية القمامة أحياناً، تخرج الكيس من السلة، تجلس وتبحث على مهل، لكنها لم تشارك طفلها نشوة الانتصار مطلقاً. على العكس أظنني سمعتها في إحدى المرات توبخه، وغالباً عذرتها في هذا.
إحصاء لتقليل الخسائر
مع مرور الوقت كفت سميرة عن ملاحظتي حتى، جراء عدم استجابتي لها، إلا أنه منذ أيام قليلة استوقفني ابنها عمر، كان بمفرده نائماً على ضفة الطريق وكأنه شخصية كرتونية خرجت من إحدى أفلام ميازاكي، بدا جثة منهكة، فارس يأخذ قسطاً من الراحة قبل استئناف معركته مع برميل القمامة ذاك، كان غارقاً في النوم ووجهه للأرض رغم الغزارة التي انهمر فيها المطر حينها.
لم يتطلب الأمر كثيراً من العناء لإقناعه بالقيام بنزهة محظورة، كان يطرح أسئلة كثيرة، ويتباهى بإنجازات لم يحققها بعد، أخذنا نراقب محلات الألبسة الفارهة من الخارج، وندخل في نزاع عندما يقع اختيار كلينا على ذات القطعة من الثياب، إلا أن فرق السن والحجم بيننا كان دائماً هو النهاية لكل خلاف.
تناولنا طعاماً لم ينل استحسانه كثيراً، ثم ودعته عند ذات النقطة التي التقيته بها واعداً إياه بوجبة أفضل المرة القادمة، آملاً أن يضع السيد ميازاكي نهاية سريعة لقصة صراع بطله مع برميل القمامة.
في كل مرة هناك المزيد من وجوه الأولاد على الأرصفة، أبدو وكأني لا أرى غيرها، بل بدأت أحصيها، وفي غياب أحدهم أتساءل أي رصيف قد استوطن اليوم.
بات الارتباط بيني وبين عدد منهم واضحاً، عرفت عنهم الكثير بطرق حقاً لا أعيها، فأغلب من تموضع وحجز له مكاناً في الشارع، هو من عائلة تقيم هنا، أو ينتمي لعائلة، ومنهم من يطفو وحده دون أي جذر يجذبه إلى أرض ما.
لا تتوقف الصحافة التركية عن محاولات الإحصاء، وتصور الأطفال غالباً كجزء يخضع للاستغلال تديره شبكات إجرامية منظّمة، لكن أحياناً كظاهرة “غير حضارية” تقضم جمال المدينة، ولا تخلو تعليقات القرّاء المتذمّرة من المطالبة بطردهم أو رميهم في السجون الإصلاحية
أتساءل إن كان أيوب وعمر قد دخَلا ضمن أي إحصاء يقوم به موفودو منظمات الإغاثة ذوي الخدود المتورّدة، لكن يبدو أنها فكرة غبية، فهدف الاحصائيات غالباً تحجيم الفاجعة، ومنحها كتلة تصورية تخفّف من حدتها.
الصحافة التركية لا تتوقف أيضاً عن محاولات الإحصاء، تصورهم غالباً كجزء يخضع للاستغلال تديره شبكات إجرامية منظّمة، لكن أحياناً كظاهرة “غير حضارية” تقضم جمال المدينة، ولا تخلو تعليقات القرّاء المتذمّرة من المطالبة بطردهم أو رميهم في السجون الإصلاحية.
في العام 2019 قامت ما تعرف بـ “فرقة السلام المتنقلة” لمكافحة التسول في مدينة اسطنبول برصد ما يزيد عن 3500 طفل، وجدت أن بينهم 976 طفلاً سورياً، أجبروا على التسول في الشوارع من قِبل عوائلهم وأقربائهم. أشارت الحملة إلى أن معظمهم توفيت عوائلهم في سوريا وأحضرهم أقرباؤهم إلى تركيا وأرغموهم على النزول إلى الشوارع ليثيروا عاطفة المارة.
يتطابق وصف المنظمة بشكل كبير مع تصريح “تانير أكبنار” وهو عضو الهيئة التدريسية لدى جامعة “أكدينيز” التركية الذي كان يتحدث بمناسبة “عيد الطفولة والسيادة الوطنية” في أبريل (نيسان) الماضي. ذكر أن قيام الأطفال السوريين بأعمال لا تتناسب مع سنهم، وبأجور زهيدة تتراوح بين 5 و25 ليرة تركية يومياً، كان سبباً في وقوع الاختيار عليهم لزجهم في مهن وأوضاع قاسية مقارنة بأقرانهم من الأتراك.
لطالما انتابني شعور أن لأي إحصائيات جانب أضخم مما ترصده، ويقترب توقعي هذا ليغدو يقيناً في حالة تلك الكائنات الهشة، المروضة بسياسات الخضوع والإذلال، والتي قد تُمارس ويمارَس عليها أي مهنة أو أي شيء دون تذمر أو اعتراض.
تصوير: علي الرميض
أسطورة الكلاب
من زار إسطنبول بالتأكيد قد لاحظ حشود الكلاب الأليفة التي تجوب شوارعها، كلاب سمينة خلتها في البداية فصائل نادرة، ثقبت إحدى أذنيها ووضع بها حلقات ملونة، ولم أكن أعلم في البداية أن هذا الاهتمام المبالغ فيه بهذه المخلوقات إنما هو وليد تاريخ دموي من الصراع مع البلديات والسكان.
حدث هذا في عام 1911 وهناك من ينسبه إلى عهد السلطان محمد الخامس. أمرت الحكومة التركية بجمع كلاب اسطنبول الضالّة ووضعها في جزيرة “هيرسيزاد” القاحلة بهدف التخلص منها.
الأتراك يعرفون هذه المذبحة اليوم باسم “هيرسيزاد” التي تعني “الجزيرة المشؤومة”. كانت النتيجة موت أكثر من ثمانين ألف كلب بسبب الجوع والعطش. اضطررت الكلاب لأكل بعضها بعضاً، جزء منها غرق أثناء محاولته الهرب من الجزيرة والسباحة في بحر مرمرة.
صاحبت المدينة عقدة ذنب اتجاه الكلاب دامت لنحو مائة عام، بل إن هناك من يعزو وقوع الزلزال الذي ضرب اسطنبول في 17 آب (أغسطس) عام 1999 إلى “لعنة الكلاب” التي حلت بعد المذبحة، وهو ما دفع الحكومة سنة 2021 إلى إصدار قانون حقوق الحيوان بعد سنوات من المماطلة والتأجيل، وهو قانون يعتبر الحيوانات الضالة “كائنات حية” ويلزم البلديات بإيوائها والعناية بها، فارضاً عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات على من يؤذيها أو يسيء معاملتها.
تعيش كلاب إسطنبول اليوم حياةً مدلّلة، تجوب الشوارع وتستلقي أحياناً إلى جانب الغرباء وكأنها تنصت إلى أحاديثهم، تبدو غير منزعجة من الضوضاء أو الخطر الناجم عن التدفق المستمر لحركة المرور. أما بالنسبة لواحد مثلي عاش حياته في سوريا، فتبدو المفارقة تبعث على السخرية والضحك.
كانت مجموعة من عناصر الشرطة تطارد فتاة في التاسعة أو العاشرة من عمرها على ما أظن، تحمل بين يديها صندوقاً ورقياً صغيراً مكشوفاً، متمسكة به وتأبى إفلاته رغم خطورة الموقف، استقر فيه بعض مما تعرضه للبيع. تجاوزتني مسرعة، بينما ضاعف العساكر حركتهم للحاق بها، والتي عرقلها بعض الشيء اعتراضي طريقهم في الاتجاه المعاكس
كانت السلطات لدينا تضع سموماً قاتلة في براميل القمامة للتخلص من الكلاب، وما زلت أتذكر حادثة وقعت منذ زمن في قريتي، عندما قام بعض الصبية بدسّ مجموعة من شفرات الحلاقة في قطع من العجين ورموها للكلاب، بعضها مات في ذات اليوم، والبعض الآخر أصبح لعابه يفرز لحى في خطوط حمراء لزجة وقضى نحبه فيما بعد.
في إحدى مهامي المتكررة في إيصال الحقيبة كان عواء الكلاب يرتفع، خطر في بالي ما كتبه جوزيه ساراماغو، “عندما تنبح الكلاب التي تعتبر حيوانات خرساء يكون ذلك علامة على نهاية العالم”. تعالى صوت الكلاب نتيجة إحساسها بخطر ما جراء من مرّوا بها مسرعين، أو ربما لاستشعارها نهاية العالم.
دخلت في البداية طريق لا يسير خلاله الكثير من المارة، بانعطافات ثعبانية بطيئة، سمعت صراخاً في آخر الممر إلا أن التوائه حجب الرؤية في البداية، والتي تدريجياً أتضحت. كانت مجموعة من عناصر الشرطة تطارد فتاة في التاسعة أو العاشرة من عمرها على ما أظن، تحمل بين يديها صندوقاً ورقياً صغيراً مكشوفاً، متمسكة به وتأبى إفلاته رغم خطورة الموقف، استقر فيه بعض مما تعرضه للبيع. تجاوزتني مسرعة، بينما ضاعف العساكر حركتهم للحاق بها، والتي عرقلها بعض الشيء اعتراضي طريقهم في الاتجاه المعاكس.
دفعني أحدهم بقوة ملصقاً إياي بالجدار، وطرحها أولهم أرضاً، ثم رفعها من ياقة معطفها وقد ارتسمت على جبينها زهرة صيفية حمراء مبهجة، جراء ارتطام جبهتها في الأرض. أخذت تقاوم بحركات ولغة ضعيفة كما بلدها الذي قذفها إلى هنا، رفعها في النهاية أحدهم عالياً لتطير في الهواء صارخة، مكشرة عن أنيابها فاردة مخالبها الصغيرة، مستعدة للنيل من الجيش التركي والسوري كله وحدها.
في طريق العودة سلكت مساراً آخر، متجنباً المكان الذي حدثت فيه الواقعة، خطر لي في البداية العودة وتجميع أشيائها المتناثرة إن بقيت مكانها، لعلي أراها مرة أخرى، لكن سرعان ما اقتلعت هذه الفكرة الغبية من رأسي.
عادات قديمة
الحتمية التي فرضتها على نفسي لسلوك الطريق الطويل، كانت تجبرني أيضاً على المرور بأيهم، ذات الصبي الذي أنتقم مني بثقب الكيس الذي أحمله سابقاً، إلا أن العلاقة بيننا كانت قد توطدت نوعاً ما.
يتموضع أيهم دائماً في ذات المكان، فارداً مقتنياته من مناديل ورقية وغيرها أمامه، ودائماً ما أراه ينجز وظيفته المدرسية على الرصيف مستنداً على ذراعيه وسط سيل متدفق من الأقدام.
لاحظت أنه يتعلم الحروف العربية، أول مرة أراه كان بحرف التاء، أظن آخر مرة رأيته قد وصل لحرف العين، التي يكتبها بخط مرتجف، على ورق مبلّل مما يجعل القلم ينزلق ويثقب صفحتين في آن.
كنت أشعر بوجنتيه البارزتين ترتجفان وتتغضنان عندما أسأله عن أهله وعن والده تحديداً. إحدى المرات بعد أن أخفض صوته وكأنه يفشي سراً، وبعد أن أخذ وعداً مني ألا أخبر والده رغم عدم معرفتي به، قام بسرد مجموعة مبعثرة من التفاصيل عنه، ما كان يتطلب عناء تجميعها معاً لتركيب الحكاية بشكل واضح.
خرج في أحد الأيام للعمل وقد نسي أوراقه وبطاقة اللجوء في البيت، الأمر الذي لم تصدقه عناصر الشرطة الذين اعترضوه، أنه يملك هذه الأوراق فعلاً، كما لم يمنحوه فرصة جلبها لهم ليثبت ذلك، وبلا مقدمات حشروا كتلته الجسدية في مؤخرة سيارتهم واستودعوه في نعيم وطنه الأم عند أول نقطة حدودية
ينحدر أيهم وعائلته من منطقة إعزاز في حلب، يملك والده عربة يدوية نقالة تعرف هنا بـ “تشك تشك” بعجلتين صغيرتين، وقد لف عليها شادراً وحوّلها لما يشبه الصندوق، ينقب في القمامة ويخرج مواد قابلة لإعادة التدوير كعلب البلاستك والصناديق الورقية ثم يبيعها.
لاحظت هذا النوع من الأعمال لدى العديد من الأشخاص منذ وصولي إلى تركيا، إلا أن لعمل والد أيهم جانباً آخر يبدو أنه يبعث الخوف في نفس الصغير. ففي بعض الأيام يزوره صديقه محضراً معه أكياس صغيرة أو علب بذات الحجم من الحبوب، ثم يبيعها والده بحذر وخفية. أختلج صوته عندما بدأ يتطرق لما جلبته مهنة والده هذه على شقيقته الصغرى ذات العام ونصف.
تابع وكأنه يصارع ضحكة وغصة في آن، في أحد الأيام وعلى غفلة من والديه اعترضت إحدى أكياس الحبوب اليد العمياء للصغيرة وابتلعت كمية منها، أفرز هذا عن تشنجها، وإحالة لون بشرتها لأسود مزرق، ثم تدفقت كتل من الزبد من فمها إلى أن ماتت في النهاية.
توقف والده المصاب بكسر بإحدى فقراته الظهرية لفترة عن مزاولة العمل والاكتفاء بتنقيبه في براميل القمامة، إلا أنه عاد بعد فترة وجيزة، وعاد أيضاً لممارسة إحدى عادته القديمة، بأن ينهال على زوجته بالضرب كلما داهمته نوبة غضب.
تصوير: علي الرميض
وسام شرف
لقائي الأخير بأيوب كشف عن جانب مرح في شخصيته، هذه المرة كان قد أنتهى من تدخين سجائره المجانية، وتحدث كمن يلقي فكاهة عن أخوته الثمانية، ووالدته، في الوقت الحالي يشكل وأخاه الأصغر مصدر الدخل الرئيسي للعائلة، إذ أن أمه لا تقوى على العمل والحركة بشكل جيد، أما والده فقد ارتكب خطأً كلفه ترحيله إلى قرية جرادة في إدلب منذ ثمانية شهور، خرج في أحد الأيام للعمل وقد نسي أوراقه وبطاقة اللجوء في البيت، الأمر الذي لم تصدقه عناصر الشرطة الذين اعترضوه، أنه يملك هذه الأوراق فعلاً، كما لم يمنحوه فرصة جلبها لهم ليثبت ذلك، وبلا مقدمات حشروا كتلته الجسدية في مؤخرة سيارتهم واستودعوه في نعيم وطنه الأم عند أول نقطة حدودية.
منذ زمن وفي حوالي عام 2013 كان شقيق أيوب الأكبر قد توفي أثناء أداءه لخدمته العسكرية في غوطة دمشق، بعد هذا منت السلطات السورية على والديه بوسام شرف، أخذ أباه يتباها به، ويحدثه أحياناً، وصولاً إلى وضعه في إطار وتثبيته على أكثر جدران المنزل بروزاً، إلا أنه ضاع بعد احتراق منزلهم وانهياره، أخذ والده بعدها يتردد على المؤسسات الحكومية لمنحه أثبات شرف بديل أنه والد لشهيد سطر بدمه انتصارات زائفه لوطن زائف، إلا أن المؤسسات الحكومية أخذت تتقاذفه بسخرية عناصرها ككرة مضرب، في النهاية أعطوه قرص مدمج CD، يفترض أنه فيلم وثائقي أو ما شابه يحتوي على مشاهد لبطولات الابن، إلا أن العائلة لم تتأكد من وجود ابنها في هذا الشريط.
لم تشاهد الفيلم مطلقاً..
لم يكن لديهم مشغل أقراص مدمجة.