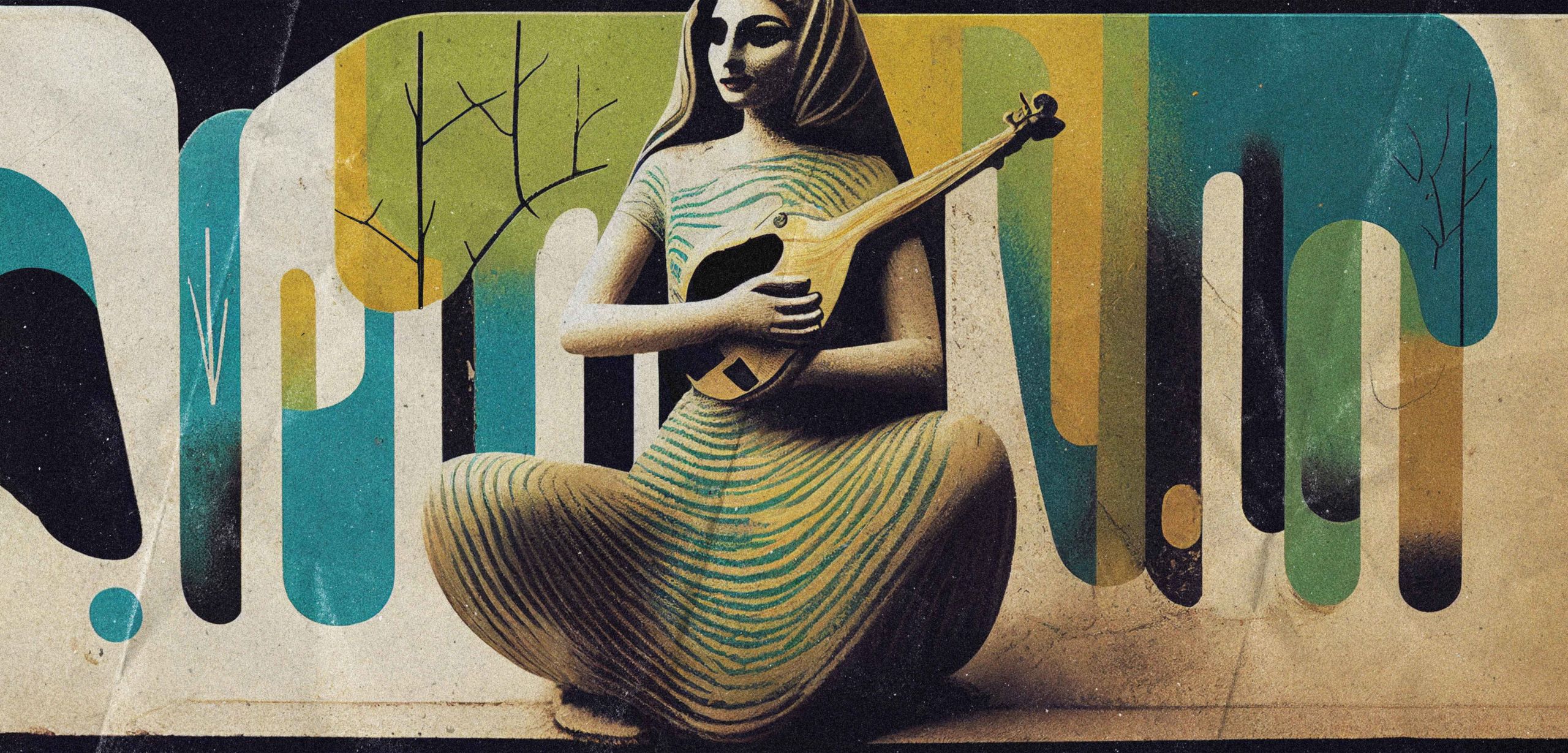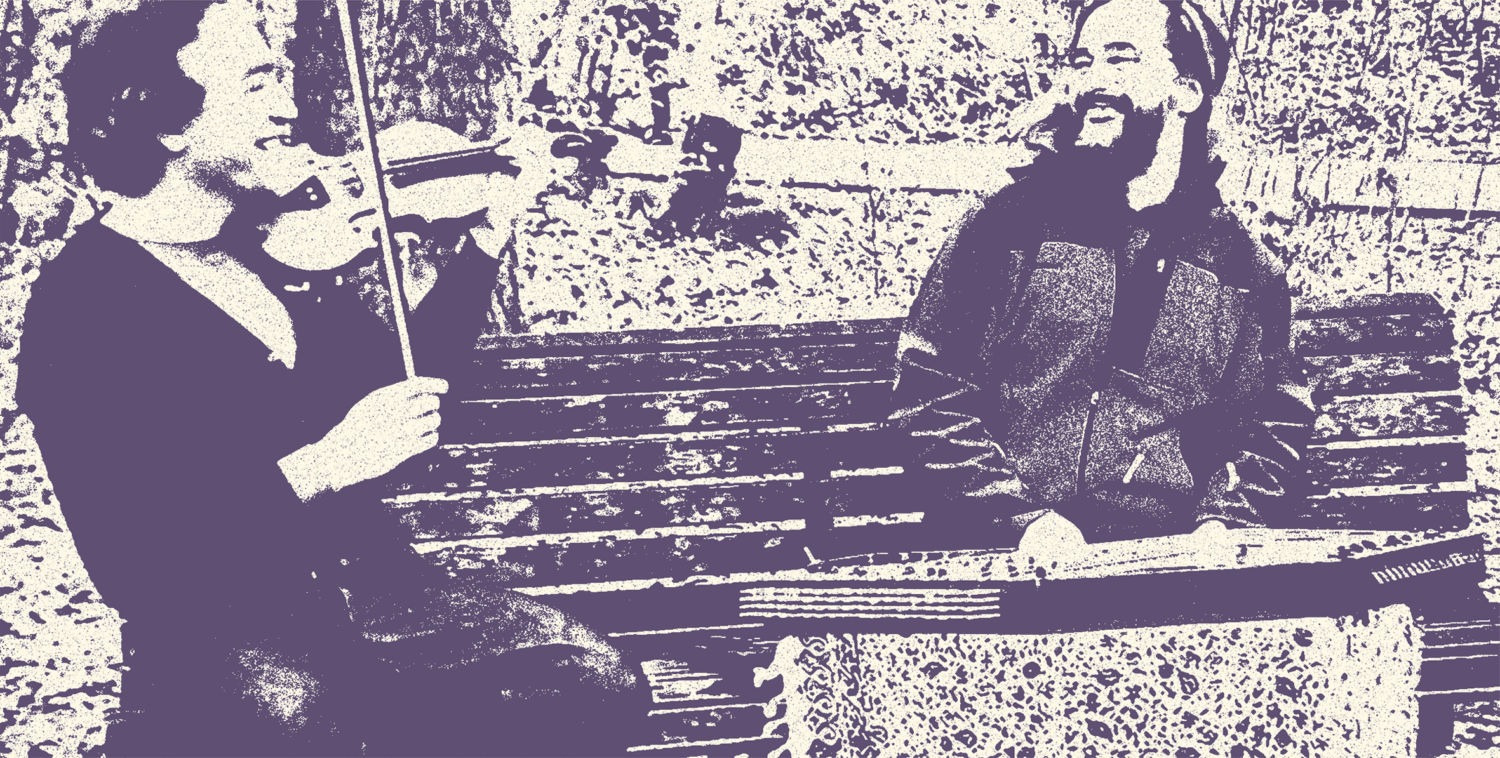عرفتُ الحاج نور الدين في صدفة لا يمكن أن تتكرر. على رصيف مقهى صغير قرب محطة مترو ستراسبورغ – سان دوني في باريس، كنت أجلس إلى صديقٍ والحديث بيننا سجال حول فناني بلدان المغرب اليهود، وكعادتي في مثل هذه السجالات تحمست أكثر من اللازم حتى بلغ صوتي طاولة جارنا، فتدخل في الحوار بجدية وربع ابتسامة تفر من شفتيه، مصححًا بعض معلوماتنا الخاطئة حول سليم الهلالي ثم دندن بصوت فيه حشرجة تكشف عن طبقاتٍ من تجارب الحياة، أغنية شهيرة لسليم:
تِسفر وتتغرب تحضِر ولاّ تغيب / ڤد ما تدور وتڤلّب ما تلقاش حْبيب / غير إسألْ مُجرّب ما تسألْش طْبيب ..
غادر الصديق على أمل اللقاء وطالت الجلسة مع الحاج، وتشعبت الأحاديث حول سليم وحياته، لأقوم باكتشاف كنز تاريخي عاصر سليم واشتغل معه سنوات عزه ومجده. عرضت عليه أن أدون شهادته. وافق دون تردد. كان جادًا ومتحمسًا وضرب لي موعدًا في مقهى بشارع الآباء القديسين في الدائرة السابعة. وتعاهدنا على اللقاء.
شأنه شأن صباحات الآحاد، كانت الحركة في ذلك الصباح الباريسي خفيفة. نزلت إلى وسط المدينة باكرًا. أمشي في شارعٍ غير واسع، مسيج بالأشجار والفراغ. حركتي سريعة نحو شارع الآباء القديسين، ينجلي معها غموض الطريق شيئًا فشيئًا.
عندما جلست إلى طاولةٍ على الرصيف رمقت يدًا تلوح لي من داخل المقهى. يدٌ ترتفع بصعوبة في باطن كفها تجاعيد قديمة محفورة بعناية القدر. في لحظة عدت مفعمًا بالتوقعات دفعةً واحدةً، وأصبح أنظر أمامي صور الحكايات التي اختزنها الغياب مجسدةً في ملامح الحاج. سلّمت بحرارة وخوفًا من أن يهرب، أو أن تضيع شهادته في الأحاديث الجانبية، طلبت إليه بلطف أن نشرع في الحديث عن سليم ومعرفته به:
“اسمي نور الدين. ولدت في تونس منتصف أربعينات القرن الماضي. حالي حال كثير من أبناء جيلي هاجرت إلى فرنسا منتصف الستينيات على ظهر سفينة بضائع ايطالية ألقت بي وحيدًا في ميناء مرسيليا، بعد حصولي على شهادة الثانوية المهنية وتسكعي في شوارع العاصمة دون فائدة. كنت يتيم الأبوين، لذلك لم أفكر يوماً في العودة. كانت باريس حينذاك ساحرةً. تغلي بالناس والسياسة والمهاجرين الجدد.”
يكمل: “تلقفني بعض الأصحاب وعملت في حظائر البناء سنوات قليلة حتى العام 1969، عندما التقيت بشخص يهودي تونسي، كانت بيننا معرفة سطحية في تونس، وكان يعمل متعهد حفلات في فرنسا، فعرض عليا العمل معه كمساعد: أرتب فضاءات الحفلات وأساعد الحراسة أحيانًا وأقوم بهمام الأمن في أحيان أخرى. كان العرض مغرياً لمن هم مثلي، ويكابدون المشقة في حضائر البناء العارية شتاءً. من هنا بدأت علاقتي بهذا العالم، وعلاقتي بسليم الهلالي، بوصفه واحدًا من نجوم عالم كباريهات باريس. وقد صادف دخولي عوالم ليالي باريس العربية عودة سليم إليها بعد غياب. ثم جاء زمان عصيب وحاد فتفرقت السبل بأبطال هذه العوالم. كان سبيلي نحو ‘توبةٍ’ جاءت على حين غِرَّة، عندما حزمت متاعي بداية تسعينيات القرن الماضي وشددت الرحال إلى قبر الرسول مجاوراً له وطالبًا السكينة. ولم يبق في خاطري من ذلك الزمان المجنون غير محبة صافيةٍ لرفاق الصبا.”
اتكئ الحاج نور الدين بكوعيه على سطح الطاولة وراح يحدق في وجهي. وبينما كان يهمّ بالحديث قاطعته بسؤال حتى أقطع حالة التأثر التي دخل فيها وأعيد وعيه إلى الحاضر. كانت ذاكرته دقيقة وهي تزحف نحو عقدها الثامن. يتذكر الأسماء والأماكن والتواريخ. ويذكر ملامح سليم وهو يعيد أمامه وأمام أصدقائه في كل مرة ماذا قالت له أم كلثوم: “لا مطربين بعدك”. هل كانت كوكب الشرق تبالغ من باب المجاملة؟ لا أحد يعلم حقيقة رأيها غيرها، ولكن سليم الهلالي كان فعلاً يردد ذلك في كل مجلس. في مقابلة مع سيرج علوش، قبل وفاته سنوات قليلة، قال الكلام نفسه، وأضاف معللاً:” لأنني أجدت غناء مقام النكريز“.
غلاف اسطوانة Salim Halali en public
سيرةٌ تقهر الزوايا الحادة
جزائري، يهودي، أمازيغي، مثلي، وفقير. ولد سليم الهلالي (اسمه الحقيقي سيمون) في عنابة، شرق الجزائر (1920)، وارثًا كل هذه المفارقات. أي روح قادرة على احتمال وطأة هذه الموروثات المتعارضة حينًا والمتألفة أحيانًا؟ لكن كل ذلك لم يعجزه عن صنع وجوده الخاص. على الرغم من أنه لم يكن دائمًا متحكّمًا في وجوده، بل أحيانًا كان ريشة تحركها الأقدار، التي وقفت في صفه، في لحظة أعطت ظهرها للكثيرين من أمثاله.
في عام 1934 وصل سليم إلى ميناء مرسيليا قادمًا من الجزائر، وبعد سنوات من التسكع والترنم على الأرصفة وفي الشوارع ظفر بفرصة للغناء في فرقةٍ إسبانية، وقد برع في الفلامينكو وبدأ بالظهور في نوادي الدائرة التاسعة الليلية، خاصةً في شارع فوبورغ مونمارتر وساحة كيليشي.
لم يمض وقت طويل، حتى التقى بالموسيقي وكاتب الأغاني الجزائري محمد الكمال (واسمه الحقيقي محمد هامل) و المسرحي الجزائري محيي الدين بشطارزي (1897-1986)، اللذان حولا وجهته نحو الغناء العربي والمقامات الشرقية، ثم تعزز هذا التوجه بعد لقائه مع الملحن الجزائري محمد اغربوشن.
خلال هذه الفترة حافظ سليم على طابعه الإسباني، لكن بنَفسٍ عربي أندلسي. كتب له محمد الكمال أغانٍ جديدة في هذا الاتجاه حققت له نجاحًا كبيرًا في نوادي الليل الباريسية بين الحربين أبرزها: “ريت الزين” و “العشق صعيب” و “تعالي” و “القلب شاهيك”، وجميعها من ألحان محمد اقربوشن.
طاف سليم مع فرقة “المطربية” لصاحبها الموسيقي الجزائري إدمون يافيل (1874-1928) مدنًا فرنسية وأوروبية عديدة، بوصفه نجمًا صاعدًا، وغنى من أغانيه وأغاني من التراث المغاربي. فكان العمال المغاربيين ينسون وعثاء العمل طيلة اليوم في المصانع الكئيبة طربًا على أنغام “دور بيها يا الشيباني“، إحدى الأغاني الأكثر شيوعًا في التراث الجزائري، حين يختم بها الهلالي الحفل ويعطيها من روحه فائضًا من البهجة والإيقاع.
لكن هتلر لم يمهل سليم الهلالي طويلًا. سقطت أحلام النجومية في بركة الحرب، ودخلت فرنسا في دوامة من النكسات حتى وصلت قوات الرايخ الألماني شوارع باريس عشية 14 يونيو 1940. كانت سمعة الألمان قد سبقتهم إلى باريس. حيث أصبح كل يهودي يخشى على نفسه الهلاك، وكان سليم واحداً من هؤلاء المطاردين.
كانت باريس موحشةً. المضي فيها موت، والبقاء موت. ولا مفر من الدخول في السرية. يمّمَ الفنان اليهودي وجههُ شطرَ جامع باريس الكبير، مستجيرًا بعميده قدور بن غبريط. انخرط العميد باكرًا في مقاومة الاحتلال النازي على طريقته الخاصة. دون قتال أو صدام، تحول المسجد في البداية إلى ملجئٍ للجنود من شمال إفريقيا الذين تمكنوا من الفرار من معسكرات الاعتقال الألمانية، وبدايةً من عام 1942، واشتداد القبضة على يهود فرنسا، بدأ في الترحيب بالعائلات اليهودية.
في عام 1942، تم إنقاذ سليم الهلالي من معسكرات الاعتقال بفضل تدخل قدور بن غبريط، عميد مسجد باريس، الذي أصدر له شهادة اعتناق الإسلام باسمه. ولتأكيد ذلك، نُقِش اسم والده على قبرٍ مهجور في مقبرة بوبيني الإسلامية. كما قام بتوظيفه في مقهى مسجد باريس حيث كان يؤدي بشكل منتظم مقطوعات غنائية طربية
أُخفِيَ الكبار في الأقبية، واندمج الأطفال ضمن العائلات المسلمة التي تعيش داخل المسجد. خلال مداهمات الشرطة أو القوات الألمانية، كان اللاجئون يهرعون إلى مصلى النساء، وهو مكان ممنوع على الرجال. كما وفرّ بن غبريط شهادات ميلادٍ مزورة مصادقة من المسجد، تثبت انتماء هؤلاء اليهود إلى الإسلام، وتجعلهم خارج مرمى الهستيريا النازية. كان سليم الهلالي من بين هؤلاء، مسلمًا على الورق وأحد المرابطين داخل أسوار الجامع الكبير. حكاية ظهرت بعد سبعة عقود على شاشة السينما في فيلم “الرجال الأحرار” للمغربي إسماعيل فروخي. لم يكن سليم غريبًا عن مسجد باريس، فقد كان يتردد على مقهاه قبل الحرب ويؤدي داخلها عروضًا فنية مع رفاقه الجزائريين، ومن هنا بدأت معرفته بعميد المسجد الذي كان شغوفًا بالموسيقى الأندلسية.
ينقل المؤرخ الفرنسي جون لالوم، في دراسة نشرت العام 2012 بعنوان “السينما والتاريخ: مسجد باريس واليهود تحت الاحتلال”، عن سليم (سيمون) الهلالي: “في عام 1942، تم إنقاذه من معسكرات الاعتقال بفضل تدخل قدور بن غبريط، عميد مسجد باريس، الذي أصدر له شهادة اعتناق الإسلام باسمه. ولتأكيد ذلك، نُقِش اسم والده على قبرٍ مهجور في مقبرة بوبيني الإسلامية. كما قام بتوظيفه في مقهى مسجد باريس حيث كان يؤدي بشكل منتظم مقطوعات غنائية طربية”.
أسأل الحاج نور الدين عن قصة جامع باريس فيفرك يديه بلطف ويضحك بخفة، لكأنه يتذكر صورًا ومشاهد، ثم يقول:
“علمت بقصة الجامع وما حدث خلال غزو الألمان من سليم نفسه. كان لا ينسى ذكرها في كل مجلس، ويذكر بالخير الكثير سي قدور بن غبريط. ويفاخر بأنه مشى قرب الموت مرات في تلك المحنة دون أن يدركه. أحيانًا كان يذكر ذلك ويقهقه قائلاً ‘عمر لكلاب طويل’ قاصدًا نفسه.
أذكر مرة كنا معه، أنا وبعض الأصدقاء، في الدائرة الخامسة قرب محطة مترو كاردينال ليموان، فأصرّ على المرور بالمسجد، ودخل صحنه وتجول في الحديقة متأملاً النافورة طويلاً. وعندما خرج كانت في عينيه دموع محبوسة. ولا أذكر أنه جاء باريس مرة دون أن يجلس في مقهى الجامع ويعيد سرد حكايات الصبا. كان مبتهجًا دائمًا، لكن في المقهى كنت أرى الحزن في ملامح وجهه. للبهجة وقت وللحزن وقت.”
يتذكر العجوز التونسي: “هذه الفترة من حياته قلبت تفكيره تمامًا. فقد كان في ذلك الوقت من بداية السبعينات، وقد بدأت نوازع العنصرية ضد العرب والمسلمين في الانتشار. ولكنه كان ينتصر لنا. لم تكن يهوديته حائلاً أمام إنسانية متأصلة فيه. كان معادٍ صريح للصهيونية، وعندما تذكر أمامه إسرائيل كان ينهر بسيل من الكلام البذيء. كان رحمه الله مبدعًا في الشتم بالكلام البذيء كما نعرفه في لهجتنا المغاربية. وبارعًا في إتقان اللهجة التونسية والجزائرية والمغربية بالجودة نفسها. وذلك ما جعله متقنًا لأداء أغاني بلاد المغرب ببراعة.”
تركت الحرب آثارًا في نفس سليم الهلالي، بعد أن فقد شقيقته الصغرى، بيرث، التي كانت تعيش قربه في شقة بشارع فرانسوا ميرون بحي الماريه -باريس- التاريخي. ألقت الشرطة الألمانية عليها القبض في أغسطس في معتقل بمدينة درانسي، ثم تم ترحيلها في سبتمبر من نفس العام إلى معسكر الإبادة أوشفيتز مع ابنها الرضيع، كلود. ولم يبق من ذكراها غير صورة نصفية وضعها سليم على شاهد قبر والدتهما شيلبيا ماري بالمقبرة الباريسية في بانو. قبل ذلك وعند بداية الحرب غادر محمد الكمال إلى ألمانيا للعمل في راديو برلين العربي، صوت الدعاية النازية، وما لبث طويلاً حتى إلتحق به محمد اغربوشن. طعنة أخرى في ظهر سليم. تفرق الأصدقاء أَيْدِي سَبا، ليبقى ذلك جرحاً في قلب سليم.
أسرى حرب ألمان يسيرون عبر شوارع باريس، 25 أوت (أغسطس) 1944. المصدر: FDR Presidential Library & Museum. تحت رخصة المشاع الإبداعي
الفن يمسح آثار العدوان
أصبح الصبح. تحررت باريس من محتلها ووُلِدَ الهلالي من الجديد. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة. لم يضيّع سليم وقتًا طويلاً في العودة إلى استوديو التسجيل. خلال هذه المرحلة لم يستأنف تعاونه مع مواطنيه محمد إغربوشن ومحمد الكمال، بل توجه بشكل كبير إلى عددٍ من الفنانين اليهود التونسيين بينهم غاستون بصيري، وسيمون أميل، ومسعود حبيب وأصدر في 1947 إسطوانة “اضرب كاسي“، عن تسجيلات الإخوان باثي في باريس.
وقد تميزت هذه المرحلة في مسيرة سليم بإعادة إحياء تراث الأغنية اليهودية المغاربية، لاسيما التونسية، من خلال إعادة توزيع أغاني التونسي الشيخ العفريت مثل “تسفّر وتتغرّب” و”يا ناس هملت” وغيرها. وكان هذا النوع من الغناء متحررًا إلى أبعد الحدود في كلماته من المحرمات، لاسيما الجنسية، والتابوهات، التي كانت سائدةً آنذاك في ما يتعلق بالتغزل بالنساء.
بدأ نجم سليم في الصعود داخل أوساط الجاليات المغربية. أغانيه كانت بلسمًا لجمعٍ واسع من الطبقة العاملة في مصانع الحوض الباريسي نهاية الأسبوع. مواويله عن الغربة والحنين والنساء، وصوته المشوب ببحةٍ خفيفة، وملابسه الملونة الغريبة، القميص الطويل مفتوح الصدر، والجلابة المغربية المطرزة التي يرتديها، كلها كانت جزءًا حاضرًا من وطنٍ مفقود. وطنٌ بعيد في الجغرافيا، بسبب الغربة وبعيد في التاريخ بسبب الاستعمار. خلال هذه الفترة أقام سليم حفلات كثيرة في كباريهات باريس العربية، ولاسيما “تام تام“، الذي كان أحد القلاع المغاربية فناً وسياسةً، حيث كان صاحبه، محمد فتوكي، والد وردة الجزائرية، داعمًا لحزب الشعب، ولاحقًا داعماً لجبهة التحرير الوطني، من خلال تخزين الأسلحة داخل أقبية الكباريه.
بعد أن كسب قدرًا من الشهرة والمال توجه الهلالي نحو إنشاء كباريه خاص به في عام 1947، عندما حوّل القصر الخاص لفرديناند دي ليسبس، المهندس الفرنسي الأشهر وصاحب فكرة حفر قناة السويس، في شارع مونتين، إلى كباريه يحمل اسم “إسماعيلية فوليز”؛ ثم نقله في عام 1948 إلى موقع آخر، في شارع كوليزيه، تحت اسم جديد “لو سيراي”.
وقد استفاد حينذاك من تنامي حركة الهجرة المغاربية إلى فرنسا في أعقاب الحرب وبدايات مشاريع إعادة الإعمار ومشروع مارشال، وكذلك تنامي هجرة يهود شمال إفريقيا بعد حرب فلسطين. وقد شكل هذين العاملين توسع قاعدة زبائن الملاهي العربية والمغاربية، خاصةً، في باريس. كانت المنافسة في العاصمة الفرنسية شديدة، وكان حظ الهلالي من حذق التجارة ضئيلاً، فلم تسعفه موهبته الفنية في إدارة الكباريه، الذي مضى نحو الإفلاس سريعاً.
عاد سليم إلى للغناء في كباريهات باريس وأقام حفلات خاصة في الفيلا التي يسكنها في الجنوب، كان يحضرها مشاهير الغناء العربي و المغاربي حينذاك، والذين كانوا يأتون إلى فرنسا في مواسم خاصة للغناء مثل عيد الفطر وعيد الميلاد من بينهم فريد الأطرش وصفية الشامية من تونس وفتحية خيري وربما محمد مازوني وغيرهم ..
كانت خصال سليم تقترب من الإسراف والسخاء المفرط. لا يلقي بالاً للمال. يبدّده كيفما شاء دون حساب. بدا ذلك في ملابسه الباهظة، والتي تخاط له خصيصًا، وفي البيوت التي سكنها. لذلك كان أبعد الناس عن حذق التجارة والإدارة. وهذه خصيصةٌ ستلاحقه في بقية مشواره.
عافت نفسه باريس بعد الخيبة التجارية. فغادر في عام 1949 نحو المغرب الأقصى. وفي الدار البيضاء، وتحديداً في حي الملاّح اليهودي اشترى مقهى قديم وحوله إلى كباريه أطلق عليه اسم “الديك الذهبي”، كان مزارًا، لعقدٍ من الزمن، لأعيان المغرب والعائلات المقربة من البلاط وحتى للأمراء والملوك العرب وأشهرهم الملك فاروق، ملك مصر.
وعلى خشبته غنى العديد من الفنانين مثل:الحاجة الحمداوية (المغرب) وشافية رشدي (تونس) وفتحية خيري (تونس) ولين مونتي (الجزائر) ووردة (الجزائر) والمعطي بن قاسم (المغرب) وعمر طنطاوي (المغرب). لكن التجربة المغربية، قد بدأت برائعة “سيدي حبيبي“، انتهت على نحو كارثي، بحريق كبير التهم الكباريه أعقبته عودة خائبة لسليم إلى فرنسا.
عاد الهلالي إلى باريس منكسرًا. دفعته حالته النفسية السيئة إلى المغادرة مرة ثانيةً. هذه المرة نحو إسرائيل، دولة اليهود الوليدة. وكونه كان معادٍ صريح للصهيونية، لم يطل مقامه هناك طويلاً. ويذكر الموسيقي الإسرائيلي، توم كوهين، في مقال له أن سليم الهلالي صاح باللغة العربية خلال عرض في القدس في الستينيات: “عاشت الأمة العربية”، وكان ذلك أخر عهده بالقدس، بعد أن أصبح في مرمى الجمهور الذي لم يوفر الفضلات وقوارير المياه كي يصيبه بها. وهذه خيبةٌ أخرى في مسيرة فنان يحمل هوية متوترة. وميولاً لا تتوافق مع السائد. يحدثني الحاج نور الدين عن قصة اكتشافه لمثلية سليم قائلاً:
“عندما تعرفت على سليم نهاية الستينات، صحبة صديقي اليهودي التونسي، لم يكن يقيم في باريس. كان يأتي إليها كل أسبوع تقريبًا، لكنه فضل الإقامة في فيلا فخمة جنوب فرنسا. ولم أكن أعي حقيقة ميوله، حتى حدثني عن ذلك زميل لي في حراسة ملهى كنت أعمل فيه في شارع سان ميشال بالحي اللاتيني. كان يسخر مني ويسألني عن حقيقة علاقتي بسليم. كنت خالي البال من أي فكرة حوله وحول ميله نحو الرجال.”
يواصل الحاج: ” في البدء نظرت إليه بتقزز. لم أكن متقبلاً للفكرة. ثم بدأت أراقب سلوكه. كان سخيًا مع الجميع منتصرًا دائمًا لنا بوصفنا مهاجرين عرب ومسلمين ومجر عمال، أقل شأنًا، فيما كان بعض العرب والمسلمين ينظرون إلينا باحتقار، خاصة من زوار الملاهي. يساعدنا بالمال وبالتوصيات خاصة في مسائل ترتيب الإقامات والأوراق. عندما كان يتحمس لما يجري في فلسطين كان بعض العرب والمسلمين يسخرون منه. كشف لنا ذلك أن مسألة الرجولة ليست متعلقةً أبدًا بأجناس الناس بل بمعدنهم. أنا في النهاية عربي ومسلم، ولا أزال غير متقبل للفكرة. لكن دائمًا عندما أتذكره أقول سيغفر الله له لأنه يحب خلقه ويعطف عليهم.”
خلال هذه الفترة عاد سليم إلى للغناء في كباريهات باريس وأقام حفلات خاصة في الفيلا التي يسكنها في الجنوب، كان يحضرها مشاهير الغناء العربي و المغاربي حينذاك، والذين كانوا يأتون إلى فرنسا في مواسم خاصة للغناء مثل عيد الفطر وعيد الميلاد من بينهم، يتذكر الحاج نور الدين: “فريد الأطرش وصفية الشامية من تونس وفتحية خيري وربما محمد مازوني وغيرهم. ومن خلال سليم تعرفت على هؤلاء. كانت السبعينيات العقد الأخير في تاريخ الكباريهات الباريسية العربية. ومع نهايتها بدأت أذواق الناس تتغير، وزحف الرّاي بقوة وبدأت أحوال الجاليات المغاربية في التحول. لم تعد مجرد كتل من العمال الباحثين عن البهجة أو مثقفين من ذوي الأذواق الطربية، بل عائلات مستقرة، ليس بوارد أن تكون من جمهور ليل.”
المصدر: folkmusicsmb.blogspot
مستدار الثمانينات: الخوف من الغروب
أذِنت شمس عهدٍ كاملٍ على الأفول. شهدت الثمانينات صعودًا كبيرًا لما بات يعرف بالصحوة الإسلامية، التي بلغت آثارها المهاجر الأوروبية، مدفوعة بلجوء المئات من الإسلاميين إلى فرنسا هربًا من الأنظمة السياسية في بلاد المغرب والشام ومصر. ترافق ذلك مع صعود الاشتراكيين للسلطة في باريس، والذين فتحوا المجال واسعًا أمام سياسة لمّ الشمل، وتحولت طبيعة الجالية من الأفراد إلى العائلات. بدأ المزاج العام للجالية في التحول نحو مزيد من المحافظة والتدين. لم تعد الكباريهات مصدر جذب ولم يعد للفن الذي تقدمه جمهور. في المقابل كان شباب الضواحي مستمتعًا بالرّاي، الذي أخذ مكانه بقوة.
في أجواء الغروب هذه، واصل سليم إقامةَ بعض الحفلات هنا وهناك. محافظًا على نسقٍ من البهجة الخاصة في فيلته الفخمة. كان الحاج نور الدين، شأنه شأن كثرين قد فقد عمله في أحد الكباريهات في الحي اللاتيني، ثم توجه مزاولة أعمال وقتية في الحراسة، ليطوي صفحة المرح بعمرةٍ ثم حجة واعتكافٍ طويل.
كان قرار الإعتزال يراود سليم الهلالي منذ منتصف الثمانينات، كما يقول نور الدين. لكن القرار تأجل حتى العام 1993 عندما قرر بيع فيلته في مدينة كان والانتقال إلى سكن جماعي مخصص لكبار السن في مدينة فالوريس جنوب فرنسا. حتى وفاته في عام 2005.
كان في عزلة مديدة عوّض بها عقودًا من الصخب لكنه احتفظ ببهجةٍ طفولية وروح مرحة إلى أبعد الحدود، كما يتجلى ذلك في المقابلة اليتيمة التي أجريت له خلال تلك الفترة على يد سيرج علوش. ويذكر الكاتب المغربي، محمد امسكين، في مقال تأبيني للهلالي بعنوان “موت تروبادور الحب” أن سليم بعد اعتزاله قد عهد بحقوق أغانيه لجمعية خيرية في الجزائر، وأنه كان في كل عيد أضحى يوزع شاحنةً محملةً بالأغنام لفقراء المدينة القديمة في الدار البيضاء كما باع لوحاته القيمة في المزاد لصالح الهلال الأحمر المغربي، وقد زاره مرةً الشاب خالد برفقة مدير أعماله لشراء حقوق إحدى أغنياته، فعرض الهلالي السعر كما يحلو له ثم أعطى نصفه لأيتام الموسيقيين الجزائريين.
“قلال كيفه”، يقول الحاج نور الدين. وفي الحقيقة لن نعثر كثير عن أشباه ونظائر لسليم الهلالي. روحٌ تحمل كل هذه التناقضات، التي ورثتها. لكنها فضلت أن تتعايش مع الموروث دون أن تُسجن داخله. قطع الحاج نور الدين جلستنا بالوقوف فجأةً مُلحًا على الرحيل، وعندما كان يهم بالذهاب والسلام، قال لي: “عندما مات سليم لم أحضر جنازته، لأنه لم يريد أن تقام له جنازة، فقد نثر رماد جسده في إحدى المقابر غفر الله له”. يلوّح الحاج بيده مغادرًا ويختفي، وأسعى في خطاه عائدًا تاركًا شارع الآباء القديسين منكفئ الرأس أعد مربعات الرصيف.