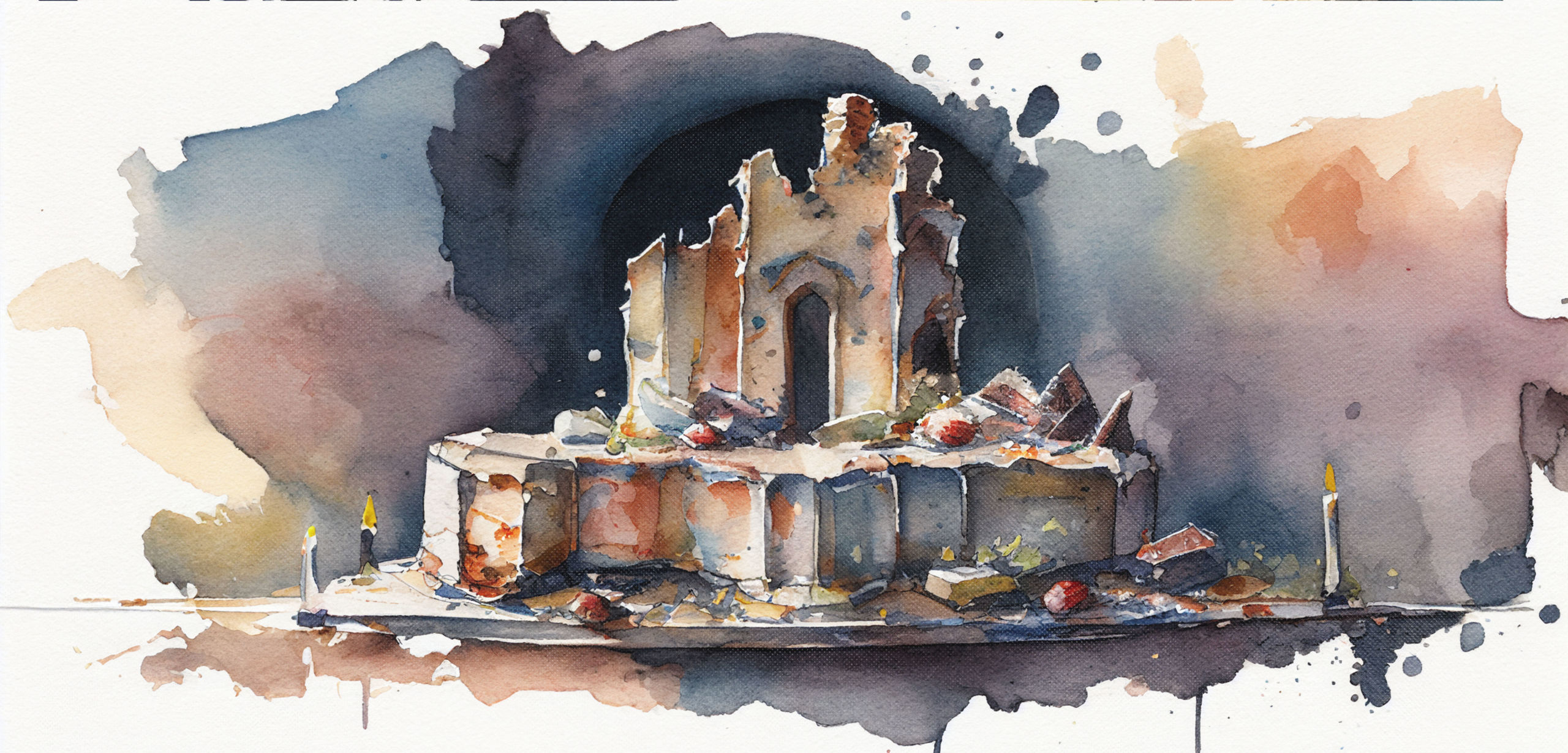حتى لدى انطفائها المؤقّت، يلازم صوت صهاريج المياه أذنيك كصمغٍ دبق من الصباح إلى المساء. إن أسعفتك الدقائق أو الجَلَد ستتمكّن من اللحاق بصاحب الصهريج ودعوته إلى ملء خزان الماء، فهناك حتماً من يقوم من الجيران بالتعبئة على مدار الساعة. في لحظات الذروة قد لا تجد أي بائع مياهٍ مستعداً للقدوم ما لم ترفع مبلغ النقلة بناء على ما يطلبه هو بالتأكيد.
أم عبدالله ليست بحاجة إلى أن تنزل أو تطلب الصهريج بنفسها. لقد هبطت إلى الجحيم منذ بداية الصيف، وباتت تعرف لغته جيّداً. تصرخ من شبّاك مطبخها إلى أحد الفتيان من أجل ملء خزّانها الفارغ. تأمرهم أمراً فيملؤونه قبل خزّانات الآخرين. المشهد بذاته يختصر حالة القحط: نوافذٌ مشرّعةٌ بانتظار صهاريج المياه، كنظيرٍ كابوسي معاصر عما كانت تجري عليه الأمور في السابق؛ عندما كانت شبابيك بيروت مشرّعة دائماً على البحر، ولو أن مياه البحر لا تُشرب.
نحن في الجحيم مع أم عبدالله
تتوالد قصص المياه من البناية الواقعة في مار الياس، أحد أحياء بيروت. نحن في الجحيم مع أم عبدالله: صيف 2022 الذي تزامن قدومه مع عطلٍ مفاجئٍ أصاب خط الشبكة الرئيسي فأدّى إلى انقطاع المياه عن الخزّان الذي يغذّي أحياء المدينة.
سوّيت الأمور لفترة، كما أشيع، لكن تسرباً آخراً ظهر مجدّداً مؤكدًا أن لا سبيل إلى إصلاح شبكة المياه المهترئة إلا بشكل مؤقّت، ففي ظلّ الأزمة الاقتصادية ليس هذا هو الوقت الأمثل لتسوية ما عجزت سنوات الإهمال الطويلة عن إصلاحه.
العطل الذي استمرّ لحوالي شهرين في بيروت ليس إلا فاتحة لأعطال متراكمةٍ ومقبلةٍ لا محالة. كل شيء ينبئ بذلك، لا سيما في غياب التيّار الكهربائي عن العاصمة وكافّة المناطق اللبنانية، وأمام عجز مصلحة مياه بيروت عن تكبّد تكاليف المازوت الباهظة.
ما حاجتنا إلى التصريحات الرسمية، ما دامت الخزّانات فارغة. هذا ليس سؤالاً. لقد فجّرت عتمة البلاد كل المآزق الأخرى. لا شيء على ما يرام إلا بالنسبة إلى أصحاب الصهاريج التي لا يزال هديرها يشقّ الطريق نحو البنايات جيئة وذهاباً.
آبار خالية
تتخلّى بيروت عمّا صنع اسمها. تشلح الأساطير وتجنح قليلاً فتستبدلها بنقيضها، أو تستخرج اللعنة وحدها من تسميتها. كأنما كُتب للمدينة أن تشهد الغزو دائماً من جهة المياه، أكان ذلك بسبب إهمال الدولة أو أهوال الطبيعة.
المياه في بيروت، لا تقتصر على ناحيتها الغربيّة المتمثّلة بالبحر، بل إنها قابلة دائماً لاتخاذ هيئة الكارثة أينما حلّت: هجوم الأمواج على اليابسة، انفجار المرفأ القادم من ناحية البحر، جفاف آبارها، وتحوّل نهرها الوحيد بمجاريره إلى قفص للجرذان والأوساخ العضوية، فيضانات فصل الشتاء، حيث تطوف المياه مختلطة بسوائل الصرف الصحّي. حتى المياه المخزّنة في جبال لبنان، تعلّمت مع الوقت أن تضلّ طريقها إلى جوف العاصمة، بسبب اعتماد وزارة الطاقة والمياه لسنوات طويلة على المشاريع الربحية مقابل تغييب الخطط الفعّالة لإدارة الثروة المائيّة الغنيّة في لبنان.
لدى المياه قابليّة دائمة للتحوّل والتشكّل، على تغيير المواد الأخرى، على الإذابة والابتلاع والمحو. هذا ما تقوله تركيبتها العلمية. والمياه بتحوّلها البيروتي، باتت في شكلها المعاصر لا تتعدّى الخراطيم الممتدّة إلى أسطح أبنيتها وخزّانات شُقهها، كأسلحة رمزية مصوّبة إلى أجساد أبنائها العارية من الاستحمام.
تتّخذ بيروت من الآبار اسماً لها. التسمية الأولى للمدينة هي بيروتا، المستمدّة من موارد المدينة المائية وآبارها المحفورة على تلّها المواجه المرفأ. فكلمة بيروتا تحمل تشابهاً صوتياً مع كلمة “بئر” في اللغات الساميّة: “بير” في العربية، و”بورتو” بالأكادية، و”بئر” بالعبرانية وفق المؤرّخ اللبناني سمير قصير، ما يرجّحه أيضاً الأب لويس شيخو، في إحالته اسم بيروت إلى اشتقاق من الكلمة العبريّة بئروت.
العودة إلى تاريخ المدينة ليست مقرونة برغبةٍ في مقارنة اختزاليّة بين حاضرها وماضيها، بل بغية تظهير الملامح الأولى التي صنعت اسمها ومهنها وأحيائها ونظامها الاقتصادي الحرّ. أحياءٌ لا تزال تحتفظ بالمياه في أسمائها مثل “عين التينة”، و”ساقية الجنزير”، و”عين الرمانة”، و”بئر العبد”، و”بئر حسن”، و”عين المريسة”..
تلتحق بهذه الآبار المطلّة على البحر، ينابيع متدفّقة وصفها الجغرافيون الفرنسيون برومانسيّة فائضة، مثل قول إليزيه روكلو “كلّ السفن الآتية من بحار فينيقيا واليونان احتمت من الرياح الجنوبيّة والغربية قرب الينابيع المتدفّقة في بيروت، عند أسفل كثبان الرمل الأحمر، حيث تنتشر أشجار الصنوبر مرسلةً حفيفها العذب”.
العودة إلى تاريخ المدينة ليست مقرونة هنا برغبةٍ في مقارنة اختزاليّة بين حاضرها وماضيها، بل بغية تظهير الملامح الأولى التي صنعت اسمها ومهنها وأحيائها ونظامها الاقتصادي الحرّ. أحياءٌ لا تزال تحتفظ بالمياه في أسمائها فحسب، وسط قحط الصيف، مثل “عين التينة”، و”ساقية الجنزير”، و”عين الرمانة”، و”بئر العبد”، و”بئر حسن”، و”عين المريسة” وسواها من الأحياء السكنيّة التي اكتسبت أسمائها من وجود آبار ارتوازيّة.
أخذت منطقة “راس النبع” اسمها من البئر الذي حُفِرَ في ستينيات القرن التاسع عشر، كبديلٍ عن شبكة جرّ المياه من نهر الكلب التي تأجّل تنفيذها بسبب تكلفة المشروع الباهظة في الفترة العثمانيّة. لم تنفّذ هذه الشبكة إلا سنة 1875، بعدما لم تعد المياه الجوفيّة تلبي أبناء المدينة الآخذة في التوسّع حينها، ومنذ ذلك الوقت بقي نهر الكلب الذي ينبع من أعالي جعيتا هو المصدر الرئيسي لتغذية بيروت إلى جانب بعض الآبار الأخرى.
المصدر: صفحة تراث بيروت، فيسبوك
جيراننا لصوص الخزانات
تعيش أم عبدالله بمفردها في شقّة الطبقة الأولى. ليلة واحدة لا تكفي لكي ينضب ماء الخزّان. في العادة، لا تطول فترة استحمامها لأكثر من عشر دقائق، كما أنها وحدها، مهما استعملت من المياه لن تصرف عشرة براميل في بضع ساعات. هذا ما ظلّت تردّده، لتؤكّد للآخرين أن مياه خزّانها سُرقت خلال الليلة التي أوَت فيها إلى النوم عند العاشرة مساء.
كان الجوّ خانقاً، لكنها غفت على كنبة شرفتها، بعد عدّة ليال حارّة بلا نوم. ولا تذكر أم عبدالله أنها رأت المياه أو استخدمتها في منامات ليلتها المشؤومة تلك، لم تستحم، ولم تروِ نباتاتها، مع هذا فرغ الخزّان. ليس أمامها إلا الجيران. لا دليل بيدها لاتهام أي منهم بالسرقة. بيدها غالون فارغ فقط، لكي تبررّ طرقها على أبوابهم طلباً للماء. في الغالون الشفاف، بانت المياه على حقيقتها: سائل عكر يميل إلى الرمادي.
“الحمد لله أننا لا نقشع (نرى) الماء الذي نستحم ونغتسل به حين تنزل من الحنفيات، لكنّا بقينا بلا استحمام”. كادت أم عبد الله تتعثّر بعبارتها على الدرج، إذ ظلّت تردّدها بعصبية إلى أن وصلت باب بيتها. سمعتها وهي توصد بابها وتصرخ: لن يقول لكم موزّع المياه أنه بات بإمكانكم أن تستحمّوا بالخراء. لن يقولها لأنه لا يجرؤ. الله فقط يعلم من أين يحضر ماءَه.
مياه لا تأتي
في محاولتنا لدحض فرضية أم عبدالله بأن الله وحده هو من يعرف مصدر المياه المعبّأة، اتصلت بنعيم، الشاب الذي كنت قد اشتريت منه في السابق نقلة ماء، لأسأله عن مصدر المياه العكِرة التي وصلت إلى خزّاناتنا. لم يتهرّب نعيم بل أكّد أن هذه هي المياه المتوفّرة في الوقت الحالي “أعجبكِ لونها أم لم يعجبكِ”، وبأنه اشتراها بدوره من أحد أصحاب الآبار في بيروت: “لديه موتورات وتكاليف كهرباء لاستخراج المياه، ولعلمك كل أصحاب الصهاريج يستخرجون المياه بهذه الطريقة، من الآبار الخاصّة”.
حين نقول إن المدينة خلعت اسمها وأسطورتها، لم نكن نعني بذلك بأنها فقدت آبارها، بل على العكس تماماً. تضاعف اسمها بصورة كاريكاتوريّة إلى أن ابتلعتها الآبار العشوائية باعتبارها البديل الفردي الوحيد لسدّ رمق الصيف الذي لا تؤمّنه الدولة. ففي بيروت الكبرى وحدها، تعتمد 80% من الأبنية على الآبار الارتوازية، فيما لا تملك وزارة الطاقة والمياه إحصاءً دقيقاً لعدد هذه الآبار.
الخوض في ملفّ الآبار العشوائية، لا يَقرَب من أسباب المشكلة بذاتها، بقدر ما يشوّش عليها، كما يحذّر الأكاديمي اللبناني والباحث في المياه الجوفية سمير زعاطيطي. برأيه فإن إحالة أزمة المياه إلى الآبار، من شأنها أن تصرفنا عن جذر المشكلة أي سوء إدارة الموارد المائية الذي تقاذفها وزراء الطاقة والمياه طوال عقود، من دون أن يجدوا لها حلولاً تتعدّى السدود مثلاً، رغم آثارها الكارثيّة على البيئة. لذلك، فإن حفر البئر يكون الكوّة الوحيدة أمام سكان المدينة مع انقطاع وشحّ المياه الذي يحلّ سنويّاً بين شهري أيّار (مايو) وتشرين الأوّل (أكتوبر).
قام مكتب الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية بتحديد منطقتين قريبتين من بيروت غنيتين بالمياه الجوفية الموجودة داخل الصخور الكربوناتية الكارستية للعصر الجوراسي ..لكن لم تكن أولويّة الوزارات المتعاقبة يوماً تأمين المياه المستدامة لبيروت. وفي حال قرّرت الوزارة تنفيذ مشاريع كهذه، فمن المتوقّع أن يستغرق الأمر سنوات؛ فكل المشاريع تُبطئها المماطلة والتسويف ..
لن يتفادى الزائر للجبال اللبنانية في فصل الربيع بشلالتها الكثيفة نتيجة ذوبان الثلج، سؤالاً بديهياً: أين تذهب كلّ هذه المياه؟ الجواب سيكون مكروراً وجاهزاً: تذهب هدراً. يساعد في هذا موقع بیروت الجيولوجي الذي يتّخذ شكل ھضبة مسطحة تمتدّ على مساحة 60 كلم، تلتصق شرقاً بالمرتفعات الصخرية. وبما أن الطبقات الأرضية للمدينة لا تملك مخزناً جوفياً من شأنه تخزين المياه، تنخفض كميات المياه السطحية من الینابیع والأنھار مباشرة بعد فترة توقّف هطول الأمطار والثلوج، التي تستمرّ من كانون الثاني (يناير) حتى شهر آذار (مارس) سنوياً.
ما الحلول إذاً؟ يشير زعاطيطي إلى “أننا قمنا (مكتب الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية) بتحديد منطقتين قريبتين من بيروت غنيتين بالمياه الجوفية الموجودة داخل الصخور الكربوناتية الكارستية للعصر الجوراسي: المنطقة الأولى، هي وادي شحرور (كفرشيما)، والثانية ناحية جسر القاضي (الدامور)، حيث يمكن حفر آبار إستثمارية فيهما وتأمين مصادر مياه جديدة لبيروت وضواحيها.
هذه مشاريع معلّقة إلى أجلٍ لا يُرى. لم تكن أولويّة الوزارات المتعاقبة يوماً تأمين المياه المستدامة لبيروت. وفي حال قرّرت الوزارة تنفيذ مشاريع كهذه، فمن المتوقّع أن يستغرق الأمر سنوات؛ فكل المشاريع تُبطئها المماطلة والتسويف، وليست تلك المتعلّقة في المياه فحسب.
سنة 2014، قدّمت “المؤسسة الفدرالية لعلوم الجيولوجيا والمصادر الطبيعية” (BGR – هانوفر/ ألمانيا)، تقارير وتوصيات نتيجة دراسات أجرتها على نبع جعيتا الذي يزوّد بيروت بالمياه. لم يجر الأخذ بأي من هذه التوصيات التي كشفت عن هدر هائل في المياه المتّجهة صوب المدينة، رغم أنها صوّبت مباشرة على أبرز مشكلات القطاع المائي، مثل إنشاء خطّ لتوصيل المياه بين نبع جعيتا ومعمل ضبيّة تحسباً لأي عطل قد يصيب أحدهما. كذلك أوصت بتخفيض الهدر في شبكات بيروت من خلال صيانتها، وزيادة حجم معالجة وتكرير المياه في ضبيّة وتجدید طرقھا ووسائلھا. ربما علينا انتظار حياةٍ أخرى لكي تبصر هذه التوصيات النور.
المصدر: Water Alternatives Photos. تحت رخصة المشاع الإبداعي
مياه لا تروي
في قراءته السيميولوجية للمدينة، يرى رولان بارت أن البقع المائية، أكانت أنهراً أو بركاً أو شواطئ، هي ما يؤدّي الوظيفة الأمثل للّقاء. المدن الخالية من المياه تحتّم على سكّانها مواجهة صعوبات في التأقلم والتواصل. تمدّ المياه وتقطع. تحمل التضادّ الصارخ الذي وصفه دافينشي للمياه العذبة، بأنها المورد الطبيعي الذي لا غنى عنه بسبب قدرته، في غيابه وفي وجوده، على توحيد وتقسيم المجتمعات، وعلى بناء الهوية الاجتماعية والوطنية، وتحديد علاقة البشر مع بيئتهم. وقد لعب نهر بيروت قبل اختفائه هذا الدور على أكمل وجه، حيث كان صلة وصل بين المدينة والجبل وبين السكّان ومزروعاتهم. الأمر نفسه ينطبق على جسد الإنسان الممتلئ بنسبة 67% تقريبًا من مكوناته من المياه. وبهذا تقع المياه في صلب الممارسة الفردية والاجتماعية على السواء.
حين تغيب المياه عن الأبنية السكنية في بيروت، يدخل أبنائها في حالة من الشكّ المؤقت تجاه كل القاطنين فيها، خصوصاً مع سرقة المياه الرائجة باستخدام الخراطيم المنزليّة. كلّ جار هو سارق محتمل، ما لم يثبت العكس. سكّان الطبقات العليا هم الأكثر عرضة لشبهة السرقة، خصوصاً أن صعودهم إلى السطح عبر الدرج (الوسيلة الوحيدة المتاحة حالياً)، لا يتطلّب الجهد ذاته الذي يتكبّده سكّان الطبقات السفلى.
مع انقطاعها، تقطع المياه الصلات اليومية ما خلا تلك المتوتّرة منها. وحين تطلّ، بعد انقطاع طويل، فإنها تنهمر بتدفّق حادّ، من شأنه أن يقيم تواصلاً يطيح بالحواجز والجدران الرمزية بين الشقق السكنيّة إلى أن يقتلعها نهائياً. هكذا عرفنا جميعاً بموعد استحمام أم عبدالله. لدى طلبها تعبئة المياه من أحد الجيران، تنفّست أخيراً لأنها ستستحم بعدما تأجّل حمّامها أسبوعاً كاملاً بسبب سرقة المياه من خزّانها.
في استحضارنا لمختلف وظائف الاغتسال، نبحث عن طريقة الاستحمام الملائمة للأجساد المحرومة من المياه في بيروت. بالطبع لا تبحث هذه الأجسام عن غسل الخطايا باستثناء، ربّما، من سوّلت لهم أنفسهم سرقة مياه الجيران. ولا يناسبها اغتسال تهدئة الأعصاب لأن الأدوية النافذة لم تعد تقوى على تهدئتها ..
بإعلانها موعد الاستحمام “الآن”، تحوّل هذا الفعل البديهي والخاص إلى فعل استثنائي بسبب ندرة حدوثه، ما جعله يستحقّ المشاركة كحدثٍ قائمٍ بذاته. على من يستحم أن يدخل بيت الخلاء، ويغلق الباب وراءه. هذا فعل فرديّ خالص في المجتمعات الحديثة، رغم أنه ظهر كطقس جماعي في حضارات سابقة.
يحمل فعل الاغتسال بالماء بعداً جسدياً وآخر روحياً ومعنوياً يتمثّل في غسل الذنوب، ما وضعه في طليعة الطقوس الدينية اللاهثة خلف محو الخطايا. يقلّب مؤرّخ الأديان الروماني ميرتشا إلياده معاني المياه على أوجهها في سياقاتها الكونية والدينية والثقافية. يختصر سطوة الماء كالتالي: “في التنقية المائيّة كل شيء يذوب، كل شكلّ يتفكّك. ما كان قد حدث لا يعُد موجوداً، لا شيء يبقى على حاله بعدما تغمره المياه، ولا حتّى علامة، ولا حدث”.
في كتب نشأة الكون وفي الأسطورة والطقوس والأيقونات تملأ المياه الوظيفة نفسها تقريباً “إنها تسبق كل صوت. يُراد من الغطس في الماء إعادة الجسد إلى ما قبل التكوّن، فالخارج من الماء يعيد فعل الخلق الأوّل”، وفق إلياده، بغسله الذنوب، بمحوه الأوساخ، بتبديده الخطايا، بقتله الأنا الماضية وإحيائها أكثر طهراً. كما أنه يصل إلى حدّ غسل الواقع كما في استحمام الليدي ماكبث في مسرحيّة شكسبير التي تستحمّ بعد جريمة قتل الملك دانكن لمحو الدم عن يديها، لكن أيضاً لغسل الواقع الغارق بدم الجريمة.
لا نخفي أننا في استحضارنا لمختلف وظائف الاغتسال، نبحث عن طريقة الاستحمام الملائمة للأجساد المحرومة من المياه في بيروت. بالطبع لا تبحث هذه الأجسام عن غسل الخطايا باستثناء، ربّما، من سوّلت لهم أنفسهم سرقة مياه الجيران. ولا يناسبها اغتسال تهدئة الأعصاب لأن الأدوية النافذة لم تعد تقوى على تهدئتها. ليس أمامنا إلا اللجوء إلى طقوس الاغتسال المعتمدة في الجنازات، لكونها تسدّ عطش الموتى كما ينقل إلياده، وما لم تروِ ظمأ الصيف، علينا حينها أن نطلق صرخة من قلب الجحيم كتلك التي ناشد فيها الغنيّ إبراهيم في إنجيل لوقا: يَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ارْحَمْنِي، وَأَرْسِلْ لِعَازَرَ لِيَبُلَّ طَرَفَ إِصْبِعِهِ بِمَاءٍ وَيُبَرِّدَ لِسَانِي، لأَنِّي مُعَذَّبٌ فِي هذَا اللَّهِيبِ.
لقد أسرفنا في الكتابة هنا، ولساننا أذابه اللهيب.
إفرازات الأجسام المتعرّقة
لا يعني أن لا تجد الأجساد سبيلها إلى الماء في بيروت أنها ستظلّ جافّةً. أجساد قليلة تنجو من العرق الذي تسببه رطوبة البحر العابقة طوال الصيف. مصير الجلد واحد: البلل من الجبين نزولاً إلى القدمين. العرق هو التجسيد الرطب للتلوّث في المجتمعات الحديثة، ما يدعو الفرد إلى التشكّك في العلاقة الذاتية مع جسمه، إذ العرق وليد الجسد والمطرود منه في آن.
تناقلت المجتمعات نبذها لهذه المادّة اللزجة من خلال طقوس التطهّر عبر الحضارات. تصف الأنثروبولوجية البريطانية ماري دوغلاس فتحات الجسد بالهوامش (حيث كلّ هامش هشّ)، التي تشكّل نقاط الضعف الأساسيّة للجسد، بإفرازها اللعاب والدموع والبول والدم والعرق، وغيرها من السوائل، و”بمجرّد خروجها” تكون قد اجتازت حدود الجسم. لا تكفّ هذه المادّة المتسرّبة من مسامات الجلد عن توليد السؤال نفسه عن حدود الجسد والذات وعلاقتها بالآخر والخارج، بوصفها تجربة خارجية وداخلية في الوقت نفسه.
مثل كلّ النفايات الجسدية الأخرى، صُنّف العرق غالباً ضمن المحرّمات التي تهددّ حدود النظام. إنه شذوذ، وخروج عن النظام بالمعنى الذي قدّمته دوغلاس في كتابها الشهير “الطهارة والخطر“. فالتفكير في الأوساخ، وفق دوغلاس، يحتّم علينا التفكير في العلاقة بين الفوضى والنظام، وبين الوجود والعدم، والشكل واللاشكل، والحياة والموت.
ولكن هذه الأوساخ قد تحمل بعض الاستثناءات المعاصرة. كأن يتمّ التسامح مع العرق الناتج عن القيام بمجهود بدني كالعمل والتمرين، في المجتمعات التي تقدّس الرياضة والأجسام الرشيقة. هنا يحضر العرق كإكسسوار أساسي للجسد الرياضي القوي والشاب في إعلانات النوادي الرياضية والماركات العالمية، كما يتنبّه الباحث الفرنسي جيل رافونو في مقالته عن العرق. إعلانات تروّج للعرق بجانبه الإيجابي، فتغسل العرق من سماته الأساسية كما تفعل المياه حين تهطل على الجسم.
غالباً لن نعرف ما إن كان عرق العارضين في الإعلانات عرقاً حقيقياً أم أنه مياه أخرى؛ الشاشة عاجزة عن نقل رائحته إلى المشاهد. بخلاف ما يحدث في الواقع، حين يهدّد خروج العرق تمثيل الذات والهويّة ببثّه مختلف أنواع الروائح، التي تتحوّل إلى علامة تميّز الشخص. علامة تخترق مساحة الآخر، وقد تواجه خطر التصنيف على أنها كريهة.
يبقى الإنسان محاطاً ومحبوساً داخل فقاعته الشميّة، بحسب الأنثروبولوجي الفرنسي ديفيد لو بروتون في كتابة “تحسس العالم: أنثروبولوجيا الحواس“. رائحة الآخر هي أكثر السمات الفردية التي لا يتم التسامح معها حين تجتاح فقاعته ومساحته الخاصة، باستثناء الروائح المألوفة لأشخاص يعرفهم، منها ما يحمل الإغواء بالطبع.
رأت أم عبدالله المياه الآسنة جيّداً في الغالون، لكنها لم تر بالطبع البكتيريا البرازية التي عُثر عليها قبل سنوات في إحدى آبار الضاحية الجنوبيّة لبيروت، ما رجّح أيضاً وجود هذه البكتيريا في الآبار الأخرى طالما أن مصدر المياه واحد؛ البحر الملوّث. وطالما أن تمديدات مياه الصرف الصحّي تعاني من ثغرات هائلة.
يشير لو بروتون إلى أن “الروائح الكريهة والمقزّزة هي دائماً رائحة الآخر”، رغم خوف هذا الشخص من أن تزعج رائحته الخاصة الآخر نفسه. هذا ما يبرّره نوع آخر من الإعلانات التي تحذّر المشاهد دائماً من الوصول إلى نموذج الأجسام المطرودة، بترويجها لمزيلات العرق والروائح الكريهة من الجسد والفم. تحمل حاسة الشم إذاً سلطة من شأنها أن تحجّم الآخر إلى ما تحيل إليه رائحته فحسب، تصبح رائحته هي المسؤولة عن إيقاظ المزايا الأخرى للشخص المقابل.
وعادة ما تخدم روائح الأجساد وجهات النظر العنصرية، بإقرانها الرائحة الكريهة بالأشرار (من المنبوذين والفقراء والشعوب “الأخرى” خارج المحورية الأوروبية مثل الأفارقة والهنود والعرب) والرائحة الحَسنة بالأخيار المركزيين (الذين يمثّلون في هذه الحالة النظام/ النموذج). لهذا لم يتردّد السوسيولوجي الألماني جورج سيمل في التعبير عن الأمر في وقت مبكر، قائلاً: “السؤال الاجتماعي ليس مسألة أخلاقية فحسب، بل إنه أيضاً مسألة رائحة”.
إلام سنحيل الأجساد المتعرّقة وروائحها في حالة بيروت؟ تلك المتعرّقة، من دون جهد أو عمل، بفعل الرطوبة التي تهجم على المنازل هجمًا مع انقطاع التيّار الكهربائي؟ نعود إلى دوغلاس التي رأت أن الطهارة يقابلها الاتساخ في معظم تقاليد الشعوب القديمة والأديان، لأنه يحمل تهديداً بخربطة النظام. لكي تصحّ هذه المعادلة، من المفترض أن يكون النظام نظيفاً أولاً، أقلّه من أجل الحفاظ على تضادّ الطهرانية مع السوائل المقزّز. العرق والماء كلاهما بلل. إلا أن إحداهما يقابل الآخر؛ الأول يوسّخ والثاني يطهّر.
رأت أم عبدالله المياه الآسنة جيّداً في الغالون، لكنها لم تر بالطبع البكتيريا البرازية التي عُثر عليها قبل سنوات في إحدى آبار الضاحية الجنوبيّة لبيروت، ما رجّح أيضاً وجود هذه البكتيريا في الآبار الأخرى طالما أن مصدر المياه واحد؛ البحر الملوّث. وطالما أن تمديدات مياه الصرف الصحّي تعاني من ثغرات هائلة.
جسد أم عبدالله تعرّق ونشف سبعة أيّام بلياليها قبل أن تتمكّن أخيراً من الاستحمام بمياه آسنة. هكذا تتلاشى كلّ التناقضات بين الجسد المتسخ ونقاوة المياه، يكاد الشاذ أن يتحوّل إلى النظام نفسه، لو فقط اكتفت أم عبدالله بالتعرّق اليوميّ باعتباره استحمامًا من المياه الآسنة (التي قد تكون مشبعة بالبكتيريا البرازيّة، من يدري؟).
المصدر: Water Alternatives Photos. تحت رخصة المشاع الإبداعي
نهر واصل جريانه حتّى اختفى
واصل نهر بيروت جريانه في جغرافية المدينة وتاريخها، منذ العصر الروماني، حتى تلاشى كليّاً. تسجّل بيروت سابقة في هذا السياق، فالنهر لم ينضب لسبب مناخي، بل بفضل معجزات المشاريع العمرانيّة، وتمدّدها العشوائي في نهاية القرن الماضي. التحوّل الأساسي الذي شهده النهر، تزامن مع انتقال اللاجئين الأرمن من منطقة الكرنتينا إلى برج حمّود، شرقيّ النهر، خلال ثلاثينيات القرن الماضي، حيث شهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب بقايا الاسمنت والمواد البنائية التي ترسّبت في قعره.
وفي سنة 1942، وقعت الكارثة: فاض النهر. حادثة الطوفان وثّقتها جريدة “لسان الحال” التي نقلت الخبر كالتالي: “في 19 مارس من عام 1942 حدث فيضان قُدر بمعدل تدفق 700 م 3 / ثانية، نتيجة هطول الأمطار الكثيفة التي أثارت سيلاً تدفق من الجبل إلى الوادي بقوّة رهيبة. وقد غمرت المياه منازل ومزارع المنطقة السفلية ودمّرت كل ما واجهته، مما تسبب في أضرار جسيمة في الأحياء الفقيرة.
تتناقل الأساطير الحديثة المنبثقة عن النهر، خبر فيضانه في الستينيات من القرن الماضي، حيث ارتفع ليطال الجسر الذي يقطعه من الأعلى. هناك صورة تظهر الحادثة. ربّما تلك كانت المرّة الأخيرة التي طاف فيها النهر وابتلع سيارة تاكسي مع ركّابها الخمسة، كما توثّق إحدى صفحات بيروت التراثية على فيسبوك.
وإن كان النهر لا يزال موجوداً كهيكل براّني، إلا أنه غائب بالطبع، مع غياب المياه منه. رغم جفافه التام، إلا من بقايا الأمطار ومياه الصرف الصحي، والنفايات الصناعية الصلبة والسائلة، لم يتوقّف النهر عن اختلاق القصص، كأنه يذكّر السكان بوجوده، آخرها ظهور نوع من تماسيح النيل بداخله سنة 2013
حمل النهر هذه العلاقة المتوتّرة مع المدينة: إما أن يبتلع النهر بيروت وإما أن تبتلعه هي. ربح الإسمنت في النهاية. حالياً، لا يزال المكان موجوداً كقناة واسعة بحوافً أسمنتيّة عُمّرت في العصر الروماني (لدى بنائها من منبع قرية الديشونية في المتن)، وظلّ لفترة طويلة يلبيّ الريّ في ضاحية بيروت الشماليّة، خصوصاً بعد استحداث الشبكة توزيع المياه من نهر الكلب لاحقاً.
وإن كان النهر لا يزال موجوداً كهيكل براّني، إلا أنه غائب بالطبع، مع غياب المياه منه. رغم جفافه التام، إلا من بقايا الأمطار ومياه الصرف الصحي، والنفايات الصناعية الصلبة والسائلة، لم يتوقّف النهر عن اختلاق القصص، كأنه يذكّر السكان بوجوده، آخرها ظهور نوع من تماسيح النيل بداخله سنة 2013.
التمساح الذي شغل الصحافة والرأي العام المحلّي لأشهر، لم يكن سوى إشارة ظاهرة إلى تهديد أكثر هولاً يقبع في مجرى النهر. ففي سنة 2014، علق التمساح أخيراً في شباك صيّاد كان يقف على تقاطع النهر مع شاطئ بيروت الشمالي. ولدى نقله إلى إحدى حدائق الحيوانات في بريطانيا، تمّ عزل التمساح عن تماسيح المحمية الأخرى لفترة، ريثما ينتهي علاجه من فيروس يرجّح أنه التقطه في نهر بيروت.
بالإضافة إلى هذه الأحاديث، والمعجزات المفاجئة التي يلفظها النهر كل فترة، لم تعد مياهه تظهر إلا في الصور. لا تفرّق الصورة الفوتوغرافيّة بين المياه المالحة و المياه العذبة. ومياه بيروت، حين تلتحق بصورة المدينة، ليست بحاجة إلى أي تبرير في كلّ العصور، إذ يندر أن تختفي عن مجال الرؤية بسبب البحر تحديداً. كما أن المياه كمادّة مصوّرة احتضنت كلّ السرديات التي تجمع ما بين الممارسة اليومية للناس وما بين الأسطورة الجغرافية التي صنعت صورة بيروت ونظامها الاقتصادي الحرّ، وسواها من التسميات المبتذلة مثل “سويسرا الشرق”.
وبما أن المياه في بيروت، تظلّ سطحية وظاهرة، بسبب غيابها الآني في حالة نهر بيروت، أو متخليّة عن وظيفتها في حالة شاطئها الملوّث، فإنها لا تصلح إلا أن تكون مجرّد صورة مسطّحة غالباً، كمناظر طبيعيّة للرؤية ببعدين مسطّحين لا ثالث لهما.
المصدر: صفحة تراث بيروت، فيسبوك