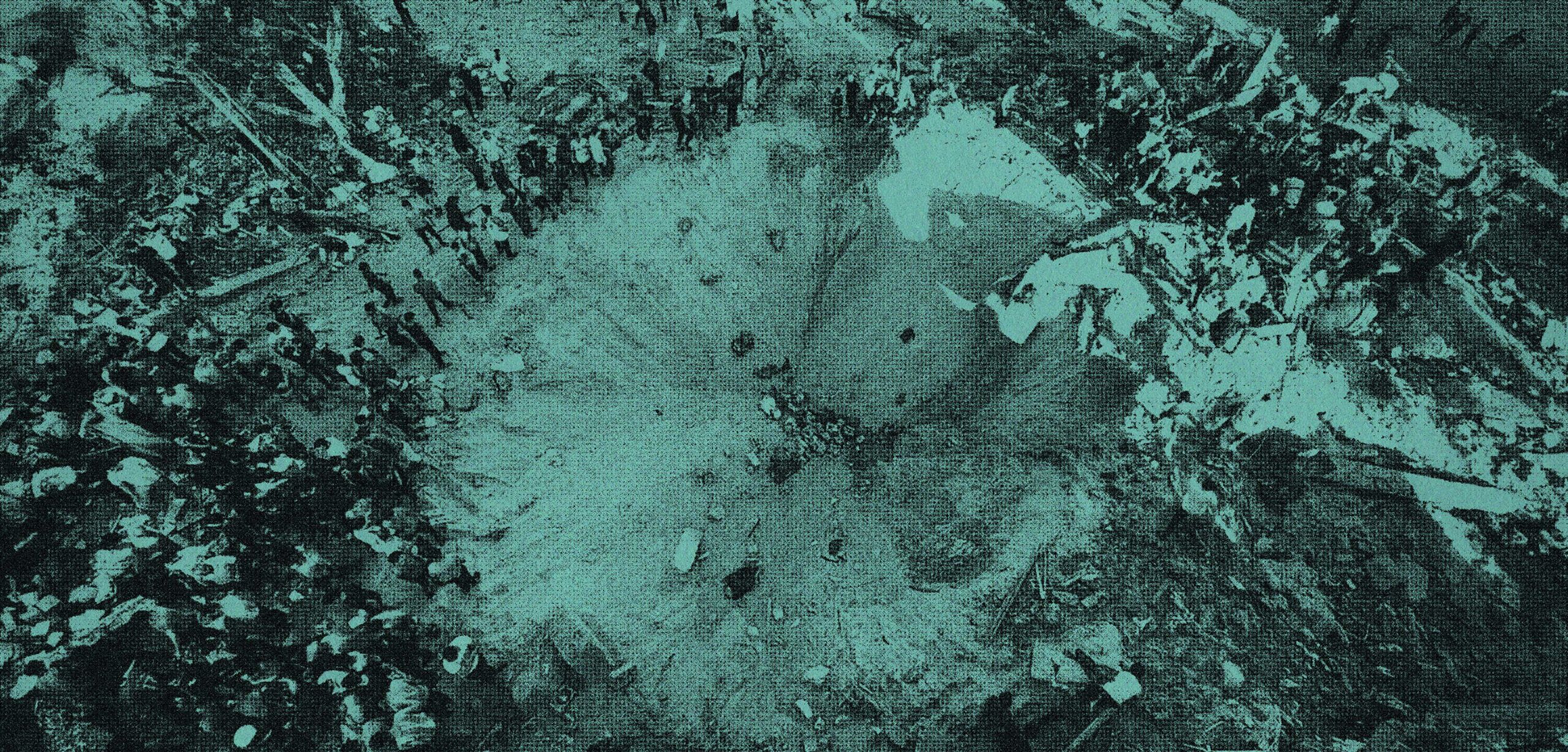الثامن عشر من مايو 2021، تسع معلمات في منطقة برج باجي مختار في الجنوب الجزائري يتعرضن لاعتداء وحشي شمل الاغتصاب، الضرب، التعذيب وسرقة ممتلكاتهن البسيطة، وذلك عند الساعة الثانية صباحاً وفي حضور رضيع صغير.
مثل عشرات المعلمات في الجزائر، تأتي هؤلاء من مناطق بعيدة. كانت نورية بن غبريط، وزيرة التربية والتعليم السابقة، قد أتت بإجراء جديد قبل سنوات سمي بالأرضية الرقمية، توزع فيه المناصب على الفائزين في مسابقات التوظيف بشكل قد يضطرهم للتنقل مئات الكيلومترات للعمل، وفي حالة الرفض يخسر المعني الحق في التوظيف تلقائياً.
وقع خبر الاعتداء صادماً عليّ، أنا التي أنتظر توظيفاً حكومياً الخريف القادم ولا فكرة لدي في أي منطقة وعلى أي مسافة من مكان سكني في ولاية المدية شمالي الجزائر ستكون خدمتي، ووقع مرعباً على صديقاتي اللواتي يقمن بالتدريس في ظروف مشابهة.
اتصلت ببعضهن للاطمئنان عليهن، وجدتني أسمع قصصاً وتفاصيلَ عن الظروف التي يعشنها، ظروف لا يبدو أن وسائل الإعلام تبذل الكثير من الجهد في إظهارها للعلن. كما لا يظهر أن المجتمع الجزائري يتعاطف مع حال المعلمين في ظل انتشار إشاعة تدور حول تقاضي هؤلاء أعلى الأجور، بينما في الحقيقة لا يتجاوز متوسط الأجر الشهري للمعلم 34000 دينار (حوالي 250 دولار).
هاجس الكتابة عن ظروف المعلمات بدأت في التشكل ليلتها. خضت اتصالات كثيرة تخبرني بحوادث متشابهة في الكدح والمعاناة، ثم وقعت حوادث اعتداءات أخرى لاحقاً، طاولت واحدة منها سكناً وظيفياً للمعلمات في محافظة بسكرة الجنوبية تعرضن فيه للسرقة والترويع، ثم تكرر السيناريو في ولاية باتنة شمال شرق البلاد عندما اقتحم مجهولون سكناً للمعلمات وقاموا بتخريبه.
لكن رواية قصة كهذه لا يمكن أن تنجز دون معايشة، لذلك فكرت في قضاء ليلة واحدة مع معلمات في إحدى المناطق النائية بولاية المدية.
من البداية، قررت خوض تجربة الكتابة هذه مدفوعة بسؤال ملح: هل هذه حلقة أخرى في مسلسل العنف ضد المرأة في الجزائر، أم هي شكل آخر من الاضرار بمنظومة التعليم في الجزائر التي باتت مخترقة على أكثر من مستوى، أم أنه هجوم مزدوج على الحلقة الأضعف في هذه المنظومة: المعلمة.
محطة البداية
أبدأ رحلتي بالكبسولة، سيارة نقل محلية تسع 6 أشخاص، هي أشبه بالتوكتوك المصري. السائق شاب صامت متجهم الوجه، يبدو أنه لا يطيق الحديث مع الناس في هذا الوقت من الظهيرة.
المحطة الواقعة على طرف المدينة تشهد حركة كثيفة مقارنة بالماضي، وهذا بعد أن صارت ملكاً لشركة خاصة. يبقى أنها لا زالت مكاناً معزولاً يصعب بلوغه مشياً.
المركبات تنتظم تبعاً للحجم والوجهة. الحافلات التي تنقل لداخل المدينة تحتل الجزء الشمالي من المحطة، أصفر سيارات الأجرة يطغى على الجزء الجنوبي، بينما تستعد ثلاث حافلات كبيرة للانطلاق للجنوب. يراودني شعور بالغثيان بمجرد رؤيتي لهاته الأخيرة، أتذكر الرحلات الشاقة العديدة التي كان عليّ خوضها بينها لاستكمال دراستي في الجنوب.
في المحطة يمكن تمييز جميع أنواع البشر، الحقائب بدورها تشي بأصحابها. طلاب الجامعات يضعون عادة محافظ الظهر، أرتدي واحدة أيضاً وأشعر بالخفة. تعلو أكتاف مرتادي الجيش حقائب منتفخة يجتهدون في حشوها بالمستلزمات التي يحتاجونها فقط، القفف والحقائب المطرزة عادة ما تلتف حولها أسر صغيرة تأتي من الريف لزيارات عائلية، الحقائب الجلدية الصغيرة للنسوة العاملات، محصّلو التذاكر في الحافلات يميزهم عادة نوع من المحافظ الرياضية الصغيرة يثبتونه على خصورهم.
يندر أن ترى في محطة صغيرة كهاته حقائب العجلات، بشكل ما يتفق على أن هذا النوع صالح فقط للمسافات الطويلة والمحطات الكبرى.
بشكل ما يختلف سائقو التاكسي عن بقية سائقي الحافلات، هم أكثر استعداداً لفتح المحادثات والتطوع بالإرشادات. هم أيضاً أناس متعبون، يمكن استطلاع الكدح بسهولة من وجوههم المسمرّة من الشمس ومن تجاعيد الجبهة التي أعتقد جازمة أنها تتشكل من حركة رفع الحواجب المتكررة في محاولة فحص الطريق والاتجاهات.
انتظر قرابة الساعة مع كهل آخر داخل سيارة الأجرة، لا يبدو أن هناك الكثير من المتجهين إلى الفيلاج الذي أقصده، أشهد الحركة تخف تدريجياً داخل المحطة.
أسأل الكهل عن المسافة المتوقعة، يخبرني أنها تفوق الساعة بقليل. ينطلق في الحديث فيتضح أنه كان سائقاً بدوره. اعتاد قبل توقفه عن العمل على نقل مجموعة من المعلّمات يومياً، من هذه المحطة إلى أماكن توقف معينة، ليواصلن بعدها التنقل مع سائق خاص إلى أماكن أبعد، الأمر الذي يحمل الكثير من الخطر عكس سيارات الأجرة التابعة للحكومة، هذه مضمونة دائماً.
محمولاً بالتعاطف، كان أحياناً يتطوع ليوصلهن لمؤسسات العمل، شهد بعضهن يتوقفن عن العمل بسبب عدم قدرتهن على تحمل هذه المعاناة.
في نظر هذا الرجل، الفيلاج، وهو مكان أصغر كثيراً من المدينة وأكبر من القرية، الذي أتجه له مكان ممتاز للعمل مقارنة ببقية الدشور في الضواحي. سألني عن سبب زيارتي المكان فأخبرته أني أزوره استعداداً لتوظيفي هناك الخريف القادم.
لا أماكن في المحطة للتظلل ولا كراسٍ للجلوس، يحتمي بعض الرجال من وهج الشمس بظلال شجيرات صغيرة على الأطراف، بينما تضطر فتاة هنا وشابة هناك إلى الوقوف انتظاراً.
تمنع النسوة هنا أنفسهن بشكل تلقائي من الجلوس على حافة الرصيف أو على سور صغير، أفعل ذلك عادة وأقابل بنظرات مستهجنة وتحرشات هامسة.
في المحطة بناية تتوسط الساحة، من المفترض أن تحتوي على محلات وقاعات للانتظار، لكن لا يبدو انها تستخدم لهذا الغرض عدا عن مقهى رجالي على الجانب يشغله عمال النقل أكثر من المسافرين.
في الساحة كشكين من حديد، أقدم الشاب صاحب واحد فيهما على الانتحار قبل أشهر. جلس الكهل في المقعد الأمامي قبالتي بمجرد امتلاء بقية المركبة بالرجال، جاء ذكر الشاب المنتحر، حديث قصير انتهى بتنهد الجميع، دعوات شحيحة بالرحمة وصمت مطبق طول الرحلة.
الرحلة
تلتوي الطريق الضيقة كالثعبان وسط سهول وحقول ممتدة، ألمح على جانبيها بشكل خاطف قطعان متفرقة من الغنم والأبقار يرعاها أطفال أو شيوخ، بيوت مهجورة من الطوب والقرميد الأحمر تنتشر وحيدة في الأفق، لا يتضح متى غادرها آخر ساكن، أكان مستوطناً فرنسياً أم جزائرياً فر من ويلات إرهاب التسعينات.
تقابلنا لافتات صغيرة على الجانب تعلن مرورنا بمداشر (قرى) صغيرة، يتكرر الأمر أربع مرات ولا أكاد أفرق بين الواحدة والأخرى. أتذكر رحلتي الطويلة إلى ولاية تقرت في الجنوب الشرقي قبل عام، وكيف ظننت أني أدخل نفس المدينة مراراً وتكراراً لولا اختلافات بسيطة، كأن تجد قطيع غنم يسرح في الساحة العمومية في المدينة (أ) بينما يسرح عند مقر البلدية في المدينة (ب) .
يبدو أن المدن الجزائرية تجتهد في محاولة مطابقة بعضها، لا أعلم إن كان التصميم المعماري هذا فعل سياسات حكومية مصممة على التحكم في الخرائط بريموت كونترول واحد، أم نتيجة لكسل شعوب هذه المناطق عن التفرد والإبداع.
بين القرية والأخرى صرت أنتبه لوديان بأسماء غريبة، كلاب شاردة بارزة العظام، وأحيانا شيخ يجلس على حافة الطريق شارداً في الأفق.
الفيلاج
مثل البقية، يستقبلني الفيلاج بنفس المعالم. محلات مهجورة، محروقة، وبعضها سدت جميع منافذه بالاسمنت بعد أن صار وكراً لعصابات الأحياء، وهم شباب عاطلون عن العمل بعضهم من أصحاب السوابق وبعضهم في طريقه ليكون من أصحاب السوابق.
كان قصد الحكومة حين تأسيس هذه المحلات قبل نحو عشرة أعوام هو دعم الشباب في الانطلاق في مؤسسات تجارية مصغرة والخلاص من شبح البطالة والتخلص من التجارة الموازية.
فشل المشروع سريعاً كالكثير من المشاريع الاجتماعية الأخرى التي أطلقتها وزارة العمل، وخسر أكثر من 12 مليار دينار جزائري (حوالي 75 مليون دولار) دون أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وبات الناس يطلقون على هذه الأماكن اسم “محلات بوتفليقة” أو محلات “الرئيس”.
أصل إلى المحطة الفارغة تماماً بشكل يبث الرهبة داخلي، هاته التي تنبعث أعمق كالصدى بمجرد انتباهي أن المكان مشرع على خلاء يلتقي بالسماء. أسأل نفسي: من الذي قرر هنا أنّ على محطات النقل أن تكون دائماً في أطراف المدن؟
لا يمكنني تحديد المكان الذي أنا فيه بدقة بناء على طلب المعلمات.. سأكتفي بالإشارة إليه بـ الفيلاج.. تستقبلني المعلمة رجاء في المحطة، تخبرني بمجرد سيرنا وكأول ملاحظة أنه من الممكن أن نكون المرأتين الوحيدتين الراجلتين في هذه الفترة المسائية، تنبهني ألا أجول بناظري ولا أحدق كثيرا كي لا أثير الانتباه بأني زائرة جديدة، وأن أتظاهر أني من هذا المكان، ذلك أنه إن بدا عليّ أني قادمة حديثة للمكان، سيرغب الجميع في معرفة ما الذي أفعله هنا.
نمشي للسكن الذي تبيت فيه رجاء وصاحبتها، كانت على حق، لا وجود لامرأة واحدة في الشوارع الصغيرة. الكثير من النظرات إلينا، تحرشات لفظية سريعة يلقيها بعض أصحاب السيارات، ثلاثة مكاتب استقبال مفتوحة للمترشحين للانتخابات هذا الشهر، نصب تذكاري للشهداء، محلات معدودة للأمور الأساسية، مراكز الإدارات تتوسط الفيلاج وتتجمع في أماكن قريبة من بعض.
نمر على المقهى، ألاحظ أن الجميع يجلس مولياً ظهره للداخل موجهاً نظره إلى الشارع، يتحدث أحدهم مع الآخر في الطاولة دون أن ينظر له.
“منذ حادثة الاعتداء على المعلمات، وكلما مررت على هذا المقهى، تراودني فكرة أن من بين هؤلاء من يراقب تحركاتي ويخطط لاقتحام مكان سكني ليلا”، تقول رجاء هامسة. هنا الجميع يعرف الجميع، ولا يتردد الناس عن سؤالك أي شيء حتى أخص خصوصياتك. يفعلون ذلك والابتسامة تعلو محياهم.
الفيلاج يبدو لي أشبه بالمدن السينمائية الصغيرة الموضوعة، يبدو وكأنه بني في يوم واحد، ولولا بناية أو اثنتان على الطراز الفرنسي لظننت أن عمر هذا المكان أعوام معدودة. حتى الجدران تبدو أقرب للكرتون منها إلى الإسمنت، الأصوات تسمع بسهولة والهدوء يلقي بظلال من الريبة والحذر داخلي. ترمى على نوافذ الطبقات السفلية للعمارات شراشف منزلية بغرض السترة.
مخزن.. سجن.. أم خم دجاج؟
مثل المحطة، تطل إقامة المعلمات على خلاء متسع. ندخل من باب صغير يعلوه سور خفيض، ساحة صغيرة، ثم باب حديدي ثقيل تستشعر الجهد الذي يتحمله كتفك لسحبه.
أفاجأ أن الإقامة ليست كما توقعت، شقة أو استوديو من نوع ما، بل مخزناً قديماً واسعاً، جدرانه عالية، نوافذه واسعة لا تفتح من الداخل يصد السور النابت خلفها أشعة الشمس من المرور. يصلح هذا المكان قبواً ربما، سجناً كأسوأ احتمال، لكن إقامة للمعلمات؟ أي كان من قرر هذا، فهو سادي مختل.
كانت زهرة قد زودتني بنظرة مسبقة عن مدى سوء الوضع حين أخبرتني عن الشاليه الذي وجهت للإقامة فيه في قرية سريانة في ولاية بسكرة شمال شرقي الجزائر، نفس المكان الذي حدث فيه الاعتداء الثاني بعد حادثة معلمات الجنوب. “خم دجاج، هذا أقل ما يمكن أن يقال عليه”.
كان الشاليه مغلقاً لسنوات، الزجاج مكسور، الغبار يتراكم طبقات، القطط الكلاب الشاردة تملأ المكان، الجرذان، السحالي الأقرب للتماسيح في الحجم. سرعان ما امتلأت أجسادهن بالحبوب من المفروشات المتسخة.
شاركت زهرة المكان مع 17 بنتاً من الجهات الأربعة للبلاد. لم يتحمل جسد زهرة كثيراً وأرداها مريضة. حملت على وجه السرعة إلى قسم الإسعاف لتقابل بمعاملة عنصرية من طرف طبيبة تسألها باستهجان مالذي أتى بها إلى هذا المكان، وكيف تسمح لها أسرتها بالابتعاد هذه المسافة الطويلة.
تسلم عليّ زميلات رجاء الأربع، ألتمس في نظراتهن الشك. أتأكد منه لاحقاً وهنّ يراقبن تحركاتي، خاصة عندما أحمل هاتفي، لم يسمحن لي بالتقاط الصور خوفاً على سلامتهن وخشية من فقدان الوظيفة.
أخبرنني أن انتشار قصة الاعتداء على المعلمات اعلامياً أثار الانتباه لوضعيتهن غير الآمنة. هن يعتقدن أن الحوادث التي تلت، هي نتيجة حتمية لهذا. أن أصور المكان يعني أن تطلع عصابة ما على التفاصيل الداخلية للمكان، فيسهل عليهم التخطيط لاقتحامه. هذا إضافة للمشاكل المحتملة مع الإدارة واحتمال فقدان مناصبهن، أو مع السكان المحليين الذين يرفضون بأي شكل أن يشيع أمر سيء عن المنطقة.
“حاولي حمايتنا بقدر ما نحاول مساعدتك في كتابة هذا الروبورتاج”، تخبرني بوضوح إحدى المعلمات. أتعاطف مع حياة الخوف التي تعيشها كل واحدة منهن، تعاطف لا يلبث أن يتغلب عليه غضب عارم، لا أحد مطالب أن يعيش حياة كهذه.
أخبر رجاء، “من الأجدر أن تغرقوا السوشيال ميديا بالصور من هذا المكان لا أن تخفوها”، تجيبني، ” ثم ماذا؟ من سيحميني حين تعرضي للاعتداء؟ ماذا سأفعل بالقانون حين يكون الضرر قد وقع؟ حينها لن أفقد فقط منصبي بل حتى عائلتي، خاصة وأن مجتمعي يلومني أنا أولا وقبل كل شيء، امرأة اختارت العمل والمبيت في مكان بعيد”.
نتعشى عشاءً جاهزاً من المطعم، لا زاوية هنا تصلح للطبخ، حنفية واحدة صالحة للاستعمال، ولا وجود لقطع أثاث تدل على مكان للنوم عدا أسرة الحديد. في الزوايا تجمع طاولات، كراسٍ، رفوف خشبية وما فاض عن حاجات الأقسام.
تستخدم خزائن حديدية ثقيلة صدئة ومهترئة للفصل بين أسرة المعلمات، يقشعر بدني من الخزائن المتسخة وأتخيل أن هناك جرذان ميتة لا محالة داخلها. أشارك هاجسي هذا مع رجاء وتخبرني أنهن يخضن صراعاً دائماً مع الجرذان، ينصبن المصائد بأنفسهن، ويطلبن من حارس المبنى جر الجرذان الميتة إلى الخارج حال عثورهن عليها.
النمل يغزو المكان، البعوض سريع القفز، العنكبوت تخيط شباكها في الزوايا التي لا يمكن بلوغها بسهولة. الرطوبة تتوغل في الأنحاء، كلما استخدمت الحمام راقبت السقف متوقعة أن تسقط علي قطرة ماء، أو قشرة من الدهان المنتفخ.
تشغل كل معلمة سريرها للقيام بواجباتها العملية، المطالعة، أو الترفيه عن نفسها في الهاتف. انقطعت الكهرباء مراراً، كلما حدث ذلك، يصمتن تلقائياً، يشعلن أضواء الهواتف، يتعاون للوصول لصندوق الكهرباء المثبت عن الباب الخارجي للتأكد من أن هذا الانقطاع لم يكن بفعل فاعل.
منذ حادثة الاعتداء الأولى، في 18 مايو الماضي، تغيرت حياة المعلمات هنا. صرن يطفئن الأضواء باكرا، يتفادين وضع سماعات الأذن للتفطن لأي حركة في المحيط، يقتصدن في الحركة ولا يحدثن أي ضجيج.
“الأيام الماضية، أرغمت نفسي على السعال في المخدة حتى لا أحدث أي صوت قد يدل على وجودي، على الأقل ان اقتحم أحد المكان، سيجد صعوبة في معرفة مكاني بالضبط”، تخبرني رجاء ضاحكة.
الليلة التي قبلها، توقعت إحدى المعلمات أن أحدهم يحاول فتح الباب الخارجي، نبهت رفيقاتها بهدوء، أدخلت احداهن الرقم الأخضر في الهاتف، وهو الخط الأمني المجاني في الجزائر، بينما حملت الباقيات سكاكين صغيرة ومقلاة واختبئن خلف الباب استعداداً للدفاع عن أنفسهن، لم يفتح الباب، وعدن للنوم بنفس الخوف والترقب.
أسألهن لماذا عليهن أن يتحملن كل هذا العناء، يجبنني نفس الإجابة: “لا خيار لدينا، علينا أن نعمل لنعيل أنفسنا وعوائلنا”.
على هؤلاء المعلمات تحمل المعيشة داخل هذا المكان المقرف، الرهاب النفسي الذي بثته حوادث الاعتداء الأخيرة، والتأقلم مع طبيعة المجتمع المنغلق هنا. “علينا أن نكترث ونراعي كلام الناس هنا، ذلك أنه يؤثر بشكل مباشر على سمعتنا المهنية، ما يقال عنك في الشارع ينقله التلاميذ في القسم، تعكسه تصرفاتهم معك ويحدد احترامك وهيبتك كمعلمة”.
معلمة في العاصمة.. في القطاع الخاص
أتذكر الرسالة التي وصلتني ذات مساء صيف 2019 من صديقتي ريمة تخبرني فيها أنها تكاد تموت من الرعب، كانت تفترش أريكة في قسم شاغر، يعلوها لوح أبيض ويقابلها جيش صغير من الكراسي والمقاعد.
أستحضر قصتها الآن في محاولة لإلقاء الضوء على واقع التعليم الخاص أيضاً. كانت ريمة قد قررت الانتقال للعاصمة للعمل في إحدى المدارس الخاصة بهدف بناء تجربة مهنية. غادرت الجلفة، ولاية في الوسط تقبع جل مدنها في الظل، و عكس المعلمات اللواتي زرتهن، ريمة انتقلت لقلب مدينة كبيرة.
قبل أشهر كانت قد تعرفت على مدير المدرسة الأربعيني من الفيسبوك. عرض عليها الوظيفة مصرّاً من أول يوم. كان عليها التنبه وقتها أن إصراره هذه هو إشارة حمراء على الخطر، خاصة وأنه كان يفعل نفس الأمر مع أشخاص آخرين تعرفهم. كان يحادث شباباً مثلها قادمين من “اللامكان”، لاعتقاده أنه من السهل استغلالهم.
عرض عليها المدير المبيت في المدرسة بحد ذاتها، قائلاً إن هناك غرفة شاغرة، وإنها لن تواجه أي مشاكل متعلقة بالحصول على الطعام أو الحماية مثلاً، ووعدها بأنه سيجلب سريراً لها، شريكة في السكن، مساعدة في العمل، حارساً للمبنى ويحاول تهيئة المكان كما يلزم.
لم تمر أيام قليلة لتكتشف أنه كان يخطط لاستغلالها بأبشع شكل، فصارت هي المعلمة والمنظمة والمنظفة وحارسة المكان. لكنها قررت رغم ذلك إقناع عائلتها بأنها تشارك سكناً بظروف جيدة مع فتيات أخريات وأن كل شيء بخير، كان همها في النهاية هو الحصول على مرتّب شهري، 34 ألف دينار (حوالي مئتي وخمسين دولار) أو ما وصفه الإعلام جزائري بأنه الأعلى في سلم الأجور..
قضت ريمة الأيام الأولى في مدرسة متسعة بأقسام شاغرة، بنيانها من الطراز القديم، حمام ضيق، ثلاث شرفات واسعة، ونوافذ كبيرة، وثلاث إطلالات مختلفة على منطقة صناعية لا يرى فيها الكثير من الناس. اكتشفت لاحقاً فسحة صغيرة ممتلئة بركام الأشياء، بجدار قابل للتسلق. وعلمت أن درارية، المنطقة التي تتواجد فيها، تشيع فيها حوادث السرقة. حيث يتفق لرجال العصابات الصغيرة من الأحياء المجاورة الطمع في البيوت الثرية والمؤسسات الصغيرة المجهزة بالحواسيب والأغراض القيّمة.
لم يف المدير بوعوده، ولم تتحمل ريمة العيش في ذلك الرعب أكثر. خارت قواها بسرعة، لم تكن تجد متسعا من الوقت لترتاح، تحرك أريكتها صباحاً قبل قدوم الأطفال، تفتح المؤسسة، تقوم بكل الأعمال الإدارية والتدريس، تغلق الباب، وتبيت فطنة متأهبة لأي اقتحام. لم تجد مكاناً للاستحمام ولا الطبخ، لا رادع للحشرات، ولا للهواجس تتآكل داخليا كلما سمعت صوتاً قادماً من الخارج.
نغادر باكراً، نعمل ساعات طويلة، نعود في نهاية اليوم مرهقات، نتصفح هواتفنا أو نشاهد التلفاز. لا نأخذ أي استراحات من أي نوع، كنت أرى البؤس والاستعباد صارخين في وجوه من حولي..
انتقلت بعدها للسكن في شقة مع أخريات عاملات، هؤلاء تفاجأن حين علمن أنها اختارت العمل بعيدا سعياً للتجربة، هن اللواتي اضطررن للخروج من أسرهن والابتعاد مسافات طويلة سواء بسبب صدامات، أو خوفا على حيواتهن.
ابتلع الروتين الشاق حياة ريمة كما فعل مع الذين من قبل، وجدت نفسها حبيسة التفكير في مسألتين لا غير: كيف تجمع المال وتدفع الفواتير. “لم تكن لدى أي واحدة منا حياة جيدة. كنا نغادر باكرا، نعمل ساعات طويلة، نعود في نهاية اليوم مرهقات، نتصفح هواتفنا أو نشاهد التلفاز. لا نأخذ أي استراحات من أي نوع، كنت أرى البؤس والاستعباد صارخين في وجوه من حولي”.
كحال أي امرأة تتواجد بمفردها، واجهت ريمة ورفيقاتها رقابة مجتمعية مشددة من المحيطين. حدث أن أثار جار مشادة صاخبة مع مؤجرة المكان. هاته التي اضطرت في النهاية لطرد الفتاة المعنية بغضب الجار، تهمتها كانت أنها كانت تعود للسكن مساء برفقة رجل غريب يوصلها بالسيارة. ذات يوم وهرباً من الضغط النفسي الذي يفرضه الوضع، خرجت ريمة في رحلة بحرية رفقة بعض الأصدقاء، وكادت تفقد حياتها بسبب محاولة أحدهم الاعتداء عليها بسلاح أبيض.
هذه التجربة التي انتهت بعودة ريمة لأسرتها، غيرت حياتها جذرياً. “الآن صرت أتفهم الحماية العائلية المشددة التي تحيطني بها أسرتي، الخارج مكان خطير لفتاة وحيدة. ما حدث للمعلمات في الجنوب لم يفاجئني بأي شكل، ويمكن لأي واحدة في وضع شبيه أن تتعرض له، في أي مكان وفي أي وقت”.
محاولة لوضع سياق للأمور
أواخر سبتمبر عام 1997، اعترضت جماعة مشددة مسار مركبات تقل 11 معلمة للتدريس في ضاحية نائية بمنطقة سيدي بلعباس بالغرب الجزائري. قام المتوحشون بتجريدهن من حليهن وحتى سندويتشاتهن قبل أن يرتكبوا مجزرة دموية لازالت حاضرة في ذاكرة الشعب الجزائري.
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي راحت ضحيتها معلمات، طالبات جامعيات وعاملات في مناطق بعيدة، والدافع كان معروفا وقتها: الإرهاب والتعصب.
اليوم وبعد عشرين سنة من المصالحة الوطنية وغلق صفحة الدماء التي استمرت عشر سنوات، يستمر العنف ضد المرأة في الجزائر بأشكال عديدة واصلاً للذورة: القتل.
عام 2020 قتلت 54 امرأة جزائرية بأعمار مختلفة وفي ظروف مختلفة. ومنذ بداية العام الجاري، تجاوز عدد المقتولات الـ 20 امرأة. وكلما وقع حادث، شبيه، يمر ذكره في شريط الأخبار هامشياً، مرفوقاً بنقاشات جانبية على مواقع التواصل يحاول البعض فيها تبرير فعل الجاني، فحتى المرأة المطعونة بالسكين حتى الموت تتحمل الذنب في نظر بعض المجتمعات. وحتى المعلمة المغتصبة تواجه باستنكار من البعض: “وهي وش داها؟”.
من جهة أخرى، يتخبط قطاع التعليم في مشاكل لا حصر لها تشمل الأجور المتدنية للمعلم الجزائري، عدم تهيئة ظروف العمل وظروف الإقامة والنقل. سابقاً هذا العام، شملت حركة إضرابات المعلمين العديد من الولايات بشكل كاد يشل بالقطاع. أتت حادثة الاعتداء على المعلمات لتبين بشكل واضح ما يعيشه المعلم الجزائري، وبشكل أدق المعلمة.
العودة..
كنت قد قضيت الليلة فطنة أتحسس الأصوات وأطرد النمل من وسادتي، الطريق للحمام يغدو رحلة على إحداهن أن ترافقني فيها وتراقبني عند الباب. يعلن النهار عن نفسه مبكراً، تستيقظ المعلمات ويتجهزن للعمل، يغادرن وأبقى مع رجاء التي سترافقني للمحطة مجدداً.
أقرر أخذ جولة أخيرة، أتفحص خزائن الحديد، تنطلق صرخة مني، جرذ ضخم ميت أسفل إحداها، لا أتخيل أني قادرة على قضاء ليلة واحدة أخرى في هذا المكان.
لحسن حظي، صادفتنا سيارة أجرة فارغة منطلقة لمدينتي، يبدو أني المسافرة الوحيدة لهذه الوجهة هذا الصباح. أودع رجاء بحضن سريع وأقضي المسافة أتساءل إن كنت لأنجو إذا تم توظيفي الخريف القادم في مكان شبيه.