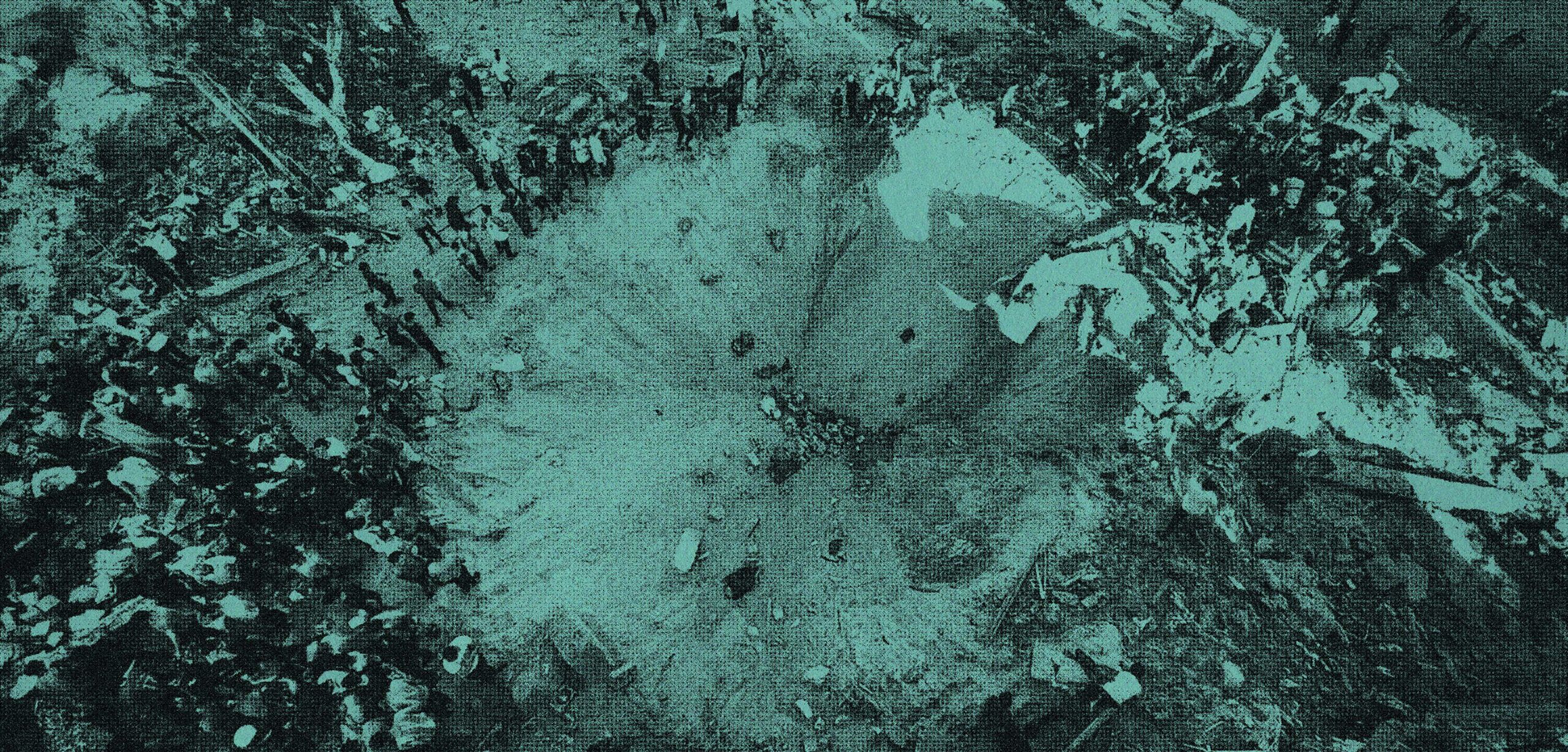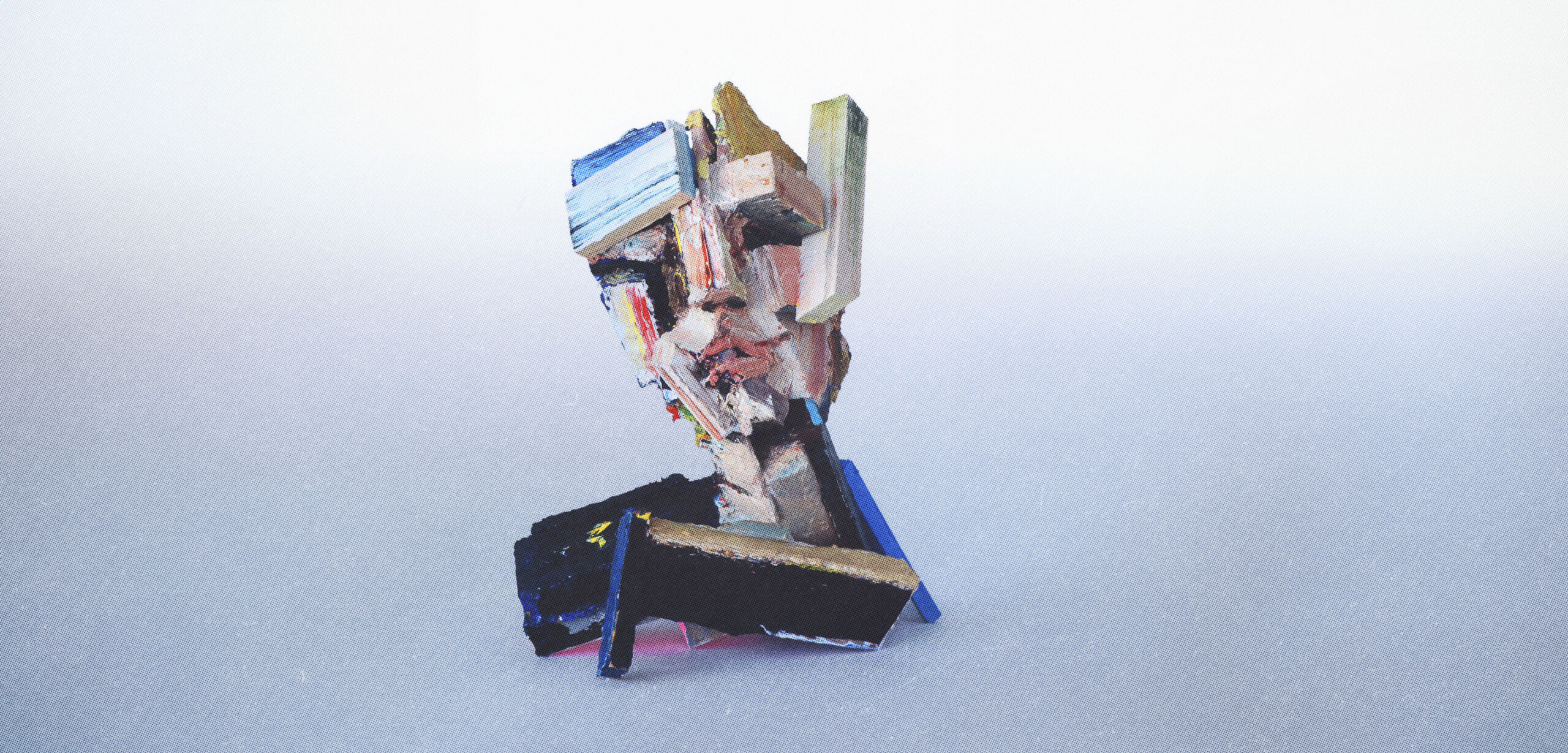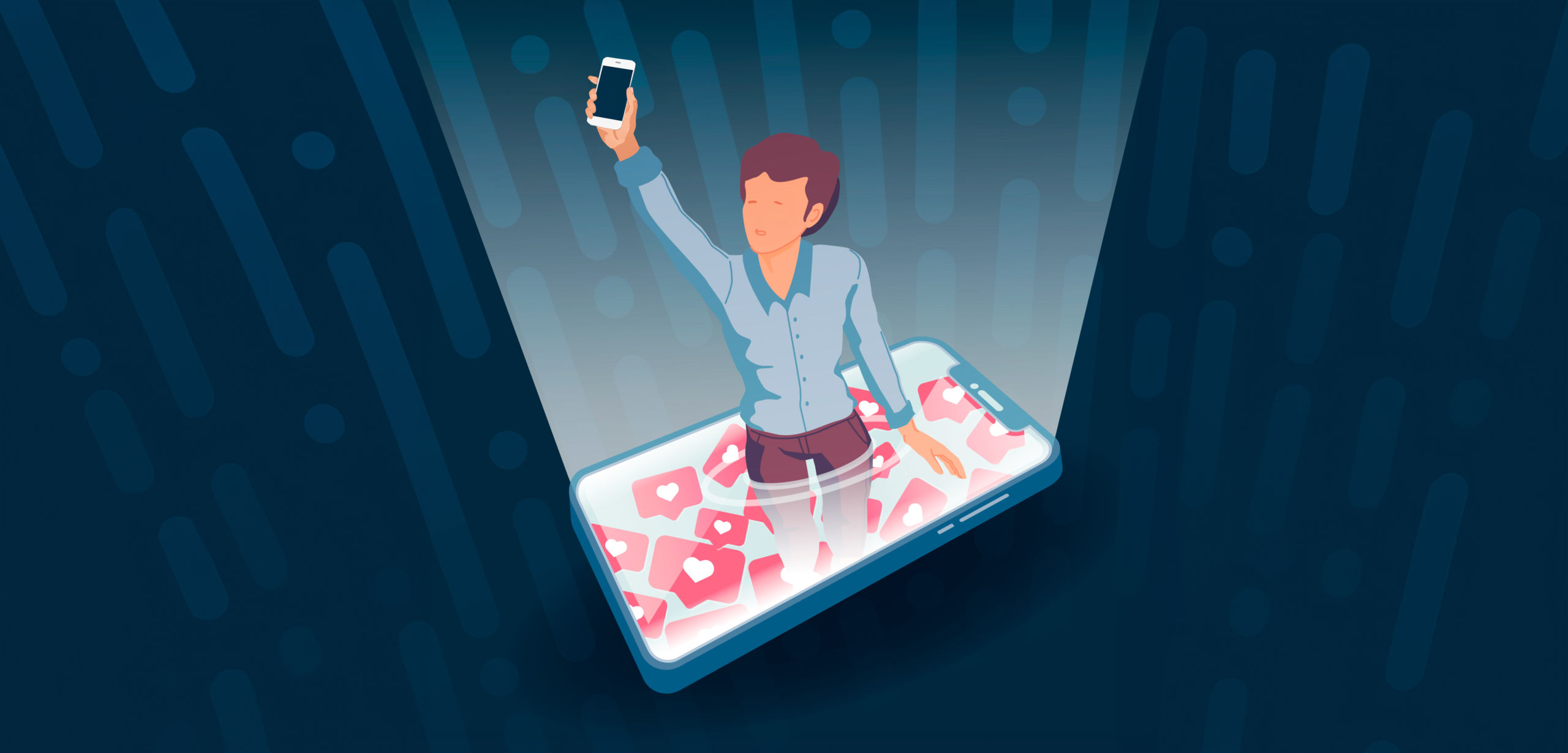منذ أشهر أعلنت “القناة الوطنية” التونسية الثانية عن تغيير موعد بث سلسلة شُوفلي حَلّ الكوميدية، وتقديمه أكثر من ساعة عن موعده المعتاد. قبل أن تتراجع القناة عن ذلك وتستجيب للتعليقات الكثيرة على صفحتها بالفيسبوك بإعادة البث إلى الوقت القديم في حدود الساعة الثامنة مساءً و20 دقيقة.
ثمّة شيء غريبٌ في علاقة التونسيين، وحتى علاقتي أنا نفسي، بهذا المسلسل الذي لا تملّ القناة الحكوميّة التونسية الثانية من إعادة بثّه، ودون أن يتراجع هو عن صدارة نسب المشاهدة في القناة وأحيانًا في نسب المشاهدة لكامل القنوات التونسية.
علاقةُ التونسيين بهذا المسلسل معقّدة ومركّبة وعسيرة عن الفهم. يتعلقّون به كلّ ما مضت السنوات، ويتابعونه مكرّرين نفس الحلقة لمرّات عديدة دون أن يفقدوا الشّغف ونفس الابتسامة.
يحكي المسلسل وهو من نوع “السيتكوم” عن قصّة طبيب يتقاسم قاعة انتظاره مع عرّافة، تقرأ الحظ بالفنجان و”الكَارطة” (لُعبة الورق). وتدور أحداث المسلسل في فضاء صغير جدًا: طابق من عمارة.
في ذلك الطابق يسكن الطبيب النفساني “سليمان لبيض” مع عائلته، جيرانًا للعرّافة، التي تمتلك العمارة بأكملها، ويسكن كذلك في شقّة مستقلة صغيرة، كاتبه وأخوه “السبوعي”، الشّخصية الأكثر طرافة والأكثر شعبيّة عند التونسيين، والذي هو خطيب (ثمّ زوج) “عَزّة” الفتاة التي تعمل عند العرّافة “جَنّات”. وفي ذات الطابق أيضًا يقع مكتب الطبيب وقاعة انتظاره التي يتقاسمها مع جارته العرّافة.
في فيلم وثائقي بعنوان “الحبلُ على الجُرّراة” (وهي عبارة تونسية تعني تكرار نفس الأمر عدّة مرّات ودون توقّف) أنتجته القناة الرّسمية التونسية الثانية، حول المسلسل وكواليسه، يقول كاتب العمل حاتم بالحاج بأنّ فكرة العمل الرئيسية هي “تلك الثنائيّة بين الخرافة والعلم” أي ذلك التعايش والتداخل بين عالمَي طبيب نفساني وحياته الشخصيّة وبين عالم عرّافة وحياتها الشّخصية والتي انتهت في النهاية بالمصاهرة. حاول الفيلم بالاستناد إلى تحليلات علماء نفس واجتماع تحليل هذا المسلسل كـ”ظاهرة” وأن يفهم تعلّق التونسيين بهذا المسلسل والنجاح المستمر لإعادة بثّه المتواصلة، حتى أنّ الوثائقي استعار تلك الصّورة في عنوانه “الحبلْ على الجرّارة”.
هناك مسلسلات شبيهة في كلّ مكان في العالم تثير نفس الأمر، لا يخبو تأثيرها ومتعتها مهما طالت السنوات، وقد تناولتها مقالات كثيرة بالتحليل مثل مسلسل “فريندز” الأمريكي، وشوفلي حل نفسه باعتباره “ظاهرة تونسية” تطرقت لها عديد المقالات التحليلية لكن لكل تونسيٍّ علاقته الذّاتية بالمسلسل وبالسبوعي خاصةً.
شخصيًا، حين أعود مساءً للبيت، وقت العشاء لابدّ أن أفتح حلقة على اليوتيوب أثناء الطّعام. أكاد أحفظ الحلقات حرفيًا من كثرة الإعادة، ولكنه طقس حميم ومحبّب من طقوسي اليومية. نفس الأمر متشابه عند معظم التونسيين. لذلك كان رفضهم واسعًا لتغيير موعد إعادة البث. الساعة الثامنة والنّصف موعد العشاء لمعظم التونسيين أو موعد السّهرة والاجتماع أمام التلفاز، وفي كلا الوضعيتين لن يكون شيء أفضل من شوفلي حَل لمتابعته أثناء العشاء أو السّهرة.
مرآةٌ عاكسة للواقع الاجتماعي التونسي، ويمكن لكلّ عائلة تونسيّة أن ترى جزءًا من نفسها فيه، كما أنّه “عائلي” بالمعنى الأخلاقي، يمكن أن تشاهده العائلة مجتمعة وبمختلف أعمارها دون أن يكون هناك إحراج أو “قلّة إحترام”، كما أنّه خفيف ومضحك ومحبّبٌ إلى النفس.
كانت تونس حينها تبدو كرقعة هادئة في عالم متغيّر، رقعة ساكنة تمامًا.
شخصيّة السبوعي، التي أدّاها المرحوم سفيان الشّعري، هي الأجمل على الإطلاق. بجسمٍ ضخم وعلى أبواب الكهولة ولكنّه ساذج وبعقل طفلٍ صغير. مزيج ممتع بين الطيبة والبلاهة والطرافة والمغامرة والمكر السّاذج. نموذج مثالي للشّخصية الكارتونيّة المحببّة عند الأطفال. لكن الجميع يحبون السبوعي صغارًا وكبارًا، وأنا منهم.
نحبُّ فيه كلّ ذلك، مثلما كنّا نحبّ شخصيّة “محروس” في مسلسل الأطفال التونسي الشهير “ضيعة محروس”، وهي ملاحظة دقيقة من أحد الأصدقاء، أثناء نقاش بيننا حول “السبوعي”. ربما نحن نتعلّق فطريًا بالسذّج والطيبين وننحاز إليهم ونحبهم، أو حتى ربّما نشفق عليهم.
سرد في “التاريخ الاجتماعي” التونسي
كان النظام السياسي، بين عامي 2005-2009 مسترخيًا تمامًا في تونس. يحقّق أرقامًا تنمويّة معقولة ويحكم قبضته بقسوة على الحياة السياسيّة. ولا شيء يفلت من رقابته أبدًا. وكان العالم يتبدّل بسرعة، كما لو كنا على مشارف تغيير كبير. رقعة الاستعمال المنزلي للأنترنيت تتوسّع، وتنتشر الهواتف النقّالة وتولد معها ظواهر وسلوكيات جديدة. في تلك السنوات المتسارعة بالتحولات الاجتماعية والثقافيّة التي تنتجها التقنيات الجديدة الوافدة، كان التونسيون يتسمّرون ليلاً لمشاهدة حلقات شوفلي حل.
لا معارضات سياسيّة مزعجة، بخلاف جرائد حزبيّة ضعيفة التأثير، ونقابات عمّالية “مُرَوَّضة”، ولا شيء يقلق النظام السياسي أبدًا. بينما، غربًا كانت الجزائر تتخفّف من آثار عشريّة داميّة مازالت أطرافها مزروعة بالجماعات الجهاديّة المسلحة، وشرقًا كانت ليبيا تدخل عهد الإصلاحات الكبيرة والمصالحات مع الغرب ورفع الحصار ونزع برنامج السلاح النووي دون أن تتخلّص بشكل نهائي من “وصمها” الثوري المتمرّد المزعج للغرب المتأهّب للانقضاض. وفي الشرق الأوسط كان العراق يغرق في فوضاه الدّامية بعد إسقاط نظام الرئيس صدّام حسين، وملفات القضيّة الفلسطينيّة تتناثر أوراقها في العواصم المتباعدة بين المفاوضات والمواجهة. وكان الإرهاب يضرب بقسوة في مختلف مناطق العالم وفي عواصم الدّول الكبرى بأجهزتها الأمنية القويّة وتفوقها التكنولوجي الكبير.
كانت تونس حينها تبدو كرقعة هادئة في عالم متغيّر، رقعة ساكنة تمامًا. وإذا استثنينا عمليّة جربة قبل ذلك بعامين أو ثلاثة، والتي نجح النظام في خفض الضجيج حولها إلى درجات دنيا، كان كلّ شيء يسير على ما يرام في بلد يصفُ نفسه بـ”النامي”.
كانت الدراما التلفزيّة اجتماعية يصفة مطلقة، لا شيء سياسي أو “فكري”، بعض تلك الهموم تسللت إلى السينما ولكنها بقيت خارج التلفاز. دراما اجتماعيّة متفاوتة العمق والإتقان ولكنها مضبوطة داخل رؤية سياسية شاملة شديدة التسييج بالخطوط والمحاذير. وحتى الأعمال الدراميّة التاريخيّة كانت تتناول المشترك الوطني في السياق الدعائي التمجيدي الطبيعي لأي عمل تاريخي (كفاحي غالبًا) يُوظّف لتكريس السرديات الرسمية عن الكفاح التحرري والوطني الجامع.
أحبَّ التونسيون شوفلي حل كعمل إبداعي، يضحكهم ويرون فيه أنفسهم. ثمّ تعلقوا به يجرّهم الحنين. لا يفسّر الحنين وحده كل شيء في علاقة بذلك المسلسل بالذّات، ولكنه عنصر قائمٌ بقوّة
في تلك السنوات كان التونسيون “يلتهمون” سلسلة شوفلي حل من تأليف حاتم بالحاج الذي نجح في نحت أحد أهم الأعمال التلفزيّة على الإطلاق في تاريخ تونس. كان السيناريو، وخارج المحاذير السياسيّة شديدة الوضوح، مكبوتًا أيضًا داخل طبيعة العمل نفسه بإعتباره “سيتكوم” بفضائه الضيّق وشخصياته المحدودة، وأيضًا داخل طبيعته الهزليّة المرهقة للكتابة والمخيال.
كانت السلسلة، مطبوعة بروح تونسيّة أصيلة، في شخصياتها وفي قصصها. تصوّر المجتمع التونسي كما هو بشكل قريبٍ جدًا للواقع، ولكن أيضًا كما تريده الدّولة والنظام السياسي. مجتمع هادئ. يخرج المجرم فيه من السّجن مؤهلا نفسيًا وسلوكيًا للاندماج الاجتماعي من جديد، وتمتلك فيه عائلة الطّبقة الوسطى سيّارة ويمكنها بناء منزل في حي راقي وليد، عبر قرض بنكي. أحد الأصدقاء وصف المسلسل ذات مرّة بأنّه “قصّة الطبقة الوُسطى عن نفسها”.
تمتلك العائلة حاسوبًا، بعد سنوات من البرنامج الرئاسي للحاسوب العائلي، وتحضر الشرطة بشكل مثالي لتوفير الحماية في المشاكل الطارئة، وتراقب الدّولة فيه بصرامة مسألة القرصنة وحقوق الملكيّة، وتفرض البلديّة قوانينها على مالكي العمارات في ما يتعلّق بالسلامة والنظافة والصيانة. يمكن لعائلة الطبقة الوسطى أن تقضي رأس السنة في نزل وأن تكتري بيتًا شاطئيًا في الصيف. العائلة التونسيّة في نموذجها المثالي، التي تقدّس تعليم أبنائها وتحرص عليه، تحترم التقاليد والأعراف الاجتماعية بجرعة محافظة لا تخلو من “تحرّر” خفيف تفرضه تحولات الحياة.
حول تلك العائلة تبنى قصص أخرى، كان فيها الهامش واسعًا لنقل المجتمع بأكثر حريّة وصدقٍ وفسيفسائيّة، لنتصادم مع التحبّل والانتهازيّة والشعوذة والعنف الأسري والانقطاع عن التعليم وأحلام الثروة السريعة والرهان الرياضي والغش والسرقة والخيانات العاطفيّة والبطالة والسّحر وكرة القدم وروائح الملوخيّة (باعتبارها طبخة تونسية شهيرة).
لا يمكن لحاتم بالحاج أن يكون قد قرأ كتاب “الشخصية التونسيّة” للمرحوم الراحل المنصف ونّاس قبل كتابة المسلسل، لأنّ الكتاب صدر (على حدّ علمي) عام 2010، لكنّه نجح فعلاً بإتقان مبهر في أن يُسيّلَ لنا فنيًا، ما صاغه الأخير بـ”صلابة” الأكاديميا في الكتاب الأوّل من نوعه حول “الشخصية القاعديّة” التونسيّة، قبل كتاب الهادي التيمومي “كيف صار التونسيون تونسيين؟”.
استثنائيّة شوفلي حل، لا تكمن فقط في المتعة وفي نجاح السيناريو والأداء وتعلقّنا الجماعي بالعمل. بل هو أكثر من ذلك وثيقة راصدة لتحولات تاريخيّة وثقافية واجتماعيّة في تونس. في تلك السنوات (2005-2009) كانت تونس تتحوّل تحت وطأة العولمة والزحف التقني والهواتف الجوّالة. حين يوثّق لنا المسلسل لحظاتنا جميعًا مع أوّل هاتف جوّال نمتلكه. وحين يوثّق لنا دخول الانترنت إلى البيت، وحين يذكّرنا بـ”الديسكات” التي نسخت عليها “دَدّو” (السكرتيرة) أحد محاضرات سليمان لبيض.
كنّا نخرجُ من زمنٍ لندخُلَ آخر. ولكننا لم نكن نشعرُ بالوطأة، كان تحوّلاً تراكميًا تحت سكينة سياسيّة. كلّ شيء كان مضبوطًا. الأسعار في المتناول، أزمة بطالة واضحة لكنها في الحّد الذي يسمح للمجتمع أن لا ينهار. الأمن مستتبٌّ والحياة بسيطة، وخاصةً استهلاكيّة وساذجة.
مجتمع بلا قضايا كبيرة، أو مزعجة. حمل عنه النّظام السياسي همّه كاملاً، واستكان الأخير كعصفور مستريحًا لا يريد أن يفكّر بعيدًا أو بشكل ثقيل، وإن كان صوتٌ ما في عقله الباطن يقول له: “ثمّة شيء قادم”. كانت سكينة تشبه تلك الضّحكة التي يعقبها التونسي بالقول: “ربّي يعطينا خير هالضّحكة”، خوفٌ كامن في خلايا التاريخ الجمعي المليء بالفواجع، من أنّ لاشيء يدوم كما هو عليه.
يشعر التونسيُّ البسيط بثقلها على أكتافه، ويحنُّ إلى زمن “الخفّة”. نهربُ جميعًا من بؤس الواقع إلى ابتسامة السبوعي وبساطته.
إحدى الصديقات مرّة كتبت أنها لا تحبُّ السبوعي. لأنّه -بما معناه- شخصيّة ضعيفة لا يمكنه العيش خارج جلباب أمّه ويكرّس كليشيهات تافهة عن الخوف من المرأة والاتكال والجبن والفشل. ربّما لو تعمّقنا في رؤية الأشياء لوجدنا أنّ أكثر شيء كرّسه المسلسل هو بالذّات وفي مقام أوّل، قوّة المرأة التونسيّة وحضورها الطاغي وسيطرتها على الحياة العائليّة. كانت رسالة أفترض أنّها تستحق الاحتفاء التقدّمي، ليس فقط لذاتها بل أيضًا لصحّتها وصوابها.
قرأت مرّة دراسة علميّة بالفرنسية عن العنف المنزلي في التلفزات التونسية، أحد الاستشهادات كانت تحيل إلى التطبيع مع العنف ضد المرأة في مشهد ضرب “سيدي داوود” لزوجته “كلثوم” وكيف تمّ تحويل الأمر إلى مسألة مضحكة. لا أختلف مع ذلك أبدًا، لكني أرى أنّ كلثوم ذاتها، نموذجٌ للمرأة التونسيّة القويّة التي تعيل عائلتها بينما يقضي الرّجل يومه في لعب “الشكبّة” (لعبة الورق).
حنين إلى “زمن الخِفّة”
أحبَّ التونسيون شوفلي حل كعمل إبداعي، يضحكهم ويرون فيه أنفسهم. ثمّ تعلقوا به يجرّهم الحنين. لا يفسّر الحنين وحده كل شيء في علاقة بذلك المسلسل بالذّات، ولكنه عنصر قائمٌ بقوّة.
حنين لزمن السّكينة والسذاجة المريحة. الاستقرار الذي لا يرهقُ فيه الناس أنفسهم بالنقاشات الكبيرة والمواضيع الثقيلة والإشكالية. كان “الدّربي”(مباراة النادي الافريقي والترجّي) ربّما هو لحظة الانقسام الكبير الممكن على صعيد نقاش في المقهى. وكان انقساما ممتعاً على كلّ حال، وبدون أضرار اجتماعية أو تكلفة سياسيّة تذكر.
شوفلي حل بدأ بعد عام واحدٍ من فوز تونس بكأس أفريقيا للأمم، الانجاز الأهم في التاريخ الرياضي الوطني. حفلة الاحتفاء والتمجيد في توصيفات “درة المتوسّط” (ملعب رادس) والانجازات المغلّفة في الصياغات الصحفيّة والرّسمية شديدة الجفاف. ثمّ “قمّة المعلومات” التي نغّصها حضور وزير إسرائيلي، وقد نجح النّظام السياسي على كلّ حال -ورغم ذلك- في تحويلها إلى إنجاز آخر بعد كأس أفريقيا. جاء شوفلي حل في سياق عام من “النجاح”، والتصق في الذاكرة الجمعيّة بتلك الفترة “المريحة” من تاريخ تونس.
لم يكن المواطن التونسي البسيط يعلم الكثير عن القمع السياسي القائم، ولا يبدو مهتما كثيرًا كذلك. “شوفلي حل” هو كذلك -بمعنى ما- الحنين إلى زمن “بلا سياسة”، فلقد أرهقت التونسيين السياسة بعد الثّورة، بصخبها وضجيجها وتحولاتها وصداماتها ونقاشاتها وانعكساتها (السلبية غالبًا) على حياته. يشعر التونسيُّ البسيط بثقلها على أكتافه، ويحنُّ إلى زمن “الخفّة”. نهربُ جميعًا من بؤس الواقع إلى ابتسامة السبوعي وبساطته.
في السرديات القوميّة الغربيّة يتحدّث المنظرون عن ما يسمّونه “البناء النفسي المشترك للأمّة” وهي تلك الأشياء التي تتراكم عبر الثقافة والتجارب التاريخية المشتركة لتصهر البناء النفسي الجماعي داخل قالبِ وعيٍ واحد، قومي غالبًا أو وطني، بدايةً من قصص التراث إلى الأشعار والأمثلة الشعبية والأغاني والفلكلور والملاحم واللحظات الانفعالية المشتركة. وشخصيًا يبدو لي “السبوعي” بضحكته البلهاء الجميلة، قائمًا في قلب هذا المفهوم لو أردنا أن نتحدّث عن “بناء نفسي وطني تونسيّ مشترك”. فالتونسيون جميعًا يحبون “السبوعي” كصديق شخصي (وحميم) لكل واحد فيهم. يصهرنا “السبوعي” ويجمعنا في زمنٍ يشتّتنا.