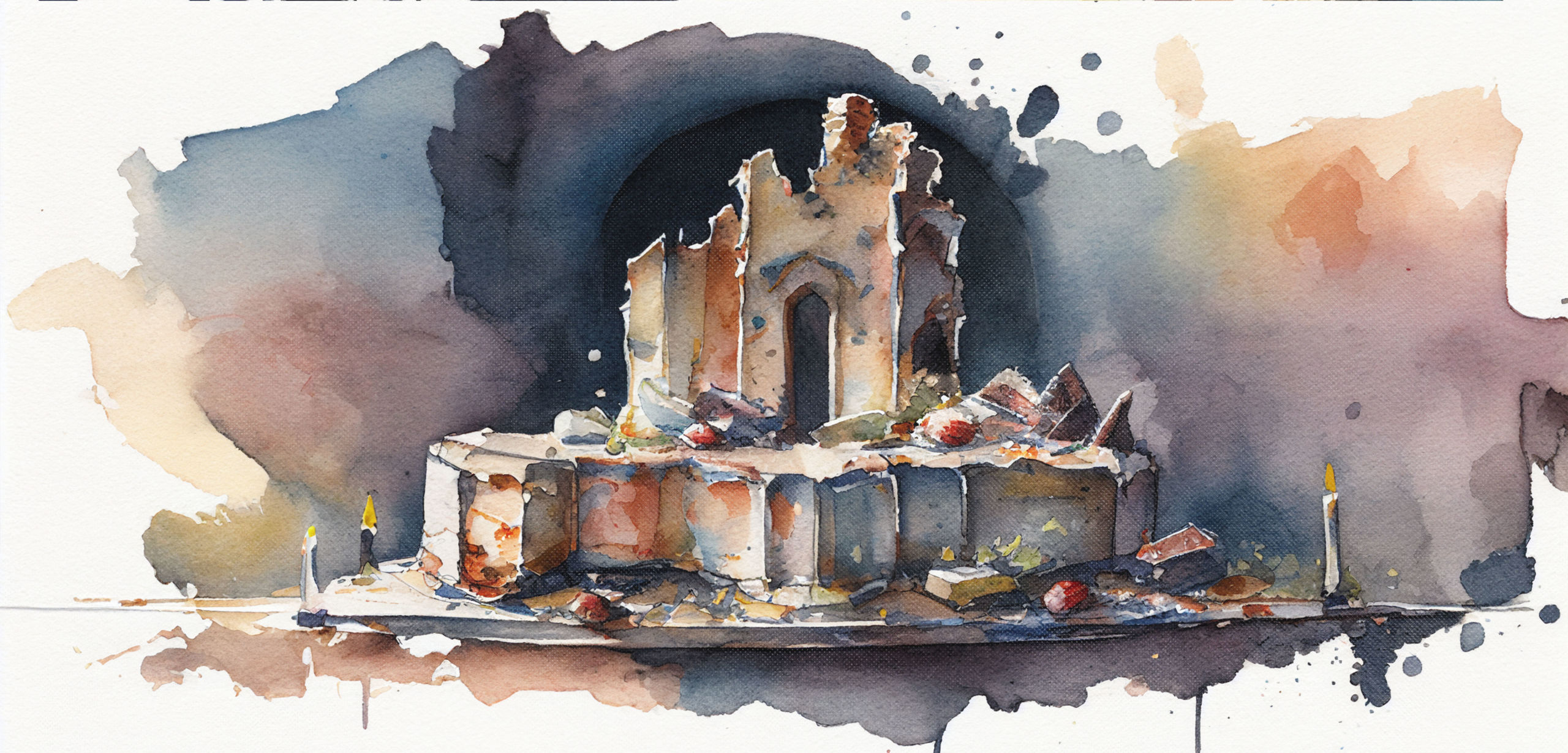الخامسة إلا ربع فجراً، تتدحرج عربات جمع الخردة في مخيم عين الحلوة دفعة واحدة كأنه طقس متفق عليه. تمشي كالأفاعي لتفادي الحفر الكثيرة ما أمكن. أحدهم يجر عربته ويضغط بقوة على المقبض الحديدي لرفع العجلة الأمامية واجتياز المطبّ. ينسج خط سير العربات خريطة متشعّبة من دون تخطيط مسبق. أحياناً يشكل التلاقي فرصة لتنظيم السير وتوزيع الأحياء، يقدمون النصح ويتبادلون المطارح وفق إشارات بأيديهم وأعينهم كفريق ينظّم تحركاته قبل أن ينصرف كل منهم إلى جهة.
ينبغي إكمال المهمة قبل السادسة ونصف- إذ ليس على هؤلاء رفع رؤوسهم قبل التقاط كل ما هو قابل للبيع؛ بلاستيك، نايلون، ألومنيوم، كابلات نحاس، أدوات أو قطع إلكترونية، معادن- وهو موعد قدوم الأسطول الثاني من العربات، وهذه يقودها عمال نظافة بلباس أزرق ويقبضون معاشاً منتظماً بالدولار، وبمهمة وحيدة؛ جمع النفايات وإلقائها في مكبّات المخيم.
نفايات تحت الحراسة
بُنيت مكبّات عين الحلوة السبعة على فترات متلاحقة، بدأت عام 2008 واستمرت حتى 2018، حين بني مكبّ حطين. آنذاك، اشترك ستة من مسؤولي لجنة المجتمع المحلي في قص الشريط الأحمر الذي أعلن افتتاح “بيت الزبالة” رقم سبعة، فأهل المخيم يطلقون على المكبّات “بيوت الزبالة” لكونها تلاصق منازلهم وتشترك معها بجدران إسمنتية وبوابة حديدية، في حين تمتاز عنها بشكل السقف الهرمي والمساحة الواسعة. اكتسبت هذه المكبات مع الوقت أسماء الأحياء القابعة فيها، وأصبحت دليلاً للعناوين فهنا “عرض أسعار لميني ماركت بجانب مكب حطين”، وهناك “بيت للإيجار مقابل مكب صفوري”.
بحسب اللجنة الشعبية (تعرف أيضاً بلجنة المجتمع المحلي) داخل المخيم، فإن المكبّات تستوعب يومياً ما بين 55 و60 طناً من النفايات. يتحكم في إخراجها، لمرة أو مرتين يومياً، الإجراءات الأمنية المشدّدة التي تمارسها مخابرات الجيش اللبناني من ساعات تفتيش وانتظار لشاحنات الأونروا على الحاجز، إلى مواكبة أمنية لحين الوصول إلى جبل النفايات بالقرب من معمل الفرز جنوبي مدينة صيدا، هناك تُلقى النفايات بإشراف المخابرات.
تنقل شاحنات الأونروا (عددها ست أو أقل) ربع الكمية في الدفعة الصباحية الأولى، قد تصل لنصف الكمية إن سمحت المخابرات بذلك بين الساعة 11 و2 بعد الظهر، ما يعني نوم أطنان من النفايات بدون تصريح خروج في المكب، تطلق روائحها الكريهة وتنقل الأمراض إلى أجساد جيرانها. لكنها تعطي فرصة أكبر لجامعي الخردة والبلاستيك للبحث عن أرزاقهم، فلحسن الحظ أن أبواب المكب الجرارة لا تغلق أبداً، تتركها الأونروا مشرعة مع وجود كاميرات مراقبة يقول عنها وسام العلي (جامع خردة وأحد أبناء المخيم) “لا ندري إن كانت تصور ظهورنا المحنيّة وأعيننا المتسمّرة نحو الأرض، أو أنها تلتقط ما نلتقط”.
وجوه مكشوفة
يحكي العلي عن تجربته، “من يوم يومي أجمع الخردة من الشوارع والزواريب فقط. قبل 2011، ورغم عددنا القليل وامتلاء المكبّات إلا أننا لم نلتفت إليها، بسبب جراثيمها وروائحها التي تبعث على التقيؤ. وبصراحة، كنّا نحسب حساباً للألسن ونظرة الناس التي قد تأكل وجوهنا”.
لكن الأمر ليس كذلك الآن، فلا يخفي العلي أنه من الذين ينتظرون المساء “الساتر ” للملمة الخردة من المكب، يغيّرون ملابسهم ويضعون اللثام، يتجنبون الحديث كي لا يُعرفوا. أمّا في النهار، فلا يدخل من باب المكب إلا من يريد أن يرمي قمامته، أو شبان يرتدون بناطيل بجيوب كثيرة يحملون مسدسات يمارسون بها هوايتهم في تصيّد الفئران والجرذان.
تغيّر الحال مع بداية اللجوء السوري إلى لبنان عام 2011، ازداد عدد سكان عين الحلوة، والقمامة، والجامعون أو النبّاشون. بدأ شبان سوريون وفلسطينيون سوريون بجمع الخردة من كامل أرجاء المخيم، ما أضافوه إلى المهنة أنهم دخلوا المكبّات بوجوه مكشوفة، دون أن يكترثوا لعيون الناس وألسنتهم، إذ أصبح مألوفاً أن ترى لاجئين وآخرين من المخيم يغوصون مع بعضهم البعض في أطنان النفايات.
خالد أبو الطيب شاب فلسطيني قدم من مخيم اليرموك، منعه قانون العمل اللبناني من ممارسة حوالي 70 مهنة، منها مهنته القديمة في الأمن والحراسة (سيكيوريتي)، فاتجه لجمع الخردة وبيعها في مراكز التجميع داخل المخيم، إذ تمنع الحواجز إخراج أكياس الخردة، في حين تسمح بدخولها شرط أن تُفتّش. بدأ أبو الطيب بالجمع مشياً على قدميه، ساعده ذلك في التعرف على شوارع المخيم وحفظ الزواريب، ثم اشترى بسكليت يحمله بسرعه ويحمل ما يلتقط، ومع توسع حلقة العمل عاد يمشي على قدميه، لكن هذه المرة يجرّ عربة.
في الشوارع يبدو المجال مفتوحاً للجميع، لا يضير شيء إن تواجد خالد وعدد من رفاقه في قطعة من شارع واحد، قد تجد أحدهم يجمع البلاستيك، آخر تراه يسأل المحلات عن كراتين وصناديق خشبية وبلاستيكية وعبوات فارغة، شخص آخر يقف مع عربته وبيده مطرقة كبيرة، بجانب بيت يقوم عمال بهدمه، ينتظر انتهاءهم ليبدأ بسلخ الحديد عن الباطون. وفي الزواريب يبدو الأمر مختلفاً قليلاً، هناك قانون لا نعرف من وضعه، يقول إنه في حال التقى نبّاشان، ينظر كلّ منهما وراءه، على أن ينسحب للخلف من قطع مسافة أكبر في الزاروبة تاركاً الجزء الأقل المتبقي لزميله.
حرائق الرزق وملائكته
حين التقى خالد بسامر (لاجئ سوري الأصل وجامع خردة)، دار حديث طويل بينهما يمكن اختصاره ببعض العبارات اليومية ” البلاستيك كتير يوم الأحد.. الكرتون ما عبيطلع سعرو منيح مع الدولار.. التنك أحسن.. الحديد أحسن وأحسن.. خلي عينك على أكياس التعزيلة.. انتبه مبارح عضني جردون.. معقول في دهب في بوردات التلفونات واللابتوبات؟!”.
ابتعد سامر عنّا بضعة أمتار حين رنّ هاتفه، وعندما أنهى مكالمته، استأذن بالمغادرة بكلمات مقتضبة أنهاها بـ “إجت الرزقة”. “أي رزقة! لماذا لم تسأله؟”، تدخّل خالد ليجيب عن سؤالي الفضولي “هناك أشياء لا يسأل جامعو الخردة بعضهم عنها، تبدو من الغباء، هي أسرار للمصلحة المكشوفة، كمكان الرزقة ونوعيتها والمصدر (الشخص المتصل بسامر)”، وغالباً ما يفسر السؤال بأنه “ديقة عين” (حسد).
صحيح أن كل ما يحصّله جامع الخردة “رزقة”، لكن أحياناً قد يحالفه الحظ من مصدر آخر غير المكبّات. يخبرنا خالد مثلًا أنه قضى منذ أسبوع يوماً كاملاً في فك أجهزة الموبايلات وانتزاع بورداتها (اللوحة الإلكترونية الأم للهاتف)، بعد أن حصل عليها إثر احتراق أحد المحلّات، وباعها بـ 40 دولاراً، أي خمسة أضعاف أجرة عامل مياومة “كان الحريق هو الملاك الذي جلب الرزقة”.
يحاول كل عامل أن يوسع شبكة علاقاته الاجتماعية، غالبية الأشخاص الذين يتعرفون عليهم من الميسورين وأصحاب المحلّات والمغتربين الذين يكثرون في فصل الصيف، هؤلاء لا يجادلون في السعر إن باعوا أشياء تصلح للاستعمال، بل يعطونها بالمجان أحياناً. ومثلهم من يعود إلى بيته الصغير في المخيم هرباً من الإيجارات المرتفعة في صيدا، هؤلاء جميعاً سيكونون ممتنين لخالد أو لرفاقه، إذ يخلّصوهم من أغراض لا يحتاجونها. طبعًا هناك خردة تتفوق على غيرها، هذا ليس سرّاً، السر كيف يتم تحصيلها، مثلاً تباع الكراسي والطاولات البلاستيكية بسعر أفضل من العبوات الصغيرة والصناديق، وإن كانت الكراسي سليمة تباع لشخص يحتاجها بسعر أعلى.
أصول المهنة
يقسّم سامر الخردة التي يجمعها إلى قسمين؛ الأول يحتفظ بها في منزله، قد تكون أجهزة إلكترونية تعمل أو أعطالها بسيطة تصلّح وتباع، أو ما يحتاجه المنزل (حنفية، ساعة غاز، خلاط ماء، طناجر، أباريق، عدّة، مطرقة، مفكات، كراسي، طاولات، لمبة إضاءة، تلفاز، ريسيفر)، وهذه بيعها سهل، إذ يكفي أن ترسل صورها إلى مجموعات البيع والشراء في “واتساب” لتأتيك عشرات الاتصالات. القسم الثاني هو خردة تباع إلى مركز التجميع، ولهذه معايير وشروط تضبطها المهنة، أهمها ميزان جيد وصاحب مركز “ابن حلال”، وعلى النبّاش أن يفرز الخردة ويتحلى بالشطارة، وهذه يعرفها القدماء، والجدد يتعلّمونها مع الوقت.
ذات مرة تقصّد سامر أن يزن أكياس الخردة خاصته لدى أكثر من مركز، الظاهر أنه كان يسومها ليحصّل أفضل سعر، وهذا وارد اليوم أكثر من ذي قبل، بسبب تغير سعر صرف الليرة اللبنانية كل يوم مقابل الدولار صعوداً ونزولاً منذ بدء الأزمة، ومنذ خمسة أشهر اضطر لبيع الخردة بنصف سعر اليوم الذي قبله. ما أخفاه سامر وقتها عن التجّار أنه كان يجري اختباراً للموازين، ودرساً لابن أخيه حديث العهد في مهنتهم، إذ لا ينبغي أن يشعر أصحاب المراكز أنهم يمارسون شطارتهم عليه، والقاعدة الآن هي البيع للوزن الأعلى إلى أن تثبت إدانة الميزان.
تأتي القاعدة الثانية بعد وزن الكمية، إذ يدور النقاش حول السعر، كلّ يحمل آلة حاسبة منفردة أو على الهاتف، يعطي التاجر سعراً منخفضاً قليلاً “لا تتظاهر أنك تفاجأت بسعره، إرمِ سعرك المرتفع، وغالباً ستتفقان على سعر يتوسّط الرقمين”. بقي أمر آخر أو قاعدة أخرى، يخاطب سامر ابن أخيه “هناك معادن أغلى من الحديد، ستانلس، ألمنيوم، فونط، تيفال، قد يضعها التاجر في الميزان مع الحديد أو التنك، أخرجها بيديك، لا تخجل، كن وقحاً، لقمة العيش تستحق، أخرج كيساً مطوياً في جيبك، ضعها داخله، أعدها معك إلى البيت أو اتركها بعد أن تحصل على السعر الذي تريد”.
لا شيء ثابت في مهنة تجميع الخردة، كل ساعة وكل يوم في مكان مختلف، خردة مختلفة، أسعار متغيرة، يصنّفها الخبراء بين المهن التي لا تتطلّب ذكاءً خاصاً، معظمهم لا يحبّون هذه العبارة، ويضحكون لذلك، ما يحبونه في مهنتهم فسحة الحرية داخلها، إذ يستطيع أي منهم أن يترك عدّته في المكب أو الشارع، ليشرب علبة عصير مع لوح شوكولا وأغنية صباحية في أي من دكاكين المخيم الكثيرة، تلك رفاهية قد لا يملكها موظّفو الشركات الكبيرة، ربما هذه إحدى قواعد سامر أيضاً.
هذا ليسَ يوم عطلة
في غوغل، يكفي أن تكتب نفايات عين الحلوة، ستخبرك عشرات التقارير التي ينكشها المحرك العظيم عن علاقة غير جيدة بين السكان والمكبّات، صحيح أنها تحوي “زبالتهم”، إنما تعود وترسل روائحها الكريهة والجراثيم والبكتيريا إلى بيوتهم وصدورهم.
تتكدّس النفايات يومي السبت والأحد، والأعياد الرسمية وعيدي الفطر والأضحى وأيام الاشتباكات بسبب عطلة عمال الأونروا وموظّفي الشاحنات، وعدم وجود طاقم بديل، رغم المطالب المتكررة للسكان. يحكي أحد سكان المخيم أن هناك روائح لا يمكن وصفها مثل اختلاط رائحة الشواء مع رائحة العظام والجلود وأحشاء الحيوانات المذبوحة في أيام عيد الأضحى.
يخبرنا الطبيب عماد أبو العلا، أخصائي أمراض تنفسية، عن أمراض أخرى تأتي من النفايات مثل، التهاب الجلد والحساسية نتيجة الهباء الحيوي، وهي كائنات دقيقة تنبعث في الهواء من النفايات المتكدسة في بيئة رطبة، إضافة إلى التهاب الكبد واليرقان والسحايا.
يقول أبو يوسف أحد جيران المكب إن ابنته (14 سنة) تعاني من تليّف رئوي، ولا يمكنها أن تنزع الكمامة عن وجهها طيلة أيام الأسبوع، غالباً ما تسهم الروائح في زيادة ضيق التنفس لديها، خاصة في فصل الصيف، لهذا يحاولون إرسالها إلى أحد أقربائها خارج المخيم أو لمكان بعيد عن المكب.
السعال وتهيج الحلق والتهاب القصبات الهوائية وحساسية الربو والإسهال، هي أغلب ما يشكو منه السكان المجاورون للمكب، جامعو الخردة يضحكون للسؤال السخيف “هل تؤثر النفايات على صحتك؟”، يشعلون سيجاراتهم ليحمّلوها وزر سعالهم وأمراضهم التنفّسيّة.
عمومًا، قلما يجري الالتفات جدياً إلى نوعية الهواء الذي يتنفسه ساكنو المخيمات، فهي مناطق جُعلت لتكون مؤقتة وغير مخدومة إلا بالحدود الدنيا وظلّت هكذا رغم مرور الوقت. ضيقة بكثافة سكانية عالية وبنى تحتية رديئة، وممنوعة من التوسع. تقع داخل البلاد غير أنها خارجها في الوقت نفسه. وحين نتصور حجم النفايات في هذه الكثافة، علينا أن نضيف إلى الصورة تلوث المياه المعروف عن المخيم، وتلف تمديدات الصرف الصحي منذ عقود، وقلة المساحات المفتوحة، وتحلل النفايات وما تنفثه أثناء ذلك إلى الهواء لتجلب المزيد من الآفات والروائح الكريهة.
إن صادفت أحداً من عين الحلوة اسأله: هل تستطيع شرب قهوة صباحية رفقة زوجتك على الشرفة في بيتك المقابل للمكب، خاصة يومي السبت والأحد؟ أم أنك ستجد نفسك مستيقظاً لحماية بيتك، متسلّحاً بـ “بخاخ” قتل الحشرات، تغلق كل شيء في وجه الجرذان والفئران والقطط، تريح عمال النظافة الهانئين في فراشهم من لملمة قمامتك برميها من الشرفة إلى المكب، وتخرج عن وقارك الصباحي بوابل من الشتائم.
ستمنع أطفالك من اللعب خارج البيت، “هذا يوم الوسخ والقرف، ليس يوم العطلة”، لاحقاً ستهرب من بيتك المحصّن إلى مكان تبحث فيه عن هواء، فقط هواء، قد تدخل إلى حديقة محمد السعودي، الأقرب إلى المخيم، ستلقي بجسدك على العشب، وتضع رأسك فوق يدك المطوية منتظراً القهوة، وستنسى للحظات أن هذه الحديقة كانت جبل زبالة بمليون ونصف متر مكعب من النفايات.