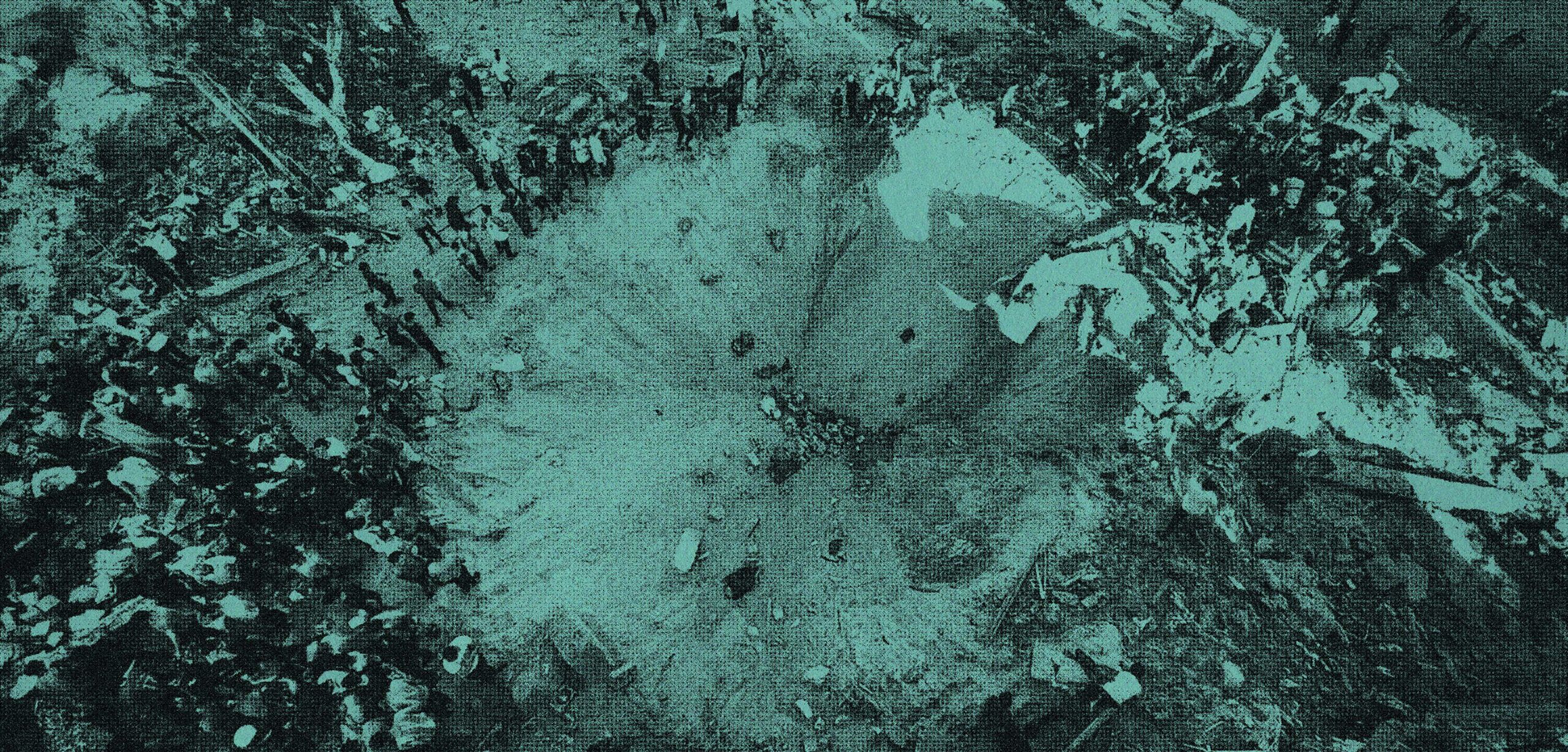يمكنك دوما وفي أي مكان أن تعبر عن حبك لأحدهم بأن تقدم له طعاما معروفا في بلدك، قد يُسعدك الفرنسي بقطعة جبن أو بنبيذٍ فاخر، وتبادله أنت عرجون تمر أو علبة جوزيّة. وهكذا صارت الجزائر – بعد أربع سنوات من الإقامة بفرنسا- دون قصد أكثر حضوراً من وقت إقامتي بها، أو ربما صار حضورها واضحاً؛ تلك الرغبة الدائمة في أن أحدّث معارفي عن طعام منطقتنا أو أن أجعلهم يتذوقون بعض الأطباق إن سمحت الفرصة، شَرحُنا المتواصل لبعض عن طريقة تحضير الوصفات اللذيذة.
ذلك ما أكدته صديقتي السورية بالحديث عن المطعم الذي افتتحته عائلتها هنا بالمدينة وكيف استطاع أن يغير علاقتهم بالفرنسيين، ويوسع شبكة معارفهم/ما جعلهم ينتقلون من تقديم الأطباق السورية حصراً إلى تقديم أطباق سورية بطابع وديكور فرنسي، لاستهداف أوساط مختلفة وعدم حصر العرض على الجالية المهاجرة.
وجدت في البداية صعوبة في التأقلم مع مذاق الأطعمة هنا، حتى تلك التي أحضرها بنفسي لم تعد تشبه ما كنت أقدر على طبخه في الجزائر. لم أكن قد تعرفت بعد على الكثير من المحلات، فكنتُ أضطر غالباً إلى تغيير طريقة التحضير لعدة أكلات لأجل أن تتناسب مع ما يمكن إيجاده في الأسواق من مكونات.
عندما كنت أخطط لسفرِي الأول لم تخطر ببالي أي أسئلة أو شكوك حول صعوبة التأقلم والاندماج حين يتعلق الأمر بالطعام لكن وجدت نفسي لا أكف عن نقل شكواي لأمي:”لا أجد تمراً بنوعية جيدة، ولا كسكسي بالسُمك المناسب، بل حتى الطماطم لها مذاق البلاستيك!”.
ليسوا طبّاخين
عطلة العودة للجزائر بالنسبة لي هي عطلة العودة لطعامِ أمي، لمشاوِي الشوارع، للسهر على موائد الطعام وطبعا لإحضارِ الذخيرة الممكنة من الكسكسي والبهارات والعديد من المواد الجافة التي لن تتأثر بطول الرحلة، كنت أحمل كل هذا كمن يحمل قُبل أمه وجلسات أصدقائه، لذلك تعاطفت كثيرا مع بارويز أحد أبطال رواية عمارة لخوص “كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك” وهو الهارب من إيران لإيطاليا بعدما أغلق مطعمه الخاص والذي كان يقدم أشهى المأكولات هناك، حين وجد نفسه في روما مجرد غسّال صحون.
“كما ترون، كرهي للبيتزا لا ينطوي على أي نوع من الحقد على الإيطاليين” … “ما يهم الآن هو أن أتفادى قدر الاستطاعة المشاكل المترتبة عن موقفي الصارم المعادي للبيتزا. أنا لا أبالغ، قبل أسابيع قليلة فصلوني من عملي كغاسلِ الصحون في مطعم قريب من ساحة نافونا عندما اكتشفوا عن طريق الصدفة كرهي للبيتزا.” كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ص 14.
أمرّ بشكل دوري بالقرب من محطة الميترو “غيوتيار” بالمنطقة السابعة لمدينة ليون والمكتظّة بالجالية المغاربيّة، وباعة “المالبورو/ سيجارة البْلاد”، بينما ذهبت خصيصا هذه المرة لأجل الانتقال بين مختلف المطاعم وتدوين الملاحظات أو ربما القصص لئلا أكتفي برأيي كمقياس وحيد حول تجربة الطعام خارج بلداننا.
تكلمت مع مدراء المطاعم الذين كان استقبالهم لي مختلفاً (قلّة من فهم أن ما أنوي كتابته ليس إعلانًا لمطعمهم بل مقالاً عن مطاعم المهجر والأكلات التقليدية بين فرنسا والجزائر)، وأول سؤال طرحته هو إن كانوا أصحاب مطاعم في بلدانهم قبل قدومهم هنا؛ لأجد أن معظمهم مستثمرين وليسوا طباخين، يبدو أن التجارة المربحة حين تكون مهاجرا هي أن تستهدف جاليتك.
أكل جزائري
اتجهت نحو عنوان “14 شارع مارسيليا” وكان المطعم باسم “ريحة البلاد – l’air de pays” يقدم أكلات تقليدية جزائرية وتحديدا من جنوب الجزائر (شخشوخة بسكرية، ومسيلية، وزفيطي…) يخبرني صاحبه أنه يعتبر نفسه المطعم الوحيد في المدينة الذي يقدم أكلا جزائريا حقيقيا، فكل ما يُقدم في المطاعم الأخرى مشترك بين عدة بلدان مغاربية، على عكس مطعمه الذي يختص في “أكل البلاد الحقيقي”. ويشير لأنه ليس طباخا لكنه متذوق، وقد اختار السيدة فاطمة منذ افتتاحه لتكون الشيف المسؤول وهي الحائزة على عدة جوائز مطبخية وطنية في الجزائر.
لا يختلف الأمر في السينما فقد طرح المخرج عبد اللطيف كشيش نفس الفكرة في فيلمه La graine et le mulet (كسكسي وسمك البوري) حين تتقدم الشابة ريم مع زوج أمها سليمان لطلب قرض من البنك لأجل افتتاح مطعم على قارب يكون متخصصا في تحضير طبق الكسكسي، وحين تسألُهما مديرة البنك عن سببِ رغبتِهما في بدء المشروع تجيب الفتاة المولودة في فرنسا، والتي لا تتقن غير بعض الكلمات العربية بصوت متلعثم أنهما يرغبان بإعادة جمع جاليتهما، وخصوصا أنهما يجهزان لأفكار جميلة لإحياء شهر رمضان في المطعم.
سليمان الذي ينوي افتتاح هذا المطعم لم تكن لديه فكرة واسعة عن الطعام ولا المطاعم، كل ما هناك أنه فكر في مشروع ربحي، يساهم فيه رفقاء آخرين، كزوجته التي ستكون الشيف.
طعم الماضي
من جهة أخرى ثمة من يرفض بشكل قاطع أي شيء يربطه بجالية بلده ويجد نفسه في إنكارٍ شديدٍ لكل ما قد يعيده لذكرياته، ذلك ما حدث لصديقتي الهاربة من جزائر التسعينات، التي لم تحضّر طبقاً جزائرياً واحدا منذ قدومها ولا تشعر بأي رغبة في إعادة تذوقه، ولا مشاركته مع من تحب، بل لم تزر الجزائر لأكثر من 12 عاما وكان ذلك قبیل وفاة والدها وبعدها قطعت الرابط الأخير المتبقي. تُقیم بعیدا عن المدینة في أحد أرياف غرب فرنسا الأمر الذي كان خيارا بالنسبة لها لتبتعد تماما عن المدن وجوّ الأشخاص القادمین من نفس منطقتها والذین لا یكفّون عن تذكيرها بكل المآسي التي عاشتها هناك، وقد قررت أن لا تنقل هذه التجربة القاسیّة لأبنائها لا من خلال الطعام ولا من خلال التردد على تلك الأماكن.
ربما يشكل للبعض الاعتراف بانتماء ما حرجا كما حدث لبطل الروائي المصري طلال فیصل في روایته بلیغ:
“من يدري، لعلّ نفوري منه هو نفورنا الطبيعي من بعض في الغربة! هذا شيء أدركه -للأسف- بعد فترة من الاستقرار في فرنسا؛ شعوري بالانزعاج أو الخجل عند رؤية شخص عربي أو مصري، تلك الرغبة الدائمة في طمس حقیقة أني قادم من تلك المنطقة البائسة التي تُصدر اللاجئین و المجرمين والمتطرفين! في كل موقف یوميّ أرید أن أؤكد على هذه الحقیقة، أنا طبیب، أنا لست من أولئك الذین تمتعضون بسبب وجودهم في بلادكم.” بلیغ ص 13
كسكسي في “بوكس”
المشترك لدى مطاعم الجالية عموما هو التنافس الشديد بين من يقدم أكل البلد الحقيقي، ومن الأكثر أحقية بطبق الكسكسي في بلدان الشمال الإفريقي، ينظرون للطعام من خلال تصوراتهم الذاتية ويكتشفون بتذوقه طعم ذكرياتهم؛ لا يكتفون بمنح الطعام هوية بل يؤمنون أن الطعام قد يحدد هويتهم.
في المقابل، على بعد ثلاث كيلومترات من حي مطاعم الجالية، وتحديدا في المنطقة الأولى للمدينة مقابل مقر البلدية، عنوان “16 شارع لالجيري”، اكتشفت مطعم “كوسبوكس CousBox” بطابع مختلف تماما.
يقول صاحبه أن والده افتتح المطعم منذ بداية السبعينات بنفس المقر وبنفس الفكرة المتمثلة في تقديم طبق الكسكسي بتصور جديد. يؤكد الشاب الثلاثيني المولود بفرنسا والذي استلم المطعم من والده أنهما حاولا خلال قرابة الخمسين سنة تقديم طبق الكسكسي في علب “بوكس” كوجبة سريعة لا تختلف عن “البرغر”، وكان ذلك لأجل كسر الصور النمطية عن هذا الطبق.
حاولت أن أفهم منه ماهي الصور النمطية المطروحة، فأجابني: “ثمة كليشيهين أساسيين، الأول يجعل من هذا الطبق أسطورة خرافية، وتصورات غير معقولة؛ يجب أكله مع العائلة في صحن مشترك، ويجب تقديمه بأحد أنواع اللحوم ضرورة! لا… بل يمكننا تقديم كسكسي نباتي، هذا لا يُنقص من قيمته إنما يوسع مدى انتشاره لدى المتذوقين بمختلف توجهاتهم.” ويضيف: “الكليشيه الثاني يتمثل في الإساءة للطبق الذي لاحظته لدى الكثير من المطاعم إذ يقدمونه بشكل غير طازج؛ يستخدمون عادة خضارا مجمدةً، ويمكن حتى أن يقدموا نفس الكسكسي لليوم الثاني والثالث”. يشير للمطبخ المفتوح أمام الزبائن ويؤكد على نظافة كل زاوية منه ثم يكمل: ” نحن نهتم بشدة أن يتم الطهي على مقربة من الزبون، مستخدمين الخضر الموسمية والمحلية لنتأكد من نوعية الصلصة المقدمة.”
أما فكرة المطعم العامة فقد كانت تقديم أطباق منوعة للكسكسي، دون البحث خلف أصله. ألا يهم إن كان في الحقيقة تونسيا، مغربيا أو جزائريا؟ نظرت لقائمة الطعام الطويلة والتي لا تحمل غير أنواع مختلفة لنفس الطبق وسألته: “ما الذي تقدمونه تحديدا؟”.
لا يوجد كسكسي حقيقي
“في الحقيقة فكرة المطعم نختصرها على الحائط: لا يوجد كسكسي حقيقي”، أجابني وهو يسير نحو الخريطة، ثم واصل: “في البرازيل يقدمون حبوب كسكس الذرة بحليب جوز الهند، أو كسلطة باردة مع الحيوانات البحرية، بينما في السينغال ومالي نجد كسكس بصلصة مافيه Mafé وهي صلصة دجاج. جنوبا في غينيا يحضرون الكسكس بحبوب الفونيو الأبيض وهي أحد الحبوب المستخدمة لتحضيره من غير ڤلوتين في مطعمنا. أما إذا اتجهنا شمالا نحو أوروبا أذكر لكِ طبق كسكس الربيع بإيطاليا، إضافة لكسكس تزاتزيكي اليوناني، أو كسكس Thaï التايلندي وغيرهم.
أنهى مروره بكامل الخريطة وهو يحدثني عن ميزة كل طبق ثم ختم قوله:
يمكن أن أختصر وأقول أن ما نقدمه هو كسكسي عالمي، ولا أخفي عليك أن القادمين لمطعِمنا غالبيتهم شُقر… نعم، نادرا ما تزورنا الجالية هنا، رغم أن أسعارنا تنافسية لكنهم يبحثون عن شيء آخر لا يجدونه لدينا، وقد كان هذا خيار والدي منذ البدء. قررنا أن لا نضع لافتة “حلال” لكننا لا نبيع لا لحم الخنزير ولا الكحول، لقد كان خيارا حساسا وعمليا في نفس الوقت، أو لنقل حاذقا بعض الشيء. تعاملنا مع شركات التوصيل المختلفة لكننا ندفع العاملين معنا منهم أن يستخدموا الفرنسية داخل المطعم: بونجور، بدل السلام.. (يقول هذا لأن الكثير من العاملين بشركات التوصيل مغاربة وعادة ما يتم التعامل بينهم وبين أصحاب مطاعم الجالية بالفرنسيّة المهجنة مغاربيا) هذه أيضا خيارات حساسة لكنها أعطت الصورة التي كنا نطمح إليها.
بالتأكيد ليس غريبا أن يزور “الشُقر” كما قال السيد مطعما يقع في قلب المدينة على مقربة من نهر “لاسون La saône” لتناول طبق الكسكسي، بينما يتجنبون التواجد في مطاعم ذات توجه طائفي، أو لنقل تفضل تشكيل لقاءات بين أشخاص تجمعهم ذات الذاكرة. فعمّال مطاعم الجالية عادة ما يتحدثون لغة البلد القادمين منه، ولن يجد الفرنسيون مكانا لهم هناك.
يستقبلك صاحب المطعم مباشرة بالسلام وكلمات الترحيب العربية، في حال كنت قادما مع عائلتك أو كنتن مجموعة فتيات سيدعوكم للإنتقال إلى الصالة الخلفية، أو للطابق العلوي، أما إذا كنتم مجموعة شباب بامكانكم الجلوس عند مدخل المطعم على مقربة من الرايح والجاي. جدير بالذكر أيضا أن تناول الفرنسيين لهذا الطبق ليس بالأمر الجديد، فحسب تحقيق أجراه موقع La sofres اُعتبر طبق الكسكسي ثاني أفضل أكلة لدى الفرنسيين بعد شرائح العجل، وقد كُتب في المقال أن طبق “الكسكسي المغاربي” قد استطاع الاندماج في عالم الطبخ الفرنسي واكتسب شرعيته بين الفرنسيين على اختلاف طريقة تقديمه (باللحم، بالدجاج، بالسمك، بصلصة حمراء، بيضاء، أو نباتيًّا.).
بالقرب من جدّتي
في الحقيقة أنا كمقيمة جزائرية غير شقراء تحمست للجلوس وتجريب هذا الطبق في بوكس بلاستيكي وبمفردي، لكنني اخترته بصلصة حمراء مع قطعٍ من لحم الغنم، الشكل الأقرب لما تعودت عليه. لقد تدربت منذ قدومي لبلد مختلف بعادات مختلفة أن أستقبل الأمور على ماهيتها ولا أنتظر أن تكون كما تصورتها، رحت أتناول الكسكسي اللذيذ والذي لا يشبه في شيء ذلك الذي تعدُّه أمي وأنا أفكر بأنه ورغم عالميته، إلا أنه لا يمكن الإنكار أن ما يعطي تصوّرا مشتركا على كونه طبقًا مغاربيًّا بالدرجة الأولى وما دفع لإدراجه ضمن التراث العالمي غير الملموس في منظمة اليونيسكو هو أهميته في منطقة شمال افريقيا تحديدا. إنها الأكلة التي تجتمع عليها العائلة في أفراحها وأحزانها؛ يُقدم في الأعراس والجنازات أيضا، في مختلف المواسم الاحتفالية، في لمّة التصالح بين المتخاصمين، لأجل الترحيب بالعائدين من الحج، أو ببساطة كل يوم جمعة بعد العودة من الصلاة.
ليس الطبق في ذاته ما يعدّ مهما، بل كل عملية التحضير التي تبدأ باختيار القمح الأفضل لذلك، وصولا لعملية فرده لأجل تجفيفه والاحتفاظ به لفترات طويلة مرورا بعملية الفتل وهي الأصعب؛ أي انتقال حبة القمح المطحونة لحبيبات كسكسي يجب أن تتساوى في سمكها لتدل على مهارة المرأة التي قامت بإعداده.
مازلت أذكر وأنا طفلة في الثامنة أو التاسعة من عمري حين جلست بالقرب من جدتي لتعلمني متى أضيف القمح ومتى أضيف الماء، كيف أحرك يدايَ الصغيرتين بشكل دائري وأي غربال عليَّ استعماله لأحصل في الأخير بعد قرابة الساعة على أول رطل من الكسكسي المفتول الذي جهزته بمفردي.
طبعا كل شيء يجب أن يكون دقيقا كعملية كيميائية في المخبر. منذ تحضيره إلى حين طبخه، تذكرني أمي بقيمة الحبة الواحدة، وتكرر على مسامعي آلاف المرات تحذيرات لئلا تضيع مني بعض الحبيبات هنا وهناك فهي تُقدَّر بتعبها وتعب جدتي ليلتان أو ثلاث لأجل فتله.
خارطة بحبات الكسكس
إتقان فتل الكسكسي في بلد مازلت قيمة المرأة فيه تقاس بشكل عام بمدى إتقانها للطبخ يعبّرعلى جاهزيتها للزواج، فحين نشرت على حساب الفيسبوك باحثة عن صور نساء يفتلن البربوشة أجابتني إحدى صديقاتي ممازحة: “أنا خايبة نشري الجاهز من السوق”.
تعليق آخر تساءل: “ما هي البربوشة؟” تسميات عديدة لنفس الطبق تتغير بتغير المنطقة: كسكسي، سكسو، طْعام، نَعمة، بربوشة… وكثيرا ما يولّد الأمر صراعات كأي شيء هشّ وقابل للصراع، هذه الكلمة هي الأصح، أو تلك؟ هذه عربية والأخرى أمازيغي، وصولا لصراعات حول طرق التحضير نفسها التي تعيدني لمطابخ الجالية حين كان يؤكد لي كل واحد منهم أنه يحضر الطبق التقليدي الحقيقي.
وهكذا بلا نهاية، نعرف جيدا أن ثمة من يحضره بصلصة حمراء وثمة من يحضره بصلصة بيضاء، أحياناً بالزبيب والسكر الناعم، وأحيانا بالمكسرات، أو بالفول واللبن. لكننا لا نعرف تحديداً أين تنتهي حدود المنطقة لكل وصفة وأين تبدأ وصفة المنطقة الأخرى، لا نعرف أيضا أيهما أكثر لذّة ولا حدود المنطقة الأكثر أحقيّة بأن ينتمي لها هذا الطبق، حيث يمكن رسم خارطة البلاد بحبات الكسكسي.