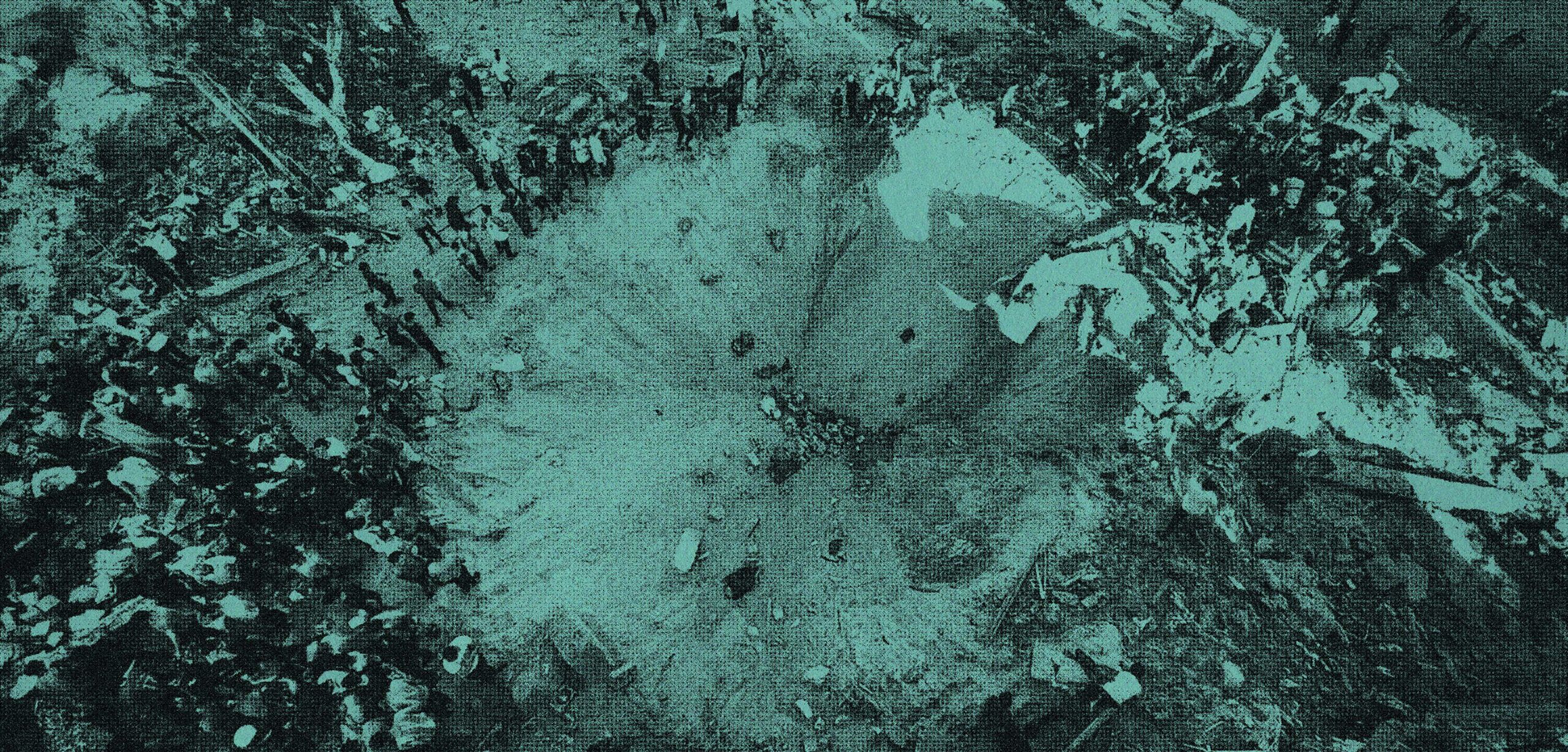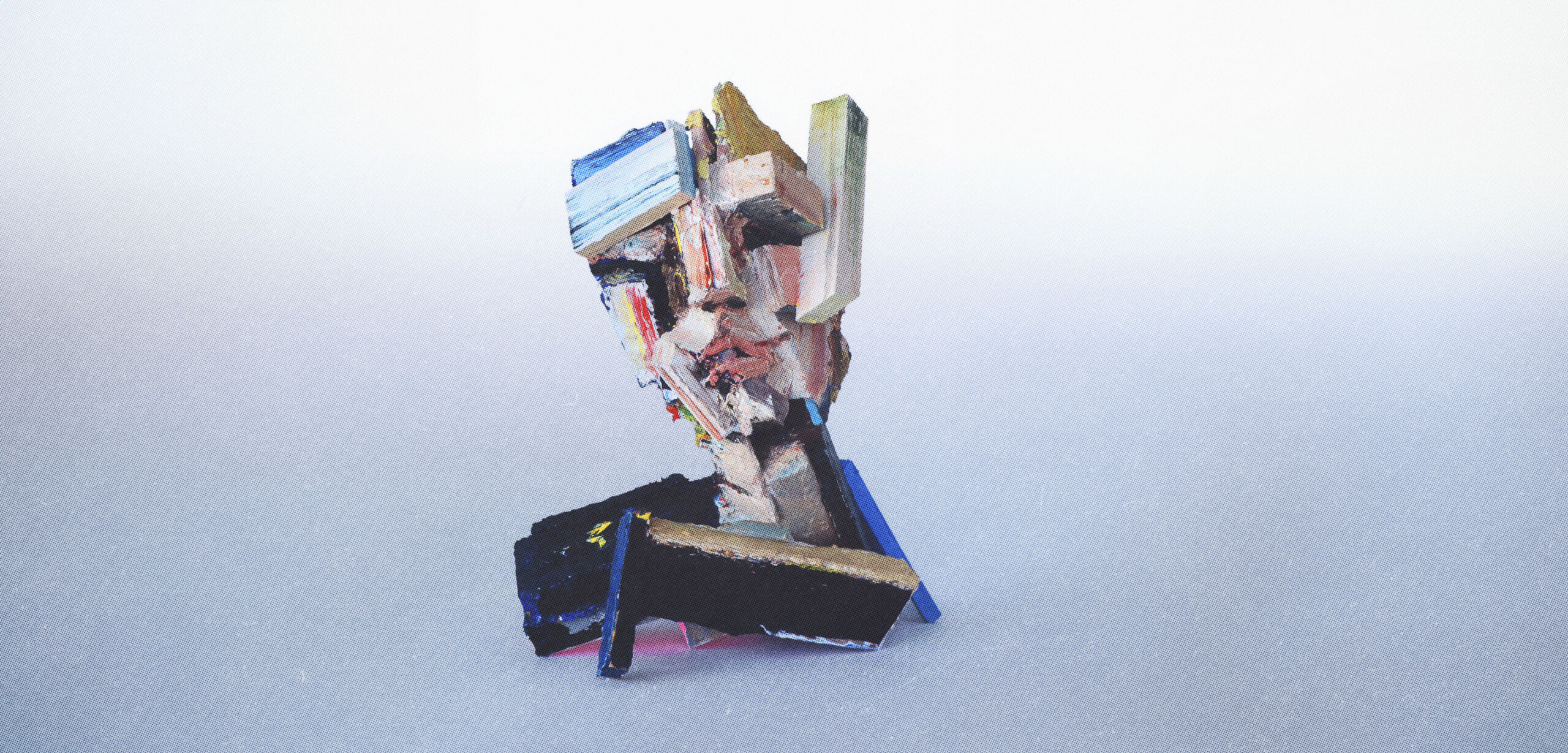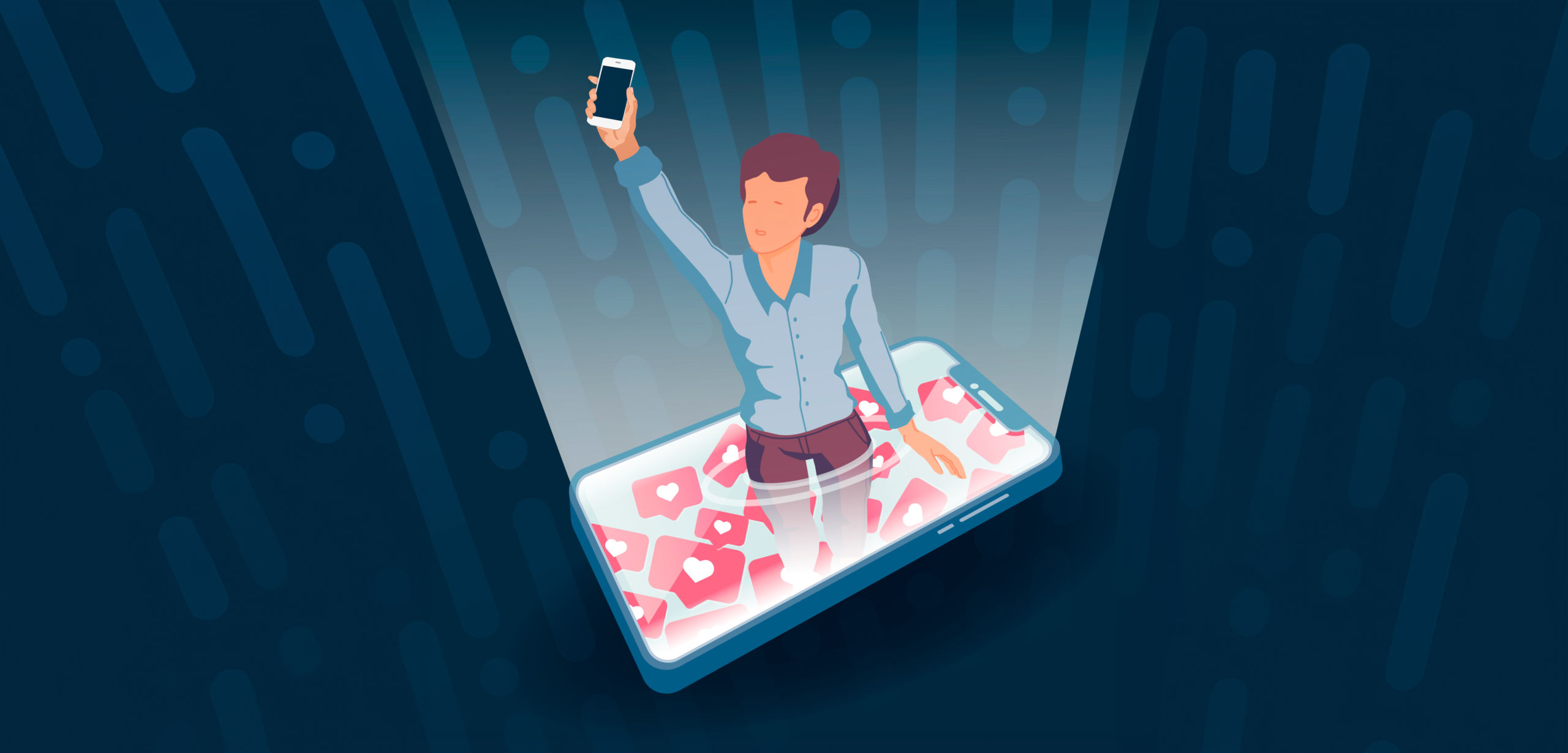“?Home, is it just a word, or is it something you carry within you”
“البيت، هل هو مجرّد كلمة، أو أنّه شيء تحمله بداخلك؟”
استوقفني هذا الاقتباس من فيلم Nomad Land الذي شاهدته مؤخّراً. حيث أنّي منذ فترة، اضطررتُ للانتقال من بيتي الذي أحبّ في حي ركن الدّين في مدينة دمشق إلى بيت صغير في المزّة 86، منطقة العشوائيات الشّهيرة التي احتضنَتْ الكثير من طلّاب العاصمة والعابرين فيها.
جئت في الأصل من مدينة السّويداء، وهي مدينة صغيرة تبعد عن دمشق سفر ساعة بالسيارة، قضيتُ فيها معظم حياتي، وشعرتُ فيها بالضّيق بما يكفي بسبب قلّة الأنشطة المتاحة والحياة الروتينية التي تفرضها.
كنتُ أزور دمشق مع أمّي كثيراً، وكانت المدارس تنظّم أحياناً رحلات إليها، وإلى اليوم، أذكر انبهاري في كلّ زيارة بمساحات المدينة واختلاف طبيعة أحيائها والتّنوّع الواسع بين سكّانها. ومنذ صغري، خطّطتُ للانتقال إليها عندما أكبر، ورسمتُ أحلاماً عن تجربة العيش فيها. دمشق التي كنتُ أعرفها من بعيد من المسلسلات، مثل “الفصول الأربعة” أو “أحلام كبيرة“، وأغاني فرقة “كلنا سوا” التي تتحدّث عن قدسيّا أو ساحة الميسات.
للأسف، لم تسنح لي الفرصة بالعيش فيها خلال دراستي في جامعة دمشق التي بدأتها عام 2012، الفترة التي اكتظّت فيها غرف السّكن الجامعيّ أكثر من أيّ وقت مضى لأنّها كانت الخيار الأكثر أماناً للطلّاب حينها. ولذلك، لم أستطع الحصول على سرير واحد في السّكن، وبعد محاولات عدّة، استطعتُ الحصول على مكان في إحدى الوحدات السّكنية.
أذكر أنّي فتحتُ باب الغرفة، كانت إحدى عشرة طالبة يجلسن في غرفة صغيرة على أسرّة حديدية متراصفة فوق بعضها، يعتليها الصدأ، وكنتُ أنا الطّالبة الثانية عشر، لم يكن لدي سرير حتى، بل فراش على الأرض. أغلقتُ الباب بهدوء، وعدتُ أدراجي إلى السّويداء إلى أن أنهيت دراستي الجامعية عن بعد.
لم تفارقني فكرة السّكن في دمشق طيلة تلك الفترة، بل عادت بقوّة أكبر بعد التّخرّج، فبدأتُ البحث عن عمل في دمشق، وشاءت الصّدفة أن أجد بيتاً صغيراً في منطقة ركن الدّين بإيجار معقول، البيت الذي قضيتُ فيه عامين ونصف، أو تسعمئة ليلة دافئة.
بيت تحت النجوم
لم يفهم أحد أسباب حزني على مغادرة بيتي في ركن الدّين، فسقف غرفتي يدلفُ الماء إذا استخدم الجيران في الأعلى حمّام السباحة “البانيو”، والبيت صغير وغير مخدّم جيداً، لا تصله مياه الشّرب، ولا يوجد فيه غسّالة، الأمر الذي عنى أن أحمل ثيابي المتّسخة إلى جميع أرجاء دمشق لغسلها في بيوت الأصدقاء والمصبغات على مدى عامين ونصف. على عكس بيتي الحالي “المُخدَّم”.
أفكّر أحياناً بالمعايير التي يُقيّم الشّباب على أساسها البيوت الجيّدة في دمشق، قد نختار بيتاً لأنّه ليس قبواً على الأقلّ، أو لأنّ الشّمس تصل إلى غرفة من غرفه وآثار الرّطوبة قليلة، أو طبعاً، لأنّه البيت الوحيد الذي يُمكننا تحمّل إيجاره، وذلك للشباب ذوي الدّخل المعقول، فقد يبلغ إيجار السّكن نصف الرّاتب أو معظمه. وإن لم يستطع بعض الشّباب تحمّل نفقات بيت أو غرفة مستقلّة، يتوجهّون للسكن المشترك، وهنا، يتحوّل البيت إلى مكان للنوم والاستحمام في معظم الحالات.
يقول حازم، مهندس معماري مقيم في دمشق، إنّ البيت الصالح للسكن من وجهة نظر معمارية هو بيت يلتزم بمواصفات محددة. على سبيل المثال، يجب أن يكون عرض الممشى 60 سم على الأقل لكلّ شخص، وأن يكون مشمساً، ومهوّى جيداً.
وفي مدينة كدمشق حيث “الرّياح السّائدة جنوبية غربية، والشّمال يُحقّق إنارة مستمرّة، ويوفّر الجنوب والغرب تهوية مناسبة، بحيث يجب توزيع غرف النّهار (غرفة الضّيوف والمعيشة والمطبخ) على الشّمال، بينما توزّع غرف اللّيل (النّوم) على جهة الجنوب والغرب”. ويُضيف: “البيت الجيّد أيضاً هو البيت الذي يشعر فيه ساكنيه بالقدر المناسب من الحميمية عند استخدام هذا الفراغ”.
أخبرتُ صديقي أنّي سمعتُ عن منزل مجاور أغلى بقليل من منزلي في منطقة مزة 86 العشوائية، لكن لديه شرفة ويمكنني الصعود إلى السّطح، وقلتُ له ساخرة: “أعرف أنّي سأظلّ حزينة ولكن سأكون حزينة تحت النّجوم”، فضحك وهنّأني على أحلامي الواقعية.
كنتُ أشاهد مسلسلاً أمريكياً تسأل فيه إحدى الممثلات التي تُفكّر في استئجار شقّة “هل إطلالتها جميلة؟”، ضحكتُ بصوت عالٍ وفكّرتُ؛ ماذا لو سألتُ صاحب المكتب العقاريّ في المزّة 86 عن إطلالة الشّقّة؟
الصعود إلى المزّة 86
تقع منطقة المزّة في الجهة الغربية الجنوبية للمدينة بامتداد نحو الغرب. وتبدأ من ساحة الأمويين شرقاً وحتى منطقة السومرية غرباً ومن جبل المزّة شمالاً إلى منطقة كفرسوسة جنوباً. وهي من أحدث مناطق دمشق وأكثرها تطوّراً وحيوية، وينطبق هذا الوصف على معظم أحيائها التي تقطنها الطبقة الوسطى العليا والطبقات الأكثر ثراء، وفيها مراكز الجامعات وعدد كبير من مؤسسات الدولة ودورها الثقافية.
لكن للمزّة 86 الواقعة على سفح جبل المزّة حكاية أخرى، فهي منطقة شعبية تشتهر بالبناء المخالف والعشوائي الذي بدأ منذ ثلاثة عقود تقريباً بقرارات ارتجالية دون مراعاة أسس التخطيط العمراني، ثمّ تمّ الحدّ منه لاحقاً.
أتى معظم سكّان هذه المنطقة من مختلف أنحاء سوريا، ومنذ عشر سنوات تقريباً، بدأت بعض العائلات الدمشقية أيضاً بالانتقال إليها نظراً لغلاء الإيجارات في مركز المدينة. وعلى الرغم من أنّ إيجارات هذه المنطقة ارتفعت أيضاً، لكنّها تبلغ الآن تقريباً نصف أو ثلث قيمة الإيجارات في باقي أحياء المزّة التي تبعد عنها 10 دقائق فقط.
للمزّة 86 الواقعة على سفح جبل المزّة حكاية أخرى، فهي منطقة شعبية تشتهر بالبناء المخالف والعشوائي الذي بدأ منذ ثلاثة عقود تقريباً بقرارات ارتجالية دون مراعاة أسس التخطيط العمراني، ثمّ تمّ الحدّ منه لاحقاً
يرى البعض، وأنا منهم، جمالية خاصّة في صورة الـ 86 من بعيد، ففي الصّباح، تظهر كمربّعات اسمنتية تستند على بعضها البعض. أمّا في الليل، يبدو المشهد كسماء مليئة بالنجوم الملوّنة، وهنا أفكّر، كيف لمنطقة عشوائيات أن تصبح مادّة دسمة للتصوير؟
تتخلل المزة 86 “طّلعات” مرهقة وأدراج طّويلة. رويتُ لأصدقائي ذات صباح أنّي أصبحتُ متأكّدة أنّ ساكني تلك المنطقة يتعاملون مع الجاذبية الأرضية بطريقة مختلفة عن باقي البشر، لأنّي، وبينما كنتُ أحاول المشي بحذر في إحدى النزلات خوفاً من أن أنزلق، كان الشّباب من حولي يتحركون بثقة وسرعة غريبة.
كنتُ أفكّر بكبار السّنّ في الحيّ، وكيف يستطيعون تحمّل هذا التحدّي الجسديّ. ولكنّي لاحظتُ لاحقاً ظاهرة غريبة لم أشهدها في مكان آخر، حيث يقف بعض المسنين أو من يحملون الأغراض الثّقيلة أسفل الطّلعات، ويوقفون سيارات خاصّة طالبين من أصحابها الركوب معهم إلى أقرب نقطة ممكنة أو إلى آخر تلك الطّلعات على الأقلّ، وبالفعل، يتعاون الكثير منهم مع هؤلاء الغرباء بصدر رحب.
يشاركني الرّأي صديقي “وجيه” الذي سكن عدّة بيوت في المنطقة خلال فترة دراسته الجامعية، ويعتبر أنّ الجزء الأصعب الذي عانى منه في تلك المرحلة هو رحلة العودة إلى البيت. حيث كان عليه المشي في تلك الطّلعات القاسية وصعود مئتي درجة أو أكثر بعد يومه المتعب ليصل إلى بيته غير المريح بدوره.
وعلى الرغم من رداءة البيوت، كان إيجارها مرتفعاً ولم يستطع تحمّل تكلفته بمفرده، فغالباً ما كان “وجيه” يسكن مع رفاقه أو أشخاص غريبين عنه كلياً. ويقول ضاحكاً: “من الغريب أن تفتح باب منزلك الجديد وتتعرّف عندها على زميل سكنك الذي لا تعرفه، ولفترة لا تعرفها بعد”.
لا وقت لبناء العلاقات
أمضيتُ الشّهر الأوّل في بيتي الجديد وأنا في حالة قلق دائم، وكنتُ أنهض عدة مرّات من فراشي ليلاً لأنّي ظننتُ أنّ أحدهم اقتحم البيت، لأكتشف لاحقاً أنّ جاري يتحرّك في الطّابق فوقي وحسب. اعتدتُ الأمر قليلاً مع مرور الوقت، ومع أني لم أتعرّف على أحد من الجيران، ولكنّي أسمع، دون قصد طبعاً، جميع أحاديثهم وأعرف المسلسلات التي يشاهدونها ووقت طعامهم، فالبيوت والمباني هنا متداخلة، ولا مجال لفصل نفسك عن الآخرين مهما حاولت.
أسمع من جهة شجارات مستمرّة بين زوجين وبكاء طفلهما الرّضيع، تمتزج أصواتهم مع صوت شاب يغنّي أغانٍ إنجليزية ويعزف الجيتار في أحد الطوابق العلوية وأغنية لأم كلثوم تنبعث من نافذة قبو البناء. أبتسم وسط كلّ هذا الضّجيج العشوائي، وأعجب من هذا التجمّع الغريب.
مع أني لم أتعرّف على أحد من الجيران، ولكنّي أسمع، دون قصد طبعاً، جميع أحاديثهم وأعرف المسلسلات التي يشاهدونها ووقت طعامهم، فالبيوت والمباني هنا متداخلة، ولا مجال لفصل نفسك عن الآخرين مهما حاولت
طرقتُ باب أحد البيوت مرّة كي أستعير مطرقة لكنّهم لم يفتحوا لي الباب، استغربتُ وتجاهلتُ الموضوع ولم أحاول بعدها التعرّف على أحد، لأنّي فسّرت الأمر ببساطة؛ من يعش هنا يبدّل جيرانه باستمرار، المزعج منهم واللطيف، فلا وقت وفائدة لبناء علاقات من أيّ نوع.
تأكّدتُ من هذا بعد موقف طريف ومخيف بنفس الوقت، حدث عندما استيقظتُ صباح يوم جمعة ما، لأجد رسالة دسّها أحدهم تحت باب منزلي، كُتب فيها “صلّحوا خزان الميّ (الماء) أحسن ما اشتكي للشرطة”. قلّبتُ الورقة بحثاً عن رقم لأتصل به أو اسم صاحب الشّكوى ولم أجد شيئاً. اتصلتُ بصاحب الشّقة خائفة، فأنا لا أعرف مكان الخزّان بالأصل، وأتى على جناح السّرعة. وبعد حلّه للمشكلة، عاتب الرّجل على أسلوبه في الاعتراض، ثمّ قال له ضاحكاً: “بعدين هي المشكلة حلّها مو مع الشّرطة، لازم تشتكي للبلدية”.
استقرار مشروط
ليس من الغريب في دمشق أن تُغيّر منزلك مرتين أو أكثر في السّنة لأسباب تتعلّق بسوء المكان أو الجيران أو رفع الإيجار المستمرّ بشكل جنونيّ، ويتنقّل الأغلبية بين مناطق محدّدة؛ جرمانا، باب شرقي وباب توما، والـ 86، التي يُخيّل إليّ أنّها مجهّزة بالأصل للسكن السّريع فقط، فغالباً ما تكون بيوتها مفروشة “من قريبه”، وتتشارك جميعها بالتّصليحات السّريعة أو “التّسكيج”، فتجد أنّ السّرير يسنده مسمار، والفجوات في الحائط مسدودة بأكياس نايلون، ولاصق “التّوال” يغزو المكان.
لا يملك الشّباب هنا رفاهية انتقاء أثاثهم. يكتفون فقط بتزيين الحيطان ووضع بعض القطع هنا وهناك لإضافة لمستهم الخاصّة، دون بذل جهد إضافي أو المبالغة في التّصليحات والعمل على الكماليات، مثل التّفكير بتمديد أسلاك كهرباء داخلية ووصلها على بطارية خارجية كمصدر إضاءة بديل عند انقطاع الكهرباء. فيبقى الاعتماد الأساسي على الشّموع أو البطاريات الصّغيرة وضوء “ليد” بسيط.
وهنا، يوجد حلّ بديل لكلّ شيء تقريباً، فيمكن الاستعاضة عن الخزائن الخشبية بأُخرى قماشية يسهُل تركيبها وفكّها وتوضيبها، فكلّ شيء هنا مؤقّت ريث قدوم انتقال جديد أو فرَج ما.
يوجد هنا حلّ بديل لكلّ شيء تقريباً، فيمكن الاستعاضة عن الخزائن الخشبية بأُخرى قماشية يسهُل تركيبها وفكّها وتوضيبها، فكلّ شيء مؤقّت ريث قدوم انتقال جديد أو فرَج ما
بالنسبة إلى “حسن” بتجربته الواسعة في عالم الإيجارات، البيت هو الاستقرار. ولكنّ هذا الاستقرار الآن مرتبط بمدّة عقد الإيجار. يهتّم حسن بتفاصيل البيت الداخلية والشّكل العام للأحياء. الأمر الذي لم يجده في سكن العشوائيات، حيث يغلب على الحيّ اللّونان الأسود والرّمادي، أمّا البيوت فلا تدخلها الشّمس والسّكن فيها غير صحيّ على حدّ تعبيره. “ازداد هوسي بترتيب البيت و”دوكرته” العام الماضي خلال فترة جائحة كوفيد-19، ففي غياب النّشاطات، اضطررتُ إلى البقاء في المنزل لفترات أطول كما كان حال الجميع، وبذلتُ جهداً كبيراً إلى أن حصلتُ على نتيجة مُرضية قليلاً”.
بالمقابل، يعتبر “حسن” أنّ الجانب الإيجابي لتجربته تلك هو الحرّية المرافقة للسكن في الـ 86، حيث يمكن أن تعيش لسنين في الحيّ نفسه دون أن تعرف جيرانك. “أفكّر أحياناً وأنا أمشي في المناطق التي أحبّ في المدينة وأنظر إلى بيوتها، أنّي مهما أنتجتُ لن أستطيع السّكن في واحد منها أبداً”.
ما تركه الآخرون
تركت الشّابة التي كانت تسكن البيت قبلي آثاراً مختلفة، رأيتُ في المطبخ فتات وجبات “الإندومي” وحبّات معكرونة، كما وجدتُ بعض الأوراق من عملها وقطع ثياب وحذاء.
تشكلّت في رأسي صورة عنها؛ شابة عشرينية نحيلة تعمل لدى جهة حكومية، تُزيل الدّبابيس من شعرها بأماكن عشوائية بعد يوم طويل، تأكل وجبة سريعة مساءً وتُدخّن سيجارة على حافّة الشّباك. كنتُ أستغرب أحياناً توزيعها لقطع الأثاث، لماذا أبعدتْ الدروج عن الحائط مثلاً، ثمّ اكتشفتُ لاحقاً أنّ الماء يرشح منه عندما تُمطر، فأبعدتها بدوري مجدّداً.
أتساءل دائماً عن المستأجر الجديد لبيتي القديم في ركن الدّين، ماذا غيّر في المكان؟ هل انزعج من آثار اللاصق الذي استخدمته لتعليق رسوماتي على الحائط؟ هل استغرب بقعة البلاط المحروقة وتساءل كيف حدثت؟ ماذا لو تركت له رسالة قصيرة قبل مغادرة المنزل؟ رسالة تتضمّن توجيهات وتعليمات ونصائح وبعض القصص والحكايات عن حياتي فيه، ففي النّهاية، هذه بيوتنا جميعاً، كلّنا سنسكنها في مرحلة ما، والثّابت الوحيد لدينا هو الانتقال.
ها أنا أجلس عند مشبك النافذة المطلة على غابة من النجوم، أكتب رسالة مشابهة لشخص مجهول ريما يسكن بعدي في هذه الشقة في المزة 86. قبل أن أنتهي منها، أسال ذلك الشخص: هل سأصل أنا وأنت يوماً ما إلى بيوت نطرق في حيطانها المسامير دون اكتراث، ننسجُ فيها قصصاً وذكريات تدوم لسنوات وسنوات؟