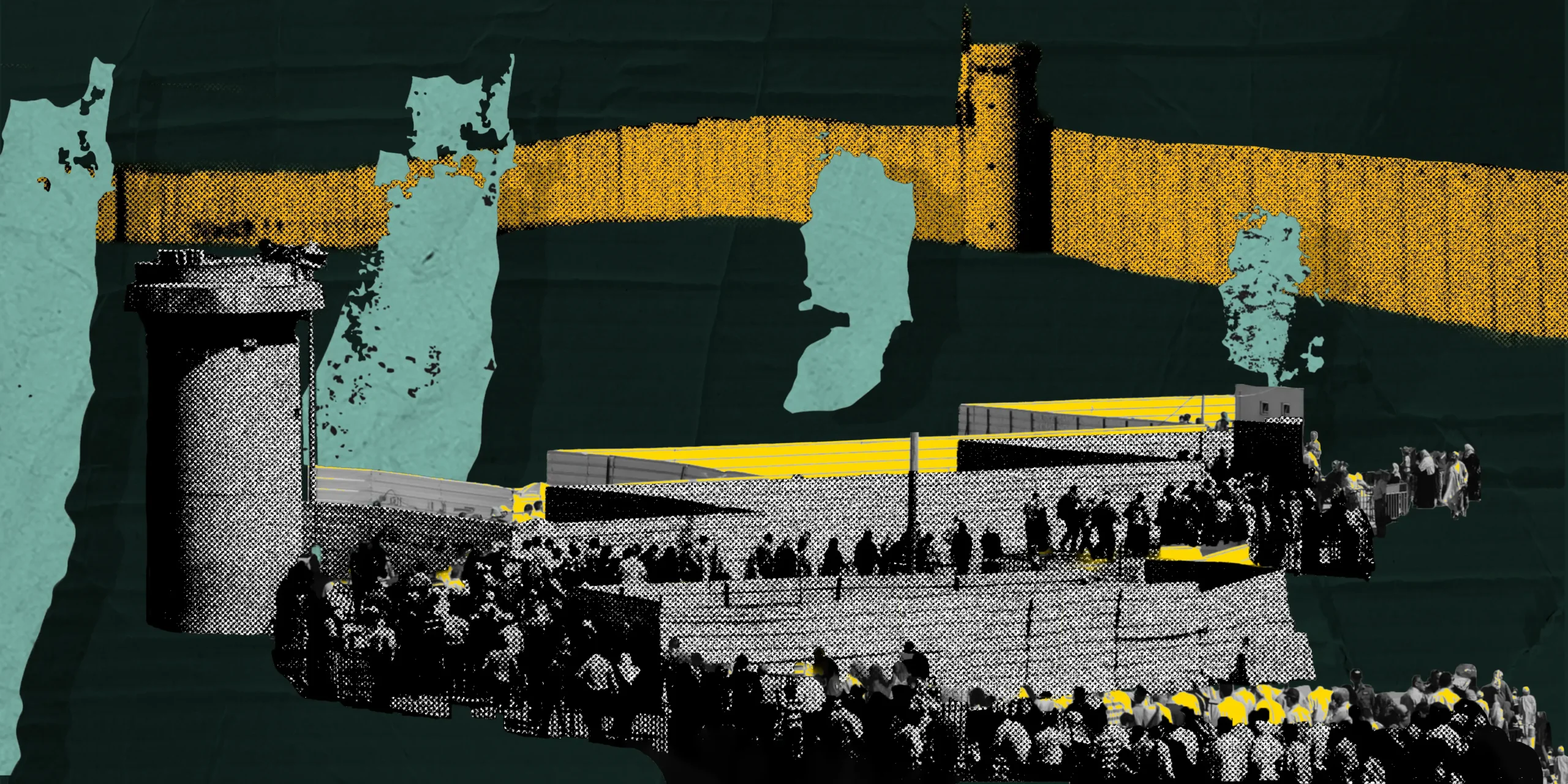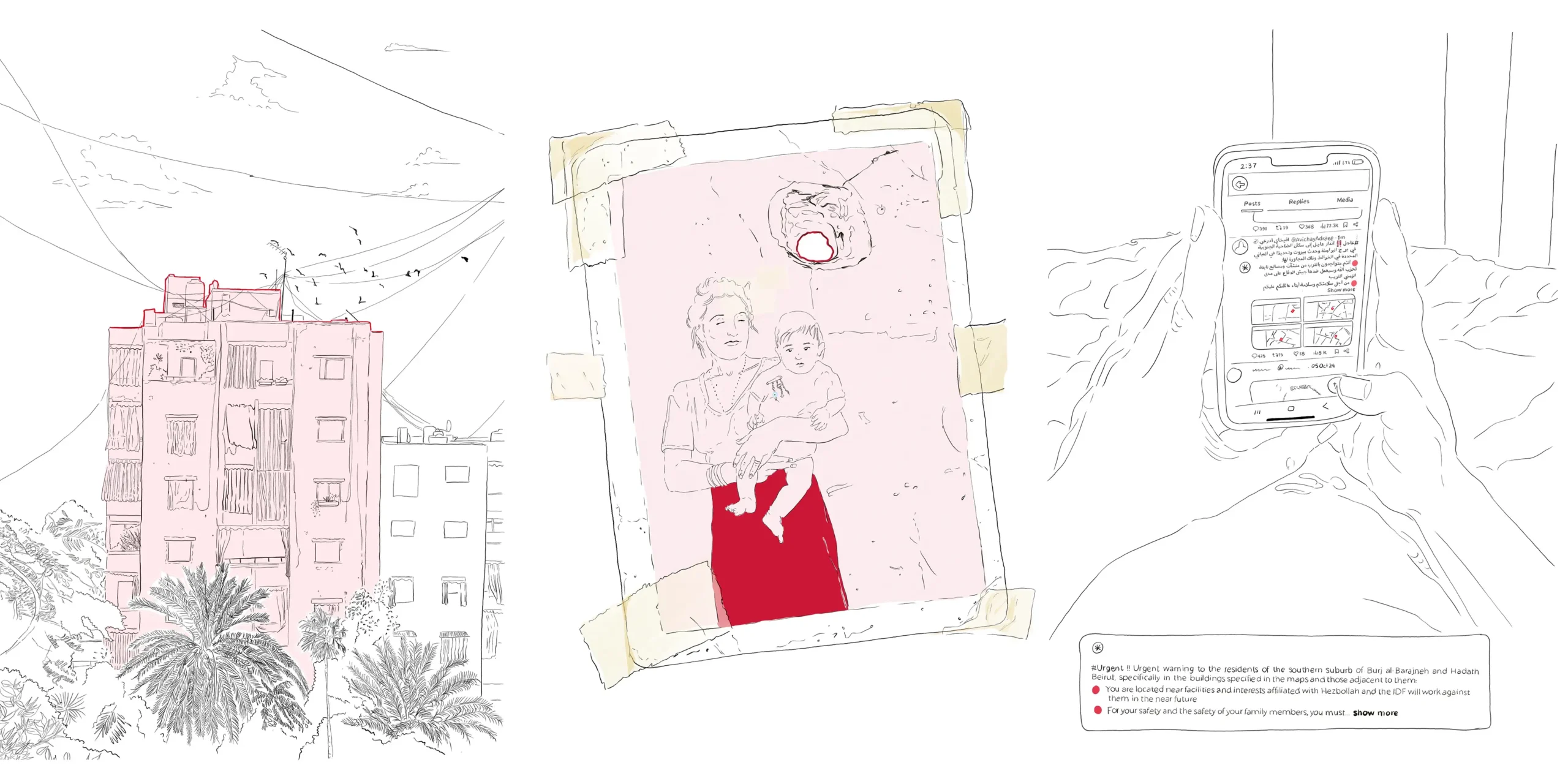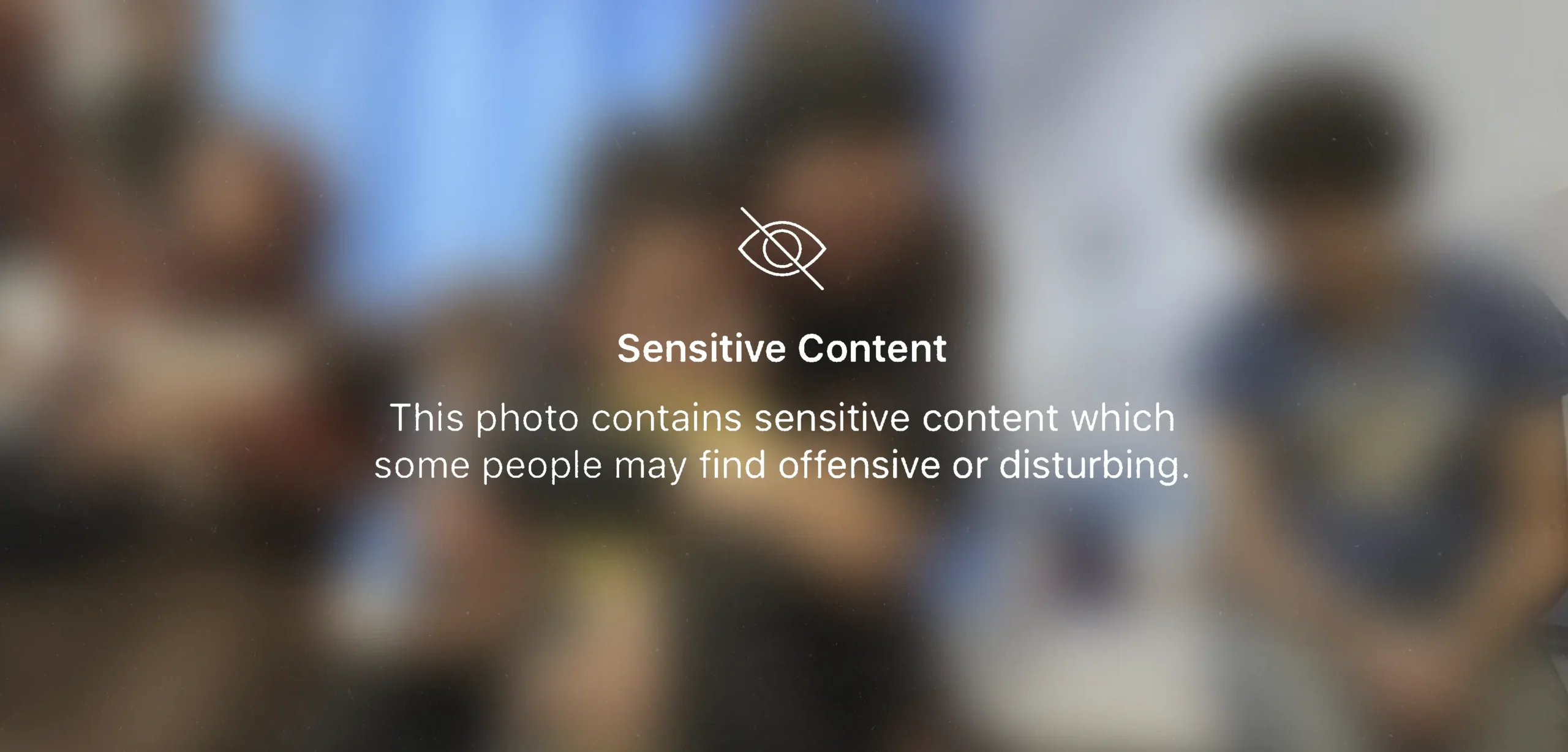“مواقع التواصل منحت حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء”
مقولة إمبرتو إيكو، المثيرة للجدل دوماً، فمن ناحية يدفعك شيء غريزي لاحتقارها بسبب تعاليها، ومن ناحية تكتشف قدرة فيالق الحمقى على قتل الكلام ومنع الحقيقة. كما أن السوشيال ميديا في مصر، ظلت هي الملجأ الأخير في ظل الإغلاق المتعمد، الوحشي والعصابي، لكل منافذ المجال العام، وتكميم الصحافة وحجب المواقع والاعتقال الممنهج للصحفيين وإرهابهم، ونجحت في فرض عدد من القضايا على الساحة والاقتراب، ولو قليلاً من الحقيقة لا قتلها. ورغم أن استخدام السوشيال ميديا في مصر، منذ عام 2014 وحتى الآن في قول رأي عابر أو نكتة عادية أو استخدامه كـ” تنفيسة” محل مخاطرة كبرى قد تذهب بصاحبها وراء الشمس، وقد يحاكم أو يغيب في غياهب سنوات الحبس الاحتياطي الطويلة، بسبب رأي عابر أو ميم أو نكتة، إلا أن الإصرار على استخدام ذلك المنفذ الخطر والأخير، إنما يدل على إصرار للروح ألا تموت، خاصة بعد سوء الحالة الاقتصادية بشكل لامس الجميع وأولهم مؤيدي النظام.
من اللافت أيضاً أن الفنان محمد صبحي، صاحب المقولة الخالدة “اقفل علينا ياريس” لم يجد طريقة سوى صفحته على السوشيال ميديا لنشر المقاطع التي حذفتها شركة المتحدة، التابعة لأجهزة الدولة السيادية، من عرضه المسرحي الأخير” عيلة اتعملها بلوك” بعد عرضها على التليفزيون والتي تحمِل، رغم كل تحفظاتنا على صبحي، أول انتقادات للسلطة وقراراتها في عمل فني مصري كارتفاع سعر الدولار والإفقار وقطع الكهرباء، وقد يكون ذلك سبباً لمضاعفة الحملة المسعورة تجاهه من صحف “المتحدة”، رغم أنه واحد من كبار المؤيدين للسلطة.
نجحت السوشيال ميديا مثلاً في فرض قضايا التحرش الجنسي على المجتمع، وتحويل بعض أصحابها إلى المحاكمة، أو على الأقل في الإطاحة بهم من أماكن عملهم التي أدينوا فيها بالتحرش، أو حتى نبذهم من المجال العام أو تجريسهم (والتجريس لعبة السوشيال ميديا القاتلة والمخيفة، لكن المستحقة في قضايا التحرش في ظل أن الاحتمالية الأكبر هي إفلات المتحرشين من العدالة القانونية) وأغلب هؤلاء كانوا من بين النخبة العاملة في الوسط الصحفي والحقوقي والثقافي.
وفي الآونة الأخيرة نجحت السوشيال ميديا في فرض قضيتين مرتبطتين بالفساد الرياضي هي قضية لاعب الكرة أحمد رفعت المتوفي بسبب ضغوط نفسية مورست عليه بسبب تلاعب رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، والرئيس التنفيذي السابق لفيوتشر، من أجل الحصول على قيمة إعارته إلى نادي الوحدة الإماراتي، رغم عدم استيفاء أوراقه بسبب التجنيد، وكان الأمر ليمر مرور الكرام بعد وفاته بأيام عقب ظهوره المؤثر والعاطفي في برنامج إبراهيم فايق أشار فيه إلى من سيصيرون لاحقاً المسؤولين لا عن وقوعه في غيبوبة إثر نوبة قلبية على أرض الملعب، بل عن وفاته لاحقاً.
لولا ضغط السوشيال ميديا، وتجميع المعلومات المتفرقة، ومقارنة شهادات غير دقيقة، للوصول إلى الحقائق، لما صارت قضية رأي عام، يطالب فيها بالتحقيق مع المسؤولين وكشفهم، بل أن الطرح الأولي للأسماء المتهمة ثبت صحته بعد أن تناولها الإعلام الرياضي في برامج أخرى، كحوار الإعلامي هاني حتحوت مع وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، الذي أعلن استقالته عقب إذاعة الحوار.
ما كشفته السوشيال ميديا في القضية، كان أهم وأخطر وأكثر جرأة، من بينها ضغط نادي طلائع الجيش للحصول على لاعبين مجاناً أو بأرقام زهيدة، في استغلال واضح لمسألة طلب اللاعبين للتجنيد الإجباري، وهو ما لم يجرؤ أي صحفي أو إعلامي رياضي على الحديث عنه.
الأمر نفسه تكرر مع لاعبة الدراجات شهد سعيد التي كانت على وشك السفر إلى أوليمبياد باريس لتمثيل مصر، رغم اتهامها بدفع زميلتها جنة عليوة في أثناء إحدى السباقات، ولولا منشور الشاعر عمر حاذق على صفحته على فيسبوك، لمرت الفضيحة بسلام، إلا أن تحول القضية إلى رأي عام، بسبب أن الألوف رأوا في القصة ما يمس تعرضهم للظلم بشكل شخصي، لسافرت شهد إلى أوليمبياد باريس، ولم يصدر قرار من اللجنة الأوليمبية بعدم أحقيتها في السفر؛ نظراً لأن اللوائح تمنع من صدر ضده حكما بالإيقاف المحلي من السفر.
ربما لا ينعكس فساد الوسط الرياضي المصري خارجه، لكنه يمثّل بوضوح حجم الفساد في البلد ككل. وعلى عكس فساد الدولة، تظل واحدة من التقاليد القديمة هي السماح بحرية نسبية في مهاجمة الفساد الرياضي، لكن تلك المرة، بعد أن امتدت السيطرة الأمنية بشكل لا لبس فيه على الرياضة، لتحويل كرة القدم إلى لعبة بلا جماهير، خوفاً من تمرد تلك الجماهير، وعقاباً لمشاركة ألتراس الأندية الجماهيرية في “ثورة يناير”، بتعيين رجالها الذين لا علاقة لهم باللعبة، لكنهم بكل تأكيد منخرطين في فسادهم.
بعيداً عن الرياضة، فمن البداية تكاد أن تكون منصات التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة أخبار المعتقلين السياسيين، وظروف حبسهم شديدة السوء، وتعرضهم للتعذيب والتنكيل.
في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الأخيرة التي يرأسها مصطفى مدبولي، لم نكن لنكتشف فضيحة تزوير وزير التعليم الحالي لشهاداته، لولا صفحة Factcheck بالعربي على السوشيال ميديا التي تتبعت حقيقة شهادتي الماجستير والدكتوراه المضمنتين في سيرته الذاتية، وقدموا أدلة قوية على زيفِهما، مما دفع الصحافة للتحقيق، ليكشف أن المسألة أكبر من مجرد تزوير شهادة مسؤول، بل عملية منهجية من الاحتيال على مئات الطلاب وذويهم سنوياً للحصول على شهادات غير معتمدة تدعي شركات أنها تعادل الدبلومة الأمريكية. ورغم أن الوزير لم يُقل إلى الآن، بل خرج مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في تصريحات داعمة لوزيره، تؤكد أنه لا يعطي أهمية كبرى لكون الشهادات معتمدة أم لا، إلا أن كرة الثلج لن تتوقف وستظل عاراً في عنق تلك الوزارة والسلطة في مصر.
تلعب السوشيال ميديا إذن دور الصحافة، لكن هل هي قادرة وحدها على عبء كهذا؟ وأن تكون بديلاً للسلطة الرابعة؟
وفاة الصحافة
في كتاب الصحفي والمدون عبد الرحمن مصطفى، “العودة إلى آخر الحارة“، حالة التوثيق الوحيدة التي قرأتها لسنوات ازدهار الصحافة، في رحلة مر بها معظم أبناء جيلنا وهي السنوات من 2005 إلى 2011، والتي حظينا فيها بحرية نسبية لم نشهدها من قبل، وكان من المتاح لحسني مبارك وقتها أن يمارس الضغط من جهته، لكن من دون أن ينهي اللعبة بأكملها، بإمكان ضباطه ممارسة التعذيب مثلاً، ويمكننا أن نكتب عنه، “أن يصل الفساد للركب”، وأن يكون صاحب الجملة أحد رواد هذا الفساد. صفقة عادلة بمعايير تلك الأيام.
دلالة شهادة عبد الرحمن وأهميتها، بما فيها أن تجربته كصحفي تحقيقات اجتماعية ميداني في جريدة الشروق قد انتهت بفعل فاعل، وهذا الفاعل لم يكن موجهاً ضده بالذات. صارت الصحافة الميدانية وصحافة التحقيقات والتعب على الحقيقة، لعبة خطرة على من يمارسها، وفي عرف الجهات السيادية صارت تهدد “الأمن”، ومثل تجربته أجهضت تجارب عشرات الصحفيين الشباب والمحترفين، فلعبة “العثور المهني على الحقيقة” من قلب الشارع، أو من قبل صحفي تحقيقات نابه يطبق الأدوات المهنية والمحترفة لمهنته، لم تعد أمراً مطلوباً الآن، إنها سنوات “الكذبة الموحدة” الحقيقة الوحيدة المتاحة.
أغلقت صفحة التحقيقات الاجتماعية التي يعمل فيها عبد الرحمن، والتي كان من المفترض أن تعمل باقي أبواب جريدة الشروق وفق خطط مؤسسيها على منوالها من الاحترافية والجدية والاشتباك مع الحقيقة، إلا أن الصحيفة نفسها قُزمت بسبب الضغط السياسي على ملاكها. وهو الشيء نفسه الذي حدث مع صحف “المصري اليوم” التي أحدثت طفرة حقيقية في الصحف الخاصة في عهد مبارك، أو بتعبير الصحفي مصطفى يحي، كانت الصحيفة التي رسمت خط الأفق بعد أن لعبت دوراً هاماً في فترة ما قبل ثورة يناير على أن تصنع ما يشبه الصحافة الحقيقية المؤثرة وتوسيع هامش الكلام في فترة مبارك، بعيداً عن الصحافة القومية المعلبة.
اشترت “المتحدة” بعد 2014 الصحف الخاصة أو أقدمت على تحجيمها إلى دكاكين صحفية، من خلال تهديد ملاكها بالحبس مثلا، كما حدث مع مالك صحيفة المصري اليوم صلاح دياب، والضغط على الصحف للتخلي عن الصحفيين المهنيين من الشباب اللذين طوروا مهارات احترافية أكثر مواكبة للعصر أو منع كتاب الرأي من الكبار كجمال الجمل على سبيل المثال، مما اضطر أغلبهم إلى الهجرة والعمل من الخارج، كأغلب المواهب والخبرات في مختلف المجالات، أو اضطروا للعمل في صحف وقنوات عربية من خارج مصر، وسط إرادة سياسية معلنة من رأس النظام نفسه بضرورة تكميم الصحافة، وبعضهم هجر الصحافة تماماً.
ولم يتبقى من مشهد الصحافة إلا استثناءات قليلة في موقعي “المنصة” و” مدى مصر”، رغم أن فريقهما طيلة الوقت تحت رحمة تحقيقات لا تنتهي سواء من الجهات الأمنية أو المجلس الأعلى للإعلام، ولعل آخر هؤلاء وليس آخرهم هو رسام كاريكاتير بموقع المنصة، أشرف عمر، الذي اعتقل وخضع للتعذيب ووجهت إليه لائحة الاتهامات المعروفة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
لم يعد لدينا داخل مصر من أمل في لعبة العثور على الحقيقة سوى السوشيال ميديا، التي تصنع الكلام، وتقتله في آن.
اشترت “المتحدة” بعد 2014 الصحف الخاصة أو أقدمت على تحجيمها إلى دكاكين صحفية، من خلال تهديد ملاكها بالحبس والضغط على الصحف للتخلي عن الصحفيين المهنيين من الشباب أو منع كتاب الرأي، مما اضطر أغلبهم إلى الهجرة والعمل من الخارج في صحف وقنوات عربية، وسط إرادة سياسية معلنة من رأس النظام نفسه بضرورة تكميم الصحافة ..
ربما للمرة الأولى نرى أن أهم منصتين صحفيتين الآن، وهما “ما تصدقش” و”صحيح مصر” المتخصصتين في تدقيق الأخبار، يفضلان الحضور على منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من أن يكون لهما موقع صحفي على الإنترنت، وهو ما يوفر لهما انتشاراً أوسع وخفة في الصياغة غير الملتزمة بالكتابة الصحفية الرصينة، رغم الجهد الصحفي الهائل المبذول، وقد لعبتا الصفحتين، دوراً هائلاً في كشف الكثير من الحقائق والملابسات المخفية، مثل قضية طائرة تهريب الذهب من زامبيا، والكشف عن رشوة سيناتور أمريكي يعمل لصالح النظام المصري، وكذلك صفحة الموقف المصري التي يحاول أصحابها بلورة مواقف وأسئلة موجهة للرأي العام، أكثر ما هي موجهة للنظام المصري. وتمزج الأخيرة بين صياغة التحقيق الصحفي والتحليل القائم على المعلومات، واستخدام العامية الدارجة.
لا أذكر عدد المرات التي كتبت فيها مقالاً للرأي، كنت في حاجة فيه إلى معلومات أو تحليل، أو على الأقل إعادة ترتيب منطقي للأحداث المشتتة، فاعتمدت فيهم على الصفحات الثلاث “ما تصدقش” و” صحيح مصر” و” الموقف المصري”.
من المنطقي أن المنصات الثلاث تعمل في الأساس على تدقيق الحقائق المنتشرة على السوشيال ميديا وهدفها الأساسي هو التوجه إليها لتشكيل رأيها.
أين المشكلة؟
في 2020 انتشرت أكثر من 11 شهادة موثقة ضد أحد الصحفيين العاملين بمؤسسة أريج كصحفي تحقيقات استقصائية، ه. ع، وهو أحد صحفيين المصري اليوم، نجحت الحملة في نبذه من فضاء السوشيال ميديا، وإعلان عدد من المؤسسات الصحفية، وعلى رأسها أريج وقف التعامل معه، في ظل غياب أي آليات قانونية لمساءلته.
بعد 4 سنوات من هذا الانتصار، احتفت المصري اليوم في عددها الذي يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها ب” ه.ع” كأحد أهم العاملين السابقين بها.
وهو ما يشير إلى أن الانتصار في السوشيال ميديا ونبذه من فضائها قد لا يكون إلا محض وهم، ففي الحياة الواقعية هو منتصر، وليست الدعوة هنا إلى محوه، بل حصوله على عقاب يكافئ جريمة التحرش.
المشكلة أن تلك القوة كما كشفت عن نفسها، فهي تذكرنا أيضاً بمواطن ضعفها، إذ هي عدالة عاطفية، انتقائية وعمياء، تصدر حكما نهائياً، دون أن تستمع إلى الطرف الآخر، كما أنها لا تملك القدرة على أن تواصل عملها إلى النهاية، فما يوحي أنه يبدأ عمله كتسونامي ينتهي إلى زوبعة في فنجان.
على سبيل المثال، لم يحاسب المجرمون الحقيقيون، رغم إعلانهم بالاسم في قضية أحمد رفعت ودون إمعان في فضح وملاحقة السياق الأكبر من الفساد الرياضي، الذي تسبب في هذا الوضع؛ مما يعني أن تكراره قائم. وانتهت قصة لاعبة الدراجات جنة عليوة مع زميلتها شهد سعيد بصورة بائسة لوزير الرياضة، وهو يصالحهما على بعضهما البعض، كأنها مسألة شخصية بين فردين، ورغم أن ما ظهر من حقائق أن شهد سعيد رغم ارتكابها لخطأ كبير، ليست هي الفاسدة الأكبر هنا، بل اتحاد لعبة الدراجات والوضع البائس للاعبين في ألعاب غير شعبية.
كما أن الحكم النهائي في قضية شهد صدر على السوشيال ميديا قبل أن نسمع منها كطرف آخر يملك روايته، وهي أبسط آليات عمل الصحافة، حكماً صار أكبر حتى من حجم الخطأ، إذ لا يبعد يبحث عن أن تدفع اللاعبة ثمن ما فعلته بما يتناسب معه، بل إلى نبذها بالكلية ليس فقط من دائرة النشاط الرياضي، بل من دائرة المجتمع ككل، كما أنه ركز المسألة في عنقها وحدها، دون الالتفات إلى فساد اتحاد الدراجات وعشرات الاتحاد الرياضية، التي دفعت اللاعبة إلى ارتكاب خطأ كهذا، بما فيها سرقة المكافآت، شح المبالغ التي يتقاضونها، الظروف السيئة التي يصارعها الرياضيون.
كما اختلطت فيه مشاعرنا الشخصية التي تتعرض إلى الظلم على المستويات كلها، لكن لا يمكنها مواجهته، فتعمد إلى تفريغه في أطراف أضعف، كاللاعبين الرياضيين، كما أن معركة انتقاد الفساد الرياضي، تظل معركة آمنة إلى حد ما، حتى لو بلغ الجنون بالسلطة أن تعتقل رجلاً رفع لافتة في الميدان يطالب فيها بحق أحمد رفعت، فهي لن تتسامح مع تجاوز الغضب لسور الواقع الافتراضي.
وفي واحدة من أشهر الجرائم مؤخراً، وهي قتل محمد عادل لنيرة أشرف، بنحرها في وضح النهار أمام شارع رئيسي بمواجهة جامعة المنصورة، فقط لأنها رفضت التجاوب مع عرضه لها بالحب، لكن السوشيال ميديا، إذ يتولاها الحمقى نجحت في دفع حملة تعاطف مع القاتل إلى الضوء وتحميل الضحية مسؤولية قتلها، بل وجعله بطلاً مما أسفر عن موجات من قضايا القتل للنساء التي رفضن حب الذكور.
تلعب السوشيال ميديا دور الصحافة، خصوصاً في ظل غيابها عن عمد وتكميم أفواهها، لكنها أيضاً عاجزة دونها عن أن تجعل من قوة دفع التسونامي عملية فحص دقيقة للحقيقة، وأن تتحول إلى قوة تطهير لجذور العفن والفساد، كما أن بإمكانها أن تتجاهل المنطق، وتقلب الحقيقة وتدافع عن الظلم، وتضعه في موضع الضحية.
إننا في النهاية في حاجة إلى صحافة حقيقية وحرة، وكل مسكنات السوشيال ميديا، لا تعني أنها كافية، ففي النهاية، هي غير معنية بتحري الحقائق أو العقلانية، لا تحركها الحقيقة بل العاطفة، وتبحث عما يلمس وتراً منحازاً داخلها، وهو حق مكفول بالطبع، لكن الكلمة الأخيرة تكون لجحافل الحمقى بتعبير إيكو، تعمل على طمس أبعاد أي قضية، تقتل الحقيقة بقدر ما تقترب منها.
عدالة السوشيال ميديا، عدالة عوراء وقاسية، يتحكم فيها العقلاء جنباً إلى جنب مع الحمقى، دون أن نغفل أن الكلام عن الخطأ وأشكال الفساد والانحراف في ظل تلك الظروف، هو فعل شجاع، وهو كل ما نملك من أدوات، لكنه قليل جداً مقارنة بما نحتاجه.