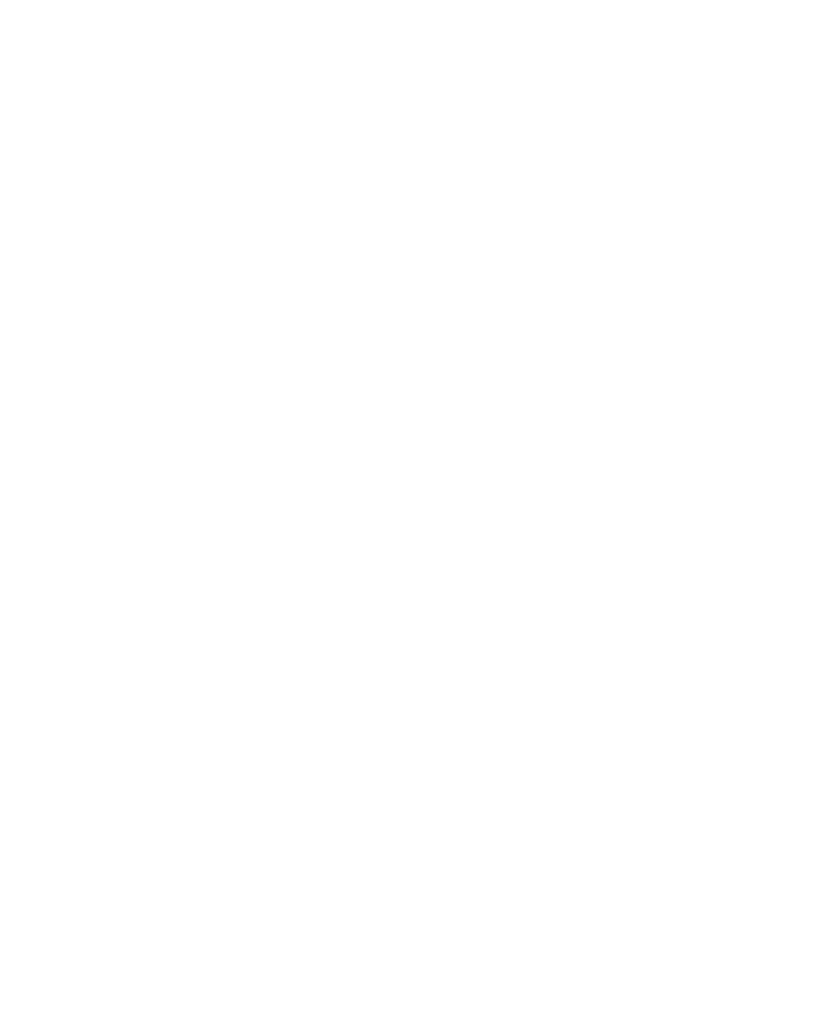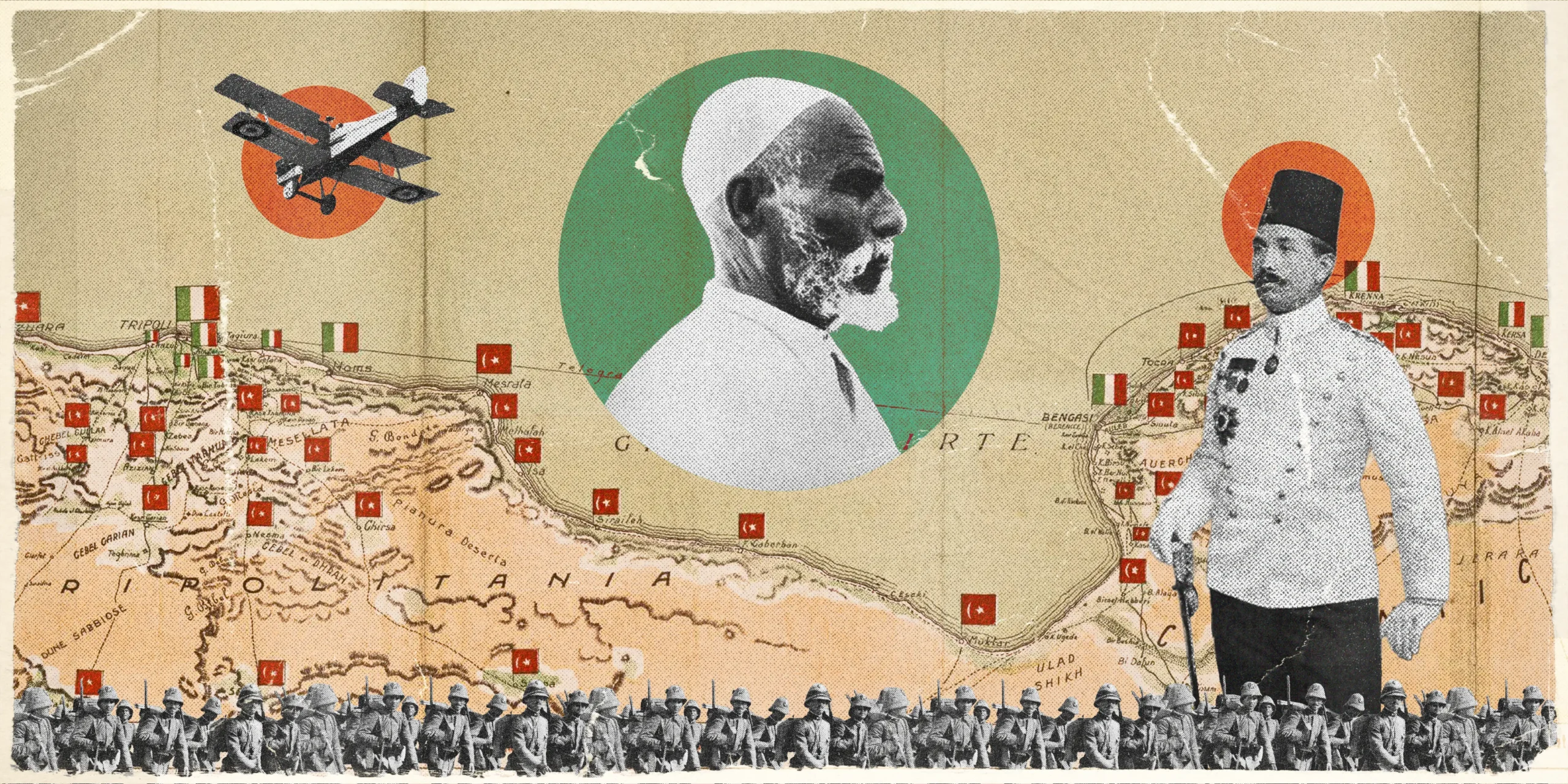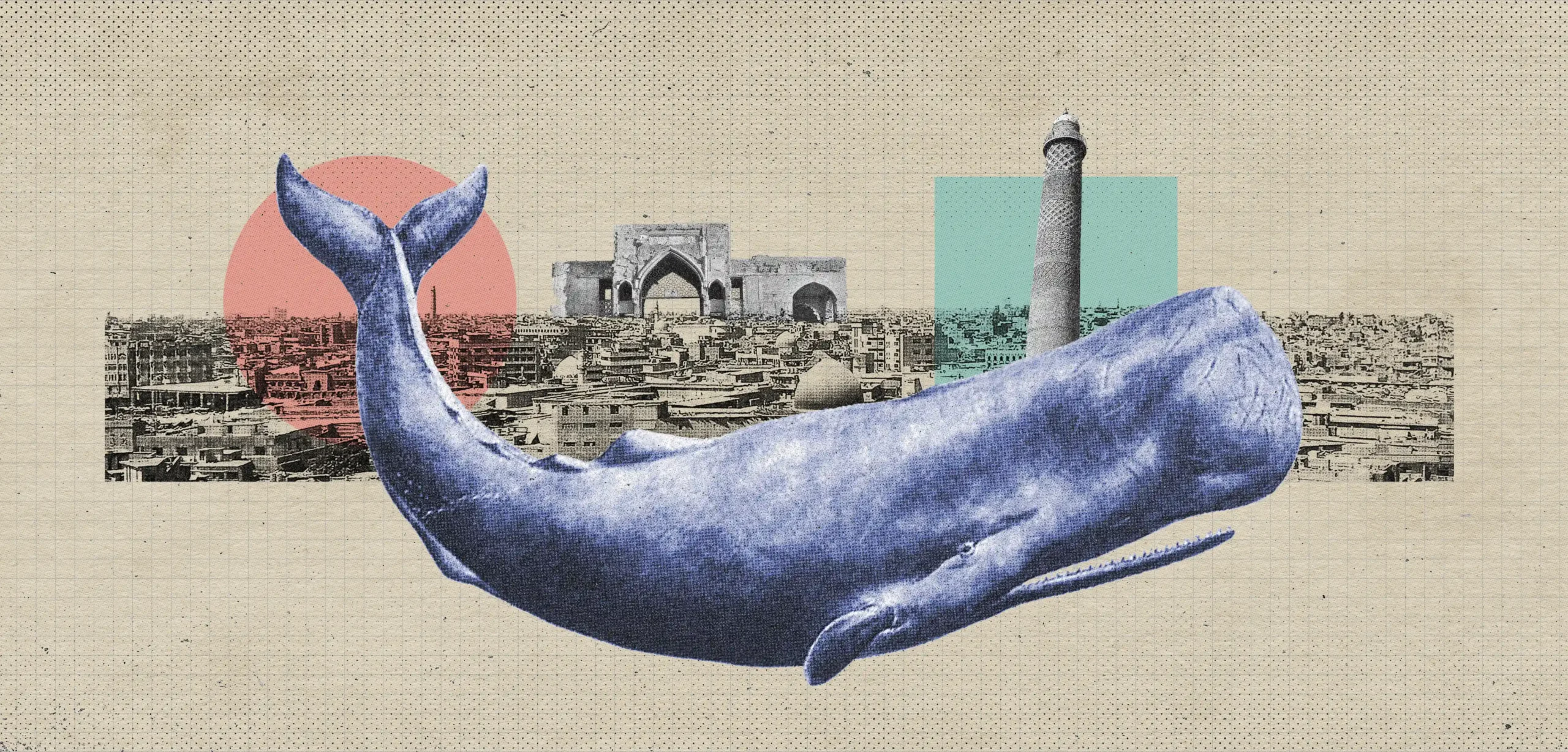“وصلنا عالحاجز، اسكتوا ولا كلمة”، “أخذوا ابن فاتن وكسّروله إجريه”، “لا تطلّعي بالبناية، حطّي عيونك بالأرض”، “بيقولوا حدا شاف أبو ابراهيم عندهم، بس عيلته ما بتعرف عنه شي من وقتها”، “ممنوع تحكوا بهالمواضيع”، “قتلوه وصبّوا فوقه اسمينتو (إسمنت)”، “ذوّبوهن بالأسيد”… تردّدت هذه الجمل كثيراً على مسامعنا عندما كنّا أطفالاً، جملٌ غير واضحة لِمَن يسمعها أو يقرأها الآن لكننا فهمنا ما تعنيه عندما سمعناها، ولم نطلب شرحاً إضافياً عندما قيلت لنا، فقد اعتدنا أنّه، عندما ينخفض الصوت كثيراً خلال أيّ حديث حتى لو كان داخل المنزل وعندما يُجهَّل الفاعل في الجمل المقتضبة، فهذا يعني أن الفاعل هم “السوريون” (التسمية الشعبية المختصرة لأجهزة النظام السوري في لبنان) وأن الحديث كان يدور “حولهم” وأنه لا يجب أن نسأل أكثر.
كنّا، نحن الجيل الذي بلغ الآن مرحلة الأربعينيات من العمر، في بداية وعينا الطفولي عندما دخل الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 تحت اسم “قوات الردع العربية”. دخلت تلك القوات بطلبٍ من قوى اليمين المسيحي اللبناني وبمباركة “جامعة الدول العربية” بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية في لبنان والقوى اليسارية الحليفة لها تحت شعار “حلّ النزاعات وحفظ السلام” بعد سنة من اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. أُطلقت يد النظام السوري في لبنان منذ ذلك الحين فحكم البلد عسكرياً وأمنياً وهيمن على اقتصاده وسياسته الداخلية والخارجية لنحو ثلاثين عاماً مارست خلالها أجهزته العسكرية والاستخباراتية سياسة البطش والقمع والقتل والترهيب بحق المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية. جاءت الهيمنة السورية لتضيف ضغوطاً خانقة إلى أهوال الحرب الأهلية الدائرة أصلاً في البلد والتي انتهت عام 1990 لكن الاحتلال السوري لم ينتهِ معها بل بقي “وصيّاً” متحكّماً بالبلد حتى عام 2005.
الخوف الأوّل كما أسميته، “الخوف الذي حفروه في حمضنا النووي” كما وصفته إحدى الصديقات. هو الخوف الذي تعرّفنا إليه في عمر الخمس سنوات أو أكثر بقليل، وكان على شكل جندي سوري على حاجز مرور، صوت طقطقة العظام، صراخ الأمّهات، ورأس حافظ الأسد.
تبادلنا قبل أيام، أصدقاء وصديقات من سوريا ولبنان رسائل التهنئة بكافة أشكالها غناءً وبكاءً ورقصاً وشتائم تلعن نظام البعث السوري من رئيسه الأب حافظ الأسد إلى أفراد سلالته وأجهزته وضبّاطه وصولاً إلى الرئيس المخلوع الهارب بشار. بشكلٍ لا إراديٍّ، استفاقت في أحاديثنا بعض الذكريات الشخصية عن فترة الحكم السوري للبنان (1976-2005)، أصدقاء الطفولة والمدرسة في طرابلس وأصدقاء الجامعة من بيروت والمتن والشوف، جمَعَتنا على اختلاف المناطق والانتماءات الحزبية والدينية، تجارب قهرٍ متشابهة ومشاعر ثأرٍ مشتركة. نعلم جيداً أنّ ما عشناه من تجارب قد تبدو بسيطة الآن وما سنرويه من أحداث شخصية قد لا يُقارَن بتجارب أقسى عاشها آخرون في سوريا وفي لبنان لكنها تجارب لعينة بقي أثرها فينا ووجب علينا توثيقها.
لم نجد صعوبةً في فرز ذكريات الحرب الأهلية عن ذكرياتنا مع حكم النظام السوري، رغم تزامنهما مع بداية وعينا كأطفال. تكلّم الجميع عن شعورٍ واحدٍ ارتبط عندنا بـ”السوريين” وهو شعور الخوف. الخوف الأوّل كما أسميته، “الخوف الذي حفروه في حمضنا النووي” كما وصفته إحدى الصديقات. هو الخوف الذي تعرّفنا إليه في عمر الخمس سنوات أو أكثر بقليل، وكان على شكل جندي سوري على حاجز مرور، صوت طقطقة العظام، صراخ الأمّهات، ورأس حافظ الأسد.
يُقال إن المخاوف الأولى أو البدائية ساهمت باستمرارية الحياة البشرية، كأن تُطوِّر إحساسَ خوفٍ من الحيّة فتهرب منها وتتجنّب لدغتها فتعيش، لكن الخوف الأول/البدائي الذي زرعه السوريون فينا كان مجهول الشكل والأسباب ولم يكن بأيدينا تجنّبه، لا بل شاهدنا كأطفال، فشل أهلنا في تجنّبه وفي حمايتنا منه. بالتالي، لم يكن لخوفنا الأول حدودٌ مكانية أو زمانية أو مصدر واحد معروف، هو موجود على الدوام حتى لو غاب المسبّب المباشر له، وهذا ما جعله يغلّف كلّ تفاصيل يومياتنا ويفرّخ كلّ مرّة في عقولنا بشكلٍ جديدٍ على الطرقات ومن داخل جدران المنازل وفي أحاديثنا الهامسة وفي الصمت الطويل الذي كان يلي أيّ ذكرٍ “لهم”.
أدركنا غصباً عنّا وعن الطبيعة وفي عمرٍ مبكرٍ أنّ هذا الخوف تحديداً لا يمكن الهروب منه. وأن فكرة الهروب لا تعني النجاة كما يجب أن تفهمها الغريزة ويحلّلها العقل ويطبّقها الجسد فيخزّنها اللاوعي. بل على العكس، ولّد لدينا فشل الهروب من ذلك الخوف والعجز عن وضع حدٍّ له مخاوفَ أكثر، إذ عزّز غموض شكل التجربة التالية ومصيرها وحرَمَ النفس من اللجوء إلى فكرة الخلاص المطمئنة. لم نكن نعرف إذاً متى تأتي التجربة المخيفة وكيف، وهذا أمرٌ مرعب، أُضيف إليه شعورنا بأن الهروب منها متى حصلت، أمرٌ مستحيل. ندرك الآن وقد تجاوزنا الأربعين أننا لم نُشفَ من “خوفنا الأوّل” ذاك وأننا لن نُشفى منه أبداً، لا لشيءٍ إلّا لأن البُعبُع القابع تحت أسرّتنا لم يكن محض خيال.
في طرابلس.. النفَس ممنوع
البداية من عاصمة شمال لبنان، طرابلس، المدينة التي وُلدتُ وعشتُ فيها والتي نالت النصيب الأكبر من بطش النظام السوري منذ دخوله إلى لبنان وحتى بعد انسحابه منه بسنوات، وكأنّه كان لـ”البعث” ولحافظ الأسد ثأراً خاصاً مع طرابلس وسكّانها. المدينة الحيوية ذات الميناء النشيط والأسواق التجارية والريف المنتِج ومصفاة النفط القادم من العراق، شلّها الحكم السوري أكثر ما شلّتها الحرب الأهلية، وما زالت آثار ذلك حاضرة في حياة الطرابلسيين حتى اليوم. خاض نظام الأسد في طرابلس عام 1983 معركته الأشرس لإضعاف “منظمة التحرير الفلسطينية” والفصائل المقاومة المتواجدة فيها حيث قصف الجيش السوري المدينة برّاً وبحراً وجوّاً واستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فيها ومينائها وأسواقها ومحطّة تكريرها، ما أدّى إلى تدمير جزء مهمّ من المدينة وتشريد أهلها وقتل المئات من المدنيين. بعدها، أحكم نظام الأسد قبضته الأمنية على المدينة وسطا على مواردها وعطّل مرافقها الاقتصادية، وقَمَع أي محاولة لمقاومة سيطرته عليها من خلال الاغتيالات والخطف والتعذيب والسجن وأكثر من 30 عاماً من الترهيب.
مرّ على هذه الحادثة نحو 37 عاماً، لكن استعادتها يترافق حتى اليوم مع تشنّجات في كامل الجسد والفكّين ورغبة عارمة في بكاءٍ مكبوتٍ لا يقوى على الخروج
لم نتكلّم طوال الطريق، تلك الليلة بعد الحادثة، ولم نخبر أحداً عنها بطبيعة الحال. كنّا عائدين من عكار إلى منزلنا في طرابلس، وكان الطريق مظلماً جداً. ضوء الشاحنة القادمة في الاتجاه المعاكس أعمى والدي فجنَحَت السيارة قليلاً قبل أن يتمكّن من السيطرة عليها مانعاً ارتطامنا بحاجزٍ للجيش السوري. انهال الرصاص علينا وصوت تلقيم البنادق لم يتوقّف، علا معه صوت أحد الجنود يقول “وَقِّف وْلَا حِيوان!” توقّفت السيارة، “صِفّ عاليمين” أمَرَ الصوت إياه وتابع “انزل وشرّف معنا”. تصاعد صراخ أمي تتوسّل أبي عدم النزول وتشدّه من كمّ قميصه ثم تتوسّل الجنود الذين تجمّعوا حول السيارة، ستّ عيون شاخصة في المقعد الخلفي مفتوحة ملء بياضها لا ترفّ وتُعمى من أضواء مصابيح اليد التي سُلطّت إلى وجوهنا مباشرة عبر الزجاج. أذكر أنني أدرتُ وجهي بصعوبة شديدة نحو غرفة الجنود حيث اقتيد أبي وحدّقتُ في مدخلها كما لم أحدّق بشيءٍ يوماً وأنا أكرّر كلمة واحدة في داخلي: “سأراه”. كان عمري خمس أو ستّ سنوات حينها، شقيقي وشقيقتي الجالسين بقربي في المقعد الخلفي يكبرونني بأربع سنوات. أذكر ضوء الشاحنة القوي، أذكر حركة المقود السريعة يميناً ويساراً، أذكر صوت تلقيم البنادق، أذكر صراخ أمّي، أذكر أضواء المصابيح اليدوية وأذكر الضوء الخافت في غرفة الجنود. خرج والدي بعد دقائق طويلة، أخبر أمي بشكل مقتضب ما جرى بينه وبين الضابط وأكملنا الطريق بصمت.
مرّ على هذه الحادثة نحو 37 عاماً، لكن استعادتها يترافق حتى اليوم مع تشنّجات في كامل الجسد والفكّين ورغبة عارمة في بكاءٍ مكبوتٍ لا يقوى على الخروج.
أخي (47 عاماً، من سكّان طرابلس) الذي شهد معي تلك الحادثة وأحداثاً كثيرة غيرها، روى للمرّة الأولى قبل أيام، حادثة مشابهة تعرّض لها عندما كان في سنّ المراهقة. إذ كان برفقة صديقته على الطريق السريع المؤدي إلى طرابلس، تجاوز إحدى السيارات بطريقة عفوية جداً فما كان من تلك السيارة إلا أن لحقت بهما والتصقت بباب السيارة وخرج منها مسلّحون سوريون ومدّ أحدهم بندقيته داخل الشبّاك ونهر أخي قائلاً “قول أنا حِيوان وْلَا، قول أنا حِيوان!”… لم ينجُ أخي وصديقته إلا بعد أن قال “أنا حيوان” عدّة مرّات، ابتعد الجنود السوريون، فتابعا طريقهما إلى المدينة بصمت.
هناك شوارع في طرابلس وضواحيها كنّا نخاف أن نعبرها طوال فترة الحكم السوري، شارع “مار مارون” مثلاً الذي استولى الجيش السوري على أحد بناياته وحوّلها إلى مركزٍ أمنيٍّ للتحقيق والتعذيب. صراخ الموقوفين كان يُسمَع أحياناً من الشبابيك ومن الطابق السفلي. “لا تنظري أبداً إلى تلك البناية، لا تتنفّسي ولا ترفعي رأسك إلّا عندما أقول لك” كانت تلك توصيات والدتي وعمّاتي في كلّ مرّة اضطررنا أن نعبر فيها ذلك الشارع وشوارع أخرى في المدينة. بقي سرّ ذلك الشارع الغامض وتلك البناية المخيفة معي وقتاً طويلاً لا أجرؤ حتى على السؤال حوله ولا أحد يتكلّم عنه أو عن كافة الممنوعات التي كنّا محكومين فيها داخل المدينة. صورٌ كثيرة لحافظ الأسد على جدران المباني وعلى أبواب المقاهي وجدران المدارس والأكشاك والسيارات، وقد لاحظتُ في عمرٍ صغير أنّه مهما كَبر حجم صورته أو صَغر فأنت لن ترى فيها إلّا رأسه. رأسٌ مربّع كبير شكله غريب ومريب يحتلّ كامل الصورة مهما كانت طولية وحتى لو زُيّنت بلمبات ملوّنة وبسعف نخيل على الجانبين، لن تقع عيناك إلا على ذلك الجبين المبلطح الضخم، وربما أحياناً، قد تنتبه إلى تلك الابتسامة الباردة المحيّرة أسفل الصورة. صورة حافظ الأسد تلك كانت تخيفنا أينما وُجدت ومن دون أي محفّز آخر. عندما أُعلن خبر وفاته عام 2000، خرجتُ مسرعةً إلى الشرفة لأزغرد وأضحك بصوت عالٍ، سارعَت أمي إلى إسكاتي وأدخلتني فوراً وأقفلت الأبواب والشبابيك. لم يُنهِ موته خوفنا منه.
السنتيمترات المرعبة
تتذكّر لانا (44 سنة من طرابلس) أنها تعرّفت إلى بعض شوارع وأحياء مدينتها في فترة متأخرة جداً من حياتها “كنّا نخاف عبور تلك الشوارع ونلفّ لفّة طويلة لكي نتجنّبها”، توصيات والديها قبل الوصول إلى أي نقطة “ردع” ما زالت حاضرةً في ذهنها “لا تضحكي، لا تبلعي ريقك بصوت عالٍ، وإيّاكي أن تنظري في عيونهم”. كان خروجنا النادر من البيت، عبارة عن فقرات من التجمّدات والتشنّجات وأوامر الوالدين الحازمة من دون أي تفسيرات، والثابت الوحيد حالات توتر عند الاقتراب من جندي سوري أو مركز تابع لهم. “في إحدى المرّات، توقّف أبي عند حاجز “ردع” كالمعتاد، لكن الجندي الواقف خارجاً رأى أن سيّارتنا تخطّت بسنتيمترات قليلة الحدّ الذي كان يجب أن تتوقّف عنده، فانهال على والدي بالشتائم وتجمّع الجنود حولنا رافعين أسلحتهم، كانت دقائق مرعبة لم نعرف كيف نجونا منها. بعدها، بِتُّ أقطع أنفاسي كلّياً عند اقترابنا من النقاط الأمنية وأصلّي أن يقيس أبي جيداً المسافة اللازمة بين السيارة وحدود الحاجز”.
حوادث الإذلال على حواجز “الردع” لا تنتهي، تروي هبة (43 سنة من طرابلس) أن ابن عمّها الطبيب كان متجّهاً في عجلة من أمره إلى عمله في المستشفى ذات صباح، طلب منه الجندي السوري على حاجز المرور بطاقة هويته ولم تكن معه، فأنزله من السيارة وأمره بأن يتسلّق تلّة رملية عالية بجانب الحاجز صعوداً ونزولاً لساعات من دون توقّف وأمام أعين المارّة، حتى انهار الرجل من التعب فأفرج الجندي عنه.
“نزل والدي مع صديقه واختفى”
اتّبع النظام السوري في لبنان أسلوب الخطف والإخفاء. لا أحد يعرف لماذا قد يُخطف فلان ولا كيف، وقليلون هم مَن كانوا يتأكّدون، بعد فترة، من تواجد ذويهم في السجون السورية ومن النادر جداً أن يتمكّن الأهل من زيارتهم. “أخدوه السوريين” هي العبارة المقتضبة الرائجة آنذاك والتي قد تلخّص الوضع القائم حينها، إذ مَن يُخطف من قبل السوريين نعرف عنه فقط أنه “أُخِذ”، لا شيء أكثر. وفيما يُقَدّر عدد المفقودين في الحرب الأهلية اللبنانية بحوالي 17 ألفاً يصعب تقدير عدد المفقودين على أيدي النظام السوري والمعتقلين في سجونه منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن بعض الجمعيات الأهلية المتابعة للقضية قدّرته بـ 622 مخفياً داخل السجون السورية، معظمهم مجهولي المصير.
عاشت لانا أيضاً تجربة خطف عمّها واعتقاله في سجن المزّة السوري. “لا أنسى يوم جاء خبر الخطف، كانت الكهرباء مقطوعة ونحن نتحلّق حول جدّتي في منزل العائلة، كلام قليل وتوتر كبير ملأ الغرفة، وجوه جدّتي وعمّاتي فيها حزنٌ وخوفٌ كئيب بقي طوال سنوات اختفائه”. عمّي الموظف غير المنتمي إلى أي حزب أو تنظيم، زُجّ اسمه في أحد التقارير الكثيرة التي كانت تُرفع من جواسيس النظام السوري بهدف نيل رضاهم أو مقابل مبالغ مالية. أذكر أن جوّاً من الخوف والكآبة خيّما على العائلة كلّها لفترة طويلة من الزمن، مُنعنا من إقامة أي احتفالات في المنزل الذي بات أشبه بدار عزاءٍ مفتوح. لم نتكلّم بموضوع الخطف أبداً.
كبرتُ كما كبر معظم أبناء المدينة في جوّ من الخوف والقلق الدائمين، الرعب على الحواجز وخوفنا من مركز الجيش السوري المحاذي للمدرسة حيث كنّا ممنوعين من فتح الشبابيك المطلّة عليهم، ثم في الجامعة حيث كانوا يحتلّون أجزاءً كبيرة من الكلّية التي تعلّمت فيها.
أتفاجأ من الصور الواضحة العالقة في رأسي “يوم أخذوا والدي”، رغم أن عمري كان ثلاث سنوات فقط، تقول سلمى (39 سنة من طرابلس). أذكر جيداً أنّ صديق العائلة أتى إلى البيت وطلب من والدي بكل هدوء أن ينزل معه “لأنه عايزه بشغلة”، لم نقلق في تلك اللحظة لأن الوضع بدا طبيعياً إذ مَن دخل منزلنا وأخذ أبي كان “صديقه”، الذي تبيّن لاحقاً أنه جاسوس لدى المخابرات السورية وقام باختطافه لصالحهم. أذكر أنّ الأشهر الثلاثة الأولى كانت جحيماً إذ لم نعرف عن أبي أي شيء، نزل من البيت واختفى، ثم جاءتنا أخبار أنه في سجن صيدنايا، ثم علمنا أنه نُقل إلى المزّة. بقي أبي في سجن المزّة مدّة 3 سنوات ونصف أذكر منها عذابات أمي وجدّتي في مواعيد الزيارات والرشى الكثيرة العينية والمالية التي حملوها معهم من طرابلس إلى دمشق لتتيسّر أمور الزيارة وليسمحوا لهنّ برؤيته. أذكر حلم جدّتي بأنها “ستحتفل عندما يموت حافظ الأسد” وأمنية والدتي الدائمة: “سأرقص في الشارع عندما يخرج محمد!”. كبرتُ كما كبر معظم أبناء المدينة في جوّ من الخوف والقلق الدائمين، الرعب على الحواجز وخوفنا من مركز الجيش السوري المحاذي للمدرسة حيث كنّا ممنوعين من فتح الشبابيك المطلّة عليهم، ثم في الجامعة حيث كانوا يحتلّون أجزاءً كبيرة من الكلّية التي تعلّمت فيها.
أذكر أيضاً يوم أبلغونا أن والدي خرج من السجن، كنّا في الشارع مع أمي، لا أذكر أنها رقصت، لكنها فَرِحت إلى حدّ الارتباك والتهليل بصوت عالٍ، بكت وأرادت أن تصل إليه في نفس اللحظة. أما أبي، فأذكر لون وجهه شديد البياض عندما رأيته للمرة الأولى بعد خروجه. لا أعرف الكثير عن تفاصيل الاعتقال، لا يتكلّم أبي عن الأمر مطلقاً، حتى الآن. نوبات غضب مفاجئة وصعوبة كبيرة في التعبير عن المشاعر، هذا ما عادت به شخصيته الجديدة من هناك.
“سنقتل كلّ أولادك”
قضاء المتن هو أحد أكبر أقضية محافظة جبل لبنان التي عانت أيضاً من فظائع الحكم السوري. وحتى اليوم، يمكن لزائري قرى وبلدات هذا القضاء أن يشاهدوا بعض منازله مهجورةً ومحروقة كشواهد على تلك الحقبة السوداء. إذ تمركز الجيش السوري في مختلف تلك القرى الجبلية وقطّع أواصلها واحتلّ منازلها بعد أن صادرها من أهلها بالقوّة، كما نهب الكثير من الممتلكات والأراضي ومحاصيلها خلال فترة سيطرته ثم عند انسحابه عام 2005 قام جنوده بحرق المنازل قبل مغادرتها.
تروي نيكول (43 سنة، من إحدى قرى المتن)، أن والدها عاد إلى لبنان في بداية الثمانينيات بعد أن توقّف عمله بشكل مفاجئ في الكويت التي أمضى فيها معظم سنوات شبابه يعمل ليعيل عائلته الكبيرة والصغيرة. لدى عودته إلى لبنان، استثمر مدّخراته في بناء منزلٍ للعائلة في قريته، وشراء بناية في قرية مجاورة بهدف تأجير شققها وتأمين عائد مادّي من خلالها. لكن ما إن انتهى من تجهيز تلك البناية حتى صادرها الجيش السوري بالقوّة. لم يستطع الرجل فعل أي شيء ليمنع ذلك طبعاً، فخسر كلّ مدّخراته وانتهى مشروعه الاستثماري الوحيد الذي عوّل عليه بعد عودته من الخليج. في تلك الفترة أيضاً تعرّضت العائلة لتهديدات كثيرة ومضايقات من عناصر الجيش السوري ومن المحسوبين عليهم في المنطقة وذلك في محاولة لـ”تطفيشهم” من منزلهم. قُصف البيت عدّة مرّات وتُركت رسائل تهديد كثيرة على مدخله مفادها “أنكم لن تكونوا بأمان، خاصة الأطفال، إذا بقيتم هنا”. تحت هذه الضغوط انتقلت نيكول مع والدتها وإخوتها الثلاث إلى قرية اخرى، لكن والدها بقي في منزل العائلة لـ”يحميه” ويحول دون مصادرته.
“كان يزورنا مرّة واحدة في الأسبوع. كنّا حُرمنا من وجوده أثناء عمله في الكويت ثم حرمنا منه مرّة جديدة عندما عاد”، تقول نيكول وتشير إلى أجواء القلق الدائم على والدها إضافة إلى الإحساس بعدم الأمان وهم لوحدهم في قرية اخرى.
بعد مصادرة الأملاك وإقفال كلّ مصادر رزق العائلة، “اضطرّ والدي أن يبيع كلّ ما نملك وبأبخس الأسعار فعشنا فترة طويلة في ظروف معيشية صعبة”، تشرح نيكول. عائلات كثيرة في منطقة المتن اضطرت إلى ترك منازلها والنزوح إلى مناطق اخرى أو الهجرة خارج البلد تاركين بيوتهم التي احتلّتها القوات السورية وحوّلتها نقاطاً عسكرية ومراكز تعذيب. “منازل كثيرة في القرى والبلدات المتنية ما زالت فارغة حتى الآن، لأن أهلها لا يستطيعون التعايش مع فكرة العودة إلى مبنى شهدت غرفه عمليات تعذيب وسجن وقتل”. تتذكّر نيكول من تجارب المرور على الحواجز السورية “أن الجنود كانوا يصادرون أيضاً أشياءً صغيرة شخصية كنّا نحملها معنا في تنقّلاتنا القليلة. طلَبَ الجندي في مرّة القبّعة التي كنت أعتمرها، فسارع أبي إلى إعطائه إياها. كنت طفلة جالسة بهدوء في السيارة وفرِحة بثيابي، لا أتذكّر القبّعة لكني أتذكّر جيداً الشعور بالقهر من سلبي إياها عنوةً ومن منظر والدي الذي عجز عن رفض طلب الجندي.. في كلّ مرة. الإذلال، هذا ما أراده الجيش السوري أن نشعر به أيضاً إلى جانب الخوف”.
من المشاهد المخيفة العالقة في ذهني أيضاً منظر انهيار أمي أمام ضابط سوري جاء إلى منزلنا متوعّداً مردّداً اسم شقيقتي، فخِلنا أنه سيخبرنا أنها ماتت أو اختُطفت، ليتبيّن أن الضابط جاء يشتكي من أن أختي “شوهدت تضع العلم اللبناني على رأسها خلال وقفة طلابية داعمة للجيش اللبناني”. خضعت أختي (طالبة في المرحلة الثانوية) ووالدي للتحقيق في مكتب مسؤول أمن المنطقة السوري بسبب هذه الواقعة، والتحقيق تضمّن إلى جانب الإهانات اللفظية تهديد صريح لوالدي بقتل جميع أبنائه في حال شارك أحدنا في أي نشاط طالبي أو سياسي مرّة اخرى. منَعَ أبي كلّ أفراد العائلة من مجرّد الكلام في السياسة داخل أو خارج المنزل منذ ذلك الحين.
الخوف رافقنا على مستويات عديدة. أذكر جيداً حادثة خطف شابّين شقيقين من أقاربي، كانا متوجّهين إلى المطار للسفر خارج البلد. ما أذكره من تلك الحادثة هو معاناة عائلة الشابّين التي تلت الخطف وامتدّت لسنوات. أتذكّر والدتهما، التي ابتزّها الضبّاط السوريون إذ أخبروها مرّة أنهم يعرفون معلومات عن مكان اعتقالهما في سوريا، ومرّة اخرى أكّدوا لها إنهما على قيد الحياة، ومرّةً وعدوها بزيارتهما… ولقاء كلّ معلومة من تلك المعلومات المضللة كان الضبّاط يطلبون مبالغ طائلة من الأموال. وبعد انتظار طويل، ماتت الأم ولم ترَ ولديها. لا نعرف عنهما شيئاً حتى اليوم.
يوم دخل الجيش السوري حيّنا
تتذكّر رولا (43 سنة، من سكّان منطقة الدكوانة، شمال بيروت) اليوم الذي دخل فيه الجيش السوري إلى حيّهم. “كنت صغيرة جداً لكن المشهد محفورٌ في رأسي كما لو أنه حدث أمس وذلك الشعور بالخوف والصدمة الذي رافقه”. رأيتُ الجيش السوري يُخرِج عناصر الجيش اللبناني من مركزهم المجاور لمنزلنا ويضعون البنادق خلف رقابهم. المشهد كان صادماً لشدّة غرابته بالنسبة لي كطفلة لكن خوفي جاء عندما استدرتُ ورأيتُ وجه أبي يبكي بانفعال وصمت. دموعٌ كثيرة ذُرفت من عينيه المحدّقتين بذلك المشهد من شرفة المنزل. لم ينطق بأي كلمة ولم يصدر عن بكائه أي صوت، تسمّرت في أرضي وحدّقت به ولم أسأله عن سبب دموعه، تلك كانت أول مرّة أرى فيها والدي يبكي. خفتُ كثيراً ربما بسبب الضعف والعجز الذي شاهدته في ملامح وجهه هو الذي فرض رهبته على العائلة كلّها.
كنت طفلةً أقف عند باب الغرفة أسمع أنفاسها المتسارعة وأحدّق بيديها اللتين تسابقان أنفاسها. اختفت معظم صور أهلي وانمحت ذكرياتهم في ثوانٍ. “عنّا ولاد ولازم نخاف!” قالت أميّ لوالدي عندما عاد إلى المنزل وعاتبها غاضباً على قيامها بتمزيق تلك الصور.
الخوف كان موجوداً في كافة تفاصيل حياتنا اليومية ومع تنوّع أحداثها. أذكر مثلاً الخوف من ناطور البناية السوري. طُلب منّا كأطفال أن نبتسم له دائماً وأن لا نطيل الحديث معه، كنتُ أخاف جداً أن يوجّه إلي أي سؤال فأمرّ مسرعة من أمام غرفته، وقد لاحظتُ أن جميع أفراد عائلتي كانوا حريصين أن لا يزعجوه بأي جدالات أو مطالب. لم أكن أفهم يومها سرّ الخوف الشديد والحذر من هذا الشخص تحديداً، فهو بالنسبة لي ليس جندياً مسلّحاً على أحد الحواجز هو الرجل الذي يجلس بثياب عادية أمام مدخل البناية، لكن خوف أهلي تسلل إليّ تلقائياً.
انتقال مشاعر الخوف تلك من الأهل إلى أولادهم وبعض المشاهد المحفورة حتى اليوم تسجّلها أيضاً ريتا (42 سنة، من الأشرفية، بيروت) إذ تتذكّر وصول خبرٍ إلى المنزل يفيد بأن القوات السورية تداهم منازل الحيّ وتعتقل من يتبيّن أنهم ينتمون إلى الأحزاب المعارضة لهم. لم أرَ والدتي يوماً في هذه الحالة من الارتباك والخوف. توجّهَت مسرعةً إلى صندوق يحتوي ألبومات صور العائلة، كانت تنبش الصندوق ويديها ترتجفان، تمزّق كلّ صورة تظهر انتماءنا السياسي، أو أي مشاركة لنا في مناسبات حزبية أو أهلية أو حتى عائلية. مزّقت بسرعة فائقة عدداً كبيراً من الصور “نتّفتهم”، كنت طفلةً أقف عند باب الغرفة أسمع أنفاسها المتسارعة وأحدّق بيديها اللتين تسابقان أنفاسها. اختفت معظم صور أهلي وانمحت ذكرياتهم في ثوانٍ. “عنّا ولاد ولازم نخاف!” قالت أميّ لوالدي عندما عاد إلى المنزل وعاتبها غاضباً على قيامها بتمزيق تلك الصور.
لو أردتُ أن ألخّص مشاعري في تلك الفترة من طفولتي ونشأتي في بيروت لقلتُ “الخوف من كلّ شيء“، تقول ريتا. فقد تربّينا على دروس صارمة في المنزل تقول “إنهم موجودون في كلّ مكان“، أي المخابرات السورية ويجب الحذر من كل الناس وفي كلّ الأماكن. الحذر من الجيران في البناية، من صاحب الدكّان، من أصدقاء المدرسة، من أي شخص يوجّه إلينا أي سؤال عام، “قولوا دائماً نحنا ما منفهم بهالأمور. ما منعرف عن شو/مين عم تحكي“. هكذا، وفي العمر الذي كان يجب أن تكثر فيه الأسئلة، تعلّمنا أن نخاف من السؤال ومن سائله ومن الجواب.
إسمي حافظ
“ما زلتُ أذكر وجه الجندي السوري الذي انهال بالضرب على ذاك الرجل أمامي في الشارع في منطقة فردان في بيروت. أذكر تعابير وجهه المرتاحة، أذكر أسنانه الذهبية وأذكر صوت طقطقة العظام تحت كعب بندقية الكلاشينكوف. كان عمري 5 سنوات وكانت تلك المرّة الأولى التي أرى فيها تعنيفاً جسدياً بهذه القسوة”، يروي داني ( 42 سنة، من الشوف، سكّان بيروت). قبل دقائق من واقعة الضرب كان داني قد صدمته سيارة وهو يعبر الطريق من دون انتباه، هرع السائق لتفقّده وعرض المساعدة واعتذر من والد داني الذي قبل اعتذاره وهمّ الجميع بالمغادرة. لكن ما هي إلا ثوانٍ حتى سارع أحد الجنود السوريين من نقطة تمركزه القريبة ومن دون أن ينطق بأي كلام أوقع السائق أرضاً وانهال عليه بالضرب من بندقيته، “أوّل مرّة بنْوِجِع من صوت!” قال داني مستذكراً أنه “مع كل صوت لكمة وجهها الجندي للرجل كنت أشعر بوجعٍ في جسدي”. امتلأ وجه السائق بالدم وجسده مرميّ على الأرض وصوت أبي لا يفارقني وهو يقول للجندي “الحقّ على ابني ما بقى تضرب الزلمة”. ما زلت لا أعرف سبب الضرب العنيف الذي لحق بذاك الرجل في ذلك اليوم.
لم تكن هذه الحادثة الأخيرة التي شهدها داني، إذ بعد سنوات قليلة عاد والده إلى البيت وجهه ينزف دماً وعلى جسده كدمات كثيرة، استلقى على الكنبة وانهار بالبكاء. انتظرتُ طويلاً وبخوف شديد أن يروي لنا ما حصل، أن ينطق وأسمع صوته فأتأكّد أنه بخير. لكن ما رواه بعدما استعاد أنفاسه كان فوق قدرتي على الاستيعاب حينها، رواية سوريالية قصيرة جداً تقول إن جندياً على حاجزٍ للجيش السوري سأل والدي عن اسمه فأجابه أبي: “حافظ”، فردّ عليه الجندي قائلاً: “ما في حافظ إلا سيادة الرئيس!” وانهال عليه بالضرب والإهانات حتى أدماه وكسّر عظامه.
كره والدي حافظ اسمه كثيراً إلى حدٍّ بات يعرّف عن نفسه باسمٍ آخر خلال فترة طويلة من حياته، ولم يخبرنا بذلك إلا بعد مرور وقت طويل.