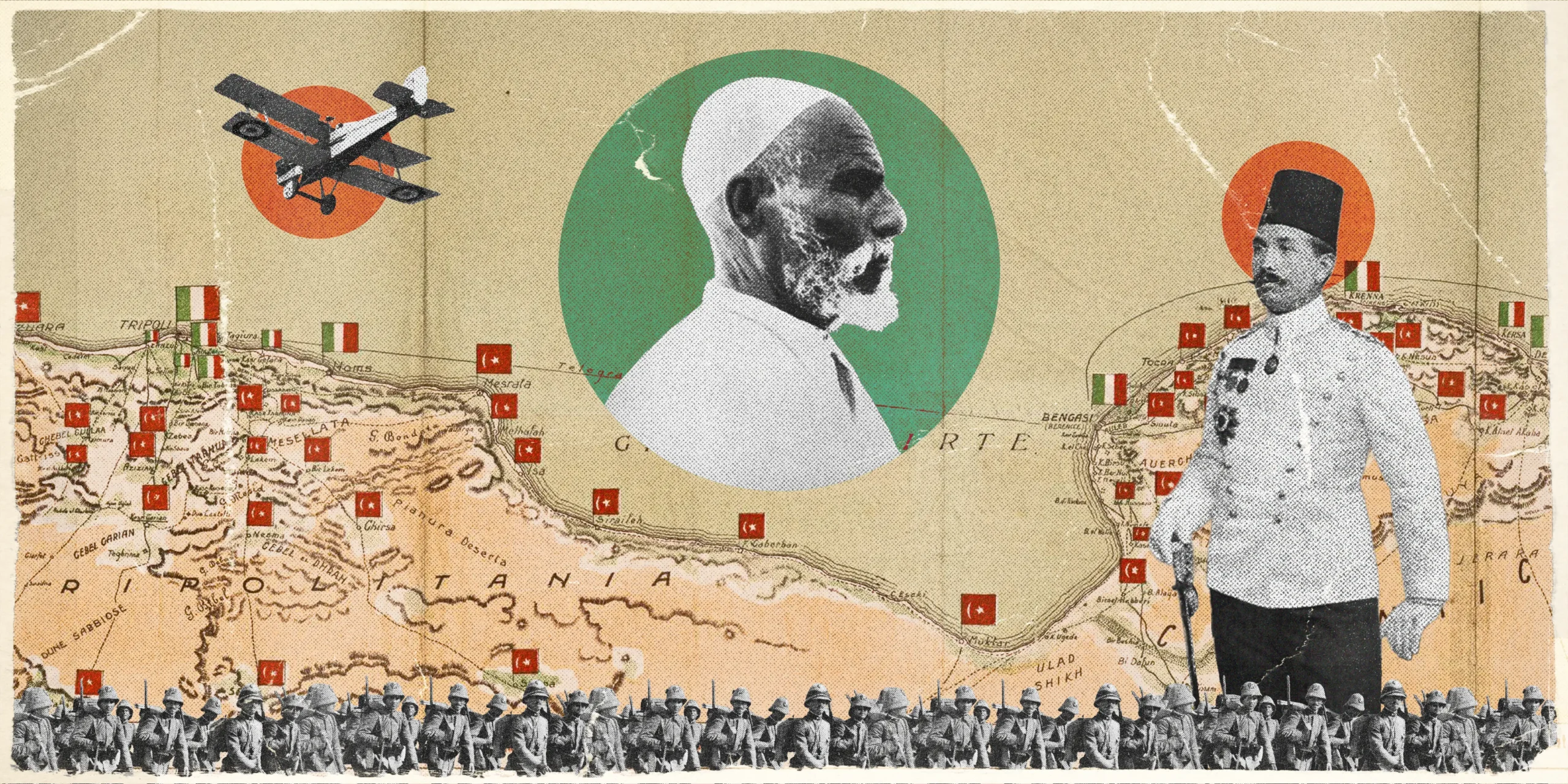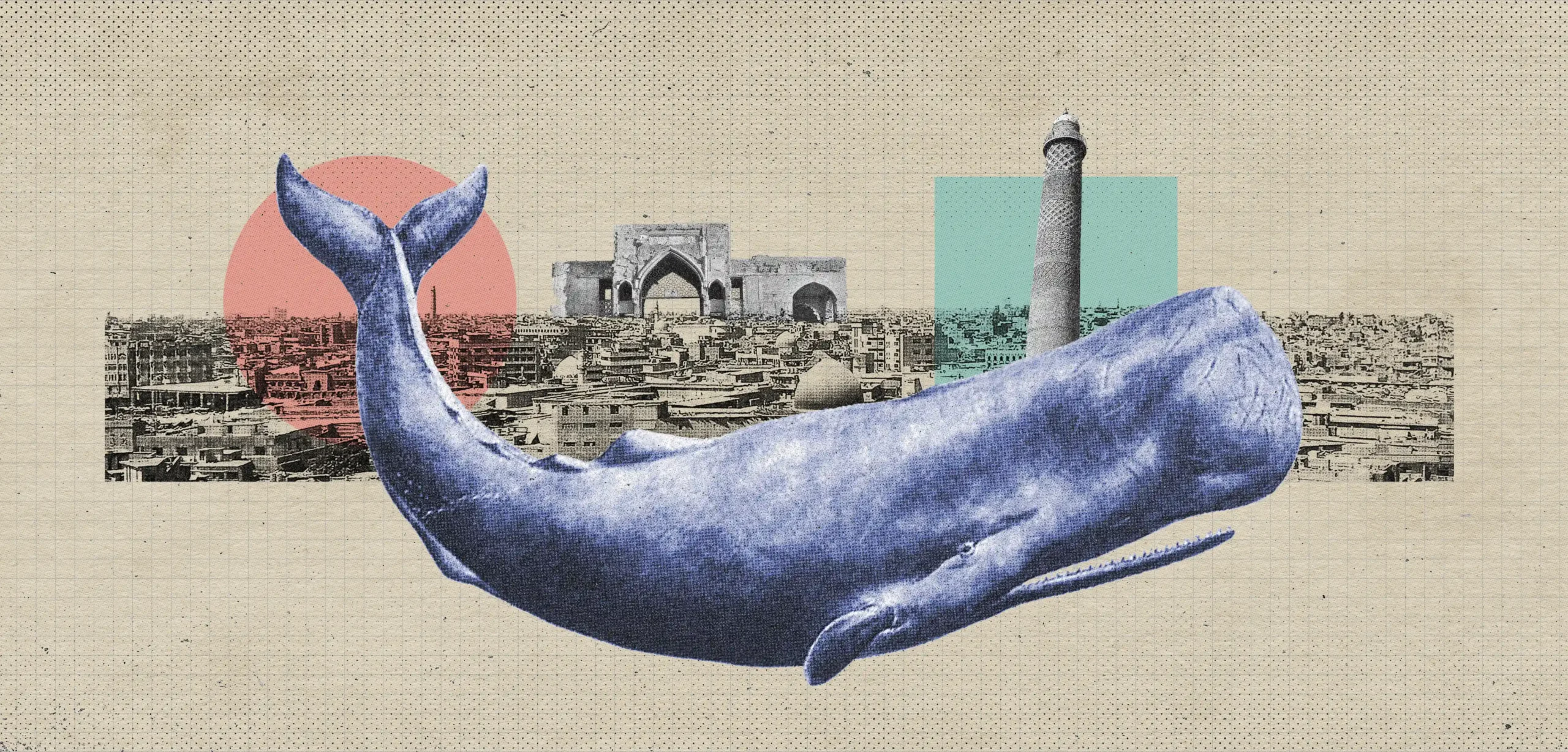بمناسبة سقوط بشار، تعود “إلى الأمام” شعارات من حقبته، أشهرها بلا منازع “(مع) الأسد، إلى الأبد وإلى ما بعد الأبد”. سبق وأن رأيت هذا الشعار على حائط في عين المريسة المطلّة على البحر، ورأيته أيضًا في برج المرّ في وسط بيروت، بعد تحوّله إلى ثكنة عسكرية. أمّا الشعار الذي أريد أن أتكلّم عنه اليوم، “بشار الأسد أو نحرق البلد”، فقد سمعته في عقر داري قبل حوالي 45 سنة. لم يُذكر حينها اسم “بشارو” ولا حتى “باشو”، فقد كان عمر بشار وقتها 15 سنة وثلاثة أشهر.
بعد 31 سنة، بداية العام 2011، في درعا على ما أعتقد، ردّد بعض شبيحة بشار نفس الجملة تقريبًا. وفي آخر المطاف (أضف أيضًا 13 سنة) وبكلفة مجنونة (إلا خلال الأسبوعين الأخيرين، دقّ على الخشب)، ذهب بشار وكانوا قد أحرقوا البلد. أي الاثنان معًا، “و” وليس “أو”.
البرهنة على قولي هذا إن الشعار قديم جداً، تعتمد على سرد قصة جرت في 7 تموز (يوليو) 1980 وفي الأيام العشرة التي تلتها.
***
كان لدي صديق اسمه جوزيف فاخوري – تحية لروحه النبيلة – يعمل في شركة “النسر” للتأمين في بيروت قرب فندق “البريستول”. كان يتلعثم عندما يتكلم (أو يتأتئ إن شئتم).. كنا نسميه “جو”. أصل عائلته من شفاعمرو في الجليل الغربي في فلسطين، وهو من العائلات الفلسطينية (المسيحية) التي جنّسها كميل شمعون في الخمسينيات.
في نهاية السبعينيات، كان “جو” يسكن في الرابية وكنا نلتقي تقريبًا كل يوم، إمّا عندنا في البيت العائلي في قرية عين عار، أو على بعد خمسة كيلومترات تقريبًا، في بيت والدته في الرابية.
يوم الاثنين، 7 تموز (يوليو) من عام 1980، طلّ عليّ باكرًا ليخبرني أنه قرر ألا يذهب إلى العمل توجسًا من عجقة السير، وأنه ينتظرنا – أنا وعائلتي الصغيرة – لنمضي النهار معًا في مسبح “الرابية مارين” في الصفرا حيث لديه “شاليه”.
بعد ساعتين، انطلقنا أنا وزوجتي حنان عبود، وابنتنا أسمرا التي لم تكن قد أكملت الثلاث سنوات بعد، باتجاه الصفرا. ولدى وصولنا إلى منطقة الضبية على ساحل المتن الشمالي، اكتشفنا أن هناك “مشكل كبير” (البعض أسماها معارك) وأن الطريق مقطوعة، فعدنا أدراجنا.
آخر النهار، اتصلت أم “جو” لتخبرني أنه لم يعد إلى البيت بعد، وأنها سمعت أن “معارك دارت في تلك المنطقة”، وسألت إن كنت أستطيع الاستفسار عمّا يحدث. اتصلتُ بزوج عمّتي جوزيف سعادة، وكان حينها أمين عام حزب الكتائب، فطمأنني أن ما حصل لم يسفر عن خسائر أو أضرار، وأنا بدوري، اتصلتُ بالسيدة فاخوري وطمأنتها.
***
كان لدى والدة “جو” أسباب حقيقية للقلق، فخلال الأسبوعين الأخيرين اندلعت مناوشات وتصفيات واشتباكات متقطعة بين ميليشيا “حزب الكتائب” و”نمور الأحرار”، الذراع العسكري لحزب الوطنيين الأحرار، وكلا الطرفين اللذين ينتميان إلى اليمين الماروني كانا يمتلكان سلسلة من المرافئ غير الشرعية الممتدة على الشاطئ الشمالي للعاصمة بيروت، كانوا يستخدمونها ليلاً لأغراض التهريب والتجارة بعيدًا عن أعين الناس، بينما يستثمرونها نهارًا بالتعاون مع شركائهم لتبدو وكأنها “بلاجات عائلية” يرتادها الناس دون أن يدركوا حقيقتها.
بعد نحو ساعة ربما من وصول “جو”، اقتحمت كتائب بشير بيار الجميل معاقل وثكنات ومرافئ ومراكز الوطنيين الأحرار. وقبل غياب الشمس، كان داني كميل شمعون و”نموره” قد استسلموا. أُطلق على هذه العملية اسم “توحيد البندقية”، وبعدها مباشرة، دعا بشير الجميل إلى اجتماع مع قادة الكتائب والوطنيين الأحرار، بمن فيهم كميل شمعون، واقترح دمج الميليشيات المسيحية تحت قيادته، ليشكل نجاح هذا الهجوم نقطة التحول التي أُعلن من خلالها ولادة “القوات اللبنانية”.
أسفرت العملية عن مقتل عشرات المدنيين – وربما بلغ عددهم المئة – ممن كانوا يستحمون أحيانًا مع عائلاتهم في مرافئ “النمور”، التي اعتقدوها مجرد “مسابح عائلية”. ومع انتشار الخبر، تجمعت عائلات الضحايا في صرح البطريركية المارونية في بكركي، مطالبة بمعرفة مصير أبنائها، مما أجبر البطريرك على إصدار بيان عالي اللهجة ندد فيه بما وصفه بـ”المجزرة الرهيبة”.
في الأيام القليلة التالية، تعرض البطريرك مار أنطونيوس بطرس خريش (وكان من مواليد الجنوب اللبناني) لحملة تشويه، وظهرت “عادة قواتية” بتلقيبه بـ “محمد خرفيش”، بينما اغتيل لاحقًا الكاهن الذي كتب البيان.
***
في ذلك الوقت كنت صرت موجودًا في منزل جوزيف سعادة، وقد أعطاني ترخيصًا “لمن يهمه الأمر” (ما زلت أحتفظ به!)، أستعد لأنطلق بسيارتي الصغيرة الى الصفرا. لدى وصولي إلى “الرابية مارين”، كانت الحرائق لا تزال مشتعلة ولم يُسمح لي بالدخول، لكن طمأنني أحد المسلحين على الحاجز بعد أن استفسر عما أفعله هناك قائلاً: “صديقك لديه جروح طفيفة، وقد نُقل إلى مستشفى في جبيل”.
بحثث عن “جو” في مستشفيين في جبيل (“المعونات” ومستشفى آخر لا أذكر اسمه)، لكنني لم أجده. ما أثار استغرابي أنه سُمح لي في كل مرة بالبحث عنه حتى في المشارح. كان شعورًا غريبًا أن أقلب عشرات الجثث في الليلة نفسها، بينما لم أكن قد رأيت جثة واحدة في حياتي من قبل. الحمد لله: جو لم يكن بينهم. عدت إلى نقطة البداية، إلى “رابية مارين”.
***
صارت الساعة التاسعة ليلاً.. هذه المرة، يسمحون لي بالدخول، وكأنني أدخل فيلم سينما: جثتان تطفوان في المسبح، وجثة أخرى تبدو نائمة على العشب. أصعد الدرج إلى الطابق الثاني، لأجد جثة تعترضني، رأسها متدلٍّ نحو الأسفل. أقلبها على ظهرها… إنه “جو”. بعد ساعة، تقريبًا، يصل صهره مع سيارة دفن الموتى. يوقّع الأوراق لسحب الجثة واستعادة سيّارته، وننتقل بعدها إلى منزل مدام فاخوري. قليلاً قبل منتصف الليل، أصل إلى بيتي. ومن بعدها، أطول استحمام في حياتي، ثم أدخّن سيجارة بنفس عميق، وأغرق في النوم كطفل صغير، بعد أن قلت لزوجتي: “غدًا وبعد غد، لن أذهب إلى الشغل”.
***
في اليوم الثالث، أنا في الشغل كالعادة. صورة “جو” تحوم كالشبح فوق راسي، أمسك سماعة تلفون المكتب وأجدني اتصل ببشير الجميل في المجلس الحربي للقوات اللبنانية حديثة الولادة . بعد انتظار طال حوالي عشر دقائق، بشير الجميل شخصياً على الخط. اطلب منه موعدًا، لكنه يعتذر قائلاً أن ليس لديه وقت كافٍ.
أترك مكتبي قرب صيدلية بسترس عائدًا إلى الضيعة. وعندما أصل قرب الكرنتينا، أتوجه نحو مقر المجلس الحربي للقوات اللبنانية. يا لغرابة النفس الإنسانية! كل يوم أغض الطرف خوفًا، “لا أريد أن أراهم ولا أريدهم أن يروني”، واليوم أسير واثقًا بنفسي إلى داخل فم الذئب.
أركن السيارة في مكان شرعي ثم أترجل، مستعينًا بالإشارات التي تدل الزائر على مكتب القائد. أدخل وأقول للسكرتيرة إن لدي موعدًا مع الشيخ بشير. تشير إلى الكنبة تحت الدّرج وتدعوني للجلوس والانتظار عليها. بعد عشر دقائق تقريبًا، يخرج بشير الجميل مسرعًا من مكتبه. يفاجئه وجودي فينقز قائلًا: “موسيو أشقر، قلت لك إنه ما عندي وقت”. فأجيبه: “وأنا بحاجة لأن أتكلم معك”. أمام إصراري، يعدني أنه سيرسل لي معاونًا له بعد بضعة أيام.
***
وهكذا صار.. رنّ الهاتف في البيت بعد يومين. (كيف حصلوا على رقمي؟ ولم يكن لدينا بعد هواتف خليوية!). إنها السكرتيرة، تخبرني بكل لطف أن اثنين من معاوني الشيخ بشير سيزوراني غدًا في منزلي عند الساعة السادسة مساءً.
أطلب من زوجتي أن تحضّر لنا كأسًا. يصلان في الوقت المحدد. أحدهما طويل القامة، شعره أسود، نحيل وبنية جسده رياضية، والثاني قصير القامة، مدعبل وأصلع، كأنهما ثنائي سينمائي كوميدي. يجلسان – أفضل ألا أذكر اسميهما احترامًا لهما، مع أنهما شخصيتان عامتان. يسألني النحيل، بصوته الرقيق: “ماذا تريد من الشيخ بشير؟”. أعرّف عن نفسي، وأتحدث عن طيبة “جو” وعن رغبتي في أن تخدم وفاته القضية بشكل إيجابي.
يسألني الثاني: “كيف يعني؟”. أسترسل في الحديث وأقول لهما إنه من المهم أن يوسّعا أفقهما لكي ينجحا في احتضان كل اللبنانيين، لا فئة دون غيرها. أتكلم وأتكلم، وألاحظ أنهما لم يعودا ينطقان بأي كلمة مفيدة، يكتفيان أحيانًا برمي كلمة من هنا أو من هناك. يكتفيان برشف كأس الويسكي، وينظران إليّ كأنني حيوان غريب. تمر لحظات صامتة، ثم يقرران أنه يكفي: “نحن مشغولون وعلينا الانسحاب”، وكل ذلك بعد شكري على حسن الضيافة.
على باب البيت، أحرق خرطوشتي الأخيرة. أستلهم من حديث نبويّ قائلاً: “أليس أنتم من يقول إنه لا فضل للبناني على لبناني آخر إلا بالولاء للوطن؟”. المدعبل ينطق عندئد بأطول جملة قالها لي طوال تلك الليلة: “أستاذ أشقر، ما عم تفهم علينا… هاي البلد يا منِحكمها بالصرماية يا منِحرقها”.
***
أنا واقف عند باب البيت، أراقب سيارتهم العسكرية تبتعد في الأفق. أنظر إلى السماء المفعمة بالنجوم، وأتنفس رائحة زهر الدراق التي تعبق في المكان. أعود إلى الداخل، وما إن فتحت الباب حتى سمعت صوت زوجتي تقول بحدة: “إذا دعسوا هالاثنين بعد ببيتنا مجدداً، أنا بطلقك فوراً!
پول أشقر، (من بيروت، شقيقة دمشق)