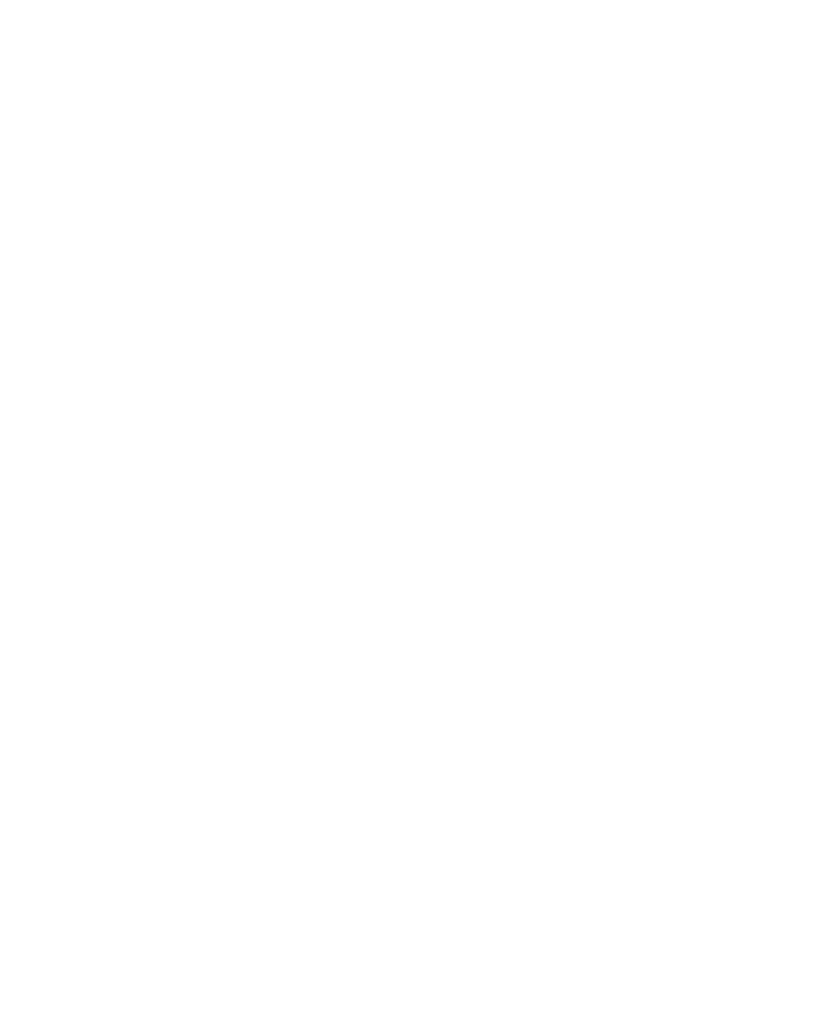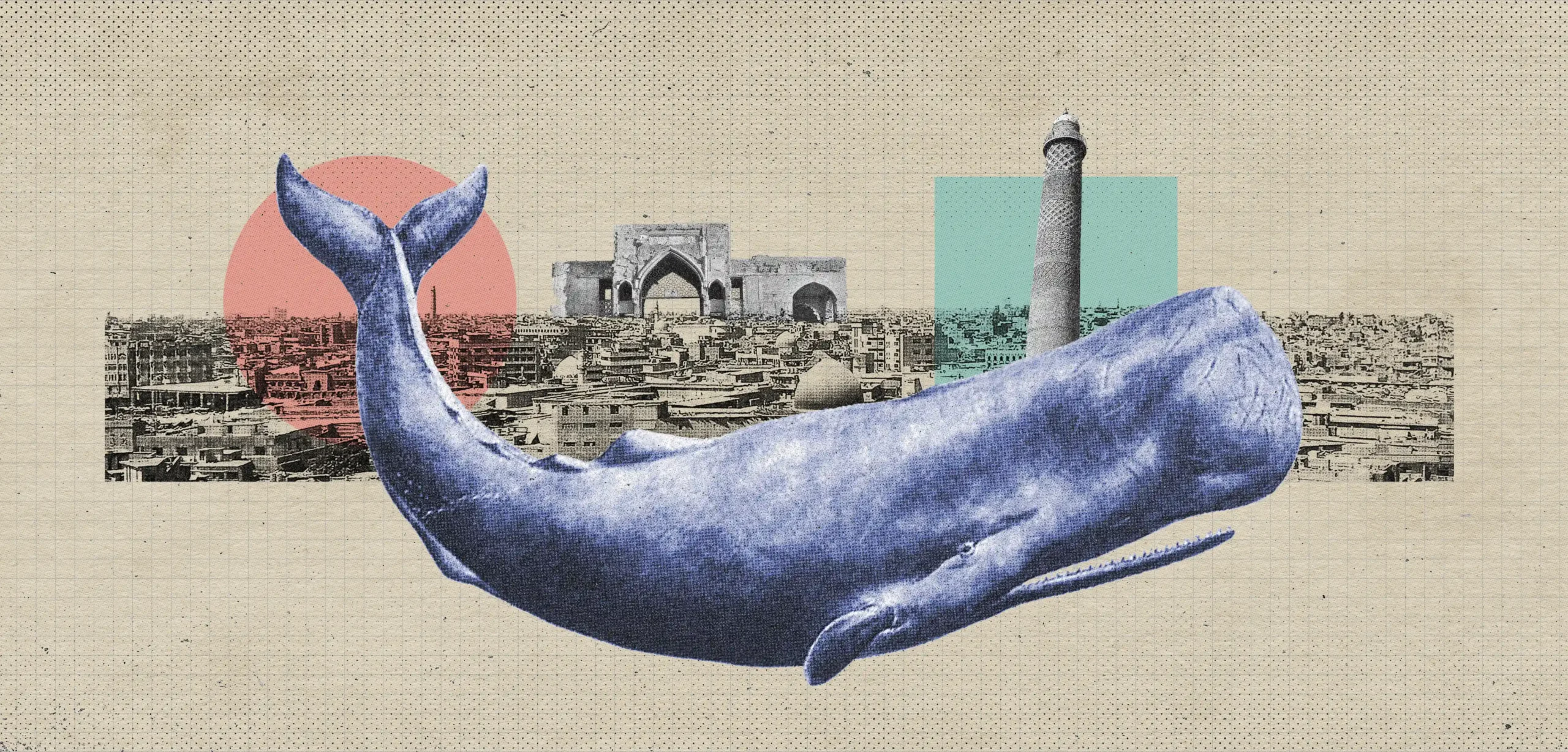1
لا تستدعي الذاكرة في مخيال الليبيّين، في حيّزيْها الخاص والعام، أيقونة الإمام والقائد العسكري/الثوري، عمر المختار، إبان تأسيس الدولة الحديثة، سيما قبل عرض فيلم أسد الصحراء في 1981. فيبقى على الذاكرة التالية لعرض فيلم العقّاد وعلى والراهن أيضًا، أن يستوعبا هالة المختار وصدمته الروحانية على تشكيل الهوية الوطنية. نَبَعت هذه الهوية من مقاومة المستعمر الإيطالي؛ ومن طريق أنتوني كوين في الفيلم، تأبدّت جملة المختار، “نحن لا نستسلم؛ ننتصر أو نموت”، لترسّخ الاستماتة في مواجهة أي عدوان في المستقبل، سواء كان أجنبيًا أو داخليًا.
لسنا معنيين هنا بالبحث التاريخي الذي نتركه لأصحابه وصاحباته، وإنما نستدرك معرفتنا الشخصية بالقائد العسكري وصورتيْه اللتين رسم النظام الجماهيري أول تجلياتهما في أوائل مراهقتنا، وكشفت مآلات الحرب الأهلية ثانيهما في أواخر شبابنا. استفاقت الصورة الأولى على آخر سنوات القمع في آخر التسعينيّات ومستهل الألفية الجديدة، ولم تشهد على حروبٍ واسعة، إذ انتهت الحرب الليبية – التشادية (1978-1987) قبل أن نولد. ولنفترض انبثاق الصورة الثانية المفترضة من الحرب الأهلية التي اشتعلت غداة انتفاضة 17 فبراير 2011، فقد تحوّلت أيقونة البطل الوطني من مقاومة المستعمر الإيطالي إلى مقاومة حكم استبدادي دام أكثر من أربعة عقود، ولا جديد يُطرَح في ثنائية المستعمر والمستبد في المنطقة إبان حركات التحرر بعد الحرب العالمية الثانية.
ستتوالد الصورة الثانية فيما سُمّيَ الحرب الأهلية الثانية (2014-2020) التي انتهت بالوضع الراهن، وتتحوّل هنا إلى تبنّي أطراف النزاع قيَم المختار وهو الذي فعل العكس؛ فمنذ بدايات قيادته حركة المقاومة في 1911 وحتى شنقه في 1931، باتت أعظم إنجازاته توحيد قبائل إقليم برقة والإسهام الجوهري في تشكيل وحدةٍ وطنيةٍ لازمة.
2
يكتب بنسالم حمّيش في روايته “مجنون الحكم” على لسان عز الملك المسبحي، وفي شأن تهافت المؤرخين “الأوائل”، فيقول، “لكن يا مولاي، هذا النص المنظوم بالشعر والخيال، سيتحول بالتدريج إلى وثيقة صحيحة يكرر نسخها حتى أقرب المؤرخين إلى قيام الساعة. وأنا أراها من الأهمية والنفاسة، بحيث يحسن روايتها كما تروى كل الوثائق التي بدأت خيالًا ثم صارت تاريخًا.” والرد هنا على استهزاء الحاكم بأمر الله بمؤرخي البلاط. فأسطرة الأمم واجبة منذ الحضارات القديمة وحتى ابتكار الأوروبيين للدولة القومية.
نشير هنا إلى تأصيل الأسطورة التي نحتت هوية الليبيين الوطنية/ القومية من طريق المختار وليبيّته العابرة للأزمنة، ولا نلمّح إلى أسطَرَة مفترضة لسيرته؛ على العكس، فغالبًا لا يشوب سِيَره الشهيرة المبالغات وما يلازمها من انطماس. ولئن دأب الرجل في تأصيل الحركة السنوسية في برقة، ثقافيًا وعسكريًا، فلم تحذف سيرته من سرديّة الوطنية الليبية منذ انقلاب 1969 على المملكة والسنوسية المؤسسة لها. على العكس مرة أخرى، فقد اُستُبدِلت أيقونة الملك إدريس بصورةَ “شيخ الشهداء” الجانبية التي سادت الحيّز العام وطُبِعَت على العملات.
وفي محاولة 17 فبراير المُجهَضة في تأسيس “جمهورية جديدة”، لاحت أيقونة المختار الجهادية ضد الاستبداد، مُختزَلَةً في الانتصار أو الموت، أي احتفظت روح الانتفاضة بالعنصر الوحيد الذي ناصره القذّافي وثمّنه، وأضعف الدلالات كامن في صرف الأخير 35 مليون دولار من خزينة الدولة لتمويل إنتاج فيلم أسد الصحراء، وهو ما يفوق 148 مليون دولار اليوم.
من أشكال الرمزية الثورية هذه، صار نشيد الأمر الواقع للدولة هو نشيد المملكة الليبية. بيد أن التراث هنا محمولٌ على إعادة صياغة للوطنية، فعوضًا عن:
حيّ إدريس سليل الفاتحين … إنه في ليبيا رمز الجهاد
حمل الراية فينا باليمين … وتبعناه لتحرير البلاد
نسمع:
حي المختار أمير الفاتحين … إنه في ليبيا رمز الجهاد
حمل الراية فينا باليمين … وتبعناه لتحرير البلاد
أسارع في التنويه إلى غياب دستَرة السلام الوطني بعد انتفاضة فبراير، فضلًا عن استغناء الكثير عن هذا المقطع في النشيد. وإنما نستقصي من هذا التحوير حذر النخبة في إرساء دعائم الملكية وعودتها، ربما. فالمقاومة ضد المحتل الإيطالي ليست نظام حكم؛ إنها مرحلة صراع وقضت، جاز لقادتها ومنظّريها أن يُخَلّدوا، أما الاحتفاظ باسم الملك، يعني الجزم بعودة النظام الملكي إلى أمزجة الليبيين قبل تقنينه. فإدريس السنوسي (1890 – 1983) هنا “سليل” الفاتحين الذي بات سلفًا لرجالات أسرة حكمت بالروح، فحكم هو بالفعل ولم يخلّف سلفًا حتى في المنفى، وهذا على الضد من “أمير” الفاتحين الذي أنجز مهمته دون توريث وديوان.
العديد ممن خاب ظنهم في الانتفاضة يتهكمون على ما بقيَ منها، قائلين إن الشيئيْن الوحيديْن الذيْن تغيرا بعد موت القذافي ودولته هما النشيد الوطني والعلم. وكما نعلم الآن، هما قديمان قِدَم استقلال البلاد.
3
نتصوّر “المواطن البسيط” في ليبيا عاجزًا عن تصوّر مادّي لعمر المختار المراهق أو الشاب، أو حتى الزوج والمعلّم، فبهذه التصوّرات ينكشف الإنسان في زلّاته وتنبثق حتمية الصدام مع أفكاره وآرائه، بل والصدام مع سلوكه. صعوبة التصوّر متأتّية من ثقل ظلال وجه أنتوني كوين (مثّل شخصية المختار في أسد الصحراء) وما جسّده: إيماءات الرزانة وأحادية التوجّه الجهادي، لا سيما أن التجسيد يبدأ في آخر عمر الرجل.
والحال أن كوين لم يكن شغوفًا بالمسألة الليبية، كما يتراءى لعديد الليبيين، بل بات مستهزئًا بمصطفى العقّاد وألاعيبه الإنتاجية، كما رآها، التي أقنعت القذافي بتمويل الفيلم. هذا ديدن الأساطير؛ ألم يكن بطل الأسطورة الليبية الكبرى، أبو زيد الهلالي، قائدًا عسكريًا إسماعيليًا اُستُجلِبَ لإخماد ثورة سنّيّة! لا يعلم عديد الليبيين أن بطل أسطورتهم الحقيقي ينتمي إلى طائفة ينبذونها، بالرغم من وئام الطوائف قبل أن تُسيَّس.
وإن جاز الحديث عن طائفية ما، فجزء لا بأس به من حزب “الإنسان البسيط” اليميني يفتخر بأن مكوّنات الشعب الغالبة من “ملة واحدة”، على المذهب المالكي “الوسطي”. وإذا سلّمنا بطوباوية الطرح ذاك، فهو لم يمنع التحارب بين فصائل الثروة والسلاح و”الفتنة”، وانتشار داعش والقاعدة السريع وسقوطهما الأسرع، والنزاع القبلي الذي تطول سيرته بين غليانه المطموس تحت قبضة الجماهيرية وانفجاره بتهجير مدينة بأسرها في 2011، وهي تاورغاء. مجرد الإشارة إلى هذه الوقائع يجرّ من يشير إليها إلى خانة الفتنة.
على أن الحديث في “الواقع” أعلاه لا يغيّر من واقع مضاد، كامنٌ في عظمة المختار، بلغة موضوعية، ذاك أن عظمة “الشخصيات التاريخية” ليست معنيّة بالقداسة. صحيحٌ أن سيرة المختار تحمل سمات مشابهة للعديد من الأبطال القوميين؛ الطفل اليتيم الذي اجتهد وحاول فهم مجتمعه الوليد وآل على نفسه الإسهام في تشكيل دولةٍ ما. صَحَّ أيضًا أن نقاشنا هنا إنما ينهل من رغبة في اكتشاف الهوية الليبية الراهنة، بشروطها وعوائق تشكيلها، عبر أيقونة الرجل الذي طُمِرَت انسانيّته فور شنقه، بين شكليْ التطرّف المعتاد الذي نسمعه ونقرأه: بين القائل إنه مجرد قاطع طرق وبين الآخر الذي يحرّم حتى مناقشة نوايا أفعاله.
خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft
4
وإذ شدّدنا على غياب دور المختار السياسي (أي في غياب دولة ليبية)، فها هو عدد لا بأس به من عمداء ووزراء، بل ورؤساء وزارة يُشاع أنهم إما استفادوا اقتصاديًا واجتماعيًا من الاحتلال الفاشي أو تعاونوا معهم بصفة رسمية ضد حركة المقاومة، وعادة ما تُخلَط الشائعات بالأحقاد القبلية، وتخلِط في اتهاماتها بين الحقبة الإيطالية (1911-1944) وما تبع ذلك من إدارة الحلفاء (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) لشؤون البلاد حتى استقلالها في 1951، إذ لم تتشكل الطبقة السياسية الوليدة دون التعاون، بطبائع الأحوال، مع الثلاثي حسب مناطق نفوذه. بهذا نرى قدرة الليبيين على انتقاد قادتهم.
وبغض النظر عن جهل أصحاب الشائعات آنذاك بتاريخ ساستهم السياسي، قد يشير بعض أعضاء حزب “المواطن البسيط” اليساريين إلى سؤال غارق في بساطته: ما الذي منع المختار من التسوية، ولو مؤقتًا، مع الوحش المنتصر؟ زعيم حركة المقاومة نفسه آنذاك انتهج الدبلوماسية للحد من سيل الهزائم. الحديث هنا عن خلاف الأمير إدريس السنوسي مع المختار، ما حثّ الأخير إلى مكاتبة أحمد الشريف، زعيم المقاومة في المنفى، عام 1924 (وهي بالطبع ضمن سلسلة مراسلات قبل وبعد رسالتنا هذه).
بين المراسلات وأزمة المقاومة، وجَبَت العودة الخاطفة إلى أحمد الشريف السنوسي (1873 -1933)، مؤسسها الفعلي الذي أمسى قبل الغزو الإيطالي قائدًا أمميًا مساهمًا في الحروب التي شُنَّت ضد الإمبراطوريّتيْن الفرنسية والبريطانية في إفريقيا وغرب آسيا، واحتكاكه بـ “آباءٍ مؤسسين” تنوّعت رؤاهم، كي لا نقل تنافرت، من مصطفى كمال (1881 – 1938)، قبل أن يُعرَف ب “أتاتورك”، إلى عبد العزيز آل سعود (1876 – 1953).
تزدحم سيرة الشريف بسياقات المقاومة من أقصى غرب “الوطن العربي” في حرب الريف (1920-1927) – مع إشارة خاطفة إلى ازدحام سيرة قائدها، محمد بن عبد الكريم الخطابي (1882 – 1963)، بين اصطلاح “المغرب العربي” والهوية الأمازيغية لمنطقة الريف – إلى أقصى شرقه في “الثورة السورية الكبرى” – مع إشارة خاطفة بنفس الاستلاب إلى قائدها، سلطان الأطرش (1891 – 1982)، مع “الثورة العربية الكبرى”، أم/بنت السورية الكبرى. إشارتان إلى بطليْ سوريا والمغرب القوميّيْن في الراهن يحيل اليساري في حزب “الإنسان البسيط” إلى مط سؤاله الغارق في البساطة: ماذا لو قرّر القذافي التنازل قليلًا واختار أيقونة أحمد الشريف عوضًا عن أيقونة عمر المختار؟
مهما يكن من أمر، تصير كل الأسئلة جائزة إذا اجتازت فن السيرة وفلسفة التاريخ وركزت على فرضيّات تُطرَح في البيوت. أما إذا أردنا الخوض قليلًا في وحل “فن” السيرة، فوَجَبت العودة إلى الرسالة المذكورة كربع مثال يشكّل ثمن المعادلة في استيهامات إنساننا البسيط واستفهاماته.
يختزل المؤرخ عقيل محمد البربار نص الرسالة في تقديمه كتاب “عمر المختار وإعادة الاحتلال الفاشي لليبيا” الذي ألَفه مؤرّخون إيطاليّون، منوّهًا إلى “الموقف المتخاذل الذي أخذه إدريس”، إذ اُجتُزِأت الرسالة وأُحيلَ القارئ إلى نص الرسالة كاملًا في الهوامش (محتفظًا بالنزاهة العلمية لمن يبحث). نقرأ:
“بعد السلام عليكم… نخبركم بأننا وجميع أهل وطنكم العزيز في حال صعبة وخوف شديد من العدو…
والسيد إدريس هرب إلى مصر وتركنا في النار الحمراء، وأننا والله ثم والله نحاسبكم بين يدي الله على فعلكم هذا، سبحان الله تأخذوها وهي حلوة وتتركوها وهي مرة”.
فبعد حذف عبارة “الذي استولى على جميع الوطن” التالية لخاتمة “العدو” في الفقرة الأولى (ولعلها محاولة لطمس سياق الهزيمة)، يتجنب البربار كلمات المختار التي انتهت ببداية فقرته الثانية، فالخوف متأتٍّ من عدوٍّ:
“أبطل كل العهود والمفاوضات التي كانت بينه وبين الأمير إدريس، كما أبطل المعاهدات التي كانت بينه وبين أهل طرابلس من الجهة الغربية، وبسبب ذلك هرب الأمير إدريس السنوسي والتجأ إلى مصر وتركنا مشتتين لا نظام لنا ولا انتظام، أصبحنا كأننا سفينة في وسط البحر لا نعرف غربًا من شرقٍ… وأنت تركت الوطن وأقمت في بلاد الترك والسيد إدريس هرب إلى مصر…”
يستهل المختار الكتابة مشدّدًا على خرق المحتل ما أُتِّفَق عليه مع أطراف المقاومة كافةً، في الشرق وفي الغرب، ويسترسل في “عتابٍ” لطالما اعتدنا قراءته بل وسماعه بين أصحاب الصف الواحد، لا سيما بين قادته، فهو لم يعاتب الأمير وحسب بل المخاطَب أيضًا. توفّيَ الشّريف في 1933، بعد سنتيْن فقط من شنق المختار واضمحلال المقاومة، وبالتالي لم يمسِ مؤسّسًا للمملكة. من هنا يتأتّى تجاهل اسمه في نص الرسالة المقتبَس على الضد من اسم إدريس، ذاك أن البربار رفض حتى اقتباس “الأمير”.
يواصل المختار، “نخبركم أننا ذهبنا إلى مصر ولحقنا بالأمير إدريس وطلبنا منه إغاثتنا ومساعدتنا بأية صفة كانت فقال لنا والله ما نقدر نساعدكم بشيء، ودبروا أنفسكم وعندكم أخونا الرضا روحوا عنده فرجعنا من عنده ودموعنا على خدودنا نتعثر في طريقنا، إنّا لله وإنّا إليه راجعون…”، ويختتم بإصرار قادة المقاومة على مواصلة القتال، وإنما وجَبت المساعدة “بالسلاح والعتاد والنقود والأرزاق والكساوي…”
لعلّ القارئ الليبي يتذكر هنا رد القذافي على أحد المشتكين من فساد “الأمناء” في مؤتمراته الشعبية، حين شدّد “الأخ القائد” أن شكوى المشتكي هي لب خطاب الثورة منذ بدايتها، أن المشكلة ليست مشكلته، بصفته رمزًا للثورة وحسب، قائلًا، “خودو نفطكم ودبروا حالكم برواحكم.” بيدَ أن الأمير إدريس بات حينها قائدَ حربٍ تؤول إلى الهزيمة، ممثلًا لشعبٍ لم يعرف الاستقلال بعد. أما عن رد القذافي، بصرف النظر عن مسرَحَة الشكوى أو صدقها، فقد جاء من رأسِ سلطةٍ بالفعل.
تُرجِم الكتاب برعاية الدولة، إذ صارت الرسالة مكسبًا لسرديّة الجماهيرية القائلة بخيانة السنوسي في أقوى تصريحاتها، وبضعف قيادته في أخف التصريحات. يقدّم المؤرّخون الإيطاليّون الأربعة في الكتاب عرضًا أرشيفيًّا يعد الوحيد من نوعه في إيطاليا، ربما، الذي يعترف بجرائم الفاشست في ليبيا، لا سيما في إقليم برقة.
5
فيما خص تأريخ سيرة عمر المختار، تتبدّى آراؤنا مخلّةً بجهود أهل الاختصاص، وهذا حقهم، فلم يبخل علينا مؤرّخو “مركز الجهاد” وزملاؤهم المستقلين داخل البلاد وخارجها ببحوثهم وأطروحاتهم. هذا الإخلال يتوغّل في وقاحته إزاء حساسيّة “المواطن البسيط” الذي يتشبّث برموزه وأيقوناته فيما انحطاط الراهن يتثاقل. يرحّب الوجه الآخر للمواطن البسيط بتعدّد القراءات، نتناول باقتضاب هنا إثنيْن منها.
الأولى تخص القادة ومآلات سِيَرهم، سواء لتشخيص نجاحات الماضي وإخفاقاته، أو لإضاءة الحاضر بالماضي والعكس، في بحثٍ ما عن توجّهات في السياسة والاجتماع. مرحّبٌ أيضًا بالقراءات المُسطَّحَة والموَجّهة إن كانت قادرة على تحمّل مسؤولية العواقب، والمثال الأشهر كامنٌ في تصوير الشّارف الغرياني الكاريكاتوري في فيلم (أسد الصحراء) واعتذار الدولة الرسمي إلى أسرة الغرياني وحذف المشهد الذي أبَّد صورته في مخيّلة الليبيين.
الثانية تحاول التذكير بتعقيد مسألة تعاون المواطنين مع سلطة الاحتلال، سواء من ساكني المدن أو من انقلب على عملية المقاومة إثر توحّش الآلة الفاشية والشروع في الإبادة (بدءًا بما سمّاها المؤرخ، علي إحميده، “معتقلات الموت”). تناول المؤرّخ الإيطالي أنطونيو إم مورون هذه المسألة بالأرشفة والمقابلات المباشرة مع بعض المتعاونين الأحياء حينها، وعنوَنَ مقالته ب “العساكر وذاكرتهم: مساران للحياة بين ليبيا وإيطاليا”. العسكري هنا إشارة إلى كلمة “Ascari/Askari” التي أطلقتها الإمبراطورية الإيطالية على من جنّدتهم من المستعمَرات.
يظل الجهاد سمة كبرى في شخصية الرجل الليبي حتى وإن لم يكن نافرًا. في عودة أخيرة إلى حقبة القذافي، فقد فرض “مجلس قيادة الثورة” في حقبة الجمهورية الليبية، وفي 1970 تحديدًا، قبل أن تتحول إلى جماهيرية حكم الفرد في 1977، “ضريبة الجهاد” التي ما زالت جارية حتى الآن. ونصّت إحدى مواد القانون في 1972 على أن الصندوق يهدف إلى “دعم استعداد العالم الإسلامي في جهاده ضد القوى الاستعمارية، وتمكينه من الحفاظ على كيانه واستقلاله وإسلامه، كما يهدف الى تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى أسر الشهداء والجرحى وضحايا العدوان الاستعماري من أبناء الأمة الإسلامية، وكذلك المساهمة في بناء ودعم المنشآت التي تخدم الدعوة الإسلامية وشئون المسلمين”.
يُعزى هذا التعريف إلى الخطاب الناصري المعهود، إنما بنكهة قذافية انتهجت الجهاد، وما عاد له ذات الوقع. وقد صدرت فتوى عن إحدى الداريْن في البلاد في 2022 بعدم جواز استقطاعها من مرتبات الموظفين وأوصت بمراجعة القانون في نقاط عدة نظّمت خطاب الفتوى ومن هنا يتأتّى القول بإن الجهاد ليس نافرًا، فالسلطة الدينية الأعلى لا تقحمه في قانون الضرائب.
لا ضير من التذكير بالبديهيّات: سيرة عمر المختار تقابلها سِيَر أبطال الأمم في الكوكب كله. بين هذه الأمم، ثمة من يسمح بنقاش هذه السِّيَر في الحيّز العام، ولا ينجر الجدل إذا ما انبثق، سواء صار كبيرًا أو صغيرًا، إلى السجن أو القتل. تظلّ ليبيا بين أمم عديدة أخرى لم تعبر بعد طور أسطَرَة الأمة إلى محاولة إنشاء مجتمع حديث لا يظفر باسم “شعب” إلا عندما يقر بمبدأ المواطنة.
أمّا الماضوية فهي ماضية في تصوير “تاريخنا” وفي تسيير الفنون والآداب، وتلحّ بألطف تعبيراتها على الاهتمام بالأولويّات، دون الانتباه إلى المفارقات المنبثقة. هكذا غدا عمر المختار أسيرَ الراهن فيما يُنظَر إلى تاريخه عبر فقاعة القداسة قبل أن تحل صورة عمر الإنسان.