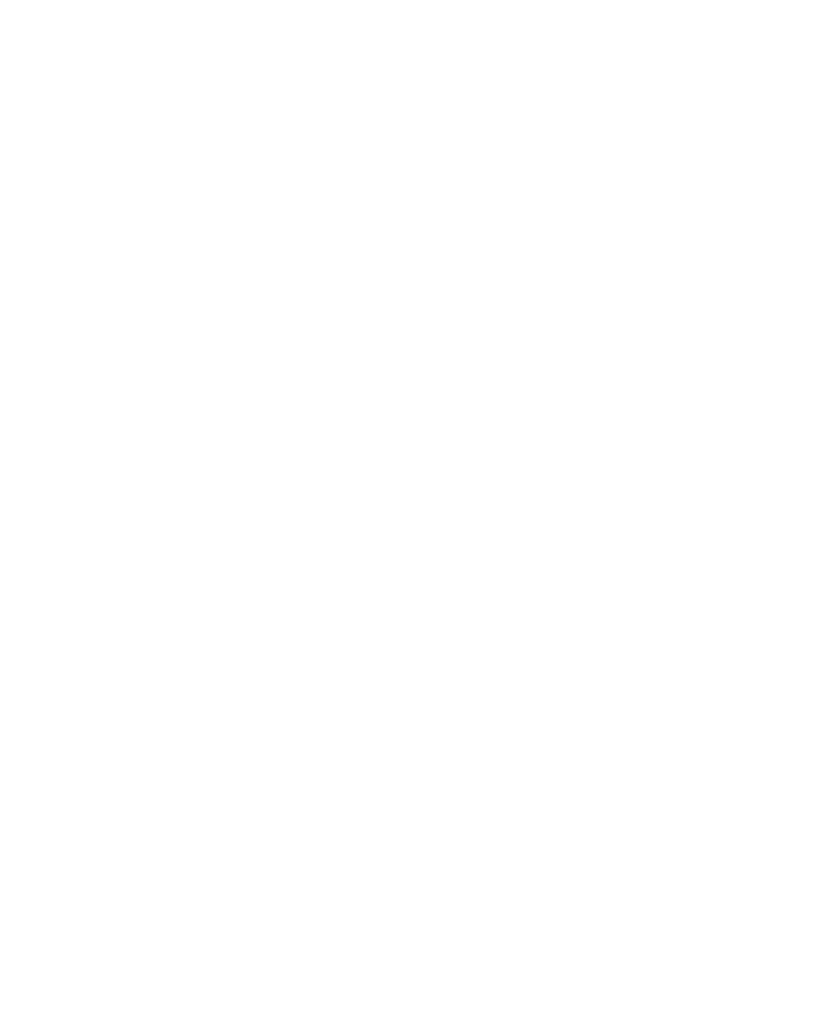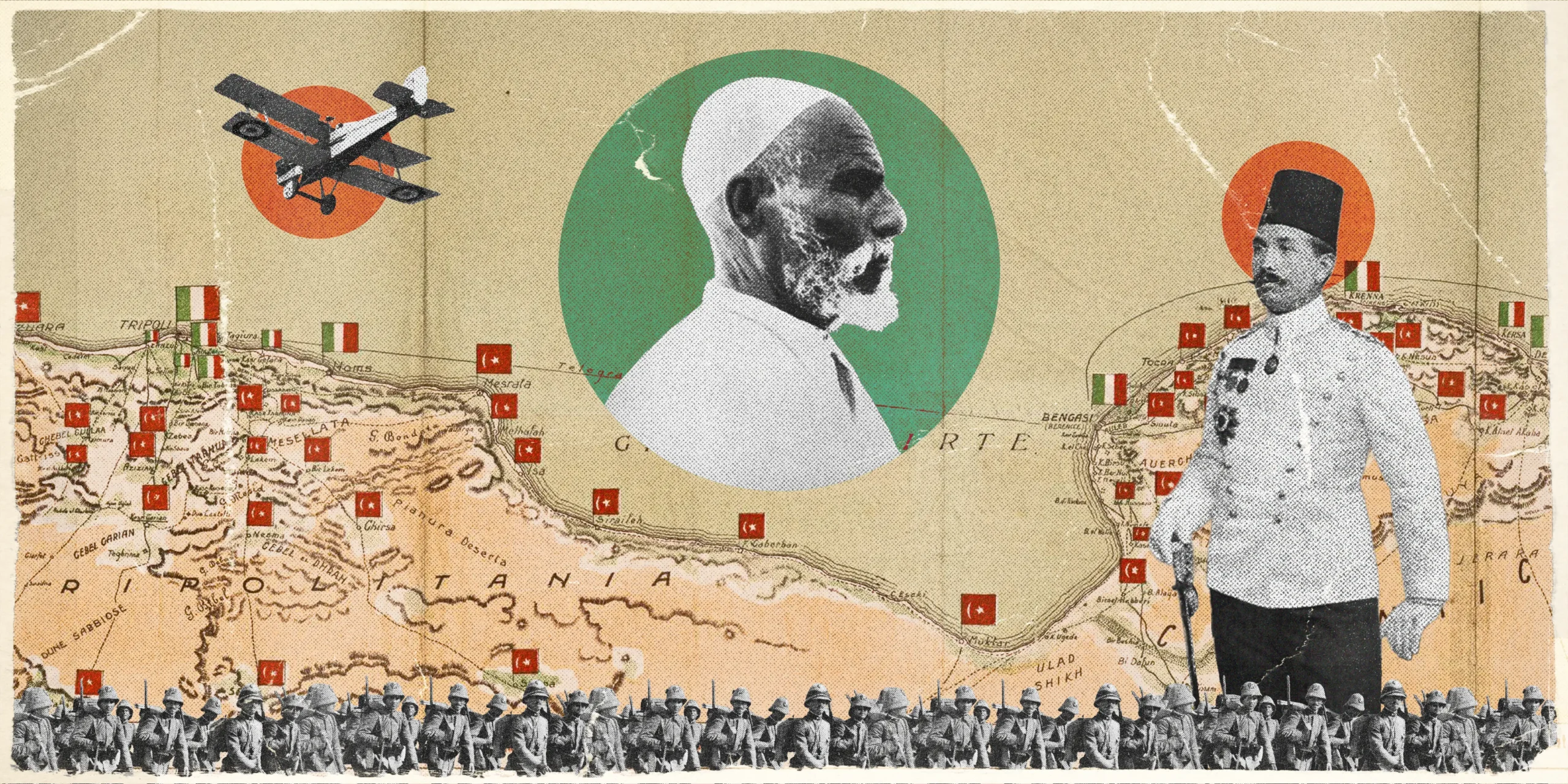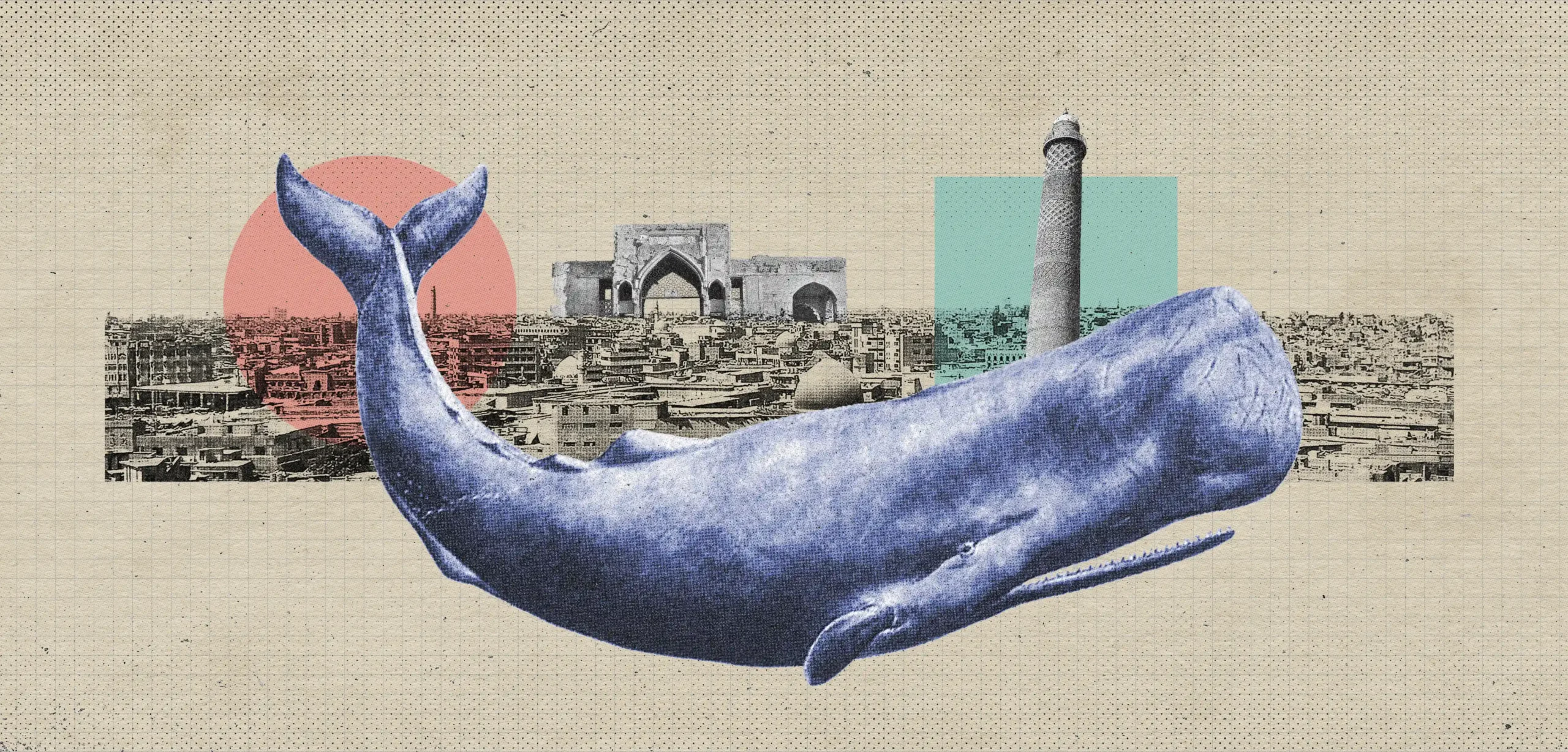صباح يوم عشرين ماي/ مايو الماضي، استيقظ شارع لكسمبورغ على مشهد مختلف، فالواجهة الخشبية لفيلا إيفون أمست رمادًا، غطى سخامه نقائش وزخارف “الآرت ديكو” المزينة لمبنى أمسى رمزًا المهتمين بفنون العمارة والتاريخ، ممن اعتادوا تصويره والوقوف عنده. ففي السنوات الماضية، مثّلت واجهة الفيلا للراجعة لعام 1909، مثالًا نموذجيًا للمعمار الاستعماري الفخم والمهمل، في الآن نفسه. وفي سنة 2021، تدخل المعهد الوطني للتراث، من أجل تصنيف واجهة المبنى كمعلم أثري لا يمكن المساس بها أو تغيير معالمه الجمالية من طرف مالكيها أو غيرهم. وعوض أن يساهم هذا القرار في وضع مشروع عملي لترميم المبنى وحمايته، ضاعف من حالة الجمود والهجران التي آل إليها، لولا أن حريقًا مجهولًا، تدخل من أجل التسريع في انهاء احتضار مبنى، طال أكثر من اللازم. وبذلك التحقت الفيلا بقائمة طويلة من معالم حقبة معمارية، ضاعت دون أن نجد لها في ذاكرتنا أو مشهدنا الثقافي، موضعًا بعد.
تصفية غير مكتملة
لم تعرف مكونات الأحياء الاستعمارية بعد الاستقلال نفس المصير في البداية -ولكن ستتشاركه فيما بعد- كالكنائس والمعالم الدينية، التي ستحظى باهتمام خاص. فالكنائس الكاثوليكية مثلًا، والتي هجرها أغلبية مريديها من المعمرين فرنسيين وإيطاليين ومالطيين عشية الاستقلال، كانت تتطلب حلًا خاصًا. وهو الحل الذي جاءت به اتفاقية “مودوس فيفندي” بين الجمهورية التونسية ودولة الفاتيكان سنة 1964. وقد بتت الاتفاقية في مصير 107 كنيسة منتشرة في المجال، من خلال تسليمها للدولة التونسية مجانًا، مقابل احتفاظ الكنيسة الكاثوليكية بست كنائس فقط للعبادة. ولم يشترط من الجانب الفاتيكاني في هذه المبادلة سوى شرط وحيد مفاده أن هذه المباني لن تستخدم إلا فيما يتوافق مع دورها القديم. غير أن هذا الالتزام، لن ينفذ إلا بشكل أقل من الجزئي. فباستثناء عدد قليل من الكنائس التي حوّلت لمعاهد أو لمتاحف مثل كنيستي القديس أوغسطينوس في النفيضة ونوتردام دو لاغارد في جرجيس، كان مصير جلّ الكنائس متمثلًا في الإهمال أو النسيان وأحيانا الهدم. فكنائس القيروان ومدنين هدمت، وكنائس صفاقس وباجة أشيع أنها ستكون معالم ثقافية، لم تر النور أبدًا، في حين حوّلت أخرى ككنيسة القلب المقدس بتونس لمركز شرطة. ولعل كنيسة العوينة، مثال فريد عايش كل هذه التحولات، فالكنيسة الضخمة، التي كانت ذات يوم فضاءً يستقبل أعدادًا ضخمة من الجاليات الاستعمارية، تحوّلت لقاعة ملاكمة، ثم لشعبة للحزب الدستوري الحاكم، ثم صودرت لصالح الحرس الوطني. وفي النهاية، أضاف لها الصحفي التونسي زياد الهاني، دورًا آخر شغلته قبل الثورة وهو.. “المزبلة”.
في المدن والمناطق السياحية، مثل جزيرة جربة ومنطقة حلق الوادي وشارع الحبيب بورقيبة، حافظت الدولة على كنائسها القديمة، ولم تسع للمس من “حليّها” الديني، طالما أن ذلك يخدم صورة البلد المشرق، وموطن التسامح والتعايش بين الأديان.
عدد الكنائس المحدود، وطابعها -باعتبارها منشآت عمومية- وضعف الجاليات المسيحية الأجنبية وبدرجة أكبر المحلية، سهّل مبكرًا، على دولة الاستقلال مهمة السيطرة على هذه المنشآت وإدماجها في المشهد العمراني الجديد لدولة الاستقلال. ولو أن هذا الإدماج سار في طريقين متناقضين. فبالنسبة لكنائس المناطق السكنية العادية والقرى الفلاحية الاستعمارية السابقة، التي غادرها المعمرون وحلّ محلهم الفلاحون والعمال التونسيون، كانت أولى خطوات دولة الاستقلال، تتمثل في تجريد تلك المباني من صلبانها الخارجية والتخفيف قدر الإمكان من الشحنة الدينية التي تزينها، شحنة لم يخف المعمّرون السابقون رغبتهم في إعلائها أمام السكان “الأهليين المسلمين” والمهزومين، قبل عقود. أما في المدن والمناطق السياحية، مثل جزيرة جربة ومنطقة حلق الوادي وشارع الحبيب بورقيبة، حافظت الدولة على كنائسها القديمة، ولم تسع للمس من “حليّها” الديني، طالما أن ذلك يخدم صورة البلد المشرق، وموطن التسامح والتعايش بين الأديان.
أما بالنسبة للمباني السكنية، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. بداية من الحجم الضخم لهذه المباني، والذي تجاوز عشية الاستقلال 12 ألف مبنى من عمارات وفيلات ودكاكين. وتشتت ملكيتها بين الخواص من مختلف الجنسيات. وضاعف من هذا التعقيد، الإطار القانوني المركب والمشتت بين نصوص ومراحل مختلفة، كان أولها وأشهرها “رخصة الوالي” التي تم تفعيلها سنة 1957، والمتمثلة في طلب الحصول على ترخيص الوالي – أي المحافظ- عند كل عملية بيع عقارية. ونظرًا لصعوبة الحصول على هذا الترخيص، تم التراجع عليه سنة 1977 واقتصر على كل عملية تصرف تشمل عقارًا من أملاك “الأجانب”، هي على ملك ذلك الأجنبي قبل سنة 1956، أي قبل الاستقلال. ولكن هذا النص القانوني، لم يكن كافيًا بدوره، وإنما تطلب الأمر إجراء اتفاقيات ثنائية مع دول هؤلاء الأجانب، بداية من فرنسا سنة 1998، ثم إيطاليا سنة 2000. وهي اتفاقيات سهّلت على مواطني هذه الدول، بيع عقاراتهم التي لازالت ملكهم في تونس، للتونسيين، دون ضرورة الحصول على ترخيص مسبق.
ولكن هذا الإجراء، اصطدم بدوره بقانونين صدرا سنة 1976 و1983، بهدف التصدي لمشكلة الاكتظاظ العقاري وارتفاع أسعار الكراء وهشاشة وضعية المكترين في المدن الكبرى. وذلك من خلال تمكين المكترين، ممن يسكنون عقارات مبنية قبل غرة سنة 1970- وهي غالبًا ما تكون مباني من المرحلة الاستعمارية – الحق في البقاء في تلك العقارات في إطار علاقات كرائية دائمة. أما قانون 1983، فقد كان أكثر صراحة، إذ كان موجهًا مباشرة لأملاك الأجانب، والذي وسّع من نطاق حق البقاء، ليشمل لا فقط حالات الكراء، وإنما يمنحه لكل “شاغل عن حسن نية” من التونسيين لتلك المباني. وأمام تكريس حق البقاء هذا، أصبح التفويت في هذه الأملاك أكثر صعوبة لمالكيها وللمؤسسات التونسية المكلفة باقتنائها مثل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “السنيت”، أمام دخول فاعل جديد هم الحائزون لها لجيل وأكثر. وفي حالات كثيرة، أصبح الجمود والإهمال، هو النتيجة الطبيعية لعقارات خارج التداول. وحتى “السنيت” نفسها، كثيرًا ما عجزت عن التصرف في العقارات والعمارات التي آلت إليها، ففي سنة 2023، أعلنت المؤسسة مثلًا أن حوالي 500 عقار من أملاك الأجانب التي هي على تصرفها مهددة بالسقوط.
عمارة العدو
نشأت الأحياء الأوروبية في فترة مبكرة منذ بدايات القرن التاسع عشر، على تخوم مدينة تونس ذات التخطيط العمراني والسكان العرب والمسلمين. ولو تحرينا الدقة أكثر، لقلنا إنها نشأت في مواجهتها منذ البداية. تحديدًا في منطقة باب البحر، وهي البوابة التي كانت تفتح قديمًا على خلاء فارغ يقود في النهاية نحو البحر. في ساحة هذا الباب، ظهرت نواة المدينة الأوروبية: فنادق للتجار الفرنسيين والإنجليز والطليان، منذ نهايات القرن السابع عشر. ثم تحولت لسفارات ومقاهي وحانات وعمارات ومؤسسات تجارية ضخمة، كوّنت في النهاية حي ضخمًا، تحول بعد 1881 إلى مدينة قائمة الذات.
وبالنسبة للتونسيين، لم تكن فقط مدينة أخرى، ولكن عالمًا آخر مختلف، فما أن يغادر التونسي المسلم ذو الجبة والشاشية الحمراء، أزقة المدينة الضيقة، ويعبر بوابة البحر، آخر بوابة نقشت في أعلاها كتابات بالخط العربي، حتى يجد نفسه وسط شوارع ضخمة، وبناءات ذات طوابق ولافتات مكتوبة باللاتينية، ومقاهي وحانات مكشوفة ترتادها أفخاذ وأذرع نساء مكشوفة أيضًا. وإلى جانبها ترتفع صلبان الكاتدرائية وأمامها أعلام فرنسا “الدولة الحامية”. في هذه الأجواء، لم يكن من السهل للتونسي، أن يحتفظ بإحساسه بالأمان، بل على العكس، إذ سرعان ما يخشى أن تضيع شاشيته وسط زحمة القبعات السوداء، ومعها نفسه. وبذلك تشكل منذ البداية، إحساس بالعداء تجاه باب البحر وما يقع وراءه، من أحياء توسعت وطوقت المدينة العربية من كل جوانبها.
لم يكن الاستقلال قادرًا لوحده على طي صفحة العداء السابق، ولكنه حوّله لحالة من القلق المستمر. صحيح أننا “طردنا” المستعمر، ولكن مبانيه الفخمة والضخمة، مازالت تطوقنا. وبطبيعة الحال، لم يكن من الممكن تدميرها، ولا استنساخ المدينة العربية فوقها. غادر المستعمر
وفي إطار معركة التحرر، تحولت العمارة لفاعل استراتيجي. ومنذ البداية، أحس التونسيون، أن عمارة الاحياء الأوروبية لن تكون لصالحهم أبدا. فمنذ أول مواجهة، وقعت بمناسبة أحداث الجلاز بينهم وبين الجالية الإيطالية سنة 1911، كانت أسطح العمارات الحديثة العالية، مكانًا ملائمًا لقناصة الطليان -وهو ما سيتكرر في معركة بنزرت سنة 1961- وفي مقابل ذلك كانت المظاهرات الوطنية، تنطلق من الأحياء العربية نحو الحي الأوروبي، ذي الشوارع الواسعة والمكشوفة، أين يسهل للفرنسيين تفريقها وملاحقة عناصرها، الذين سرعان ما يتراجعوا نحو متاهة المدينة العتيقة ذات الشوارع الضيقة والمتقاطعة، كما يذكر محمد الأزهر الغربي، في كتابه “تونس رغم الاستعمار” 2013، بتكرار هذا، أمست المدينة العربي بعمرانها، فضاءً يحتمي به التونسيون من ملاحقة الجندرمة، ويحسون داخله بأن وجودهم الثقافي والحضاري آمن، ولم يذب بعد. أما ما يقع خارجه، ففضاء عدواني، تتواطأ مبانيه وشوارعه مع من يقطنها ضدهم.
لم يكن الاستقلال قادرًا لوحده على طي صفحة العداء السابق، ولكنه حوّله لحالة من القلق المستمر. صحيح أننا “طردنا” المستعمر، ولكن مبانيه الفخمة والضخمة، مازالت تطوقنا. وبطبيعة الحال، لم يكن من الممكن تدميرها، ولا استنساخ المدينة العربية فوقها. غادر المستعمر، ولكن تركته العمرانية، بقيت بيننا. وبالفعل عوملت المناطق الأوروبية كتركة، لابد من تقسيمها، بعض الشقق في طوابق عمارات حي لافاييت أو فيلات ميتيال فيل ونوترودام، منحت لمسؤولين وحلفاء تحت عناوين شتى، أو هكذا يشاع. على كل حال، إذ طوي الملف مبكرًا، وقنع كلّ بما ناله من نصيب. أما الفضاء العمراني العام، فقد نال نصيبًا لم يكتمل من استرداد الكرامة والهوية في أبعادها الثلاثة، التونسة كقومية والعروبة كانتماء والإسلام كدين.
فأهم شارع في العاصمة والبلاد، وقلب المدينة الأوروبية، أصبح يحمل اسم الحبيب بورقيبة بعدما كان حاملا لاسم جول فيري، عرّاب الحماية الفرنسية. وشارع قامبطا، ثاني أهم شوارعها، والمسمى على اسم يد فيري اليمنى، فقد منحت تسميته هدية لملك المغرب محمد الخامس. وبالعودة للشارع، الذي أصبح شارع بورقيبة، أزيلت معالم الانتصار السابق، فأزيل تمثال فيري وعُوّض بتمثال للزعيم المنتصر. وتمثال الراهب المسيحي لافيجري بصليبه الضخم، والذي وضع ذات يوم في قلب الطريق المؤدي لباب المدينة العربية، استفزازا للمسلمين التونسيين، فقد أزيل مبكرًا، وعوّض بتمثال للرجل الذي ستتخذه دولة الاستقلال رمزًا ثقافيًا لها: عبد الرحمن بن خلدون، والذي توسط بعمامته وبرنسه التونسي، أكثر بقاع الشارع رمزية، بين كاتدرائية القديس دو بول وسفارة فرنسا.
أما خارج الحبيب بورقيبة، أنشأت الدولة في أواخر الستينات حيًا جديدًا عوضّ جزءا من عشوائيات منطقة الجبل الأحمر، عرف بالحي الإسلامي، كرد على الحي الاستعماري القديم الموجود قبالته والذي لازال لليوم يحمل بين الناس تسميته القديمة “فرانس فيل”. وفي قلب النقطة الفاصلة بين أحياء لافاييت والباساج، المعقل الحيوي للجاليات الأوروبية واليهودية، ارتفع مسجد ضخم على الطراز العثماني، حمل اسم “جامع الفتح”، نفذ من خلال قبته الضخمة والأذان المرتفع من صومعته، إلى ما كان بالأمس فضاءً لا سيادة للتونسيين عليه.
أملاكهم.. فيء لنا
في غالب الأحيان، لم ينظر لمباني ومعالم المرحلة الاستعمارية، إلا من زاوية نفعية بحتة. ولا أدل على ذلك من العبارة القانونية الرسمية “أملاك الأجانب”. إذ لم تطرح المسألة في بعدها الثقافي أو المعماري، ربما بشكل شبه مطلق. وباستثناء معالم محددة، فرضت نفسها مثل المسرح البلدي، أشهر معالم مدينة الاستعمارية، فإن جلّ مباني ما قبل الاستقلال بقي محكومًا بمعطى الظرفية والحاجة الحينية لكل مرحلة، بقطع النظر عن أهمية المعالم وقيمتها المعمارية. ففي بلدة النفيضة مثلًا، البلدة الاستعمارية بامتياز، اختير مبنى ضخم كان بالأمس شاهدا على ازدهار البلدة الفلاحي، ليكون مقرا لعددًا من المنفيين السياسيين المعارضين للنظام سنة 1973، وعلى رأسهم الشيخ العربي العكرمي، أحد عناصر محاولة الانقلاب الفاشلة ضد بورقيبة. أما في بلدة منزل المهيري، أخذت هذه النفعية وجها أكثر إشراقًا، إذ مع توقف عمل خطوط سكة الحديد الاستعمارية الشهيرة لمنطقة الوسط، تم التخلي وهجران محطاتها الشهيرة البيضاء والزرقاء، ذات القرميد الأحمر. قلة من هذه المباني نجت، كمحطة منزل المهيري، التي أصبحت مقرّا لـ “المولودية” فريق كرة القدم المحلي. ثم سرعان ما تحولت لرمز لمحبي النادي وأنصاره، ممن أمسوا يلقبون بأولاد “لنقار” وهي تحريف دارج لعبارة La gare، التسمية الفرنسية لمحطة السكك الحديدية.
إلى جانب الكومسيون، تحولت منطقة كاملة من المباني الأوروبية القريبة والمنسية إلى سوق يعرف بسوق “الخربة”، والذي سيمسي واحدًا من أشهر أسواق السلع الموازية في العاصمة، التي تتدخل الدولة لرفع الانتصاب الفوضوي فيها، ثم يعود لها الباعة من جديد، وهكذا دواليك.
بعيدا عن هذا المثال المشرق، لم تقتصر هذه النفعية على الدولة ومؤسساتها عشية الاستقلال، ولكنها امتدت مع السنوات لتصبح سلوكًا عامًا، في التعامل مع إرث البايات والاستعمار على حدّ السواء. كما هي الحالة بخصوص قصر جينوكو المبني سنة 1832، أحد أفخم المباني الإيطالية في نهج الكومسيون. والذي كان مثالًا على ثراء الجالية الإيطالية المالي والثقافي ونفوذها في إطار الصراع الفرنسي – الإيطالي حول استعمار تونس، وتصاعد الحركة القومية الإيطالية. إذ جعل منه صاحبه ملاذًا لجملة من قيادة الثورة وحركة توحيد إيطاليا، وعلى رأسهم غاريبلدي، أشهر الزعماء الإيطاليين. غير أن قرنًا من الزمان، كان كفيلًا بإنهاء جاذبية الأجزاء الشرقية من الحي الأوروبي، والتي طالما كانت معقلًا للإيطاليين من التجار والحرفيين. فمصانع “فابريكات” الثلج والجيلاتو الإيطالي، التي ملئت شارعًا كاملًا في المنطقة، لازال لليوم يحمل اسمها، فقدت جاذبيتها مع دخول البرّادات الحديثة. ونهج الكمسيون غادره جلّ تجاره الكبار القدامى وعائلاتهم، وعوضا عنهم حلّ تجار المواد البلاستيكية، واللوازم اليومية، والثياب الرخيصة والمقلدة. وهنا، أمست المباني الكولونيالية الفخمة، عالة ومتنافرة مع الحراك الاقتصادي الجديد وروّاده، القادمين في أحيان كثيرة من دواخل البلاد التونسية. لولا أن الأخيرين سرعان ما وجدوا في هذه العمارات العالية، ذات الغرف الواسعة، فضاءً شاسعًا، يوفر عنهم عناء اكتظاظ محلات السوق وضيقها، من أجل تخزين السلع والبضائع. وهو حال قصر جينوكو اليوم، وغيره. وإلى جانب الكومسيون، تحولت منطقة كاملة من المباني الأوروبية القريبة والمنسية إلى سوق يعرف بسوق “الخربة”، والذي سيمسي واحدًا من أشهر أسواق السلع الموازية في العاصمة، التي تتدخل الدولة لرفع الانتصاب الفوضوي فيها، ثم يعود لها الباعة من جديد، وهكذا دواليك.
نسيان متعثر ..
لا يبدو أن كل ما سبق كان كافيًا، على الأقل بالنسبة لشق من التونسيين، ممن اعتبروا أن معركة افتتاك المدينة لم تحسم بعد، طالما لازال في قلب شارع بورقيبة، مركب ضخم، ذو ألوان بنية كالحة، هو مبنى سفارة فرنسا. لليوم، يعتبر هذا المبنى واحدًا من أقدم معالم الشارع وأكثرها غموضًا، إذ بني المركب سنة 1859، من قبل القنصل الشهير ليون روش، ليكون مقرًا لقنصلية أهم قوة أوروبية في المملكة التونسية. ومع فرض الحماية، تحول المبنى، ليكون مقرا للإقامة العامة، أي مبنى الحاكم الفعلي للبلاد – في حين توارى الملك الصوري في قصره البعيد- ومع الاستقلال، تحول المبنى من جديد ليكون مبنى السفارة الفرنسية. وفي حين غادرت أغلب السفارات، وسط المدينة القديم، نحو الضواحي الشمالية، بقيت سفارة فرنسا دون غيرها، ثابتة وراسخة في مبنى حكمها القديم. صحيح أن دولة الاستقلال في حركة رمزية، سمت الشارع المحاذي للسفارة بشارع “جمال عبد الناصر”، وهو اسم لا تحبذه حتما ذائقة المستعمر القديم ولا ورثته، إلا أن بقاء المبنى ذاته، في شارع بورقيبة والذي يوصف بكونه شارع السيادة، بقي مذكيا لنيران الضغائن القديمة.
يبقى العائق الحقيقي، متمثلًا في ذاكرة لم تستسغ بعد هضم هذه المرحلة بشكل سوي، ولا تنظر للعمارة فقط باعتبارها “غنيمة حرب” وإنما باعتبارها كما اختار أستاذ التاريخ والأركيولوجيا نبيل قلالة، عنوانا لكتابه الجديد “تراثًا مشتركًا” يمكن أن يسع الجميع
بعد الثورة، ومع وصول المنصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية، وهو المحسوب على المدّ الثوري، راج خبر مفاده أن الرئيس قرر في حركة سيادة، نقل سفارة فرنسا خارج الشارع، لتلحق بمنطقة البحيرة الشمالية -أين يقع مقر نشاطها الفعلي في مبنى آخر- مما اضطر مؤسسة الرئاسة نفسها للتدخل في مارس 2012، ونشر تكذيب للخبر، في محاولة للتخفيف من الجفاء بينه وبين الشريك الأول للدولة التونسية، قبل أن يزور فرنسا فعلا في الأشهر الموالية.
مسألة مبنى السفارة، ليست سوى مثال للتصور الذي ما زال يحكم علاقتنا بالعمارة والبناء الاستعماري، باعتبارها امتدادًا لمعركتنا مع المستعمر أو من يخلفه. وهذا التسييس المتواصل للعمارة، لم يسمح بالنظر لها من زاوية أخرى: زاوية الثراء الثقافي، إلا فيما ندر. فعلى خارطة التراث العمراني، يقع الاحتفاء بـ”كركوان” باعتبارها نموذجا للعمارة الفينيقية، أو “شنني” للعمارة الأمازيغية، أو القيروان للعمارة العربية الإسلامية وهكذا. في حين تغيب العمارة الاستعمارية من خارطة المسالك السياحية والثقافية. لا يتعلق الأمر هنا بغياب نموذج مادي مثالي للبلدة أو الحي الاستعماري، إذ نجد في الشمال مثلًا مدينة بعثها المستعمر من العدم، وأسسها على تخطيط شطرنجي حديث وصارم، تحت مسمى “فيري فيل” والتي أصبحت بطبيعة الحال بعد الاستقلال “منزل بورقيبة”. ولا يتعلق الأمر أيضا بغياب لنماذج وعينات ومقتنيات، تحول دون تأثيث متحف أو قسم مخصص لعرض ملامح هذه الحقبة من تاريخ التونسيين.
وحتى الإشكالات العقارية، لم تحل دون إنقاذ بعض من هذه المعالم، متى ما منحت المسألة المعمارية والجمالية الحيز الذي تستحق، كما في حالة قصر حبيبة مسيكة، أحد أجمل مباني شارع الحرية الاستعمارية. وبذلك، يبقى العائق الحقيقي، متمثلًا في ذاكرة لم تستسغ بعد هضم هذه المرحلة بشكل سوي، ولا تنظر للعمارة فقط باعتبارها “غنيمة حرب” وإنما باعتبارها كما اختار أستاذ التاريخ والأركيولوجيا نبيل قلالة، عنوانا لكتابه الجديد “تراثًا مشتركًا” يمكن أن يسع الجميع ويتطلب من أجل تثمينه تدخل من الجميع، يتجاوز احتكار الدولة وحدها لرعاية المشهد المعماري والأثري والتاريخي للمجال والسردية المبنية حوله، بقدر ما يشارك في صياغته الجميع: المؤسسات والمجتمع المدني، والأفراد. نفس الأفراد، الذين لازالوا لليوم يحتجون ضد دولة الاستقلال في نفس الأماكن والفضاءات التي أسسها المستعمر، واحتج فيها أجدادهم من بناة هذه الدولة، ضده. واستعادة الفضاء الاستعماري للاحتجاج في تونس ما بعد الثورة، كتب عنها ذات يوم، الباحث العمراني الفرنسي روميو كارابلّي: “ربما علينا أن نتجاوز مرحلة ما بعد الاستعمار، إلى ما بعد بعد الاستعمار” لعلّ ذلك يمنحنا إمكانية لإعادة تحديث المشاكل والتحديات الحقيقية من جهة، ويفتح أعيننا على رؤية “الجميل” في الفضاء.