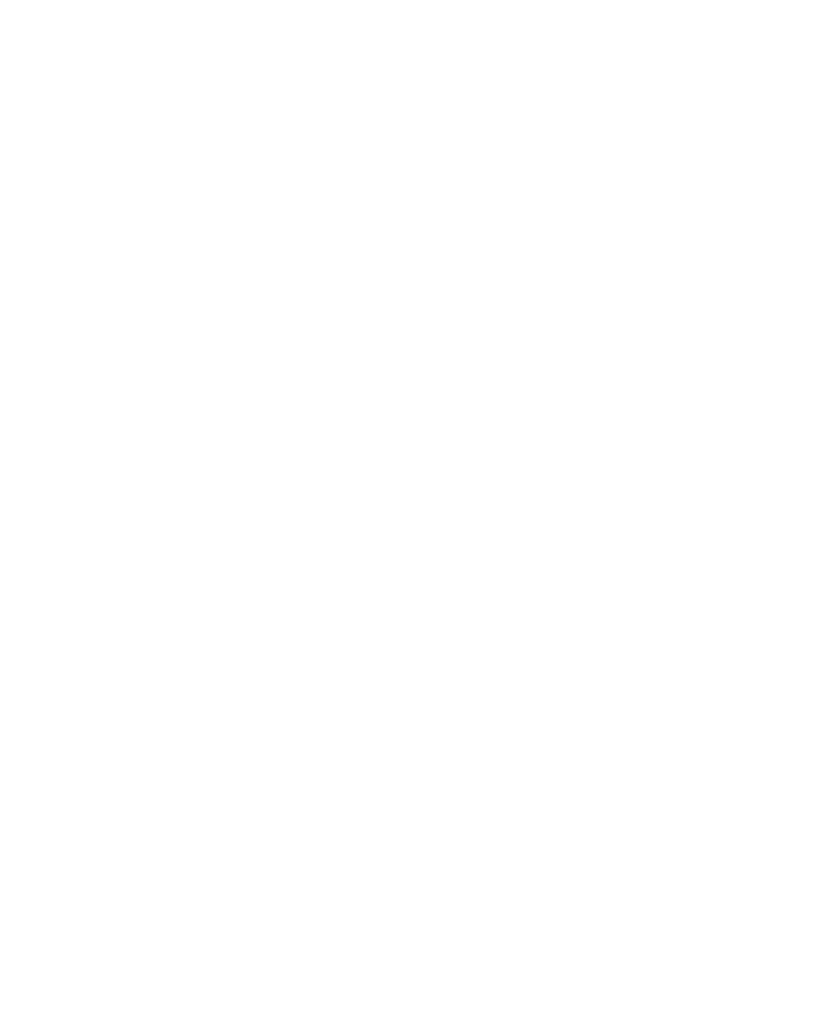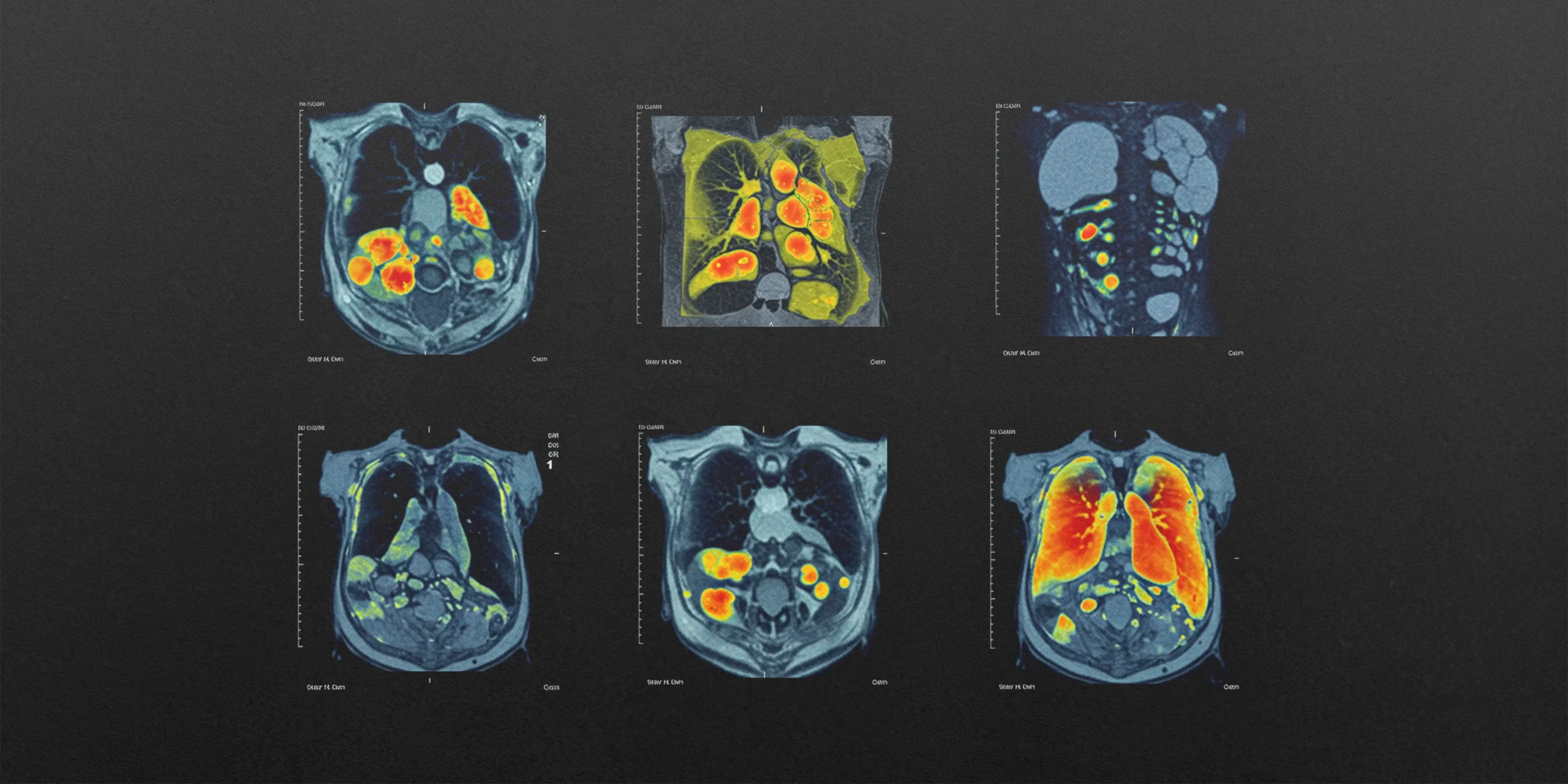في غزّة، صارت الولادة حدثًا استثنائيًا أمام الإبادة الإنجابية التي شنّتها إسرائيل، فيما مُنعت لبنانيّات من الوصول إلى الرعاية الصحيّة في حروب لبنان الكثيرة. تحارب النساء الحوامل وحدهنّ للبقاء على قيد الحياة وإنقاذ الأجنّة، وتظلّ آلامهنّ ملكًا لأجسادهنّ التي تصادرها سياسات الاحتلال الديموغرافيّة على قاعدة أنّ من يفرّ حيًّا من الرحم ليس عليه أن ينجو في الحياة لاحقًا.
تضيق المساحة للتعبير عن الآلام وسط الأمتار القليلة المتبقيّة من الحياة. وحين استمعنا إلى تجارب بعض النساء بألسنتهنّ، خلال رحلات تهجيرهنّ، حكين عن الهواجس الصغيرة، وعن غياب الرعاية الصحية، وعن رعبهن من الهزّات المتتالية للأرض التي سيحضرن إليها أبنائهن. بينما للحرب كلمة أخرى، تقولها بحزم: هذا الجسد ليس جسدًا، وهذا الطفل ليس طفلًا وهذه الرحم ليست رحمًا… تحت القصف، تتجرّد الولادة من بعدها الفردي والخاص، فتصبح تجربة سياسيّة خالصة تتعامل مع رحم المرأة على أنّها خزّان لتهديدات مستقبليّة.
في متجرٍ مهجور
عاشت فاطمة مع أبنائها الأربعة في متجرٍ مهجور خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. قصّة المرأة تختصر واقع النساء الحوامل في مراكز الإيواء في كل أنحاء البلاد. بداية نزوحها لا تختلف كثيراً عن بدايات قصص النزوح الأخرى، والتي تبدأ بمغادرة البيت: “خرجتُ من منزلي في الشياح إلى منطقة العازارية حيث أعطونا غُرفة هي عبارة عن متجرٍ فارغ لا يوجد فيه حمّام”. وبعد أيّامٍ من نزوحها، علمت أنّ منزلها في منطقة الشيّاح دُمّر بالكامل، لهذا “كان عليّ البقاء في العازارية بعد انتهاء الحرب، إلى حين تأمين مكانٍ بديل للمكوث فيه”.
تشكو فاطمة، التي كانت حاملًا في شهرها السابع، من أنّها لم تتلقّ إلّا مساعدات غذائية محدودة، وبعض فرش النوم، أمّا على الصعيد الصحّي فلم تخضع لمتابعة طبيّة أو إجراءات روتينية للاطمئنان على صحّتها أو صحّة جنينها. “تواصلت مع طبيبتي وأعلمتها أنّي بحاجة لكشفٍ طبّي لكنّي غير قادرة على دفع كلفته، فلم تجبني”، مضيفة “لم نر أي مُساعدة خاصّة بالنساء الحوامل، حتّى أنّي حُرمت من الدخول إلى الحمام. كان الحمام الأقرب إلي يقع في الطابق العلوي، بينما أحتاج لدخوله اكلّ ساعتين، وفي إحدى المرّات، لم أتمكن من الوصول إلى الحمام فبللت نفسي”.
ما تعيشه المرأة الحامل في ظروفٍ كهذه يبدو مضاعفًا، ففاطمة التي لا تتحمّل صوت القصف، فقدت الوعي أكثر من مرّة عندما سمعت صوت القصف الذي كان يدوّي في كلّ أنحاء العاصمة.. “ماذا كان يُمكن أن يفعلوا لي في ظروفٍ كهذه أكثر من محاولة إيقاظي؟ خصوصًا أنه لا يُمكنني الوصول إلى المستشفى ولا أملك المال للذهاب إلى عيادة الطبيبة”.
في الحرب الإسرائيلية على لبنان، عاشت 11 ألف إمرأة حامل تحت مخاطر الحرب (وفقًا لتقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 13 تشرين الثاني 2024). وتُجمع نساء عدّة على أنّ التسهيلات الحكومية للنساء الحوامل كانت محدودة، إذ أمنّت وزارة الصحّة تغطية كلفة الولادة في المستشفيات الحكومية بقيمة 80٪، وبقيمة 60% في المستشفيات الخاصّة. ولم تشمل خدمات وزارة الصحّة صور الأشعة والأدوية والكشف الطبّي الدوري والفحوصات التي تحتاجها النساء الحوامل، ما يعني أنّ اللواتي ينتمين إلى طبقات فقيرة أو متواضعة، لم يخضعن للمتابعة الطبية الروتينية التي يحتجنها في الأيّام العاديّة. تُضاف إلى هذه الظروف الصحية المجحفة، نوبات القلق التي كنّ يعانين منها. أدّى هذا الإهمال إلى الولادات المبكرة، وارتفاع نسبة الإجهاض كما نقل أحد الأطباء في مستشفى رزق في بيروت، خلال شهري الحرب في لبنان، معزيًا السبب إلى حصول التهابات وتشوّهات نادرة لدى الجنين بسبب عدم خضوع النساء للمتابعة الطبيّة.
حملٌ بحربٍ سابقة
عندما علمت بحملها في أحد أيام شهر أيار 2024، فاضت مشاعر ليلى (اسم مستعار) المتناقضة، وتصدّرها القلق: “عشنا حربًا لا تهدأ، وراحت الأحداث تنذر بتوسّع رقعة الحرب أكثر، فيما كنت بعيدة عن منزلي، ولم أعلم إن كنت سأعود إليه مجدّدًا”، تقول ليلى (36 عامًا) الأمّ لطفلين، مضيفة أنّ مشاعر الخوف طغت على كل شيء آخر، وبدأت الأسئلة تلاحقها حتى أصبح ذهنها لا يهدأ.
أعادت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبناني ليلى إلى حروب الماضي وإلى حملٍ سابق هو حمل والدتها التي أجهضت بسبب الصدمة التي تلقّتها خلال عملية “عناقيد الغضب” في 1996، عندما ارتكبت إسرائيل مجزرة في بلدة قانا الجنوبية
كان القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية يشتدّ بعدما أعلن حزب الله لـ “جبهة إسناد” قطاع غزّة منذ 2023. حينها قررت ليلى وزوجها وطفلاهما النزوح من منزلهم في قرية حولا بجنوب لبنان إلى بعلبك حيث مكثت شهرًآ واحدًآ، ليبدأ بعدها فصل من النزوح المستمر، مترافقًا مع الأفكار القلقة، كما تُضيف ليلى: “لم أستطع سوى التفكير في السيناريوهات السلبية، حاولت جاهدة أن أخفي مشاعري أمام طفلي، لكنني أبدأ بالبكاء المفاجئ، ولا أستطيع التوقف. ثمّ تتسارع نبضات قلبي وقدماي تعجزان عن حملي”.
أعادت الحرب الأخيرة ليلى إلى حروب الماضي وإلى حملٍ سابق هو حمل والدتها التي أجهضت بسبب الصدمة التي تلقّتها خلال عملية “عناقيد الغضب” في 1996، عندما ارتكبت إسرائيل مجزرة في بلدة قانا الجنوبية. تلك اللحظة كانت دائمًا حاضرة في ذهنها، وطاردتها حين حملت هي نفسها خلال الحرب عام 2024، ليبدأ الخوف يتغلغل في كيانها، ليس خوفًا من فقدان الجنين فحسب، بل أيضًآ القلق من أن تُنجب في ظروف ليست مستقرّة، والشعور بالغربة في بيئة انتقلت لتعيش فيها ولا تعرفها. تقول ليلى: “لو كنت لا أزال عزباء، لما شعرت بكل هذا الخوف.” ورغم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، فإنّ ما زرعته الحرب من الصعب التخلص منه، فتؤكّد أنّ “القلق من المستقبل يلازمني، لم أعد أشعر بالأمان، وأخشى من ما يحمله المستقبل لي ولأولادي“.
ولادة وراء الحدود
تنتقل قصص الأجساد عبر الأجيال في مناطق الحروب، ومعها تنبعث مخاوف تتعلّق بإمكانية البقاء على قيد الحياة. في لبنان، وجنوبه تحديداً الذي بقي محتلًّا حتى عام 2000، استفاقت بعض القصص والذكريات خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلاد. لم تستطع سامية (72 عامًا وأُم لخمسة بنات) تفادي ذكرى أعادتها إلى العام 1984. كان ذلك بعد مرور عامين على اجتياح إسرائيل لبنان، حين كانت تستعد لولادة طفلتها الأولى في قرية حولا الواقعة على الحدود مع فلسطين المحتلة. تسترجع المرأة تلك الأيام قائلة: “كانت إسرائيل قد احتلّت المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأغلقت جميع المعابر المؤدية إلى خارج الجنوب”.
لم يكن هناك أي مستشفى في المنطقة المحتلة، وكان الخروج يتطلّب تصريحًا من دولة الاحتلال والانتظار لساعات طويلة على الحواجز، مع ارتفاع احتمالات رفض العبور حتى مع وجود التصريح”. فرضت هذه التعقيدات خيارات صعبة على سامية: إمّا المغامرة بمحاولة العبور إلى خارج قرى الليطاني باتجاه العاصمة، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على الجنين، خاصة عند حلول ساعة الولادة، أو الولادة في المنزل بمساعدة الداية التي لم يكن حضورها مؤكّدًا حينها.
أما من جهة الجنوب، فكان يمكنها التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو بلدة صفد، التي تبعد ساعة واحدة فقط عن الحدود اللبنانية، حيث كانت إسرائيل لا تزال تسمح بعبور الجنوبيين للاستشفاء في فلسطين المحتلة.
عندما حانت لحظة الولادة، وقعت سامية على الخيار الأخير، فتقول: “أوصلني زوجي ووالدتي إلى الحدود، ومن هناك استقلّيت مع والدتي سيارة أجرة إلى صفد“، مضيفة: “شعرت بالخوف، فما أعرفه عن إسرائيل أنّها تقتل الناس“. في مستشفى صفد، استقبلتها ممرضات فلسطينيات وقدمن لها الرعاية اللازمة، وبعد الولادة “أصبت بمرض واضطررت للبقاء في المستشفى ستة أيام. في اليوم الرابع، تركتني والدتي وعادت إلى القرية لرعاية إخوتي الصغار والاهتمام بالأرض“. بقيت سامية وحدها لمدة يومين، حتى شُفيت وسمح لها الأطباء بالخروج. “ساعدتني الممرضات على الخروج من المستشفى، وطلبن لي سيارة أجرة. حملت طفلتي على صدري وعدت وحدي“، تتابع: “أوصلتني السيارة إلى الحدود، وهناك التقيت بعائلة من بلدة بليدة. عرضوا عليّ مساعدتي، وأوصلوني إلى منزلي“. كانت تلك المرّة الأولى والوحيدة التي تطأ فيها سامية أرض فلسطين، وقد تركت المشاهد في ذاكرتها أثرًا عميقًا. تقول: “المستشفى كان يقع على تلّة، تطل تحتها على سهل فسيح، وفي التلّة المقابلة رأيت مستعمرة إسرائيلية تمتد على أراضٍ فلسطينية. وبحسب ما علمت به أنّ “المنطقة كانت خالية من سكانها الأصليين، بينما كان يعبر موظفي المستشفى الذي تُديره سلطة الاحتلال، من مناطق الجولان“.
لا أسرّة للمواليد الجدد
تختصر قصّة سامية انعدام الحدود بين لبنان وفلسطين لولا وجود الاحتلال، وتجسّد كذلك مصائر النساء الحوامل في البلدين في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي. غير أنّ غزّة وتجربتها المريرة مع الإبادة الجماعية تبقى النموذج الأكثر قسوة لآلام النساء الحوامل. أمام الحصار الإسرائيلي، دخلت النساء مخاض الولادة في ظروفٍ قاسية لا يتوفّر فيها أيّ شكلٍ من أشكال التخدير، أكانت الولادة طبيعية أو قيصرية. ألم الولادة الجسدي أصبح مضاعفًا عند النساء المصابات أو ذوات الإعاقة نتيجة الحرب، أو اللواتي يعانين من حالات صحية تجعل الولادة تهديدًا خطيرًا على حيواتهنّ وحيوات أطفالهنّ، من دون تخفيض الألم. في ظلّ هذه الظروف، تضطرّ النساء إلى تحمّل أوجاعٍ تفوق الوصف، تتداخل فيها الآلام الناتجة عن المخاض مع تلك الناجمة عن إصابات سابقة أو مضاعفات الحمل. نقص المواد الطبية جعل فترة ما بعد الولادة محفوفة بالمخاطر بسبب غياب المضادات الحيوية والعناية الطبية اللازمة. وبهذا، تتحوّل كافة الولادات في ظروفٍ كهذه إلى معارك للبقاء على قيد الحياة. وحين يمتزج الألم الجسدي مع الضغوط النفسية الهائلة، تصبح كلّ ولادة شهادة حية على حجم المعاناة التي تُواجهها النساء في مناطق النزاع.
في حالات كثيرة، اضطرّ الأطباء في غزّة إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياة الأم، دون القدرة على تحديد السبب الحقيقي للنزيف، والذي قد يكون مرتبطًا بمشاكل أخرى مثل الأورام
هذه المعاناة، إضافة إلى تحديّات أُخرى واجهتها النساء الحوامل في غزّة، شهدتها الطبيبة النسائية الأردنية أسيل الجلّاد التي عادت من القطاع بعد شهر أمضته متطوّعة مع “الهيئة الطبية الدولية”. وكشفت في مقابلةٍ مع “بودكاست مدد” على يوتيوب، عن انعدام سبل الوصول للطبابة والغذاء في ظل المجاعة التي ارتكبتها إسرائيل عبر حصارها غزّة لـ 15 شهرًا، ما يضع النساء الحوامل أمام خطر مُضاعفات الحمل والولادة التي تؤدي إلى الموت في بعض الحالات. وأشارت الجلّاد إلى أنّ النزيف بعد الولادة كان أحد التحديات الرئيسية للأطباء في غزّة نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية الأساسية لمنع النزيف أو علاجه. وفي حالات كثيرة، اضطرّ الأطباء إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياة الأم، دون القدرة على تحديد السبب الحقيقي للنزيف، والذي قد يكون مرتبطًا بمشاكل أخرى مثل الأورام. وأوضحت أن أعداد الولادات اليومية كانت بالعشرات في حين أن أسرّة الولادة محدودة جدًا، ما اضطر الأطباء لتوليد النساء على بطانيات مفروشة على الأرض. وبعد الولادة، اضطرت النساء إلى النوم في أروقة المستشفى أو العودة إلى الخيم المزدحمة.
ورغم تلك الظروف القاسية، تحدثت الطبيبة عن إصرار نساء عدّة على الاستمرار في الإنجاب. كان بعضهنّ يسألنها بعد الولادة مباشرة عن إمكانية الحمل مجددًا، رغم المعاناة الجسدية والنفسية التي يواجهنها، وهذا ما يدلّ، وفق الجلّاد، على تمسّك الفلسطينيات بالأمل والاستمرار. وهنا تستذكر ما أخبرتها إيّاه إحدى النساء الفلسطينياتي عن أنّ إنجابها المزيد من الأطفال، هو طريقتها للتعبير عن الصمود ونقل قضية أهالي غزّة إلى الأجيال القادمة، لتعويض الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب.
تسييس الأرحام
بنسفها موارد الحياة كافّة، تندرج الحروب ضمن ما يُطلق عليه “الإبادة الإنجابيّة” (Reprocide)، الذي صاغته الأكاديمية النسوية الأفرو – أميركية لوريتا روس، للإشارة إلى التقييدات الإنجابية التي تمارسها الأنظمة والسياسات البنيوية على الجماعات المهمّشة والأقليّات. تمثّلت هذه السياسات لفترة طويلة في الممارسات الطبية الأميركية بحقّ النساء السوداوات اللواتي كنّ يخضعن، دون موافقتهن، إلى عمليات تعقيم تمنعهنّ من الإنجاب خلال القرن الماضي، للحدّ من الديموغرافيا الأفريقية في أميركا.
طبّقت الأكاديمية الفلسطينية هلا شومان مصطلح “الإبادة الإنجابية” على معاناة نساء غزّة خلال الحرب، في محاضرة استعادت فيها تاريخ سياسات الولادة في فلسطين تحت الاستعمار الإسرائيلي. قضى الاحتلال الإسرائيلي في غزّة على كلّ موارد الحياة من الطعام والكهرباء والماء والطبابة، وصولًا إلى الاستهداف المباشر للأجساد، خصوصًا أجساد النساء. فقد بلغ موت الأمّهات في القطاع المحاصر 37 حالة وفاة يوميًّا وفق إحصاءات أصدرتها الأمم المتّحدة في أيّار (مايو) 2024، وارتفعت حالات الإجهاض بنسبة 300% بسبب الصدمات والخوف والضغوطات النفسية. وهنا تبلغ المعاناة ذروة الإبادة الإنجابية التي، إن كان لا بدّ من اختصارها بمشهدٍ واحد، فستكون لقطات لأطفال خدّج يواجهون الموت وحدهم بعدما قُطعت الكهرباء عن مستشفى الشفاء في تشرين الثاني (نوفبر) 2023.
فظائع القطاع المحاصر، لم تكن إلّا تكثيفًا للتقييد الذي تخضع له النساء في ظلّ السياسات الاستيطانية القاتلة كما فلسطين وفي السياقات الاستعمارية الأخرى حول العالم.
هنا، تفرغ الولادة، بوصفها تجربة شخصيّة خالصة، من بعدها العائلي والفردي. تصبح السيطرة على أجساد النساء وقدراتهن الإنجابية تطبيقًا للتخيّلات العرقية القومية وللسياسات الإقصائية. ثمّة مصادرة إذًا للأرحام، وهي مصادرة سياسية إقصائية تشير إليها الباحثة النسوية الفلسطينية نادرة شلهوب كيفوركيان، في دراستها “سياسات الولادة وعلاقات العنف الحميمة ضدّ المرأة الفلسطينية في القدس الشرقيّة المحتلّة” (2015). تستولي هذه المشاريع العرقية القومية على الأمومة، فتقلّص حضور المرأة أوّلًا إلى رحم، ما يبرّر التخلّص منهنّ واستهدافهنّ بكافّة الوسائل. ففي السياق الفلسطيني الإسرائيلي، تشير كيفوركيان إلى “أنّ الأطر القومية للإنجاب، تتعامل مع أجساد النساء على أنّها أوعية للنمو السكاني التي يجب السيطرة عليها. وهنا يواجه الاحتلال رحم المرأة الفلسطينية كسلاحٍ يجب تقليصه”. وهذه خطوات تندرج ضمن السيطرة الديموغرافيّة التي تعدّ جزءًا أساسيًّا من السياسات البيولوجية للاحتلال في فلسطين، والتي تقتضي إنتاج قوانين وسياسات تؤدّي إلى “تهجير قانوني واقتلاع ومحو مجتمعاتٍ بأكملها”. وبالتالي، فإنّ أجساد النساء الفلسطينيات أثناء ولادتهن “تعدّ مواقع بالغة الأهمية لقراءة ممارسات المراقبة البيوسياسية وبالتالي إلقاء الضوء على عنف الدولة الاستعمارية”، وفق كيفوركيان.
تستولي المشاريع الاستعمارية العرقية والقومية على الأمومة، فتقلّص حضور النساء أوّلًا إلى أرحام، ما يبرّر التخلّص منهنّ واستهدافهنّ بكافّة الوسائل
بدورها ترجع الباحثة الهنديّة سانشيتا آغاروال انتهاك الأرحام الفلسطينية إلى المبادئ الأولى للصهيونية في ورقتها البحثية “العدالة الإنجابية في فلسطين المحتلة: السياسات والتجارب البيو – سياسيّة” (2022). ما يحصل من استهداف للنساء والأمهات الفلسطينيات منذ عقود، هو، بتعبير آغاروال، تطبيق للمبادئ الصهيونية المتمثّلة في منح اليهود كفئةٍ عرقية ودينية في الأراضي المحتلّة كافّة الامتيازات على حساب الجماعات الأخرى. انتهاك أمان الولادات يعدّ الخطوة الأولى للسيطرة على الديموغرافيا الفلسطينية على قاعدة أنّ من ينجو من الرحم، لن ينجو في الحياة. يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذه المعادلة يوميّاً على الفلسطينيين الذين يتمّ استهدافهم مباشرة بكافّة الأسلحة. ويتمثّل هذا الاستهداف الممنهج للولادات في النظام الصحي للاحتلال الذي يميّز بين أجساد النساء الفلسطينيات وإسرائيليات، فتفتقر النساء الفلسطينيات إلى المخصصات المالية أو إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحيّة، والتأمين الطبي. يستهدف النظام الصحي في الأراضي المحتلّة الدم الفلسطيني حصرًا، إن لم يكن عبر القتل المباشر، فمن خلال حرمان النساء من مقوّمات الصحة الإنجابيّة.
أجنّة غزّة بلا نَفَس
تأتي رواية رويدة وليد النزلي، 29 عامًا، لتختصر واقع النساء الحوامل في غزّة خلال الحرب، والتي نقلها تقرير أعدّه “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” في شهر آذار 2024 بعنوان “إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع الإنجاب في قطاع غزّة“. تجربة رويدة المأساوية بدأت في 8 أكتوبر 2023، يومًا واحدًا بعد عملية “طوفان الأقصى” حين تعرض المبنى الذي تسكن فيه للقصف من قبل جيش الاحتلال. كانت المرأة في الشهر السادس من حملها، وحينها بدأت تهرول من الطابق السابع حتّى انهار بالكامل خلفها بعد خروجها بلحظات. أثناء فرارها، انفتح جرح العملية القيصرية السابقة وبدأت تنزف، لكنها لم تتمكّن من الوصول إلى المستشفى بسبب القصف المتواصل. بعد قضاء ليلةٍ في “فندق المشتل”، تناولت خلالها المسكنات للسيطرة على ألمها، اضطرت للمشي لمدة ساعتين حتى وصلت إلى “مستشفى الشفاء” التي كانت مليئة بالأجساد المصابة. اضطرّ الأطباء إلى التعامل مع جرحها بسرعةٍ دون تقديم الرعاية اللازمة، فقد كانت الأولوية للمصابين الأشدّ خطراً. ومع تفاقم وضعها، اتُخذ القرار بإجراء ولادة مبكرة في عيادة الصحابة في 10 كانون الثاني (يناير) 2024. في ذلك اليوم، خضعت لعمليّة ولادة قيصريّة، وجاء طفلها وليد، الذي ولد برئة غير مكتملة، فذهب به والده إلى حّضانة مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. تتُابع “بعد ثلاثة أيام من الـولادة أخبرتنا المستشفى أنّ التيار الكهربائي قد قطـع بسبب القصف الشديد في محيطها ممّا أدّى إلى انقطاع الأوكسيجين عن طفلي ووفاته بعمر الثمانية أيّام.
وفقًا لتقرير أجراه “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” العام الماضي، بعنوان “إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع الإنجاب في قطاع غزّة“، عاشت أكثر من 50,000 امرأة حامل في مراكز الإيواء، بينما افتقرن للغذاء والرعاية الصحية المناسبة. حوالي 5,000 منهن في الشهر الأخير من حملهن، مع أكثر من 180 ولادة يوميًا. يقدّر التقرير أن 15% من النساء عانين من مضاعفات في الحمل و احتجن إلى رعايةٍ طبية لم تكن متوافرة. ويؤكّد التقرير أنّ الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحقّ المدنيين، تُضاعف من “معاناة النساء الحوامل بشكل خاص وتجعل الكثير منهن في سباق مع الموت. إذ يعانين من انعدام الحماية من الهجمات العسكرية، وتطالهن هذه الهجمات بشـكلٍ مباشـر إمّا بالقتل أو الإصابة أو استنشاق غازات سامة، وتعرضهن لأضرارٍ نفسية وجسدية جسيمة ناجمة عن الخـوف والقلق الشديدين وانعدام الحماية. كذلك تتضاعف مخاطر الحمل نتيجة ضعف الخدمات الصحية المقدمة وصعوبة الوصول الآمن إليها، بالإضافة إلى تقييد إمكانيـة الحصول على الغـذاء المناسـب، و فرض ظروف معيشيّة صعبة“.
“رصاصة واحدة تقتل اثنين”
آلام الولادة ليست “مقدّسة” كما يصوّرها البعض، إنّما هي تجربة قاسية تستحقّ كل امرأة خيار تخفيفها إذا أرادت. إحدى النساء وهي أم لثلاثة أطفال، اختصرت الآلام بقولها “ألم الولادة الطبيعية أشبه بنزع قلبك من صدرك. رغم أنني اخترت إبرة تخفيف الألم في كل مرة، فإن الألم لم يتلاشَ بالكامل”. بينما تروي امرأة أخرى أنجبت بعملية قيصرية: “الألم الذي شعرت به بعد الجراحة كان لا يُحتمل. وكل مرة كنت أسعل، كان الجرح كأنّه يتمزق من جديد”.
من الحمل الأوّل إلى ما بعد الولادة، تمرّ النساء بأوجاعٍ لا تُحصى: التهابات الكلى والمثانة، الإرهاق الشديد، التورم، والزلال. مع ذلك، تبقى هذه التجارب الفردية أسهل مقارنة بما تعيشه النساء في غزّة أو في الحالات التي يصل فيها التمييز إلى أسرّة المستشفيات.
تطمس الهموم القومية هذه الآلام، حيث لا مجال للمعاناة الفردية. بعد عام على الإبادة، اقتحمت مجموعة من الناشطين “الغاليري الوطنية” في لندن، وغطّوا لوحة بيكاسو “الأمومة” بصورة لامرأة فلسطينية وطفلها المضرّجين بالدمّ من قطاع غزّة. بعض المحتجّين كانوا من العاملين في القطاع الصحّي في بريطانيا، وأرادوا استنكار استهداف المستشفيات وتدمير أي سبيل للعلاج والطبابة في القطاع. ففي الوقت الذي يُحتفى فيه بتقدّم الطب الحديث وابتكارات تخفيف آلام الولادة، يظلّ الألم خيارًا إجباريًا للنساء في مناطق الحروب.
في اللوحات الفلسطينية خلال القرن الماضي، تكبر بطن المرأة الحامل لتتسع للأمّة أو الأرض الفلسطينية بأكملها، وتصبح أحيانًا مرادفًا لهما كما في أعمال الفنان سليمان منصور ورسومات ناجي العلي
في هذا الاحتجاج لم تعد لوحة بيكاسو هي اللوحة التي رسمها الفنان الإسباني عام 1901 لامرأة تحمل طفلها، ولم تعد كذلك صورة الأمّ الفلسطينية وطفلها من قطاع غزة. شهدت الصورتان صراعًا رمزيًّا بين وجهي العالم خلال الإبادة.
الأمومة وجسد المرأة نفسه يواجهان هذا التأويل الذي يحمّلهما العديد من المعاني بيما يتجاوز الإطار الجسدي، وتحديدًا جسم المرأة الفلسطينية الحامل، كما تشرح الباحثة والنسوية الفلسطينية روضة كناعنة في كتابها المرجعي «توليد الأمة: استراتيجيات النساء الفلسطينيات في إسرائيل» (2002). تُرى النساء من كلّ الأطراف على أنّهن المسؤولات عن زيادة حجم “الأمّة”، ومن هنا تستعيد كناعنة بيانات القيادة الوطنيّة الموحّدة للانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987) التي خاطبت فيها النساء، وتحديدًا أمّهات الأسرى والشهداء. تتوقّف الباحثة الفلسطينية عند الخطابات الوطنية التي تسيّس الإنجاب الفلسطيني، يقابلها، في الجانب الآخر، الفكر الصهيوني الذي يسيّس هذه الولادات أيضًا. كلّ هذا يحدث بعيدًا عن الهواجس والرغبات الصغيرة للنساء في الإنجاب أو عدمه، إذ تشير كناعنة إلى أنّ عوامل فرديّة هي التي قد تحدّد دوافع الإنجاب، منها العوامل الاقتصادية والعاطفية والاجتماعية وصولًا إلى أبسطها وهو نسيان تناول حبّة منع الحمل.
في اللوحات الفلسطينية خلال القرن الماضي، تكبر بطن المرأة الحامل لتتسع للأمّة أو الأرض الفلسطينية بأكملها، وتصبح أحيانًا مرادفًا لهما. في عدد من لوحات الفنان الفلسطيني سليمان منصور، تبدو المرأة هي الأرض الأمّ، حين تحتضن شجرة الزيتون وتتمسّك بها كأنّما تمنع اقتلاعها، وحين تضمّ في بطنها مدينة القدس. وفي لوحته ”الانتفاضة.. الأم” (1988)، يخرج حشد فلسطيني غاضب من فرج امرأة تباعد قدميها مثل إيماءة المرأة أثناء الولادة. يستعير منصور صورة الولادة لتمثيل الانتفاضة وتدفّقها بصريًّا.. إنّها المستقبل بجيل جديد من المقاتلين الفلسطينيين. هذا ما تمثّله صورة الامرأة الحامل الواقفة في إحدى رسومات الفنان ناجي العلي أيضًا. ويبدو من الصورة المعلّقة على الجدار خلفها أنّها زوجة شهيد، بينما يتسمّر قبالتها جندي إسرائيلي يبدو عليه الرعب من حملها أو من مستقبل هذا الحمل الذي قد يأتي ربّما بفدائيّ آخر. على خلفية الرسمة كرّر العلي كتابة كلمة صبرًا، بمعنييها: الصبر، ومجزرة مخيّمي صبرا وشاتيلا في بيروت سنة 1982، والتي ينقل بعض الناجين منها أنّ المقاتلين بقروا بطون النساء وأخرجوا منها الأجنّة. كان ذلك قبل أن يتطور القتل وبنادق القنص، ويصبح رسمة “كاريكاتورية” مطبوعة على قمصان سوداء ارتداها الجنود الإسرائيليون عام 2009. تُظهر الرسمة امرأة حامل منقّبة (تشير إلى المرأة الفلسطينية!)، لكنّها تقف في مرمى القناص، فيما كتبت تحتها عبارة “رصاصة واحدة تقتل اثنين“، ليس مهمًّا إن كانا أمًّا وطفلها، المهمّ أنّهما من “الأمّة” الفلسطينية.