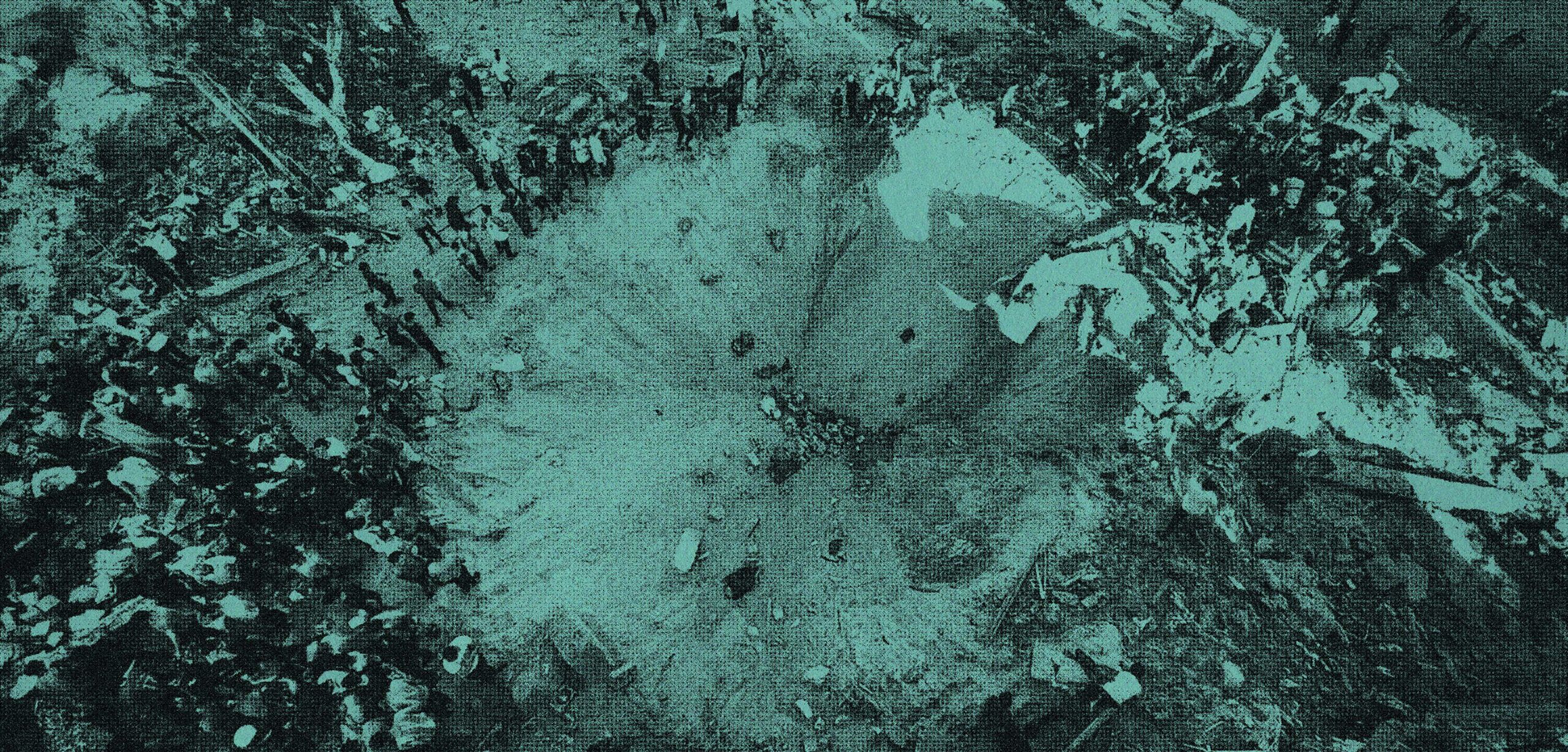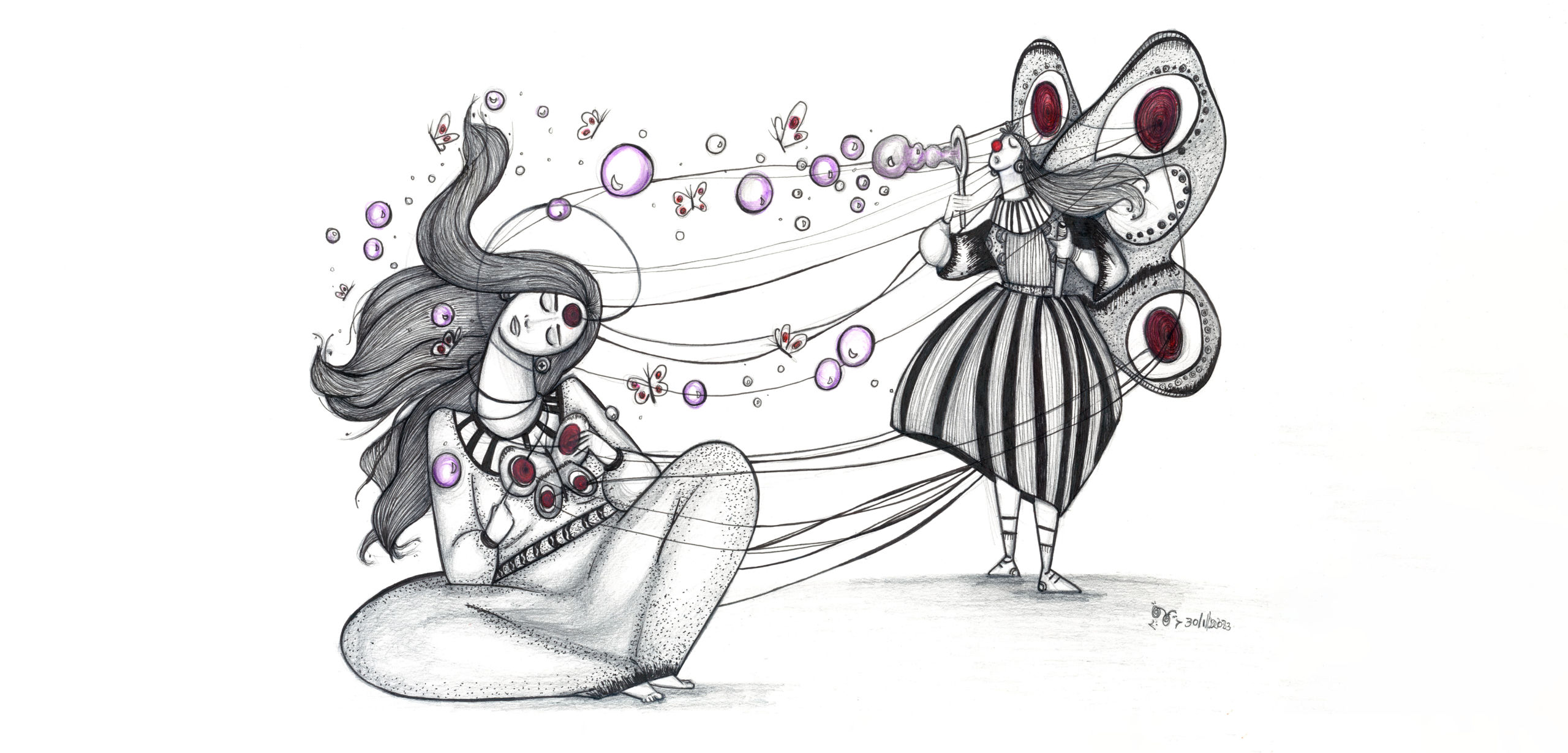لم تكن والدتي مسرورة عندما لاحقتُ رجلًا لأضربه بشنطة تسوق كنت أحملها ونحن نمشى على رصيف في أحد شوارع وسط القاهرة، لأنه قال لي: «اطفي السيجارة». بعد الحادث قعدنا في كافيه وعاتبتني بعبارات عن حتمية البرود، والكلاب تعوي والقافلة تسير، وضربي له ما هو إلا بهدلة لي.
عندما كنت في الثالثة عشر، حكيت لوالدتي عن شاب قال لي: «حظك إنك لسة صغيرة» ونصحتني بأن أمسك أي طوبة في الأرض وأضربه بها إذا تكرر الأمر. كنا نسكن في ضواحي القاهرة، وأمشي مضطرة بمفردي ليلًا في طريق خال من البشر لأذهب إلى مركز أحضر فيه درس العلوم، أزيد من سرعتي عند الجزيرة المرورية بين الطريق، أمشي عليها كي أتفادى مقابلة أي شيء على الرصيفين. قبل أن أصل إلى المركز كان هناك منعطف مظلم باتجاه سيري، هناك قابلت الشاب مجددًا لكن هذه المرة كان يمشي مسرعًا باتجاهي. كان عليّ أن ألتقط طوبة من الأرض، كما نصحتني والدتي، أو أن أجري وتلاحقني الكلاب التي تنبح على مقربة مني. جريت وجرت الكلاب ورائي حتى وصلت إلى البوابة، ونفدت منهم ومن الشاب.
أتخيل أحيانًا أن الكلاب هاجمتني، فتحولتُ إلى كلبة مفترسة، أطارد أمثال هذا الشاب وألقنهم درسًا، أحب أن أعتقد أن هذا ما حدث لي في تلك الليلة.
اختارت والدتي اسم «ريكس» الذي يطلقه البعض على الكلاب، كاسم مستعار لها وهي تلعب مع صديقاتها في الشارع، حتى لا يعرف الصبيان أسمائهن ويضايقهن، لأنها كانت “حامي الحمى” إذا تعرضن لمضايقات من الصبيان. في الثمانينيات، تغيرت مضايقات الصبيان إلى مضايقات من نوع آخر. بدأت والدتي تتعرض للتحرش في المواصلات العامة وهي في العشرينات من عمرها، استعانت بكعب جزمتها العالي لتغرسه في قدم المتحرش في الأوتوبيس، أو ابرة خياطة شبكتها في جيب حقيبتها لتشكه بها. تعايشت والدتي مع هذا الواقع واختارت المواجهة بأدواتها الخاصة على أن تركب تاكسي.
بدأت رحلتي مع المواصلات مبكرًا، في عام 2007، كنت في السابعة عشر. أتشوش قليلًا في محاولتي لتذكر أحداث تلك السنة. مواقف المواصلات مكتظة بالناس وأنا تائهة بينهم، كان المشهد أشبه بالبراري. ألتقط أنفاسي لوصف واقعة محورية حدثت في موقف ميكروباصات منطقة الهرم. كنت أساعد سيدة عجوز تحمل شنطة ثقيلة كي تركب الميكروباص، وأنا ممسكة بفرخ ورق ملفوف، لأتفاجأ بيد تلمس أسفل ظهري في الزحام، ألتفت ورائي لأرى الشخص متوترًا، ضربته بفرخ الورق على رأسه ثم مضيت بهدوء وسط أسئلة سائقي الميكروباصات: «عملك إيه يا أستاذة؟»، ورديت عليها قائلة: «هو عارف عمل ايه».
تكررت حكايات زميلاتي في المدرسة والجامعة عن مشهد رجل يقترب بعربته ويسألهن عن شيء ليتفاجئن بعضوه الذكري مكشوف. بعد سنتين من واقعة موقف الميكروباص كنت أول راكبة في ميني باص ينتظر امتلائه بالركاب ليتحرك. بينما أستمع إلى الام بي ثري، جاء رجل وجلس في الخلف لم ألمحه، ويبدو عندما أدرك أنني الوحيدة الجالسة، عاد من الخلف ووقف في مقدمة الأتوبيس رافعًا جلبابه وأخرج عضوه الذكري وهو فاشخ فمه، كأنه واقف على المسرح. صرخت وانتفضت من مكاني وجريت إلى الباب بسرعة لأهرب. صدمت عندما عرفت من والدتي عن موقف مشابه حدث لها في الثمانينيات، لم تنتفض كما انتفضت، تجمدت في مكانها وانصرفت بنظرها إلى الناحية الأخرى. قالت لي إن هذا هو الواقع وعلينا أن نقاوم. غضبت كثيرًا.
فُرضت عليّ المقاومة. حتى بعد مرور السنين، ما زلت أطبق قبضة يدي عندما يقترب رجل بجانبي. لكن عنصر المفاجأة ينتصر أحيانًا. في أغسطس الماضي، كنت أمشي وأنا أجري مكالمة مع والدتي في سماعة هاند فري وخبطتني موجة في وجهي، رمى علي شاب كوبًا ورقيًا به نسكافيه باللبن. أخذت ثواني لأستوعب الحادث، اقترب رجلًا وقدم لي زجاجة مياه لأمسح بها وجهي وملابسي من آثار النسكافيه، نظرت ناحية الشاب وقد أعطاني ظهره ومشى كأن شيئًا لم يحدث. لم أجري ناحيته وألقنه درسًا كما فعلت من قبل، لم أقل غير، «انت مين انت!» وأنا متجمدة في مكاني. فكرت أنني محظوظة بأن الكوب لم يكن من الزجاج أو كان النسكافيه ساخنًا.
بعد تلك الواقعة بعدة أيام، وجدت إعلان لمعرض تصوير فوتوغرافي بعنوان «الأنوثة»، لا أعرف عن أي أنوثة يتحدثون؟ في ظل كل هذا، لكني أعرف أنه على الرغم من ما حدث وما يحدث، أحاول دائمًا أن أبدأ صفحة جديدة مع الشارع. أدرك أن بداخلي غضب وأني أحمل چينات والدتي المهجنة بفعل ما عايشته لذا أدعه يحركني بدلًا من أن يقيدني.