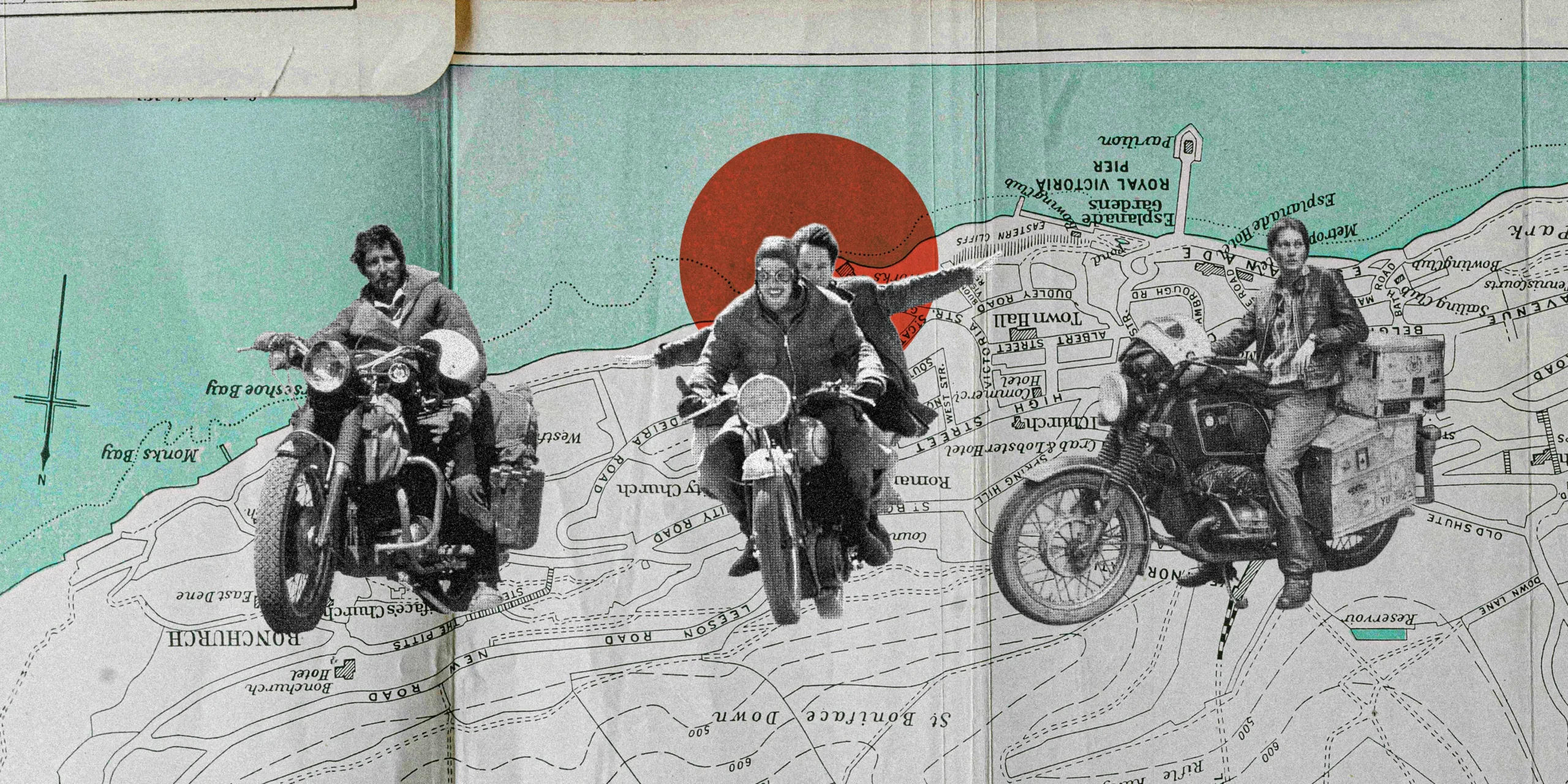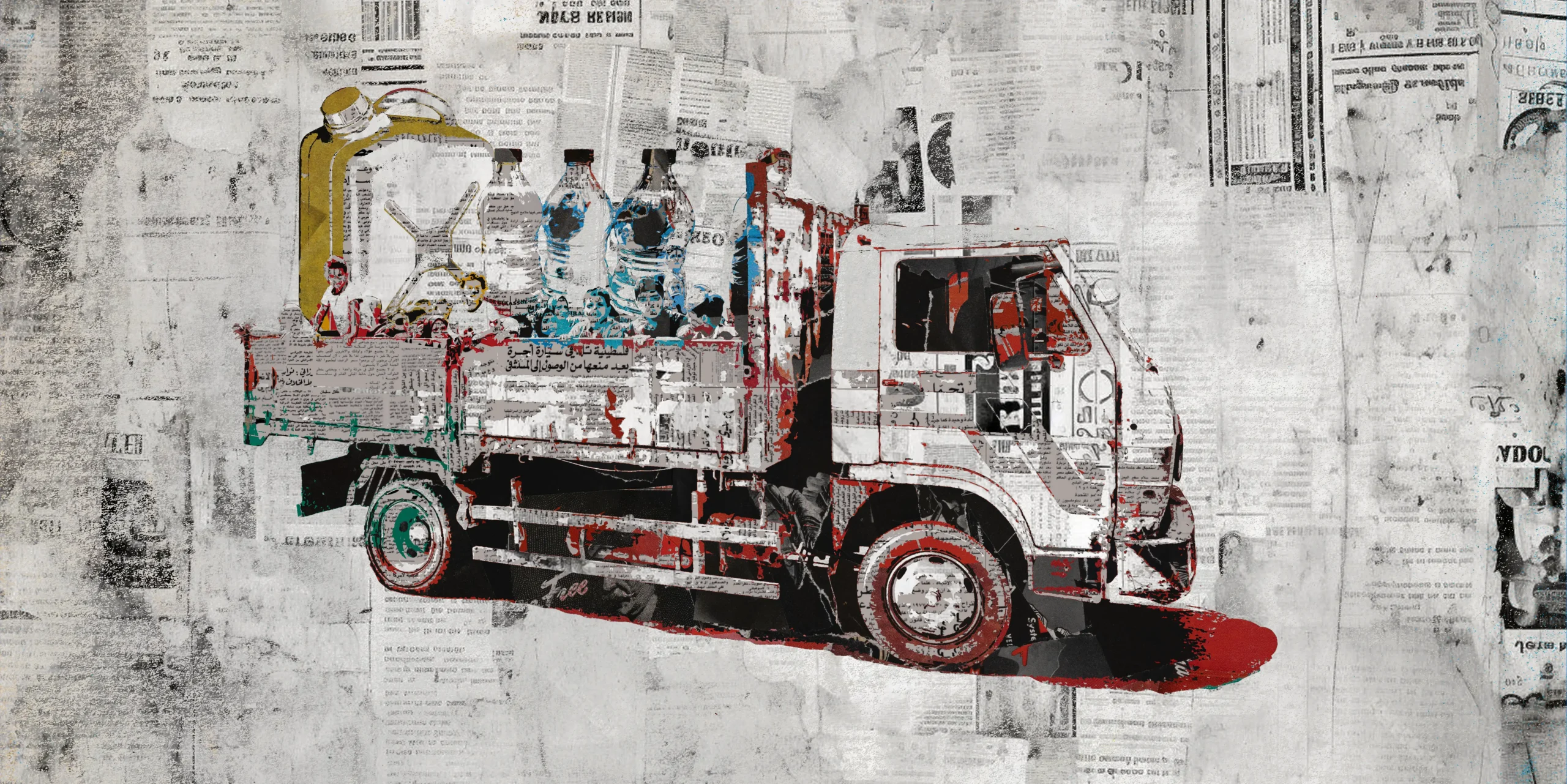وسط الإبادة والتجويع وحلّابات الموت في غزة، وقصص المأساة والكارثة، تظهر حياة مباغتة في الأماكن المسحوقة، وتظل قصة موازية في سماء غزة، لتعلن عن الحياة من جديد.
يرتص المخيم بالخيم البالية، والتي يبدو شحوبها في الصباح أشبه بموكب جنائزي تخرج من أبوابها دمى عابسة، تتحرك دون رغبة أكيدة بالحياة. هذا حال معظم نازحي غزة خلال حرب طاحنة، أبادت مقدرات حياتهم، وأفكارهم حول الأمل في مستقبل قريب، يعود لهم بالحياة.
لكن فجأة يظهر ضوء غريب داخل النازح، أشبه ما يكون بكذبة أن الحرب انتهت للتو، وعادت الحياة رغيدة، كما كانت قبلها. فلعل ذلك الضوء يأتي مع لحظة نسيان للألم تصنع قصة حقيقة للحياة من جديد، وتعيد الكثير من المفقود. كان لي جملة في مجموعتي “الحلاق الوفي لزبائنه الموتى” تقول: “ينسى الميت ويتنفس، فتنبت على قبره عُشبة”.
نعم تعود الحياة بالنسيان أحيانًا، وتذهب رائحة الموت، فتأتي الحياة طالة من أنف الميت، من عقله، من المكان اللامتوقع.
قد يكون هذا الضوء كلمة جميلة، أو جملة تمنح الآخر أملًا ولو لساعة، وسط طوفان الغرق.
هنا وسط الحرب لم يمت الكلام الجميل، فما نزال نتهاداه، نرسله ونستقبله من الأحباب. لم نمت بالشكل الكافي كي تتجمد مشاعرنا، ففي وسط الإبادة نحب ونشعر بالنظرة، ونحضن بعضنا، ونشعر بدفء الجسد، ونبقى على موعد مع فرص جديدة لتجريب حواسنا مع الجمال، وإن استمرت الحرب.
شيب
بعد مضي أكثر من عام على الحرب، انتبهت مؤخرًا إلى لحيتي عبر مرآة مكسورة معلقة على حائط حمام بيت النزوح، وخرجت من الحمام بوجه عابس. أخبرتُ زوجتي بحادثتي الأولى مع الشيب، عدة شيبات باتت ظاهرة في لحيتي، أظنها الحرب، بدأ يظهر أثرها عليّ. نظَرَتْ إلى وجهي، وابتسمت قائلة: “هادول الشيبات في دقنك زادوك جمال”. لم تكن لتكون مُلامة لو صمتت أمام خيبتي، لكنها وضعت الحياة في جسدي من جديد بكلمات قليلة. ابتسمت لها وشعرت بأن هنالك جزءًا من الجمال في أن نكون ضعفاء للحظة، ونستعير القوة من الآخر، ولو بكلمات ونظرات، ولو بضحكة.
كلامها حفزني لأبدأ عملي، فخرجت من البيت باحثًا، ذهبت إلى مخيمات النازحين، أفتش بين الناس على مصدر للقوة، تلك الكلمات، المواقف، التي تجعلهم يكملون التجديف في النهر، ويحاولون أن يصنعوا من البؤس الشاسع، حياة، كل يوم.
وجدت سيدة تجلس على مدخل خيمتها، تراقب ابنها ذو الخمس سنوات، وحيدها، وتنظر إليه كما لو أنه مصيرها. سألتها عن كلمة غيرت رؤيتها للحرب، فأجابت: “لما ابني حمزة حكالي.. أنا بخاف من الصاروخ صح، لكن حضنك بيمسح الخوف كله”. تكمل: “أنا عاد بعيش عشان هادا الاحساس، كيف أعطي لابني عازل عن الخوف والموت”.
يقول ديستوفسكي في الإخوة كارامازوف: “هناك لحظة واحدة تبرق فيها الحياة، حتى ولو كان ما حولها ظلامًا كاملًا”. تلك اللحظة ليست حدثًا كبيرًا في غزة، لكن تكمن في الخطوط الصغيرة التي تحمي جسدًا ما من الانهيار.
كنت أمشي في السوق شبه الفارغ من المواد الغذائية. والممتلئ بالناس الجوعى، يمشون بوجوه مرهقة وحزينة. كان الحزن يملؤني مثلهم تمامًا، فالأرض لم تعد تحتمل المزيد من الألم.
ضربت يد رقيقة على كتفي، نظرت بشيء من الخوف، لكنني وجدت أمام وجهي شخصًا بسيطًا، يحمل القليل من الورد، يتجول في السوق ليبيع الورود، بنظرات ما تزال تحتفظ بالرفق.
اشتريت وردة من بائع الورد ومشيت أستنشق رائحتها، وكأنها منحتني مساحة جديدة خارج الحرب السخيفة. لم يكن يبيع ورد في السوق، وإنما كان يجدد الحب في عيون الناس، ويمنحهم فرصة جديدة مع الأمل والمشاعر الدافئة.
طفولة وقبلات
“زوجي في شمال غزة، لم ينزح معنا للجنوب، لأن أمه مقعدة ويخشى على قلبها مواجهة جنود الاحتلال عند الحاجز”.. تقول لي سيدة أخرى، كانت تضع ملابس أطفالها على حبل غسيل بجانب الخيمة. سألتها ما الذي يجعلك تحتملين العذاب وحدك، ومعك أطفالك؟ قالت بوجه تورد للتو: “بيجي علينا أخويا، الله يرضى عليه ، كل يومين أو تلاتة، والله جيته عليا بتمحى كل الخوف وكل القلق”.
تكمل: “مرة شكرته وحكتله ثقلت عليك يخو”.
لم يترك الأخ لاخته مساحة الحرج وأجابها كما قالت: “ما حدا بيحرس طفولتي، بعد إمي، غيرك، أنا بآجي عندك عشان أرجع ذاتي”.
لمعت عينا السيدة بالدموع، وقالت: “هادي الكلمات بتعيد تخييط المزع اللي بتسبيه الحرب جواتي”.
هنالك مثل شعبي قديم يقول: “الملافظ سعد”. نعم، اللفظ مثل يد تمدّها للناس، إما أن تشدّهم للسعادة، أو يشدّونك لها. وفي الحرب قلائل من يستطيعون فعل ذلك.
كان ابنها ذا السنوات الست، يجلس بجانب الخيم، وبدا فرط حركته واضحًا، صرخت عليه ليهدأ، لكنه تقدم نحوي ببطء، ضحكت بوجهه وسألته: “هل تذكر ملامح أبيك؟” أجاب: “أبويا ساكن هلقيت قبال البحر، وأنا خميتي كمان قبال البحر، كل يوم الساعة ٤ العصر، بيبعت كل واحد منا بوسة للبحر، ، بتحملها المي، وبنتبادل البوسات”. وأردف: “كيف أنسى ملامح أبويا، وأنا ببوسها كل يوم”.
عجوز سينمائي
دوما أعجب بالعجوز السينمائي، الرجل البسيط الذي يأتي به المخرج على الهامش، ليقول حكمة ما، تستمر مع النشئ والأجيال، يقولها بهدوء من خلال مشهده، ويمضي تاركًا المساحة للأبطال.
قبل أيام، وجدت عجوزًا سينمائيًا جالسًا على مدخل محل في سوق دير البلح. كانت التجاعيد تحت عينيه تكاد تشقق وجهه. وتفاجأت بأنه يجلس على كرسي متحرك. ويقول: “عملتنا الحرب هريسة، يا الله، نار أكلت الأخضر واليابس” قال ذلك بينما كان يضرب كفيه ببعضهما البعض. لا أعرف لمن كان يقول ذلك. لكنه يبدو أنه كان يردد الكلام نتيجة عاصفة تدور داخله. تقدمت إليه وسألته: “من الذي يُنقذك ويعيد لك الأمل وسط هذا الدمار يا حج؟”. أجابني: “بتعرف الغريق المتعلق بقشة؟ هادا أنا، والقشة هي كلمة صغيرة من ابني كل يوم، بخبرني أنه بحبني لحد الآن، لما يحيكلي هيك بصير أشعر بخفتي وهو بيحكي”.
أرجوحة
تعمل زوجتي مدربة فنون مع الأطفال والعائلات خلال الحرب، كانت تعد لنشاط حول الأرجوحة واستعادة الذكريات والطفولة، كان الهدف استعادة المكان المفقود والمشاعر الدافئة مع الحياة وسط طقوس الإبادة اليومية التي فرضها الاحتلال.
فكرت في الأرجوحة، ورحت أسأل رجًلا خمسينيًا يبيع حلوى الكُلاج على باب مخيم غرب دير البلح: “ما هي أرجوحتك في الحرب؟ شخصًا أو مكانًا أو فكرة”. والأرجوحة التي قصدتها، شيئًا نستعيد من خلاله الطفولة، نسترخي لنلعب وسط الحرب، أو نفرغ قليًلا من الحزن المكدس داخلنا، قصدت أي لحظة تمنحنا طاقة إيجابية.
أجاب بلهفة: “مرتي، أنا بلعب مع مرتي لحد هلقيت، لولاها كان نسيت الطريق للّعب من زمان”.
يكمل: “أنا ما خلفتش أطفال، وصرت طفلها الوحيد، بتحكيلي كل يوم قصة، أنا بشعر بالثقة وهي بتتكلم، صوتها دايمًا بيعطيني الأمان”.
صممت أن أراها لأحاورها، ذهبنا للخيمة، ونادى: أم سليم. خرجت إلينا سيدة تصغره قليلًا. سألتها: زوجته؟ ردت: أنا أخته. لقد استشهدت زوجته بداية الحرب. وحين سألتها عن القصص التي تحدث عنها، ردت: “نعم، كانت زوجته حكواتية قديرة في حي الشجاعية، ومن وقت ما ماتت، كل يوم بيقعد مع أطفالي يردد حكاياتها، ويقلد صوتها”. نظرت حولي لأحضنه، وجدته اختفى من المكان.
مواقف كثيرة وكلمات خلال الحرب، تلغي الحرب ولو للحظة، وتعيد النازح إلى مكانه المفتقد. تبقى تلك الكلمات مثل العطر في اليد، ومهما فعلت الحرب، فإنها لن تستطيع منع الحياة من المجيء بما تحمله من دفء وتلقائية.
تعمل هذه الكلمات الدافئة لتساعد النازحين الغزيين على البقاء والنجاة من الإبادة.
لكن تبقى جملة ينتظرها أهل غزة جميعا، تجيء مع ساعي البريد، أو تطير إليهم من حركة الأرجوحة، أو تتساقط مع مياه الأمطار، تلك الجملة هي: انتهت الحرب.