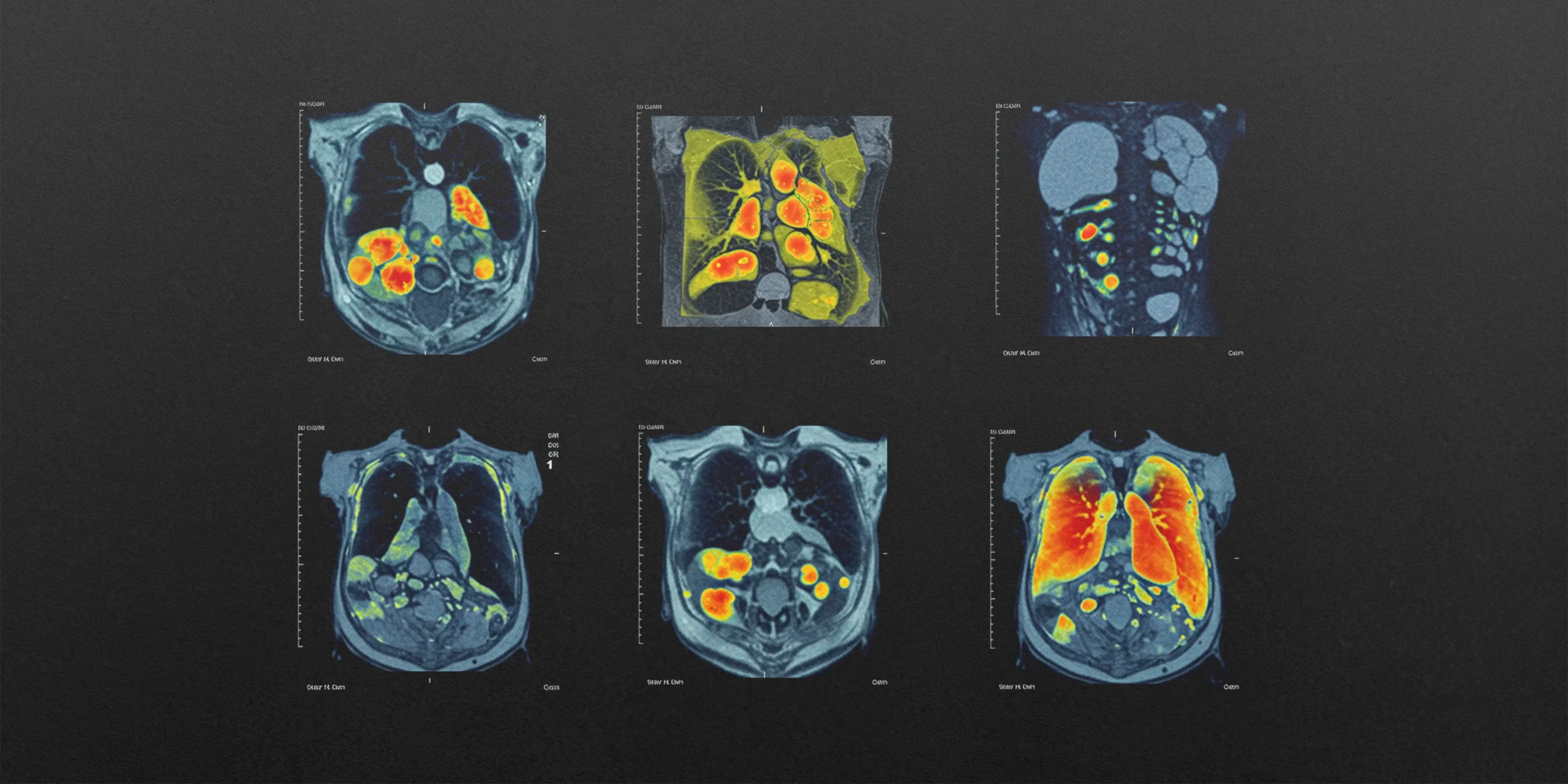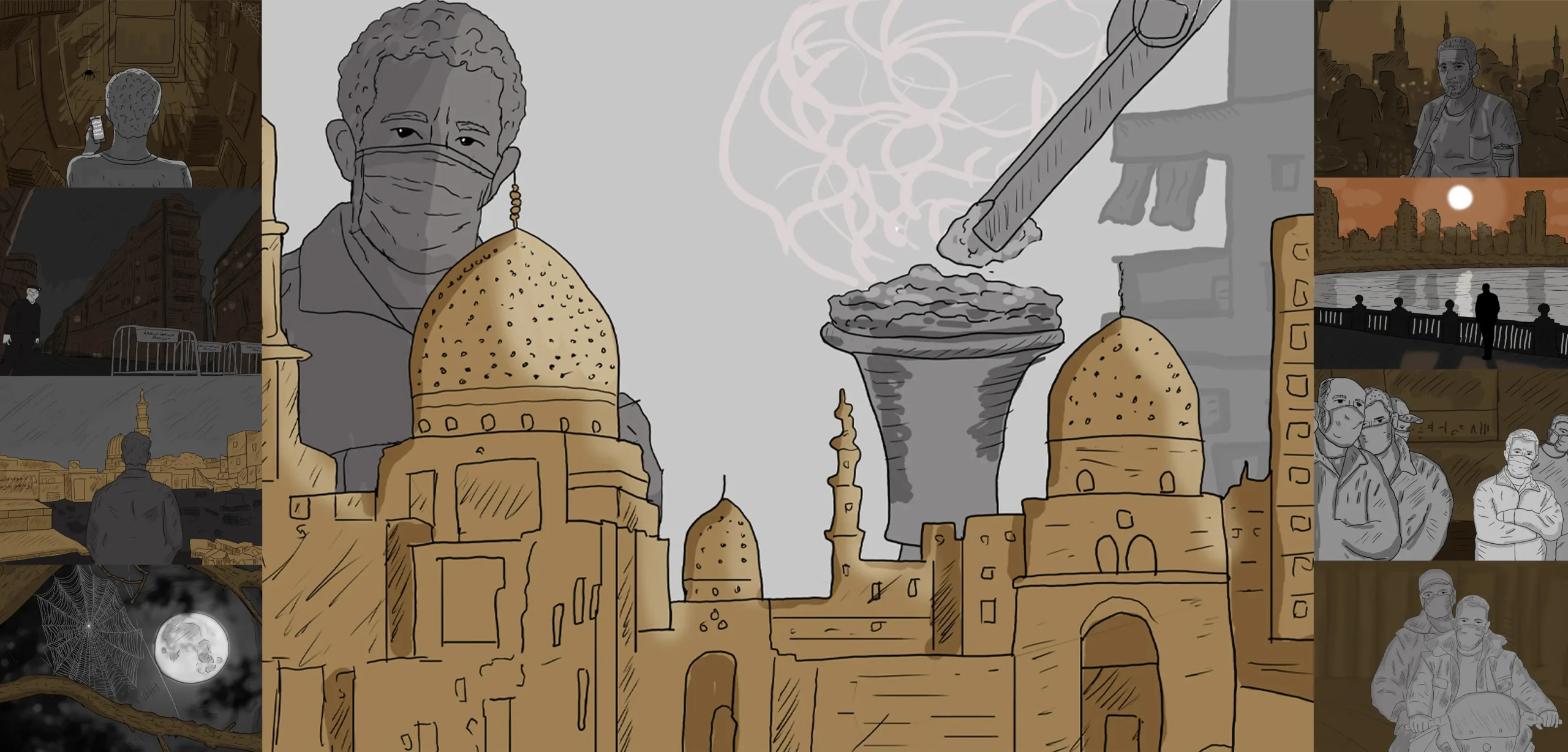على شاطئ قناة السويس، وفي منتصف المسافة بين مدخلها الشمالي على المتوسط (بورسعيد) ومدخلها الجنوبي على البحر الأحمر (السويس) تقع مدينة الإسماعيلية الهادئة والمعروفة بحدائق المانجو والفراولة على أطرافها.
وتسمى الإسماعيلية بـ “باريس الصغرى” لا سيما بين أبنائها، وذلك للأثر الفرنسي الذي تركه موظفو شركة قناة السويس الفرنسيون، والذين استوطنوها منذ تأسيسها في ستينيات القرن التاسع عشر وحتى تأميم الشركة من قِبَل عبد الناصر عام 1956 كشركة مساهمة مصرية.
وكانت تسمية باريس الصغرى تلك بمثابة مزحة تضحك لها الأجيال الصغيرة، لمعرفتهم أن الإسماعيلية ما هي إلا بلدة صغيرة. لا تتوفر فيها سبل الترفيه إلا الكافيهات الكثيرة المستحدثة ونوادي هيئة قناة السويس المتاحة فقط لأعضائها، وبعض الأماكن الخضراء التي قد تتسع للتريض أو لحفلات الشواء العائلية في الأعياد وربما أيام الجمع الصيفية.
وتظل المدينة بمثابة ملحق على تاريخ بطولات السويس وبورسعيد في المقاومة الشعبية للاحتلال، وحتى في فنون “السمسمية“، فلا تحمل إلا ظلال خفيفة من كليهما. وفي هذه المدينة ولدت وعشت حتى قاربت سنّ النضج. وبدت لي الإسماعيلية وقتها لا تسع أحلامي و طموحاتي للتحقق والتعبير عن الذات، وهي كذلك للكثير من شبابها، حتى أن الخروج من الإسماعيلية أصبح انجازًا في حد ذاته بالنسبة للكثيرين، والبقاء فيها بات خضوعًا لندرة الموارد والفرص.
تخلدُ الإسماعيلية إلى سكونها طوال العام، ولا تنتبه إلا على وقع حدثين فنيين دوليين تستضيفهما المدينة. أحدها هو مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية. وكان أبي يأخذني كلّ سنة إلى قصر ثقافة المدينة لحضور المهرجان، الذي يأتي له الكثيرون من القاهرة والعالم. لكن معظم أهل وسكان الإسماعيلية لا يسمعون عن الحدث الفني الكبير.
وكنا نُعرَف أنا وأبي في أروقة المهرجان لترددنا سنويًا عليه بـ “الراجل وبنته”، فلا أطفال آخرين يحضرون الحدث بشكل مستمر وملحوظ. والحدث الثاني هو مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي يحتفل بالتعددية الثقافية في العالم من خلال الرقص والفولكلور.
وبخلاف هاتين الفعاليتين اللتين تنظمهما وزارة الثقافة المصرية، لم توجد أي مساحات في الإسماعيلية لتجريب أنواع أخرى من الفن، حتى في قصر الثقافة نفسه. كما تظلّ الاستجابة المحلية لهذه الأنواع من السعادة محدودةً، فالأهالي إن حضروا، فهم في موقع المتفرجين حصرًا، ولا يشاركون في إنتاجها.
وعلى الرغم من اطلاعهم على تلك التجارب البصرية والحركية من أماكن مختلفة في العالم بفضل المهرجانين، تبقى تلك الخبرات الفنية الثرية مختزنًة لا تجد أي مَخرَجٍ أو داعم لتنميتها. وتبقى الإسماعيلية -كما قالت سيدة قابلتها مؤخرًا في ورشة للرقص– : “داعية ومضيفة للفنون لكنها ليست منتجة لها”.
تصوّر شائع
“ورشة رقص للسيدات في الإسماعيلية“؟! وجدت الإعلان صدفةً بينما أتصفح الفيسبوك، فوجئت، وتصوّرت أنّها إحدى الورش التي تندرج في أنشطة الجمعيات النسوية تحت شعارات من قبيل: “إعطاء صوت لسيدات الأقاليم الصامتات”، وهو تصور سائد لدى الكثيرين عن سيدات الريف والمدن الصغيرة، ما يدفع الكثيرين من الأجانب والنسويات معًا لمحاولات خلق مساحات للتعبير والتحقق لهن.
ولا أستثني نفسي من هذا التصور الشائع، فقد كنت متوترةً من خلفية المشاركات، معتقدةً أنهن سيكنّ منغلقات أو سيسارعن بإطلاق الأحكام المسبقة عليّ؛ فشكلي ومنهجي في الحياة، كما كنت أتصور، لا يتناسب مع البلدة الصغيرة وأهلها. ومثلما صار معي، أثار إعلان الورشة على الفيسبوك دهشة وحماس الكثيرات، وريبتهنّ أيضًا، قبل أن يتقدمن للمشاركة.
دوافعهن لخوض التجربة ـ كما سأعرف لاحقًا – كانت مختلفة: منها المحاولة للخروج من حالات نفسية صعبة، أو استعادة التوازن، أو ربما لإيجاد مساحة صغيرة من الحرية لحركة الجسد في هذه المدينة الصغيرة المحافظة، أو حتى مجرد خوض تجربةٍ جديدة وهي الرقص في مساحة مريحة وداعمة للنساء.
ملأت استمارة التقديم وجاءني اتصال بعد ذلك يؤكِّد قبولي في الورشة. لم أسأل عن التفاصيل. ذهبت في اليوم الأول والقلق يساورني حول المُدرب والمشاركات: هل سيتقبلّن وجودي “المختلف” بينهن؟ هل سيكّن مستوعبات للرقص المعاصر أم يعتقدن أنّه فصل زومبا لإنقاص الوزن؟ واعترف هنا أن توقعاتي عن نساء الإسماعيلية، مدينتي الأم، كانت منخفضة جدًا وتقليدية للغاية.
واتضح أن مدربة الورشة هى نرمين حبيب، فنانة مصرية وراقصة ومصمّمة رقصات معاصرة، حاصلة على درجة في الفلسفة وعضو في المجلس الدولي للرقص. وهي أيضا خريجة الدفعة الأولى من مدرسة ومركز القاهرة للرقص المعاصر تحت إشراف الراقصة كريمة منصور. وكان ذلك مطمئنًا، فأنا أعرف الكثيرين من خريجي المدرسة، وأعرف جديتها.
نرمين أيضا من مؤسسي شركة أصداء (Echo) المعنية بنشر الثقافة وأشكال مختلفة من الفنون الأدائية والبصرية في أنحاء مصر، تحت شعار “حيث يكون الفنّ ضرورة” وقد نظَّمت المؤسسة الكثير من الورشات في المنيا والإسكندرية والقاهرة، وأخيرًا في الإسماعيلية.
وعندما سألت نرمين “لماذا اختارت الإسماعيلية؟”، قالت: “الإسماعيلية من أهم المدن في التاريخ والثقافة المصرية، ومرّ عليها مراحل كثيرة من التطور والصمود، وشهدت أحداثًا تاريخية من احتلال وثورات وخلافه، ما جعل ناسها أقوياء. فاختيار سيدات الإسماعيلية يرجع لأن شخصياتهن قوية ومستقلة وهذا يظهر بوضوح، وفي نفس الوقت لا توجد مساحة للتعبير والتنفيس والبراح كافية في المحافظة” وأضافت بخصوص اهتمام الدولة بالفنون قائلةً أنه “ينحصر غالبًا في العاصمة أو في محافظات بعينها ‘هي اللي واخدة العين زي ما بيقولوا’، الإسماعيلية مظلومة في هذا الجانب وتحتاج إلى أن تصلها فنون أدائية وتدريب احترافي على قدر ذكاء وتفتح أهلها.”
مساحة جديدة
بالفعل، قد يصلح الرقص كمساحة جديدة لنساء الإسماعيلية تسد نقصًا في الاحتياجات المطلوبة للإبداع والتجريب. وقد وصفت وزيرة الثقافة الحالية الإسماعيلية مؤخرًا في إطار افتتاحها لمهرجان الفنون الشعبية كقبلة للفنون، ومدحت إقبال جمهور المدينة على المهرجان، لكنّها لم تقل شيئا عن نقصان إنتاجية هذه الفنون في الإسماعيلية، كما في سائر المدن الصغيرة والأقاليم.
عندما سألتُ نرمين حبيب عن سر اختيارها للسيدات فقط، قالت: “الحقيقة لم يكن لأن السيدات يعانين في حقوقهن، أو لتمكين المرأة أو للتعبير عن ظلم واقع عليها وهكذا! على العكس تماما، أولا هذه السنة أعلنتها مصر عامًا للمرأة. وكوني شاركت في موكب المومياوات (وهي احتفالية ضخمة أقامتها الحكومة احتفالا بافتتاح متحف الحضارة الجديد) ورأيت سيدات يقدن الموكب من أمام ووراء الكاميرا فذلك كان مدعاة للفخر لي كامرأة وكمدربة رقص أحمل على عاتقي أن أعبّر وأوصل أهمية هذه الفنون، وخصوصًا الرقص في مصر وتاريخه المهم.”
وهناك من الراقصات من لعبن أدورًا اجتماعية وسياسية مثل الفنانة تحية كاريوكا وهي أصلًا من مدينة الإسماعيلية. ليبقى اختيار السيّدات احتفاءً واحتفالًا باستحواذهن وتمكّنهن من جوانب كثيرة في المجتمع وفي الحياة عمومًا، أكثر منه اعتراض أو تمرد.
وتقول إحدى المشاركات في الورشة (مسيحية الديانة) إن كنيسة المدينة أيضًا كانت مساحة لاستضافة ندوات ثقافية وفنية ولممارسة المسرح. لكنه مسرح كنسي وعظي، الغرض منه ليس الفن أو المتعة، وبالتالي تقول “لن يجد الرقص هذا التوظيف في الكنيسة”. أما في الورشة فقد وجدت المشاركات أنواعًا من الرقص جديدةً وغير مألوفة لهن، كالمزج ما بين الرقص المعاصر والشرقي، والعلاج بالحركة، وتحريك الجسد بأشكال مختلفة تحترم ذاكرته وذكاءه ليغفر للذات والتسامح مع كل الصعاب التي يبقى العقل عاجزًا عن استيعابها.
حيث يصبح الجسد أداةً للتعبير عما هو أقوى وأصدق مما يعبر عنه العقل. وجدت السيدات، وأنا معهن، في الورشة مساحة للتجريب وفهم الذات بشكل مختلف، بعيدًا عن أنماط الهيمنة والرقابة المجتمعية التي لا تحترم تحرّر الجسد من خوفه. وكان التحدي هو التجرُّد من الأنماط والوظائف التي تتلبسها النساء قسرًا كنمط الأمومة الجادة، أو المرأة العاملة أو المهنية التي لا يليق بها أن ترقص، وطبعاً التحضير للعرض المُراد إقامته في منتصف ديسمبر 2021.
وعلى الرغم من أن الرقص الشرقي متأصلٌ في تاريخنا المصري، إلا أن بعضنا يخشاه لما قد يحمله من إيماءات إيروتيكية، تجعله محرّمًا وتجعل مشاهدته أو ممارسته تتم وراء الأبواب المغلقة قصرًا. وقالت المدربة نرمين إن تخوفها تجاه الورشة كان من هذه الفكرة تحديدًا، تشرح “عادةً يُقال إن الرقص عيب أو غلط ويوضع في خانة غير اللائق أو الفعل المُخجِل. ومن الصعب أن تمارسه سيدات بحرية دون أن يتم التحكم فيهن أو التنمر عليهن.”
“الرقص ربما.. فقدان الوزن نعم”
أيضًا صعوبة أن تتخطى السيدات لوحدهن كل هذه التصوّرات، زِد عليها عدم تقبل المدينة نفسها للعرض أو للتدريب وإطلاق الأحكام المسبقة دون معرفة أو وعي. تقول نرمين: “لكن مع بداية الورشة فوجئت أولًا بالإقبال الكبير جدًا من المتقدمات، ولأن العدد كان محدودًا اضطررت لاختيار عدد قليل منهن. لما بدأنا فعليًا وجدت وعيًا ومواهب فطرية لا تدركها المتدربات ذاتهن. ووجدت لديهن إصرارًا على ممارسة ما يحببنه ويعبرن من خلاله عن هويتهن كنساء، وقد فرحن جدًا للعثور على هذه المساحة.”
شعرت بنشوةٍ غريبة عندما رقصت شرقي لأول مرة في الورشة، هذا النوع من الرقص الذي خلق “ديفات” السينما المصرية من سامية جمال إلى نعيمة عاكف إلى تحية كاريوكا التي هي من بنات الإسماعيلية دون أن يعرف كثيرون هذه الحقيقة. وفي أحيان كثيرة، فوجئت نرمين من قدراتنا على الرقص الشرقي دون أي خلفية تعليمية أو تدريب مسبق، معلقة أنه “فطري وموجود لدينا في الجينات.”
وجدت المشاركات، وأنا أيضًا، مساحةً للمشاركة والحوار على اختلاف المعتقدات والخلفيات وسن للمشاركات. وقد تراوحت الأعمار بين العشرينات والأربعينات، منهن محجبات وغير محجبات، متزوجات وأمهات وغير متزوجات. وتبقى الحاجة لتحريك الجسد والمتعة شيئًا مشتركًا بين كل المشاركات.
أكثر المشاركات إثارةً للدهشة بالنسبة لي كانت سيدة متزوجة وأمٌ لأربعة أطفال صغار تأتي من بلدة “فايد”، إحدى ضواحي الإسماعيلية. حوالي ساعة ونصف من السفر يوميًا تاركةً أطفالها في عُهدة العائلة لخوض هذه التجربة. كانت الورشة هي تجربتها الأولى لترك المنزل وتجربةَ شيء جديد عليها تماما، وبمفردها. وقالت إن ذلك أكسبها ثقة كبيرة في نفسها وأحسَّت بتغيير كبير جدًا في ذاتها خلال هذا الوقت القصير. وهي تأمل أن تكون مثالًا لأبنائها في الثقة بالنفس وتجربة ما هو جديد. وتتمنى أن تكون بداية طريق لتغيير تفكيرهم واستكشاف مواهبهم.
بالنسبة لعائلتها، فقد تلقت نقدًا في البداية لفكرة ترك الصغار يوميًا مدة الورشة، لكن عندما وجودها سعيدة ومنطلقة بدأوا بتشجيعها وسؤالها دائمًا عما تعلّمت في الورشة ودعمها في رعاية أولادها عندما تكون غائبة. ما جذبني في قصتها هي علاقتها مع زوجها الذي اعتقدتْ في البداية أنه لن يكون داعمًا بالتأكيد، لكنه -ولدهشتها- دعمها بشدة، حتى أنه في بعض الأحيان كان يترك عمله لرعاية الأطفال وقت تغيّبها. وعندما جاءت فكرة العرض كان داعمًا أيضًا لها. وأدركتُ أنا أنّ الطبقة الاجتماعية والوعي الثقافي للرجال ليسا ضمانًا على دعمهم للمرأة أو تفتحهم تجاه الرقص او الفن. عندما سألتها عن زوجها، قالت “المهم عنده إني أكون مبسوطة”.
سألت المشاركات عمومًا عن رأي عائلاتهن وأصدقائهن في ورشة الرقص متوقعةً عدم الفهم أو القبول، لأن الرقص يبقى شيئًا مرتبطًا بالخلاعة والانحلال. وتفاوتت الإجابات ما بين عدم تفهّم الأهل لفكرة الورشة أو أهميتها، لكن تحريك الجسد بهدف فقدان الوزن كانت فكرً مقبولة تحصل على تشجيع الأهل.
بعض المشاركات فضّلن عدم إخبار الأهل بالمرة لتجنب مناقشات لن تنتهي. وظهرت الفجوة بين الأجيال واضحة بشكل ملحوظ، لقيت المشاركات دعمًا من أبنائهن وأزواجهن الشباب أو إخوتهن، لكن ليس من آبائهن ولا أمهاتهن، مع بعض الاستثناءات.
نفسٌ جديد لنساء الإسماعيلية
شاركتُ مسبقًا في عروض رقص خارج مصر خلال دراستي الجامعية في الولايات المتحدة، وأيضا في القاهرة، إلا أنّ خبرة مشاركتي في هذه الورشة تظلّ فريدة من نوعها والأقرب إلى قلبي. ففكرة العمل على عرضٍ راقص وتقديمه في الإسماعيلية، مكان مولدي وطفولتي، يظلّ شيئًا فريدًا. وهي المساحة التي طالما حلمت بها عندما كنت طفلةً، وكنت غاضبةً دائمًا لعدم وجود موارد ليتعلم لأطفال الرقص والموسيقى والمسرح، وها هي أصبحت موجودة و أنا في منتصف عشرينياتي.
هذه المساحة من الحرية والانطلاق التي عملت جاهدةً حتى أجدها خارج الإسماعيلية ومصر كلها، صارت موجودةً بعد رجوعي من الخارج. استمرار وجود مساحات كهذه في الإسماعيلية وجميع أقاليم مصر هو أمر ملح للغاية لمنح شباب مصر فرص متساوية لتعلم الفن بكل أنواعه. ويجب العمل على توفير هذه الفرص على مستوى رسمي أيضًا فلا تظلّ فقط محض جهود شخصية لشباب يفتقرون للموارد المالية التي تسمح لهم كي يعملوا بشكل مستمر وواسع.
وعلى الرغم من محاولات الشباب، مثل محاولة أصداء (Echo)، لعمل هذه الورشة وتنظيم عرضٍ لما ينتج عنها بالإسماعيلية، وعلى الرغم من وجود عدد من المسارح المجهزة في المدينة، مثل مسرح قصر الثقافة ومسرح مكتبة مصر العامة، تظلّ العوائق البيروقراطية والأمنية تمنع التوصل إليها فعاليات مماثلة. عند بحثنا عن مسرح لتقديم العرض عليه، ووجٍهنا بكثرة التصاريح المطلوبة أو ارتفاع الإيجار المطلوب أو ببساطة عدم استجابة المسؤولين أو تقاعسهم.
أخيراً، تمكننا من الحصول على الموافقة الأمنية وتم العرض بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية يوم 18 ديسمبر 2021 بعد استلام المسرح ثلاثة أيام فقط قبل العرض لمتابعة التدريبات مما ضاعف الضغط قبل العرض لكن هذه الرحلة الصعبة وإصرارنا على العرض في الإسماعيلية ذكرتنا بأهمية العرض لنا ولجمهور المدينة الذي استقبل العرض بصدر مفتوح وعقل واعي.
حمل العرض اسم “وقت مستقطع: من الداخل إلى الخارج” وهو عرض يناقش مفهوم الضغط الاجتماعي وكيف نترجمه، وكيف تبدأ هذه العملية عند الانسان. يحتوي العرض على موجات لا نهائية من السعي والتسارع نحو مجهول، تكرار نفس الروتين اليومي وصعوبة التوقف وضرورة الاستمرار. العرض يدعونا جميعًا للرجوع مرة أخرى لنقطة البداية، يتوقفن النساء قليلا عن السباق وراء حدث ماض وحاضر يتلاشى، يتصالحن مع أجسادهن لإعطاءها القدرة على التنفس في محاولة لإدراك ماهية الوقت والإحساس بوجوده الفعلي.