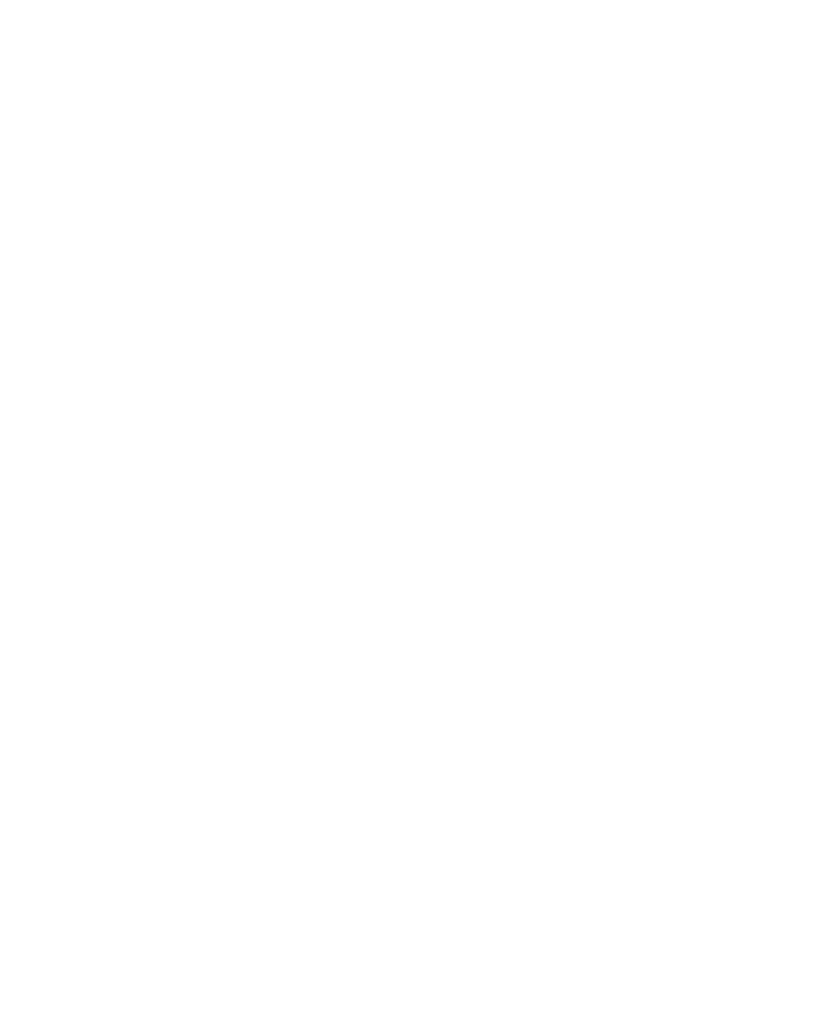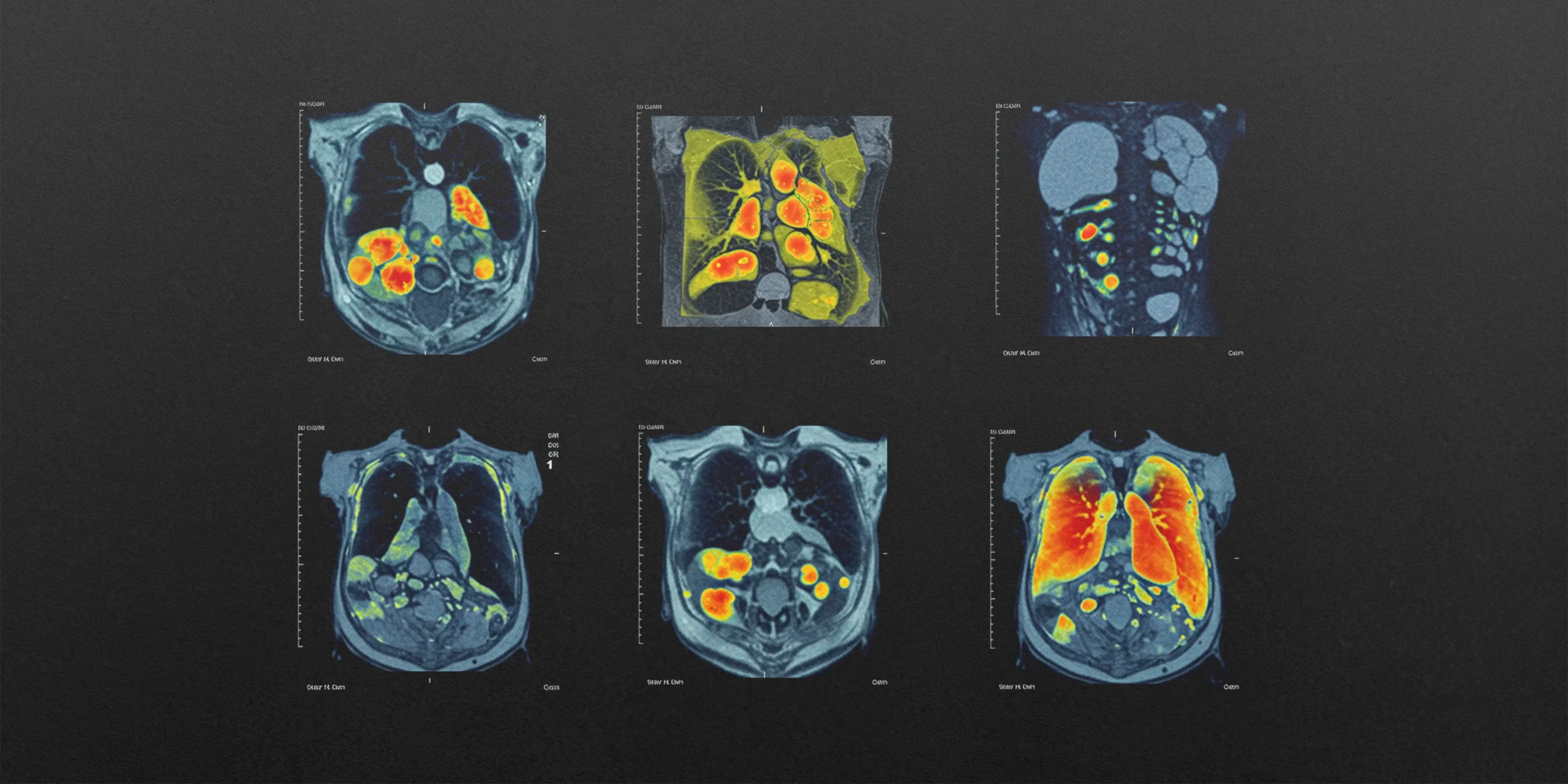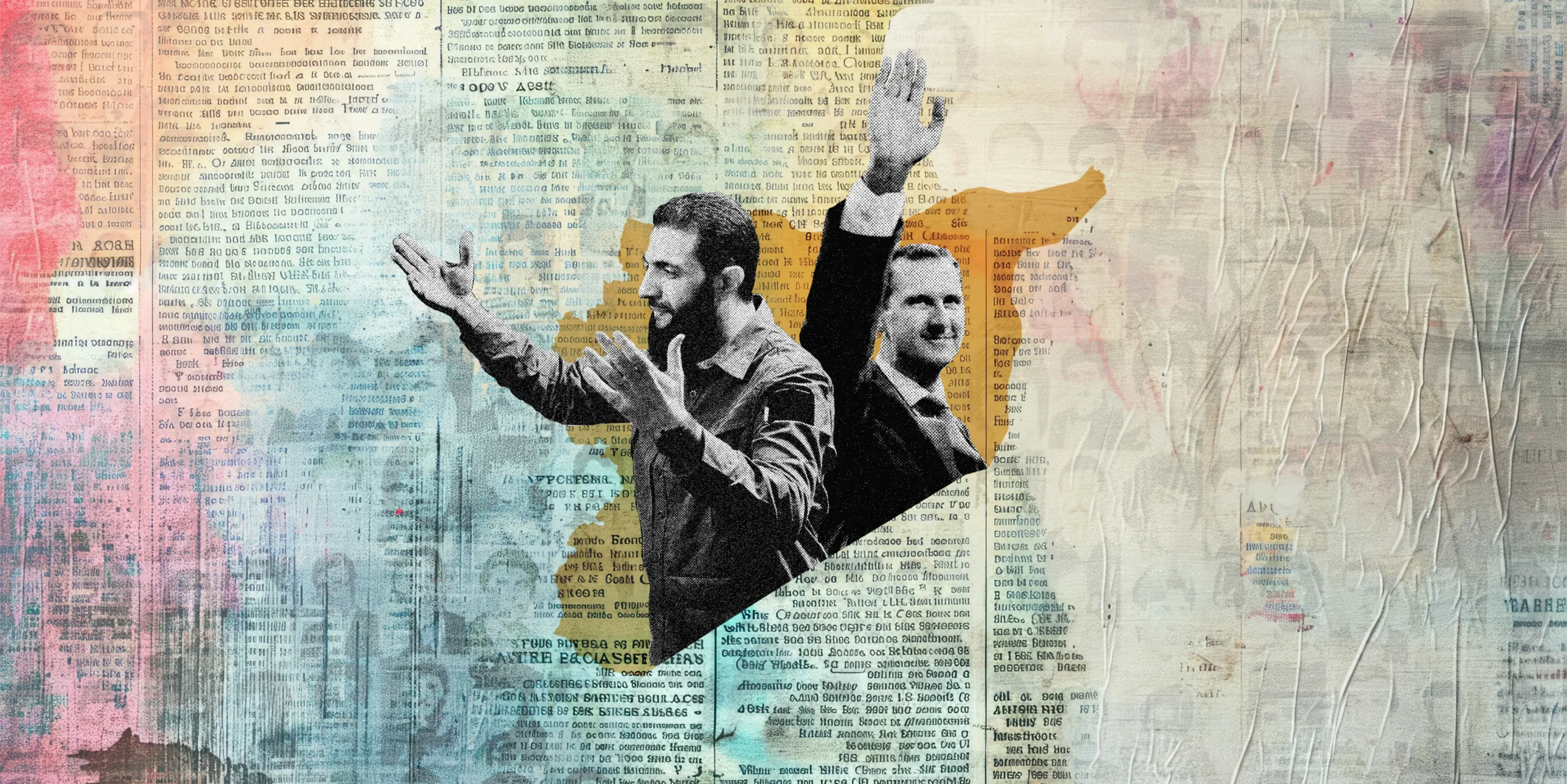تنويه: يتضمن المقال أفكارًا انتحارية، ما قد يشكّل مصدر قلق أو إزعاج للبعض، لذا لزم التنويه.
ما قبل النص، وما بعده
“أستطيع من شدة فرحي أن أمشي على غيمة“، هكذا يصف الكاتب السوري حليم بركات (1936-2023) شعوره، في طرحه حول غربة الكتَّاب العرب. أما أنا، في هذا النص، مشيتُ على جمر، وغيمة، لكنني لست فرحًا أو حزِنًا. لديَّ شعور متجمّدًا من التيه، من خلاله، أحاول تفادي كتابة عددًا كبيرًا من الكلمات، إذ ما أكتبه ثقيلًا جدًا على قلبي، كأنَّه يحمل تجربةً من أطنانٍ لا ذكرياتٍ، وغيري، كلُّنا حملناها مفاهيميًا وممارساتيًا، بمراحلها الثلاثة. السجن، المنفى، وما بينهما. لذا، سأحاول التخفف من الكتابة الطويلة، إن فلحت، لكنني لن أتخفف، أبدًا، من الكتابة الثقيلة، والموجعه، حتى أنني لا أنوي ادَّعاء أي تجملٍ للواقع. وفكرت كثيرًا قبل أن أبدأ في كتابة هذا النص، فيما اعتبره نصًا بائسًا مُحرّضًا على السؤال لا الانتحار، صرخة انتحارية دون قصدٍ (لا تخصّني، تخصكم)، ولا أعرف كيف سيسمعها من يسمعها. أيضًا هي صرخة انفعاليّة. والانفعال، في أحايين كثيرة، شرطًا للكتابة، المقاومة، والحياة التي نحاول مقاومتها.
ما بعد السياسة.. سجن
في أيلول/ سبتمبر 2023، حاول الشاعر المصري جلال البحيري الانتحار في زنزانته، بتناوله حبوبًا مهدِّئة قبل أن يتم غسل معدته، وإنقاذه. كانت محاولته اعتراضًا على استمرار حبسه، بعد قضائه الحكم الذي كان قد صدر بحقه بالسجن ثلاثة سنوات، بعدما قُبض عليه في مطار القاهرة أثناء مغادرته مصر في آذار/ مارس عام 2018. من حين لآخر، يعبّر جلال، كغيره من السجناء، عن مقاومته أو رفضه للسجن، سواء من خلال محاولته للانتحار أو حتى عبر كتابة رسائل يائسة، تعبر عن حاله، وحال السجن المُميت، وفي وقت سابق، كان قد بدأ إضرابه عن الطعام في محاولة للضغط على النظام للإفراج عنه.
جلال ليس وحيدًا، هناك كثُر يحاولون. لكن لماذا يحاول السجناء الانتحار؟ سؤال أصبحت إجابته بسيطة، وهي، أن الحياة السجنِّيّة جحيمية، أو مميتة ببطئ شديد، وأحيانًا سريع، حسب مدى قدرة الجسد السجين على تحمُّل ما يُميته لا ما يُعيشه. على مرِّ تاريخ السجن المصري، عاش آلاف من السجناء والسجينات وسط مرئيات حياتية أقل وصف حيالها أنّها غير آدمية. هذه المرئيات ظهرت مؤخرًا لكثيرين من غير المارّين بها، بفضل وجود عشرات الآلاف من الأجساد السجينة ذات البُعد السياسي، ما أدى إلى اهتمام منظمات حقوقية، في ما يخص رصد وتوثيق وتوضيح حياة السجن الحقيقية، وهي جحيمية، حسب تجارب السجناء، وتجربتي، فلا طعام أو شراب ذات جودة آدمية، بل رديئة جدًا، ولا مساحة آدمية للنوم، على الأرض (البُرش)، ولا معاملة إنسانية، سب وضرب شبه دائمين، لا وقت كافٍ للتمّشِّية والحديث، ولا حتى أي شيء ترفيهي آخر (التريض)، أو حتى لقاء العالم الخارجي، الأقارب والأصدقاء والأحباب، وقت الزيارة.
حين وصلني السجن، لأني، بإرادتي، لم أصل إليه، ورأيت مدى جحيميّته، بدأ يلِّحُ على عقلي سؤال آخر، وهو، لماذا الحياة؟ ولمَ لا الموت؟ وتُخلّص نفسك، ومن يحبك، من كل هذا الذل والظلم. لماذا؟
«كان هناك طبيب يحاول الانتحار في مقرات الأمن الوطني، بسبب تعمُّد إذلاله من قبل رجال الأمن. فكان يبحث دائمًا عن أية آلة حادة لقتل نفسه. كما رأيت شخصًا آخر غير متزن، كان يُعرِّف نفسه كمريض نفسي وعقلي، بسبب ما حدث له في مقرات أمن الدولة». هكذا يحكي سجناء سابقون، عن ما رأووه من شدَّة الألم واليأس لدى سجناء آخرين، كانوا يحاولون الانتحار أمامهم.
أتذكر حين حكم قاضي المحكمة عليَّ بخمس سنوات سجن، ومثلهم مراقبة (كان قلبُ أمي -لاقدَّر الله- سيقف حين سمعت الخبر، هكذا أخبروني بعد خروجي من السجن)، ومن ثم قاموا بترحيلي إلى سجن بورسعيد. في أجواء مُحرقة، داخل عربة زرقاء عفنة، الترحيلات. من وراء شبَّاك سلّكيّ صغير، رأيت الشوارع، الأشجار، البيوت، المطاعم، المقاهي، وجوه سجناء آخرين. سجناء الجوع، الموت، والسلطة. سمعت حديثهم، ضحكاتهم وشخراتهم.
أما أنا سجين الجوع، الموت، الجسد، بشكلٍ مُقسَّم، رأيتهم. كنت بينهم، والآن من خلفهم. “خمس سنوات سجن لجسدي، حرام، يارب، طب وأهلي.. دموعهم، وحسرتهِم“. قلت لنفسي، حرمان من كُل شيء، لماذا؟ هذا ثمن السياسة في بلدي. لمن أُشاور، أشكي، أُصرخ، أَسأل؟ الله. لا يوجد غيره. في كل مكان هو موجود، ليس كمثله شيء. منذ صغري تلقَّنت هذا. حدّثته، وحين بدأت الكلام، شعرت بالظلم، فسكتُ، وفي نحيب بكيت. حين وصلني السجن، لأني، بإرادتي، لم أصل إليه، ورأيت مدى جحيميّته، بدأ يلِّحُ على عقلي سؤال آخر، وهو، لماذا الحياة؟ ولمَ لا الموت؟ وتُخلّص نفسك، ومن يحبك، من كل هذا الذل والظلم. لماذا؟ لكنَّ الزمن جاوبني بالحرية، بعد مروره، وبعد صبري عليه.
لكن لماذا نسأل أنفسنا؟
لأن المحو الذاتي الذي حدث لنا، كسجناء منبوذين، انتقل من مفهومه المجرّد إلى أجسادنا، التي شكّلتها من جديد الممارسات السجنِّية، فجعلت منها أجسادًا مستباحة عاريّة، أو حسب أستاذ الاجتماع الفرنسي دافيد لو بروتون (1953 – )، مرآة ذاتية واجتماعية، ننظر من خلالها إلى كينونتنا فلا نجدها، إذ تكون ممحوَّة أو مرئية، بشكل غير آدمي، هويَّة مازوخيّة حيوانيّة بالمعنى الحرفي، نعيش ونأكل ونتبرّز ونستَمني وننتظر، على الأرض، فلم نترك أي ممارسة حيوانيّة يتميّز بها عنَّا، ربما غير اللسان، الذي أيضًا طوّع على مفردات الخضوع.
إذن، ما الفائدة من الاستمرار، لا شيء سوى الألم. والجسد لا يحب الألم، إذ عليه أن يُنهيه، حتى إن كان في مقدرته تحمّله، فربما لا مَقدرة عند ذوي هذا الجسد. هذا ما حدث بشكل مشابه. إذ في شهر تموز/ يوليو الماضي، حاول السجين الشاب بلال مطاوع الانتحار في قاعة الزيارة، أمام أعين والدته، هذا بعد أن مَنعت إدارة السجن إعطاء بلال والدته بعض الكتب، وبعد أن نقلته إدارة السجن إلى مركز للرعاية الصحية، بينما كانت أُمِّه تشاهد محاولة انتحاره، أصابها صدمة نفسية وجسدية، وتلقت بعض الإسعافات الأولية، لكنَّها، بعد يومين من وقت الزيارة ماتت، قتَّلتها الحسرة.
في شهر نيسان/ أبريل الماضي، كتبت والدة السجين السياسي عمر موسى، الحوار الذي دار بينهما خلال زيارته في عيد الفطر، وهو كما كتبته (بلا تعديلات إملائية) سأنّقله، لأنه يُلّخص كل شيء:
“كنت عند عمر بعد ماخلصت اجازة العيد وكان أول يوم يخرج عمر من زنزانته لمدة أسبوع كان خاسس جدا اكتر من كل مره (..) قولتله اتكلم ياعمر وحشني صوتك.. قالي التعب باين عليكي اوي نفسي تقتنعي ان وجودي جنب بابا ارحم لي وليكي انا عايش في قبر عند حاكم ظالم وبابا في قبر عند حاكم عادل تفتكري مين فينا احسن من التاني اقتنعي إن وجودي عنده افضل وتبقى زيارة واحدة منك لينا إحنا الاثنين وتوفري جهد وتعب ومواصلات انا سمعت إنها غليت (..) بدأت انسي الكلام بقيت اتوتر لو شوفت حد وانا خارج بدأت انسي أشكال ناس كتير من العيله ومن صاحبي كنت الأول بقعد أكتب جوابات لكل الناس رغم اني عارف ان الجوابات مش هتخرج بس كنت برتاح كنت بحس اني اتكلمت معاهم فعلا بس منعو الورقه والقلم فمش بعرف اكتب ولا بكتب مزكراتي زي الأول كانت بتريحني (..) صدقيني يا ماما انا عايش ميت وده إحساس مش هقدر اوصفه ولا حد يقدر يتخيله اقتنعي اني اروح لبابا عشان ارتاح انا اللي مانعني انتي لو عايزه تريحني ارضى وسبيني اعمل كده عشان ارتاح وصدقيني انتي كمان هترتاحي واخواتي يعيشوا حياتهم بدل ماهما محبوسين معايا (..)”.
هذه الرسائل الفردية، ما هي إلا ظاهرة جماعية عن الانتحار، عن محاولاته ودوافعه وأنماط ممارساته، بعد سنوات طويلة من الموت البطيء داخل السجون المصرية، والتي تحاول المنظمات الحقوقية رصدها، من خلال المقابلات والشهادات، كما عبر الرسائل المسرَّبة حول حالات ونوايا الانتحار لهؤلاء السجناء. هذه الظاهرة ليس لديها إحصائيات دقيقة، لكن الأهم أنها لم تكن متواجدة ليس فحسب، بسبب السُلطوية السياسة الحالية، التي وضعت السياسة في السجن (السياسة في الجسد)، بل لوجود منظومة سجنِّيّة ذات نمط حياتي جحيميّ، لا مرئيّ، غير دستوري ولا آدمي، أسستها سُلطويات مُستبدة، منذ عقود كثيرة، تُشبه السُلطوية الحالية (1).
ما بعد السجن.. سجن آخر
النوم قبل الفجر أمر مُخيف، محرَّم عند السجين السياسي السابق، إذ يبقى طيلة الليل ساهرًا، فلن يُغمض له جفن، وهو يعرف أنه في أي لحظة، سيأتي زوَّار قبل الفجر ليعتقلوه، بعد أن يُكسِّروا الأبواب، دون أي سبب، سوى رغبتهم في إعادة اعتقاله، وتغذية وتدوير ثلاثيَّة العقل السُلطوي، السياسة، الجسد، السجن، ليصبح سجن الجسد سياسة في حد ذاته. النوم قبل الفجر ليس وحده المخيف، معه الشوارع، المقاهي، الكمائن، مؤسسات الدولة، واستدعاءات التحقيق والاحتجاز في مقرَّات الأمن. كل هذا يُرعب السجين السياسي السابق، والقادم، لأنه حين يتواجد في هذه الفضاءات، يعرَّض نفسه لاحتمالية إعادة الاعتقال.
إن كان كلّ هذا مخيفًا، ماذا في الحياة تبقَّى آمنا؟
من شوارع خلف بيتي، كنت أسير، ذهابًا وإيابًا، واضعًا سمَّاعة أذني، مُكررًا ذات الألحان، الكلمات، والأشعار، وعيني ترى نفس العمران، الوجوه، والأجساد. لا أتكلم مع الناس. هناك شخص أعرفه قادم عليَّ، سَأحدِّق في شاشة الهاتف، في الذكريات واللا شيء، حتى أُفوِّت فرصة السلام عليه. كنت كَحرامي، سارق مقاومة سلطة، وأخاف محادثتي عنها، أو أخاف من الكمائن والتحقيق والسجن.
في صمت، عشت وأصدقائي، نحن السياسيين الضالين المغضوب عليهم. كنَّا نهمسُ بعضنا عن السياسة والسجن. الهمس واللمز والغمز لغتنا. على مقهى لا أحد يعرفه نجلس، نَتدارى، من المُجتمع، الأجساد المشكوك في تبعيتها إلى الأمن، والأصوات التي تُزعجنا. من الأماكن والناس، اغتراب داخل اغتراب داخل الوطن. أي وطن؟ “الوطن ألَّا يحدث هذا كلّه”، أو يحدث عادي، لأنه وطن يحكمه مُستبد، لكنه يبقى وطن.
في مقهانا المعتاد، ذات ليلة كنت، وبِجانبي يجلس أحد أصدقائي الخائفين، مثلي، من العودة إلى السجن، وأمامنا كوبين من قهوة ثقيلة أحضَرهم لنا مُسعد، القهوجيّ، الذي دائما ما كنَّا نُدردش معه، نُبادله السجائر والضحكات على الحال والفقر والزمن.
بينما كنا نثرثر، ارتعشت يدي. بفزعة سريعة، مسكت هاتفي وأردت بلعه أو حتى رفعه، في طيزي، مثلما يفعل السجناء خلال حملات التفتيش داخل الزنازين. «اهدئ اهدئ»، نبّهني صديقي. رجال من الأمن اقتحموا المقهى، يتفحّصون الجالسين، ثم يختارون أجسادًا للكشف على هُويتهم وهواتفهم. نظروا لنا، هم السُلطة وإحنا “ولاد الكلب الشعب”. بعيون منكسرة نظرنا لهم. هاتفي، منشورات الفيس بوك، المقالات والأبحاث، رسائل الماسنجر والواتس اب وإيميلات العمل. دقائق بسيطة. دقائق، هي دقائق ستمر، ومرة أُخرى، يبتلعني ظلام السجن، في سري قلت. يا ترى كم سنة ستكون هذه المرة؟ الأولى كانت سنتين، يا ترى. لطفك يارب.
«هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا مع، مع، مع الذين» مع من يا الله! خانتني الذاكرة، لا أتذكر كلام الله الذي كنت دائما أُردده في وقت الشدَّة، أي أمام وجوه السُلطة. آية أخرى، كانت الكرسي «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم»، وأكمَلتها دون أي حركة من شفتيَّ. رددتها أكثر من مرة. بلا مبالاة مُتصنِّعة، مجددًا، مسكت الهاتف ومسحت تطبيقيّ فيس بوك وماسنجر.
«يا عمّ.. اترك هاتفك، حتى لا يشكّوا في شيء». مرةً أُخرى، نبَّهني.
الضابط ينظر لنا، عيناه شبَّهت على ملامحنا. كان زميلنا من أيام الثانوية العامة، تحديدًا في درس الأحياء كان معي، مثلي، فشل في أن يلتحق بكلية الطب أو الصيدلة. دخل كلية الشرطة، دخلت معهد الأشعة الرخيص، ثم السجن. والده كان ابن عزٍ، ولد في طيزه معلقة من ذهب، والدي لا يعرف الذهب. أيام الدروس، يدفع الدرس مُقدَّمًا، بعد الفصال أدفعه. هل سيأتي للسلام علينا ثم نضحك. هل سيطلب الهُويات ثم يُفتشنا، وبعدها يجرُّنا على القسم. لا أعرف. لا أعرف.
في لحظة جنونية، انتفخت فيها خصانا، تركنا المقهى. بهدوء، ومن حولنا مشهد أمني، بامتياز، مشينا ناحية باب الخروج. الضابط ورجاله ترقّبونا، خرجنا نتمنَّى الطرَش، لأنهم سينادوا علينا قائلين. «أقف، باشا، يا رجالة، أقف أقف، إلى أين؟ أعطني بطاقتك، هاتفك، بسرعة». من المؤكد، السجن مرة أُخرى، نادوا علينا وتَفحصوا هاتفي. عرفوا أني كاتب، صحفي وباحث. السجن، السجن والتعب، السجن. الكلبشات. كُل مفردات العذاب. هكذا كان السجن. طعامنا، نهضمه ونشُّخه، ثم نأكل شخّتَنا. خرجنا من المقهى ولم ينادوا. الحمد لله، على أنّه انحاز تلك المرة لنا.
هذا مشهد ضمن كُثر، مشاعرها هي الخوف. الرعب. الظلام والكلّبشات، لن أكتبها، حتى أتجنَّب تفرّدي بالمعاناة. لكنني مثلًا حين كنت أعمل على تقرير صحفي، حكي لي أحد السجناء السابقين عن معاناته غير الموصوفة، حيال استدعاء رجال الأمن الوطني له فيما يُعرف بـ“المتابعة” كل فترة بسيطة، كي يذهب ويبقى هناك قيد الاحتجاز والتحقيق أو السجن لفترة طويلة، حسب مزاج السُلطة (الضابط)، فتذكر وقال: “اليوم اللي بروح فيه، أمي تفضل طول الليل ونهار اليوم التالي تبكي وتصلي وتدعي إني أرجع تاني، بروَّح الاقي عيونها حمرا ومقفولة من كثر البكاء، قررت من بعدها إني أغير رقمي، ومع الوقت وخوفاً من أن يقبضوا عليَّ من البيت، غيّرت محل الإقامة“.
وحكي لي آخر، مشاعره التائهة حيال تلك الاستدعاءات. في يأس شديد تذكّر، “السجن وِحِش، اتسجنت سنتين من 2015 إلى 2017، ومؤخرًا شهرين، السجن قاسي، روحي متقدرش تتحمله حاليًا. فكّرت في الانتحار بشكل جاد داخل السجن في المرة الثانية. أكثر فكرة ممكن ترعب كل شيء جوايا إني أرجع السجن تاني. ولذلك غيّرت رقمي ومحل إقامتي“.
أما عن نفسي، كنت مثلهم، ذات ليلة سوداء لم تتكرر. لم أقاوم، واستسلمت. ذهبت إليهم بعد أن هاتفونِي، واحتجزت. بعدها أدركت معنى الحرية، كما فهمت معنى أن يُقبض عليك، فتكون قسرًا عنك سجينًا، أو تذهب أنت بكامل إرادتك لتسجِن نفسك. في إحدى مكاتب قسم الشرطة، قضيتُ يومًا كاملًا. مرغمًا، وبكامل إرادتي ذهبت. نعم بإرادتي ذهبت، وأيضًا غصبًا عنّي. لم ينزلوني الزنزانة، مكثت في إحدى مكاتب الطوابق العليا. بعد يوم، أطلقوا سراحي، فخرجت في الشوارع الخالية، المُعتمة، أعاتب نفسي، السياسة، والله، أتمشَى مطأطئ الرأس، مُضطربًا، مذلولًا. وكأني كنت في بدايات تجرّيب ذاتي، في التمشّية، العتَّاب، والاضطراب.
بعدها في مرات أُخرى، رفضتُ هذا الاستدعاء، ودرّبت نفسي، ورأسي يرنُّ في أذنها ما قالته جوديث بتلر (1956 – )، عن مقاومة «الاستعباد الذاتي» للسُلطة. أخاف من السُلطة. لكن على الأقل، أحافظ على كُرهها. لا ولن في أي يوم من الأيام أصبح عبدها. تأمرني بالحضور، السجود. لا، لن أسجد، أهرب، أركض في الشوارع إلى أن ينقطع نفَسي. وأقول مع نفسي، لاحقوني، أمسكوا بي، غمّوني، وارزَعوا كفوفكم على قفايا. عرّوني، وطيزي التي أمست مكشوفة أمامكم، كما تشاؤون، انكحوها. احفروا خرما آخر وثلاثة وأربعة وخمسون، واجمعوا كل قُضبكم، قُضب سُلطتكم. لكن رغما عنّي، لن أساعد في إذلالي. لن يأتي جسدي، أبدًا أبدًا.
من بعد هذه المرة التي ذُلِلتُ فيها، اتبعت استراتيجية إغلاق خط الهاتف، حتى لا استقبل أي مُكالمات، كنت أنا من اتصل فحسب. انتابتني فوبيا الرسائل، من وقتذاك. هلع أصبح متلازم، يهجم عليَّ وقت أسمع صوت إشعار الهاتف. يرن الهاتف، أدعي ألَّا يكون رقم الاستدعاء هو من حاول الاتصال. تَبع هذا الخوف، خوف من أي رقم غريب يتصل، إبقاء الهاتف في وضع صامت خوفًا من صوت الرسائل. أرى، «رقم الاستدعاء حاول الاتصال بي»، فأغادر البيت، إلى مدينة أُخرى، بيت آخر، إلى أحد أقاربي، أصدقائي، أو حتى إلى الشوارع الفارغة، أمشي وحيدًا، أدهسُّ الوقت بأقدامي، ساعةً فأُخرى. وأجد عودتي، قبل طلوع الفجر، وبعده، آكلي الزبالة ينبِّشون بين الأكياس، باحثين عن فضلات الطعام، فأنظر لهم. “ملعون الفقر، السجن، والدنيا“، أسبّ بصوت عالٍ، مُنخفض أحيانًا، وأعود إلى البيت. هكذا كانت اللعبة. اغتراب وخوف، كرّ وفرّ، خضوع ومقاومة. بين كل هذا، أفكار انتحارية خائفة الدافع والمحاولة والمصير.
هذه الرسالة هي انتحار احتجاجيّ، قدريّ، فضَّلته زينب على أن تستمر ضمن حياة اجتماعية تتمثّل في“سلطة ومجتمع” التي رأتهُما أدوات قمع وتسلّط
ما بعد السجن، ينظر السجناء السابقون إلى السُلطوية كأنها “شرًا لا يُقهر”، بوصف زيجمونت باومان (1925 – 2017). أيضًا ينظرون إلى السياسة، كأنها شيئًا من الخيال، لا يمكن واقعيًا ممارسته، والاقتراب منه، يعني كلّ مفردات العذاب. ما قبل السجن، خلاله، وما بعده، أساسًا إن انعتقتَ منه. وحيث أن لا مفر من سجن ما بعد السجن، فلا يتبقى سوى الانتحار، فكرةً وممارسةً مترسخة في وجدان هؤلاء السجناء، الذين يعيشون صدمة ما بعد ممارسة السياسة (Post-Political Trauma)، إذ فجأةً وأنت تمارس السياسة، تكون حرامًا، بسبب أنماط القمع التي مورستْ عليك، وعلى آخرين شاهدتهم، أمامك أو على الشاشات أو من خلال الحكايات. أنماط قمع تجاوزت المعارضة السياسية التقليدية للسُلطوية، أي التي تنافس للمشاركة في الحكم، بل طالت جميع فئات الشعب المصري، الذي حلَّ به قمعًا اجتماعيًا وفنيًا وثقافيًا وعمرانيًا وحقوقيًا وتشريعيًا، وكل ما يحمل جوانب الحياة الإنسانية، ما يجعل الخوف ذاته “سياسة” لديهم.
هذه التمثّلات، وحشيَّة القمع النفسي والجسدي، خلقت صدمة لا معيّارية، أخلَّت بتوازنات القيم التي يأمل الإنسان أن يعيشها، وجعلته يرى أن كل ما تُمارسه السُلطوية، فعلًا، لا أحد يقدر على إيقافه أو منعه. هذا ما كتبته زينب المهدي، الفتاة الحالمة بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. لكنَّها، في نوفمبر من عام 2014، اختارت أن تنتحر، تاركة صرخة هادئة حيال مدى صدمتها، فقالت: “تعبت واستهلكت.. لا فائدة.. كلهم.. (شتيمة)، واحنا بنفحتْ في ماية “ونحن نحرث في البحر” .. مفيش قانون خالص هيجيب حق حد.. لا يوجد قانون ينصف ويحق الحق، لكننا نؤدي ما علينا.. أهه كلمة حق نقدر بيها نبص لوشوشنا في المراية من غير ما نتف عليها “لكي لا نبصق على وجوهنا حين نطالعها فى المرآة.. مفيش عدل .. وأنا أدرك ذلك .. وليس هناك نصر آت لكننا نضحك على أنفسنا حتى نستطيع أن نعيش”.
هذه الرسالة هي انتحار احتجاجيّ، قدريّ، فضَّلته زينب على أن تستمر ضمن حياة اجتماعية تتمثّل في“سلطة ومجتمع” التي رأتهُما أدوات قمع وتسلّط. هنا زينب، عبر قتل نفسها، حاولت الصراخ، ونيل الاعتراف، ليس اعتراف بوجود ذاتها وجسدها حصرًا، بل اعتراف جماعي يشمل وجود آخرين، غير مرئيين، وقَع عليهم القمع.
في سياق مكانيّ وزمانيّ آخر، حزيران/ يونيو عام 1982، بينما كانت تتقدَّم الدبابات الإسرائيلية نحو بيروت، واحدة تلو أُختها، على صوت طلقات رصاص، لا مصوّبة تجاهها، بل تجاه الجسد الواقع عليه الاحتلال، جسد الشاعر اللبناني خليل حاوي (1919 – 1982)، إذ تخلّص حاوي من جسده، بقتله. مارسَ المقاومة، برؤيته، من خلال التخلُّص من الجسد، الذي ربما يقتله أو يأسره المحتَل.
هنا، وكأنَّ الحاوي امتلك تجربته الكاملة، في الفكر، الشعر، والعدم أيضًا، كما قال في إحدى محاضراته إن، “المهم في الشاعر أن يكون مخلصًا لشعره، ولنفسه، لشعره أكثر من نفسه، وأن يترفّع عن كل غايات خارج الشعر، فَيمتلك تجربةً متكاملةً ويعبر عنها بصدق ويسر“. لا أحد متيّقن من الدافع الرئيسي من قتل الحاوي، نفسه، في هذه اللحظة، لكن غالب الظن، أنها كانت دوافع مشكّلة بين الذاتية العاطفية والسياسية، أي تحققه، من عدمه، وجود الأمان العاطفي مع من يُحب، وبين النكسات التي حلّت بالعروبة نظريةً وممارسةً، كما أنَّه، كان شاعرًا ذاتيًا لا خطابيًا لدى الجماهير العربية، كدرويش أو دنقل، لكن ربما الشعر خانه، أو لم يُكمل معه المسيرة، لأنه لم يعد، كما قال عنه، “يبرر وجودي وتحمُّلي لشقاء الوجود”.
لم يكن فعل الانتحار لدى زينب أو الحاوي أو مَن قبلهم وما بعدهم، سوى محاولة للتخلُّص من اللاميعيّارية، التي نهشت وجدانهم، ونحن، وغيرهم، ونحن، الذين مرُّوا بتجارب الفكر والسياسة، وما تلاها من اضطرابات ويأس وقمع ومنفى للذاتِ التائهة التي تفهّم المفكر الفرنسي ميشيل لاكروا (1946 – ) شعورها، فتحدَّث على لسانها، وقال “بما أن العالم لا يمنحني فرصة للتأثير فيه، فإنه لا يبقى لي إلَّا أن أمارس قدراتي على نفسي“. هنا يصبح النضال من أجل الذات لا غيرها. إذ الذات لا تُحدِّث سوى نفسها، لأن لا سُلطة ولا سياسة ولا مُجتمع يعترف بها، فاختارت، أي الذات، أن تتخلّص من جسدها، أو تُنفيه إلى مكان آخر، بلا وطن، آملةً أن تجد مرةً أُخرى حياةً، شعوريَّا وجسديًا، تعيش بهما حقيقة بلا زيّف.
ما بعد الوطن، الموت مثلًا، ربما
محو الفكر، السياسة، والمواطنة. إحياء مشاعر الاستهلاك والاغتراب السياسي والثقافي والاجتماعي والعاطفي. هذه هي التمثّلات التي يعيشها المنفيُّ من وطنه. إذ كان يظنّ أنّه بمجرّد الإفلات من مصر، السجن، سيبدأ حياة جديدة، بلا أي إشكاليات حياتية، لكنّه، تيقن استكماله التحديات والأسئلة التي ستُمطر عليه حول حقّه، كذات مُستقلة، في جسده واسمه ومواطنته، أي وجوده.
مع الوقت وخوض التجارب مع الدولة ومؤسساتها، في الخارج، سيفهم المواطن المصري أن الدولة المركزية الحديثة في مصر، كما أنّها سعت منذ بدايات القرن التاسع عشر، تحت حكم محمد علي، ونسلِه، في تسجيل اسمه في ما يُعرف بتعداد النفوس، وصولًا إلى تأسيس السجلَّات المدنية، بهدف إحصاء عدد السكان، والاستفادة منهم في بقائها وهيمنتها وتوسّعها، من خلال تسخيرهم لخدمتها في التجنيد والصحة والأمن وغير ذلك. هنا الجسد، يَفهم أنه الدولة (السُلطة) كما سجلّت وجوده (اسمه)، من أجل بنائها وهيمنتِها، الآن وبعد مرور قرابة مائتيّ عام، تمحو هذا الاسم (الجسد) من سجلّاتها عقابًا على معارضتها، وأيضًا من أجل بقائها وهيمنتها. فيجد الإنسان جسده، واسمه أيضا تحت النفي، أي نزعت الدولة منه مواطنته كمصريٍّ.
هذا من خلال رفض القنصليات والسفارات المصرية في الخارج، تجديد جوازات السفر للمعارضين، كما رفض التعامل الورقي معهم، سواء كانت أسمائهم على قوائم الإرهاب أو حتى لم تكن، لكن لهم سوابق سياسية، أي اشتبكوا مع العمل المعارض لسياسات النظام الحالي. في الحالتين، توجد تجارب كثيرة، وصلت إلى شبه ظاهرة ابتعاد المعارضين المصريين من مواطنتهم بشكل كلِّي أو جزئي، في ما يخص ممارسة الحق السياسي، أي اغتراب سياسي.
تجلَّى هذا في الانتخابات الرئاسية المصرية أواخر عام 2023، إذ مُنع المرشَّحون بطرق مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، من خوض حقِّهم السياسي في عمل توكيلات شعبية لمرشحهم أحمد الطنطاوي، السجين حاليًا في سجون مرشح السُلطة الفائز، دائمًا وأبدًا، عبد الفتاح السيسي. إذ هنا السُلطوية كأنها تقول، “أنت مواطن حين تكون خاضعًا لسياساتِي، وغير مواطن حين تُعارض. وتأكّد أنّه كما كنت امتلك جسدك قبل هروبك (منفاك)، فلن تستطِع الهرب من امتلاكي اسمك، وكما سجّلت اسمك، كجسد أُسّخره لبقائي، مرةً اُخرى سأشطُبه لذات الهدف. هذا في حال تمكّن جسدك من الإفلات من السجن، أي هربت خارج حدود دولتي، مصر، جمهوريتي الجديدة“.
لم تَسلم سارة من الاعتداءات الجسدية والنفسيّة، بجانب الوصم والنبذ وخطاب الكراهية الذي أصابها من الأسرة، والمجتمع، ما أوقع عليها أثرًا نفسيًا هائلًا، فاضطرت للخروج من مصر، لتختبر حياتها في ظل البُعد عن وطنها، وموت أمّها، وفقدان أخوتِها وأصدقائها
هذا من ناحية، من أُخرى، وهي غير منفصلة تمامًا، يجد المنفيُّ إشكاليات عدة، منها القانونية، عبر محاولة تقنين وضعه القانوني في البلد الجديد سواء بالدراسة أو العمل، وهذا أمر ليس هينًا، بسبب التكلفة الباهظة للدراسة، فضلًا عن صعوبة الحصول على فرص عمل في بلد ومجتمع جديد عليه. وهذا ما يعقّد المعيشة شيئًا فشيئًا، ما يجعله دائما قلقًا من معضلة عدم توفر أمان معيشيّ مادي، بالإضافة إلى إشكالية القبض عليه وترحيله، قسرًا، إلى مصر، أي مرةً أُخرى إلى تمثّلات القمع الذي هرب منها.
“إلى أخوتي، حاولت النجاة وفشلت سامحوني.. إلى أصدقائي، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني.. إلى العالم، كنت قاسيا إلى حد عظيم ولكني أسامح”، هكذا كانت رسالة المواطنة المصرية سارة حجازي، في منفاها (كندا)، قبل انتحارها في حزيران/ يونيو عام 2020، إذ كانت تعرّضت للاعتقال لمدة ثلاثة أشهر، بسبب رفعها علمًا للمثليين جنسيًا بإحدى الحفلات بالقاهرة أواخر عام 2017. وقد كانت تجربة السجن لها، كعادتها مع الجميع، قاسية بنسبٍ وتأثّرات متفاوتة. لم تَسلم سارة من الاعتداءات الجسدية والنفسيّة، بجانب الوصم والنبذ وخطاب الكراهية الذي أصابها من الأسرة، والمجتمع، ما أوقع عليها أثرًا نفسيًا هائلًا، فاضطرت للخروج من مصر، لتختبر حياتها في ظل البُعد عن وطنها، وموت أمّها، وفقدان أخوتِها وأصدقائها التي قالتْ عنهم، “أنا ميراثي هو أخواتي الصغيرين، وأصحابي، وهما في مصر، فأكيد مفتقدة مصر“.
النجاة. التجربة قاسية. لم أستطع المقاومة. هذا هو الأمر كلّه. الطين زاد طين فوقه، ما تسبب في إنهاء وجود الذات، إلى الأبد، منتحرةً، الذات المُنهكة، والتي اجتاحها آلام الاغتراب، بتمثلاتِه المتداخلة من السياسي، الثقافي، والاجتماعي، والأهم، العاطفي. يحكي لي صديق في المنفى، ذات مكالمة بيننا، فيقول “أنا فقدت الأمل.. من سنين، وأنا بجري وراء تقنين أوراقي، والمُحايلة على برامج الدعم والدمج وإعادة التوطين والعيش بشوية هدوء وسلام من غير خوف.. بجد زهقت”. يحكي ومعه بجانب آلام الخوف من الإشكاليات القانونية، آلام أُخرى، تخص الذات ومشاعرها الخائفة التائهة الوحيدة. مع كلّ هذا الألم، تصبح الحياة، “مجرد الحياة فقط، بطولة”، كما يقول عبد الرحمن منيف (1933 – 2004). إذ يصبح الاستيقاظ، استيقاظي، جسدي الهشّ، والأكل. المشي. الحديث. الضحك، والنوم، ممارسات بطوليّة لا عادية، منّي، من إنسان عاديّ جدًا، أو للحقيقة أقل، لا بطل أو يدَّعي البطولة.
هنا يُسلّم الاغتراب الذات إلى الاستلاب، ليس استلاب السُلطة لمواطنة الإنسان فحسب، بل استلاب وجوديّ، أي معنى الحياة، للذات الموجودة، المُفْرغة من الحياة الحالية ذات النمط الاستهلاكيّ، استهلاك مادي وإنساني يستَلبُ الذات. استلاب منوَّع من الاشتباك الفلسفي بين ماركس وفيورباخ وهيغل وألتوسير وسبعة فلاسفة آخرين، أي يجتاح الجسد/ الذات استلاب/ اغتراب وجوديّ، فتَطرح عليه أسئلة وجوده، مَمحوّا كاسمٍ، لماذا؟ مغتربًا كجسدٍ، لماذا؟ يسأل بلا أجوبة فِعليّة تملؤُ حقيقة فراغ سؤاله (2).
هكذا الحال، والسؤال، في وجدان الكثير من الشباب خارج أوطانهم. سؤال “العقاب، وأسوء المصائر”، حسب وصف إدوارد سعيد (1935 – 2003)، الذي عاش منفيًا من وطنه، فلسطين، لعقودٍ طويلة، فيما يصف تجربته، أنها ليست مجرّد تجوالًا غريبًا بعيدًا عن العائلة والأماكن الأليفة، بل هي العيش تحت حالة “المنبوذيّة الدائمة”.
حين نتهاتف، نتَجالس، وأصدقائي، تدور الأحاديث كلّها عن الأموال، الوظائف، الأوهام، الأمان، الاغتراب، العاطفة، الحب، والجسد (الجنس)، عن عالمنا القاسي الفاقد للحب، وإذ نعوِّضه بالجنس، على أمل أن يأتينا بجرعة من الأمان للذاتِ والجسد، حتى إن كان جنسًا عابرًا (دليفيريًّا)، مع من تَطالَه شفانَا، قُضبنا. وعن الاكتئاب، نمزح كثيرًا حول الانتحار، وأقول لأيٍّ منهم، “لا تنتحر. الآن، في حروب عالمية، محدش هيسأل فيك، استنى بعد الحرب، الدنيا تهدى شويّة، عشان تجيب ريتش (Reach) كويس”، ونضحك أحيانًا، دون دموع، نبكي، دائمًا، ونُفَّعل وضع الإنكار، كل منَّا على طريقته. من يهرب، يعمل، يكذب، يختفي، يسهر، يسكر، يُصلِّي، يَنكح، يُنكح، حتى نفسه أو جسدٍ آخر. هنا ربما يكون الجنس مع نفسه لا مع الآخر، لأن ليس كل عمليّة جنسية مع الآخر، هي حقيقةً معه، (ولو كان القضيب يتحدث، لتسَاءل: لماذا جعلتني أنتقم لقلبك، اغترابك وكبرياءَك؟ ولماذا ترى عيناكَ وجها آخر؟ يا مسكين، وظالم).
أما أنا، مثلهُم أتعايش، أحاول، كتمثال متحرك من حجر، ولحم، نصف ونصف، لا أعرف إلى أي مصير؟ يأخذنا الله وإسرائيل. لأني تماما أدرك، إنّنا بعد الإبادة التي حدثت في غزة، إبادتِنا حرفيًا، وبعد أن رأينا “البليَّ” في يد طفل مقتول، وسمعنا هند، هذه الملاك الصغير، وهى تستغيث بـ (قتلى لاحقين) والله، قبل أن تذهب لهم أو له، ليس كما كنَّا قبلها. ومن بعدها، هرولنا نحو السرديات الكُبرى وعودة السياسة والميدان، وعصا السنوار، وسقوط الأسد، مرةً أخرى، عدنا إلى اللاشيء، ربما إلى الهزائم، الاغتراب، نساء السودان المنّسيّات في الحرب، والسِلم، ومسالخٍ بشرية مثل صيدنايا ما زالت باقية. الآن، وكأني أسال القدر، الزمن ضمنه، هل ولِّدنا مهزومين؟ أو أعمارنا ليست كافية، لنشهد انتصارًا مستمرًا وحياة، بلا قتلٍ؟ لكنني أيضًا أرى أننا جزء ممتدًا لنسلًا إنسانيًا مستمرًا، ربما بعدنا، من يأتي يُصارع وينتصر، ومن بعده، يعيش بلا سجن أو منفى. يموت بلا تعذيب أو قتل.
أما أنا، ذات مرة، كنت قد حاولت، خلال البحث عن شيء داخلي، وخارجي، وجدته وافتقدته، الكتابة أكثر عمَّا يدور بنا من مشاعر، مُضطربة، يعيشُها البعض منَّا. وقد صادفني القدر وليله، بكتابة رسالة جنونّية في مأساتِها، نوعا ما، تحمل صرخةً سياسيَّة لا واعيّة، فضلا أنها تحلَّت ببعض من الخمول الجنسي، على الرغم من نشاطه الدائم لديَّ نظريًا، فكريًا، مِخياليًا، وأسعى أن يكون ممارساتيًا، بلطف وحبٍ (وبغزارةٍ، أسخر). واحتفظت بها لي، ولها، الرسالة، لكنني الآن أرى أنّها خرجت من ذاتيّتَي ومدار عيّنيّها، لذواتكم المشاعريَّة بما تحمل، لأنه من المؤكد لديكم، مثلي، “حب مَنقوص”، وتيه مَلعون. أيضًا، اعتبرها رسالة ساخرة، من نفسي، السياسة، الطوائف، الحرب، الرئيس، ونهديّ حبيبتي، هذه اللَعوب الهادئة.
«حبيبتي. لا أعرف، لمن أكتب! تخيلي، يا مَلكتي، أني ذات صباح فائت، ذهبت إلى السفارة التونسية، أسألهم ولا أعرف لماذا؟ ماذا تريدون مني كي أسافر من هنا؟ هكذا فقدت الأمل. هناك ليس لـي وظيفة، ولا سياحة، لكن ربما، أوهمتُ نفْسي أن أجد إنسانًا، لا أكثر. هكذا جنوني، فوضويّتي، أمّلتني. هنا، أنا يا إما مرفوض، مُتجَاهل، أو غير مفهوم، وآمن، لكني مُحب، وطيب، وحساس، وغبي ربما، وهذا لا يكفِ، عن تجارب، لا يكفِ أبدًا.
تجاهلتنِي، اعترفي، اعترفي، كأنك، عن غير قصد، تقولين لـي: اشتعل، التهبْ، واحترقْ أكثر، ولفّ في الشوارع، وحدَكَ، بذاكرتك التعيسة، ودموعك الحبيسة، وعاتب الليل والقمر والوجوه –هذه الوجوه التي لا تحبك– ونفسك، الّعنْها كثيرًا، راجعها أكثر وأكثر، وتذكر عينيَّ جيدًا، التي تصدِّقُها، وتدوّبك، كلُّ ما فيها، صدقها، نعومتها، وحدتِها، وحدَّتِها أحيانا، وقل لنفسك: لا تقصد، لا تقصد. هي خائفة، هاربة، متوترة، وجميلة. طيب، هذه رسالتي لكِ (لا أظن أني سأرسلها)، خافي أكثر، توتري، لأنها بالفصحى، فكري، تحمَّسي، تخيَّلي، جرَّبي، ها أنا هذه المرة الذي أنصحك، وانزعجي من الأذى، أذيتي منكِ، (فمنذ أن أدركت صدقكِ، وجمالكِ، لا أجرؤ تمامًا على جرحك). كما قلتِ بلسانك، أنكِ تخافي من أذيتي. والآن، ماذا تفعلي بصمتك؟ هذا أذى، عقاب. ليس مسؤوليتك، مسؤوليتي والله، مسؤولية كل شيء فيَّ، لساني، عينيَّ، ضحكتي، قلبي، جسدي، وحتى كشّكشة قميصي. طيب، أستطيع كيَّ قميصي، أو حتى تمزيقه، لكن كيف أفعل بي، ذاتي وجسدي؟ هكذا رضيت، أني غير محبوب، كيف أرضى أن أكون غير مُحب، وإنسان!، يمشي، يتكلم، يضحك، ويرقص، مع إنسان يطمئن له، معكِ، هكذا وجودك، وكل شيء منك وفيك، شفتّاكِ تحديدا، كلبشَتني، على غير عادتي، بالأمان لا بالحديد. بهذه الكلمات التي لا أريدك أن تأخذيها إليكِ أو عليك أو منّي، أونِّس نفْسي، وحدتي، كما أؤجل وقت الإفراج عن دموعي. طيب، هذه أنانية، ربما، لا أعرف سوى أني أحاول لملمة أي شيء، ابتسامة سريعة لا تحمل أي قهر، ليكن هذا، أو تقليل سؤال من حولي: ما لكَ؟ متى ينتهي حزنك! والحزن ليس لـي منه شيء. كيف وصلتُ بهذه السرعة للكتابة إليكِ؟ منذ أن شاهدتي الفيلم في بيتي، بجانبي، وأنا أكتب، رسالة أو أكثر، في كل ليلة بعد أن أقابلك، كأني أكتب ما صمتُّ عن قوله، وما قرأتِيه أنتِ في عينيَّ. وهى رسائل، ليست كثيرة، ربما عشرون أو ثلاثون، وأظنني، لن أرسلهم لك، أبدًا أبدًا، مهما حدث، ومهما حرضتني وحدتي، وسَكرتي، (ربما بعد أن أسافر أو قبل أن أموت). وأظنني بعد هذا الفجر، لن أكتب شيئًا آخر. وكيف أكتب؟ عندي ما لا تتخيّليه من الكرامة، الحب، والفوضى. ذات مرة أحرجتيني، فسكتُّ، وقلت في بالي، إنها لا تُدرك سوى البراءة والذكاء والدلال، وكنت صادقًا. وربما مرة أُخرى. لكن ما أهمّ عندي، أني كنت أقدِّم رؤية عينيّك القلقتيّن، يا ست الجميلات، أنا لست طماعا، عيناكِ كثيرة عليَّ وعلى أمثالي، ومن مثلي! معتوه، متمرد، مُفرغ في هذا الوجود. مع ذلك، كنت أقدم رؤية كتفيّك، شعرك، تنورتك، طلاء أظافر قدميك المُثيرتين، على تجاهلك، وكرامتي، فأراسلكِ وأراكِ. هكذا، لكنه الألم، وأي ألم، لا أعرف. ألمٌ يأتيني في كل مرة، قبل القمر وبعده، بشكل غريب، ينخرني ويخنقني، فلم أعدْ احتمل، ولا أعرف كيف أقاوم! حتى السُّكر، الذي يجعلني مسطولًا، مخمورًا، لم يعد مسكنا، بل أصبح نعش لا يدفنني، بل ينهشني بلا حساب. نهش يشفط دمي كل يوم، وكل يوم، في فراغ أسافر، ألف وأدور بخيالي، وأخاف، من المطار، السجن، ووجَّه ضابط أحمق. وكل يوم، آكل، أي طعام، والله لا أدري أي طعم أتذوَّقه. ابتلع، ابتلع فحسب، حتى أني، أحيانًا، فكرت في كيف أبلع نفْسي؟ وليس لـي طعم، سوى الأسى بلا ملح أو حب. الآن، أحاول أن أكتب إليكِ، بلا اضطراب، كلمات هادئة مثل خطواتك، فلا تقلقي أبدًا، فأنا خائف جدَّا، صدقيني، على قلقك، وارتعب من أن تكوني، مثلي، مُضطربة ومُرتجفة. أريدك أن تعيشي بالحب، إن وجدِّتيه، في عين غير عيّني، عيشي، تمسّكي، وتمزَّجي جيدًا، فهو من المؤكد إحساس مُريح، وآمن، وإلَّا لم يكن ليصيبني كل هذا الفزع. ولا أشجعكِ حتى على الرد، إن أرسلت ما أكتب إليكِ. لا تردي. فأنا مريض، ملعون، ولعبة محطَّمة بين قدميّ الله، الذي كفَّرني، أو أنا المراهق، المُستلَب من إرادتي، وجاذبيّتي، حتى من أن اعترف في رسالتي، وأقول، أحبُّكِ، على الرغم أني لن أرسلها. لا تهتمي أبدًا، صدقيني، فات وقت الاهتمام، والهروب أيضا. تعرفي أنني في وقت من الضعف، والخوف المُباغت، فكرت أن أرسل، أترجى المساعدة. ما المساعدة؟ ألا تضيعي، وتُضيّعي عني رؤيتك، أُلفتك. ربما، كنت سأقول: يا ربّة الإغواء والشفاء، أنا كَريه نفسي، فلا تتركيني لمَرضي، حبك. ربما قلت لكِ، في آخر مرة، قبل أن تعطيني عناقِك الدافئ، وسامحيني، فيما معناه، ألَّا تقطعي بي، وكنت لا أقصد سوى اللاشيء، ووصالكِ. فأنا لا أجيد الاعتداء على الحب. أمر عادي، بالنسبة لكل الناكِحين، أما لي، هو قيد الطلب، والدراسة، والأمان، والكلام، فلا أعرف كيف وصلت لكل هذه الرخاوة، والهشاشة، مع أني امتاز بالقوة، والثقة. صدِّقيني، عندي كبرياء كالبحر، والحرب. لكنها كثرة الخيبات، ونهداكِ.. ربما.. لا أعرف».
(1) نظـام الحيـاة المرئـي: هـو الفضاء الواسع الـذي يعيـش داخلـه السـلطة والسـجين معـا، يكون له تأثير مباشر على العلاقة بينهما، واســخدمناه للفصـل بينـه وبيـن النظـام الملفوظ، للمزيد انظـر: محمـد علـي الكـردي، نظريــة المعرفــة والسلطة عند ميشيل فوكو، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 1992، ص 11.
(2) للمزيد عن مفهوم الاستلاب، انظر، فالح عبد الجبار، الاستلاب: هوبز، لوك، روسو، هيغل، فيورباخ، ماركس، دار الفارابي، الطبعة الأولى، بيروت 2018.