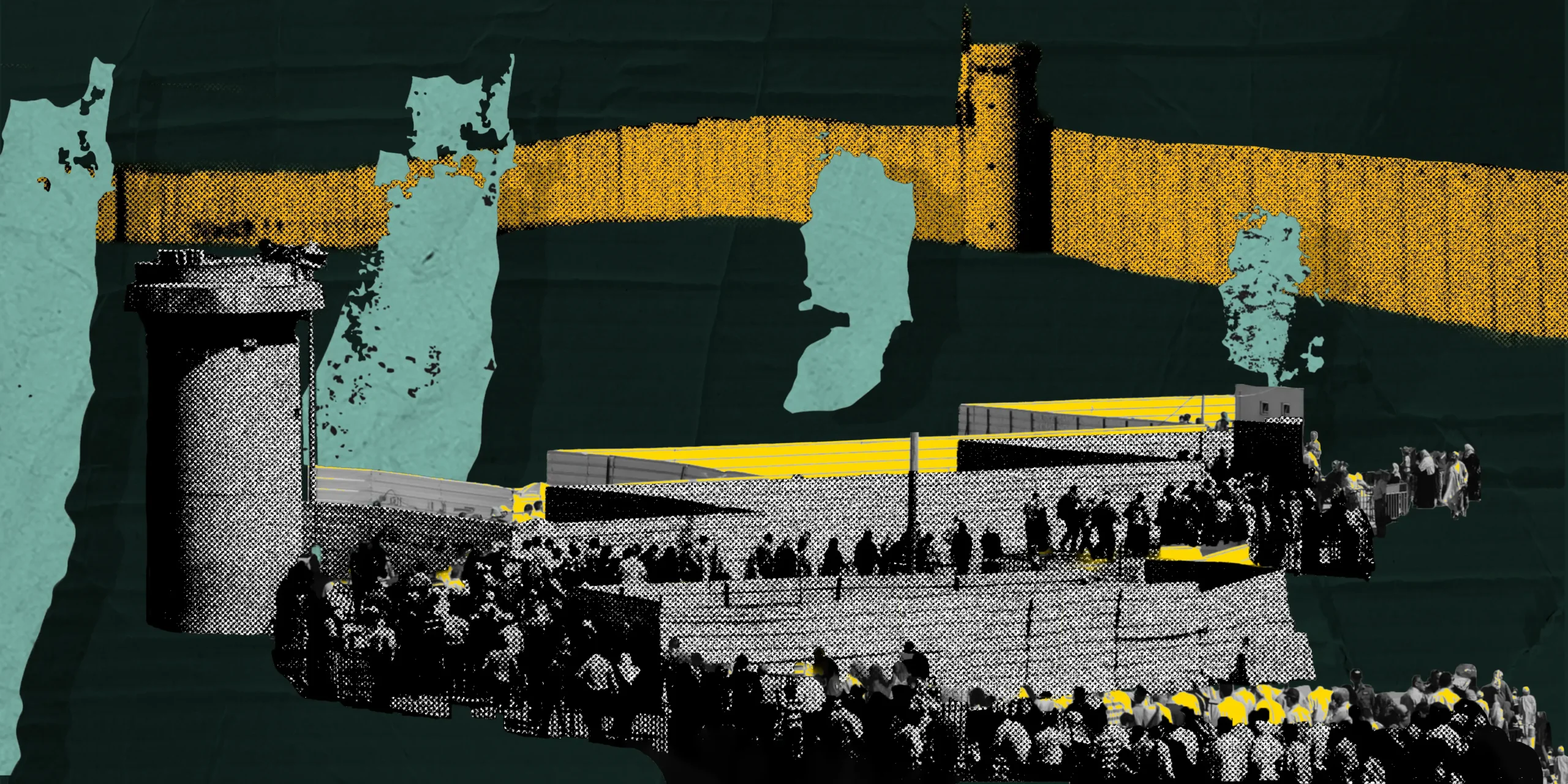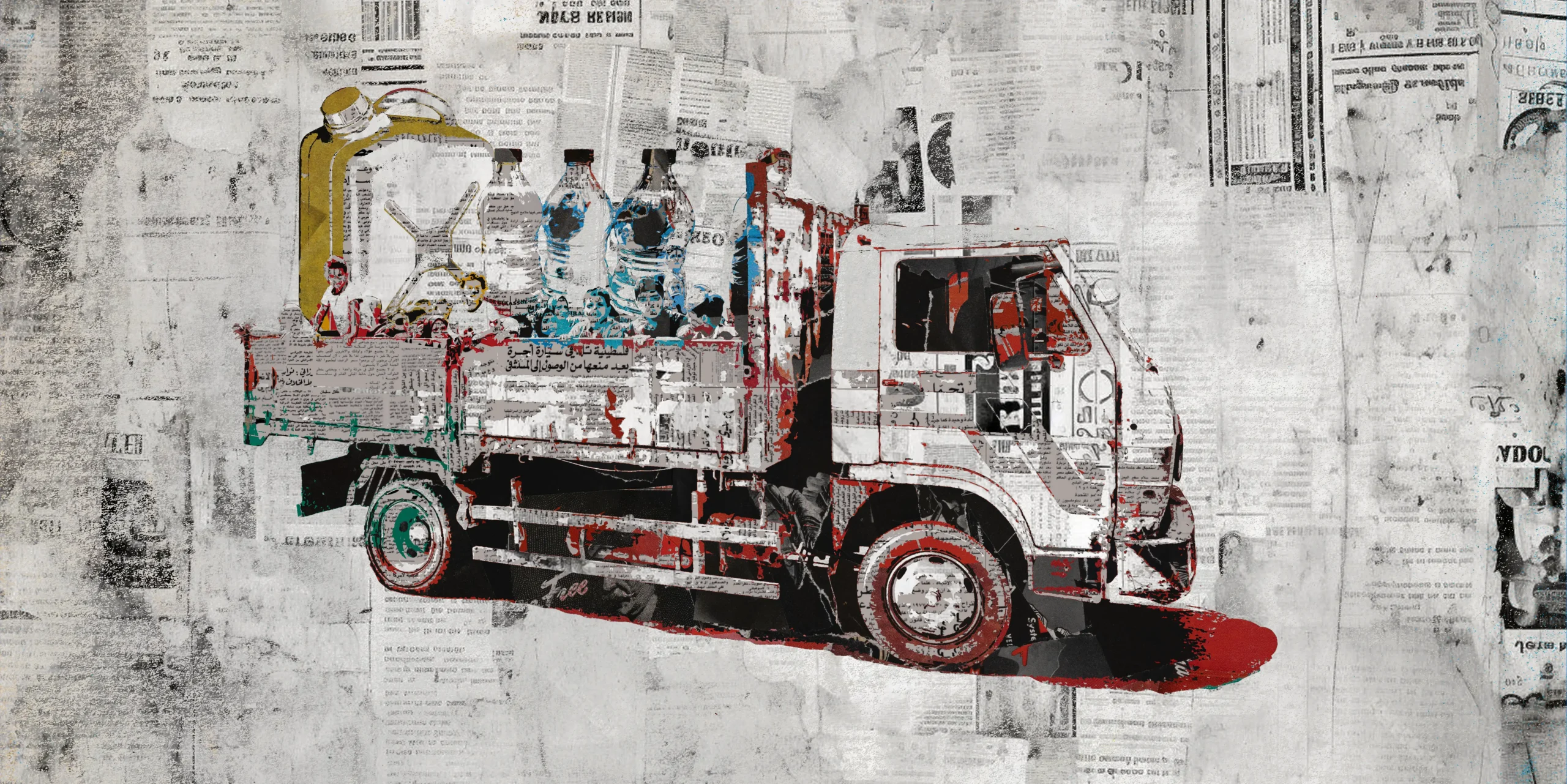عمل أبي كمهندس كهرباء في شركة تابعة للقطاع العام المصري، وقضى أوقات فراغه في إدارة متجر للأدوات الكهربائية يتشارك ملكيته مع إخوته، وعندما باع أعمامي المتجر، وأخذوا قرضًا من البنك لإنشاء مصنع لتجميع المصابيح النيون، كان مرتبه من شركة الكهرباء هو الضامن، وبين زخم الأسلاك والشحنات الكهربائية، تمكن بابا من أن يجد لنا -نحن أبناؤه الصغار- وقتًا للمرح.
قدرة البريزة الشرائية
كان مرحًا من نوعٍ مختلف؛ حيث كان يعود إلى المنزل من المصنع ومعه حقائب ضخمة متخمة بالفيوزات والأسلاك، نجلس جميعًا محاطين بالعدّة ونساعده على تركيب تلك القطع البسيطة يدويًا، أشبه بلعبة مكعبات نتنافس خلالها على من ينتهي من تركيب أكبر عدد من الفيوزات في أقل وقت ممكن، بخلاف أنه كان وقتًا ممتعًا مليئًا بالضحك والمنافسة، كنت أعرف أنني بنهاية تلك الجلسات المنتجة سأحصل واخوتي على زيادة في المصروف، نصف جنيهًا مصريًا كاملًا يُمكننا من الحصول على كيس شيبسي بدلًا من “البريزة” (الاسم الشعبي للعشرة قروش) التي تكفي بالكاد لشراء كيس كاراتيه صغير.
لسوء الحظ لم تمض السنة حتى توقف بابا عن العودة إلى المنزل حاملًا حقائب العدة، فبخلاف أن مكسب المصنع لم يكن يكفي لسداد أقساط القرض المستحقة في أوانها، أيضًا تراكمت الضرائب، وأكثرها قسوة الضريبة العقارية على أرض المصنع التي يمتلكها في الأصل أحد أعمامي، استولى البنك على الأرض لسداد جزء من القرض، وصفّى أعمامي آلات المصنع القليلة، ولعدة أعوام ظل البنك يأخذ مرتب بابا كاملًا ليسدد القروض والضرائب ويحمي نفسه وإخوته من السجن. بالتبعية؛ انقطعت زيادة المصروف وعدنا إلى البريزة وهي المصروف الذي سمح به مرتب ماما وانحشرت وإخوتي مجددًا في قدرة البريزة الشرائية وما توفره لنا من كيس كاراتيه أو باكو بسكويت شمعدان.
للبيع وليست للفهم
يمكن القول انه لأعوام طويلة انحصرت علاقة اللسان الشعبي المصري بالاقتصاد في كلمات محدودة للغاية يختلط فيها ما هو اقتصادي بما هو أخلاقي مثل “الغلاء” و”جشع التجار” و”سياسات التقشف”، أما كلمة مثل “توظيف الأموال” فعرفها المصريون في ثمانينيات القرن الماضي كأقسى تجلي للاقتصاد وذلك على خلفية قضية الريان الشهيرة. ومبكرًا جدًا عرفت في طفولتي معنى “القروض” تلك التي حرمتني من زيادة المصروف. اليوم نجد أن العديد من المصطلحات الاقتصادية قد شقت طريقها بين المصريين، وباتت متداولة في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تحرير سعر الصرف” و”التضخم” و”سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار” وحتى مفاهيم مثل “التحوط” وجدنا أن العديد قد تطرق للحديث عنه وشرحه لتفصيل الأزمة التي يعاني منها المستوردين ولتبرئة ذمة الجشع من القفزات العالية في أسعار المنتجات.
مع كل زيادة جديدة في الأسعار يعود الناس إلى لعبة المقارنات، كم كان سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وكيف أصبح. ابتلعت اللعبة الناس عميقًا جدًا حتى أنهم استشهدوا بسامية جمال في فيلم “الرجل الثاني” (إنتاج 1959) وهي تتاجر في العملة، وعادت فيديوهات الترحم على الحال كما كان في عهد حسني مبارك
القراءة في الاقتصاد ضرورة ملحة، فهو من يتحكم فيما يضعه الناس على موائدهم، لكن يقف جفاف مصطلحاته حاجزًا بيننا وبين فهمه، وعادة ما تستغرق دورة حياة تلك المصطلحات أعوامًا لتظهر آثارها على حياتنا، لكن حاليا يستشعر المصريون بأن نتائجها يومية وأحيانًا ساعة بساعة حيث تتبدل أسعار المنتجات وتتبدل معها أبسط الاختيارات اليومية.
وجب التنبيه، إن كنت ستقرأ قصة الاقتصاد بحثًا عن إجابات تساعد على التكيف مع الأوضاع الجديدة، فلن تجد، وإن كنت تبحث فيها عن رثاء في الفجوة التي تتسع يوميًا ما بين دخلك المادي وقدرتك الشرائية، فلن تجد أيضًا، لأنها ببساطة قصة الرجل الاقتصادي، ذلك العقلاني الذي يسعى إلى تحقيق أقصى منفعة اقتصادية، بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسلوك البشري، بمعزل عن قدرتنا على التكيف أو شعورنا برثاء الذات. هي قصة لمحبي الكوميديا السوداء فإن كنت منهم ستجد فيها ضالتك من السخرية المرة.
نكتة أولى
تداول الجميع مؤخرا فيديو مقتطع من حوار تم عرضه على قناة النهار المصرية، تسأل المذيعة ضيفها المهندس المعماري عن رأيه في العاصمة الإدارية الجديدة فيرد قائلًا: “العاصمة الإدارية الجديدة، دولة جديدة في مصر، إحنا بنعمل دبي جديدة في مصر”.
وطرحت كاترين ماركيل في كتابها “من قام بطهي عشاء آدم سميث؟” الأسئلة الآتية: “قد تعتقد أنه نوع من السخف أن تقع ثالث أكبر حديقة ثلجية مغطاة في العالم في دبي، حيث تبلغ درجات الحرارة في الخارج نحو 40 درجة مئوية في شهور الصيف، ويبلغ الفارق بين درجات الحرارة داخل الحديقة الثلجية وخارجها حوالي 32 درجة مئوية، أما عن مقدار الطاقة اللازمة لتبريد المكان فلا يمكنكم تصورها، ومع ذلك فإننا نسمي ذلك عقلانية اقتصادية. هل الاقتصاد عادل؟ هل يحسن من جودة الحياة؟ هل يهدر الاقتصاد موارد الكرة الأرضية؟ لا يمكن طرح أي من هذه الأسئلة ضمن المذاهب الاقتصادية السائدة اليوم. لكن إذا تساءلنا: لماذا يقام منتجع للتزلج في وسط الصحراء؟ إذا أراد الناس دفع ثمن ذلك فلم لا؟ هذا هو السؤال الوحيد الذي يمكننا طرحه”.
هنا يتوقف الاقتباس من كتاب كاترين ماركيل، فهل أراد المصريون دفع ثمن بناء دبي جديدة على حدود القاهرة؟ هل هناك مذاهب اقتصادية أخرى تحسن من جودة الحياة نلجأ إليها بدلًا من تلك السائدة؟ لم تجد أسئلة مماثلة لنفسها مجالًا في التريند، لكن تم إيقاف المذيعة عن العمل على خلفية ما وصفته القناة بالأخطاء والتجاوزات وذلك في توصيف ملابس المذيعة وطبقة صوتها وطريقة تواصلها مع ضيف البرنامج.
حديقة الثلج في دبي. المصدر: Filipe Fortes. تنشر وفق رخصة المشاع الإبداعي
نكتة ثانية
مع كل زيادة جديدة في الأسعار يعود الناس إلى لعبة المقارنات، كم كان سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وكيف أصبح. ابتلعت اللعبة الناس عميقًا جدًا حتى أنهم استشهدوا بسامية جمال في فيلم “الرجل الثاني” (إنتاج 1959) وهي تتاجر في العملة، وعادت فيديوهات الترحم على الحال كما كان في عهد حسني مبارك، من بينها هذا الفيديو الذي يتحدث فيه الرئيس المخلوع مختالًا عن قدرة “المصريين دول” على ملاعبة صندوق النقد الدولي، تفاخر فيه بالجهود التي بذلها في توطيد صداقاته مع رؤساء الدول الأخرى حتى يجد منافذ للتهرب من اقتراحات الصندوق للاصلاح الاقتصادي، خاصة تلك الصداقة التي ربطته بالرئيس الفرنسي الأسبق شيراك؛ نقل لنا مبارك على لسان صديقه قوله: ما أنا قلت لهم الجماعة الخايبانين دول -هنا شيراك والعهدة على مبارك يصف صندوق النقد الدولي بالخايبانين- ميقفوش ضد أكل، لازم يدوا مصر، ثم يختتم حديثه مزهوًا بثمرة جهوده قائلًا: راح باعت لي 5 آلاف طن سكر..مجانًا”. وتوالت على الفيديو التعليقات المترحمة على دهاء مبارك الاقتصادي، دون أن يسأل أحد إلى أي مدى كان من الممكن أن يصمد اقتصاد قائم على هدايا السكر بين الأصدقاء؟
في الوثائقي “مادوف.. وحش وول ستريت“، نتعرف على واحد من أشهر مستريحيين العصر الحديث، أو كما يطلقون عليه في العرف الأمريكي “بونزي” ، وهو الشخص الذي يوهمك أنه يوظف أموالك ولا يفعل، يجمع رؤوس الأموال من الجميع، في مقابل ربح ثابت مضمون بلا خسارة، أشبه بأسطورة خيالية أجمل من أن تكون حقيقة. أبقى مادوف على نيران احتياله مستعرة لمدة تجاوزت العشرين عامًا، تولى خلالها منصب رئيس بورصة الأوراق المالية نازداك، وساهم في وضع آليات عمل هيئة البورصات الأمريكية وهي الهيئة المسؤولة رسميًا عن اقتراح وتنفيذ قوانين الأوراق المالية لحماية العامة من الاحتيال، حاميها حراميها حرفيًا.
تقتبس ماركيل سؤالًا طرحه ألبرت أينشتاين على نفسه: هل كان أمام الله أي خيار آخر عندما خلق العالم؟ هل هناك بديل غير معروف لقوانين الفيزياء؟ فالعبقري أينشتاين يُشكك في طريقته في التفكير، بينما الاقتصاديون المعاصرون يبدون على يقين تام من قناعاتهم
تكمن المفارقة في قصة مادوف أنه كان بإمكانه أن يُبقي على احتياله لفترة أطول بكثير لولا فقاعة الرهن العقاري التي انفجرت مولدة أزمة عام 2008 المالية، وانهيار العديد من البنوك الأمريكية، مثل بنك “ليمان براذرز”، ذلك البنك تحديدًا الذي رفض التعامل مع مادوف في فترة سابقة لعدم ثقته في أنشطته، أفلس البنك مع انخفاض قيمة العقارات التي منح على أساسها القروض، وأصاب الجميع الهلع؛ الكل أراد أمواله حالًا والآن، ومن بينهم عملاء مادوف، المتوهمين أنه لابد ويوظف أموالهم في أنشطة مماثلة لما تقوم به هذه البنوك المنهارة، عدا أنه لم يكن يفعل بها أي شيء، ولو لم يصبهم الخوف أو يطالبونه بها دفعة واحدة ما انكشف أمره، ولبقيت عجلة الأموال السحرية تصب في محفظته إلى ما لانهاية، أو في قول أخر تمكن مادوف من إيهام عملائه بالأمان طوال عشرين عامًا، ولولا فشل الأنشطة الاقتصادية المشروعة ما انفضح أمره.
ما حدث بدا أنه ساوى بشكل أو بأخر ما بين تطبيقات النظريات الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة فكلاهما أفضى إلى نهاية واحدة وهي الانهيار والأزمات المالية، فهل هناك بديل لهما؟ هذا ليس سؤالي الشخصي بل هو سؤال كاترين ماركيل الذي طرحته بمختلف الطرق في كتابها “من قام بطهي عشاء آدم سميث؟” حيث تقتبس هي الأخرى سؤال طرحه ألبرت أينشتاين على نفسه: هل كان أمام الله أي خيار آخر عندما خلق العالم؟ هل هناك بديل غير معروف لقوانين الفيزياء؟ فالعبقري أينشتاين يُشكك في طريقته في التفكير، بينما الاقتصاديون المعاصرون على يقين من قناعاتهم، تقتبس ماركيل من الاقتصادي البريطاني روبينس قوله: النظريات الاقتصادية هي مجموعة من التعميمات لا تكون دقتها وأهميتها مجالًا للتساؤل والتشكيك إلا من قبل جاهل أو منحرف”.
فما رأيك لو جربنا الجهل والانحراف على سبيل التغيير؟
حدوتة الـ “هي وهو”
في 2015 نشرت النيويورك تايمز مقالًا هامًا عن طبيعة التجارة الصينية في مصر، أقصد بطبيعة التجارة هنا سياقها الاجتماعي والثقافي وليس فقط حجم رؤوس الأموال، كتب الصحفي في مقاله الآتي: “قامت شركة صينية مملوكة للدولة تسمى TEDA ببناء منطقة تعاون صناعي مشتركة بين مصر والصين في العين السخنة (88 كم شرق القاهرة)، توفر تلك المنطقة خدمات عدة للمستثمرين الصينيين، لكنهم عانوا جميعًا من ذات المشكلة: لا نستطيع الحصول على عمالة جيدة خاصة من السيدات؛… “لا يمكنني تعيين الرجال، أخبرني زوزين الذي افتتح لتوه مصنعًا لصناعة المحمول.الرجال هنا في مصر لا يهدأون، يحبون التجول طوال الوقت، ولا يقدرون على التركيز”. لذلك أراد زوزين تعيين النساء، لكنه أدرك سريعًا أن عمالته محددة بغير المتزوجات ومعظمهن يستقلن من العمل بعد الخطبة، أو الزواج، وبعد عام واحد أغلق المصنع”.
طرح المقال فكرة ملفتة، وهي أن دخول النساء إلى سوق العمل في الصين هو من الأسباب المحورية للازدهار الاقتصادي، وهنا اقتبس قوله: “اعتمدت العمالة في المصانع على النساء، يمكن أن تدفع لهن أقل، ويسهل التحكم بهن أكثر من الرجال”. يتحدث الصحفي الأمريكي هنا عن العاملات باعتبارهن نسخة جديدة من البشر، إصدار معدّل من العمال خالي من الشوائب التي تعكر صفو العمل، دون أن يدرك المفارقة في طرحه، فالمجتمع الذي اعترف بدور المرأة في ازدهاره لم يعترف بها لمجهوداتها واتقانها لكن لأنها ترضى بقليله وتطيع.
قضينا عدة أعوام معتمدين فقط على مرتب ماما، بينما هناك رجل اقتصادي في جامعة ما عريقة وبعيدة يخبرنا أن علم الاقتصاد هو تاريخ الأساليب التي نتصرف وفقًا لها في موقف معين من أجل تحقيق الأرباح المالية، وبالتالي عمل أبي الذي مارسه لأعوام ليتجنب هو وإخوته السجن لا يعد محسوبًا
يحكي الوثائقي “مصنع أمريكي” الحائز على جائزة الأوسكار عام 2019، عن رجل الأعمال الصيني الذي أعاد افتتاح وحدة تابعة لمصانع سيارات جنرال موتورز الأمريكية والذي توقف عن العمل مع الأزمة المالية في 2008، يخطب رجل الأعمال في فريقه الصيني الذي يساهم في تشغيل المصنع في أمريكا، قائلًا: “أن القضية ليست متعلقة بالربح المادي لكن بتغيير نظرة أمريكا إلى الصين وقدرات رجالها”، ثم نراه في المشهد التالي وحيدًا في طائرته الخاصة الفسيحة، يتحدث مهمومًا إلى الكاميرا عن أزمة العمال الأمريكيين الكسالى غير المنتجين (رجال ونساء).
تقله الطائرة عائدة إلى الصين للاحتفال بعيد رأس السنة، ويستضيف فريق من العمال الأمريكيين ليشهدوا بأنفسهم على سير العمل الدؤوب في المصانع الصينية، وأثناء جولتهم يسأل أحد العمال الصينيون نظيره الأمريكي منبهرًا إن كانوا حقا يحصلون في أمريكا على إجازة أسبوعية، وعاملة أخرى تخبر الكاميرا أن لديها ابن في بلدتها البعيدة ترعاه أمها وتزورهم مرة واحدة في السنة، تنظر إلى المصور مبتسمة وهي تقول: “مجهدة لكن ليس لدي خيار”.
مشهد من الوثائقي “مصنع أمريكي”. المصدر يوتيوب
المرأة كرجل اقتصادي
لدي جارة طبيبة وزوجها طبيب يعمل كلاهما بداوم كامل، وفجرًا عندما استيقظ لأجهز ابني للمدرسة، أسمع صوت عاملتهم المنزلية وهي تدق جرس بابهم، وأتساءل متى تستيقظ لتصل إلى هنا في هذا الوقت المبكر جدًا؟، وفي أحدى المرات وجدتها تقف خلف أحد أعمدة العمارة، تحمل هاتفها وتخاطب طفل في محادثة فيديو وهي تبكي.
كلما أتينا على ذكر للعمالة المنزلية نفتح عالم ممتلىء بالأزمات، تلك المهنة التي تتخطى مناوبة عملها أكثر من الدوام الكامل إلى العمر الكامل، وتسخر أفلامنا المصرية من موظفة الحكومة التي تُفصص البازلاء في المكتب، وإن لم تفصصها تتهمها بالأنانية وبالإهمال، وفي سياق آخر تستعين فيه السيدات بعاملة منزلية تفصص لها البازلاء نتذكر أن لتلك العاملة أطفال تركتهم في بلدها وترعاهم أمها، وهناك حد أدنى من الأجر لتلم العاملة شمل أسرتها، لا تستوفيه أبدًا، وإذا حدثت معجزة وجاءت بهم سيحتاجون بدورهم إلى عاملة ترعاهم، ففي كل مرة تصبح فيها المرأة رجل اقتصادي تحتاج إلى من يرعى صغارها، ومع ذلك يصرون أن صورة الفرد في قصة الاقتصاد غير جنسانية، وحسب ماركيل لابد أن يكون هناك شخص عاطفي حتى يكون هو عقلانيًا ولابد أن يكون هناك شخص تابع حتى يكون هو مستقل.
السقوط من النظرية
في الوقت الذي كان يجرب فيه رجال عائلتي حظهم مع المتاهات الاقتصادية ما بين التجارة والقروض والانتاج وانتهاءً بالاستيراد من الصين، كانت ماما ترفض أن تُفصص أي خضار في عملها، ولقربه من منزلنا كانت تستأذن خلال اليوم مرتين؛ في الأولى تعود إلى البيت لتضع الطعام الذي جهزته بالأمس فوق البوتاجاز، وفي الثانية لتطفىء البوتاجاز بعد تمام نضجه، وقد يمضي الأسبوع وكل ما نعرفه عن بابا أنه عاد متأخرا جدا فما زال نائمًا، أو لديه الكثير من العمل وغادر ونحن نائمون.
ومع كل هذا العمل قضينا عدة أعوام معتمدين فقط على مرتب ماما، بينما هناك رجل اقتصادي في جامعة ما عريقة وبعيدة يخبرنا أن علم الاقتصاد هو تاريخ الأساليب التي نتصرف وفقًا لها في موقف معين من أجل تحقيق الأرباح المالية، وبالتالي عمل أبي الذي مارسه لأعوام ليتجنب هو وإخوته السجن لا يعد محسوبًا مع أن من يقوم به رجل وعقلاني وفي سياق اقتصادي سائد لكنه لا يحقق منفعة خاصة فلا يعتد به في علم الاقتصاد ولا يؤثر على اتخاذ القرار.
اختتمت كاترين ماركيل كتابها بفقرة متفاءلة قائلة: “ينبغي أن ينظر علم الاقتصاد إلى الإنسان على أنه شخص يتصرف وفقًا لعلاقاته وصلاته بالآخرين وليس وفقا للمنفعة الخاصة وإنكار كل السياقات، وسيكون من الممكن حينها تغيير هدف الرحلة، أن ننتقل من محاولة امتلاك العالم إلى محاولة الانتماء إليه”.