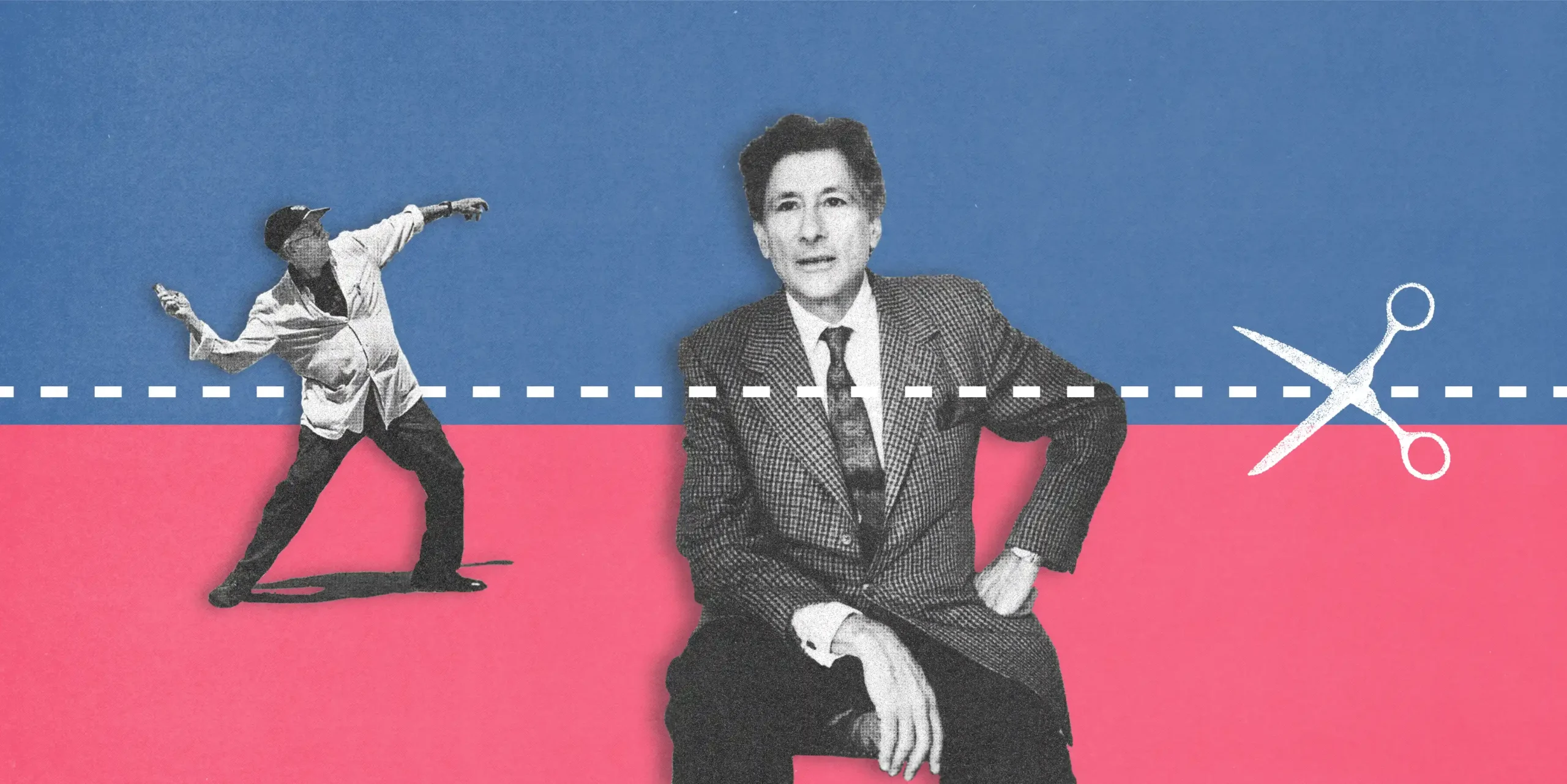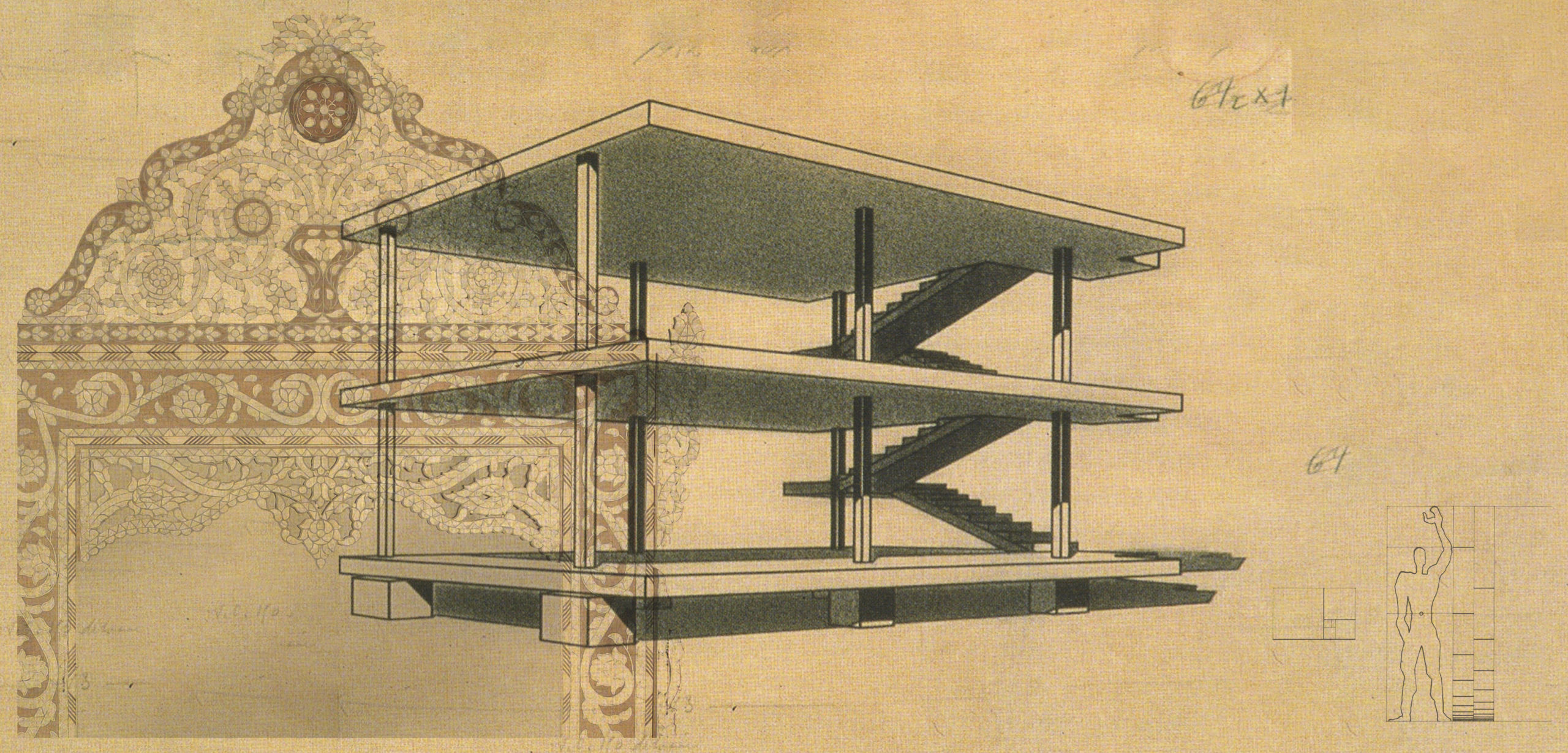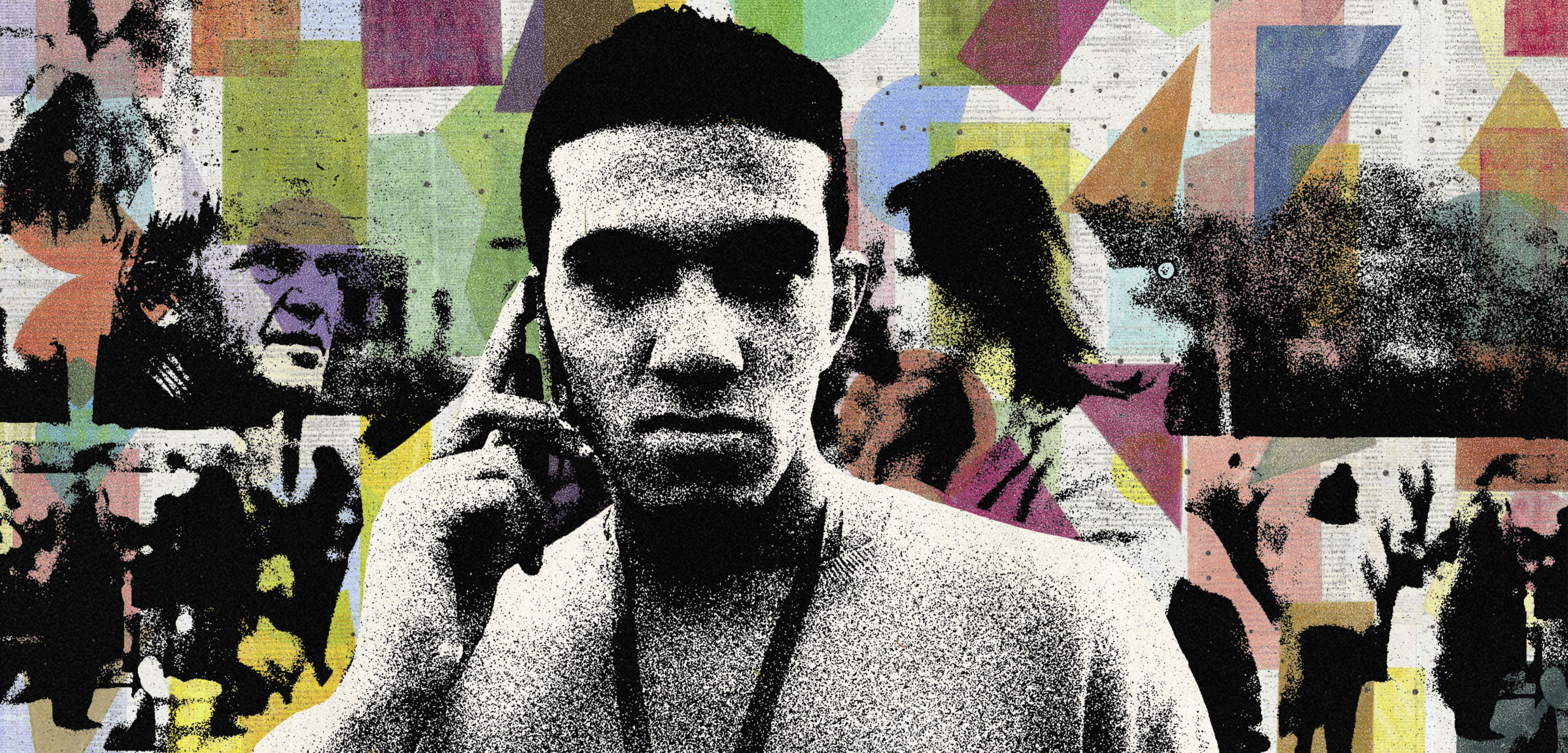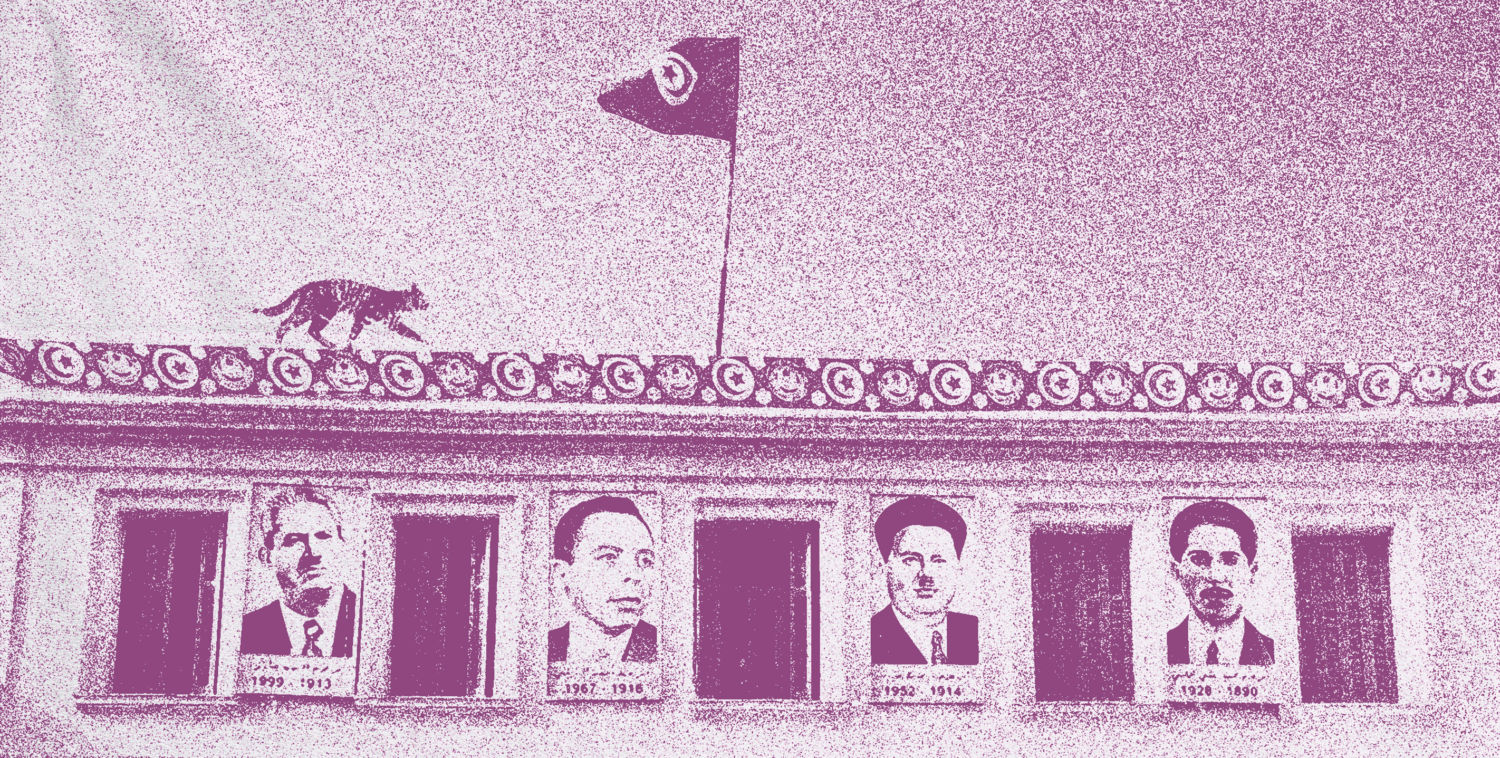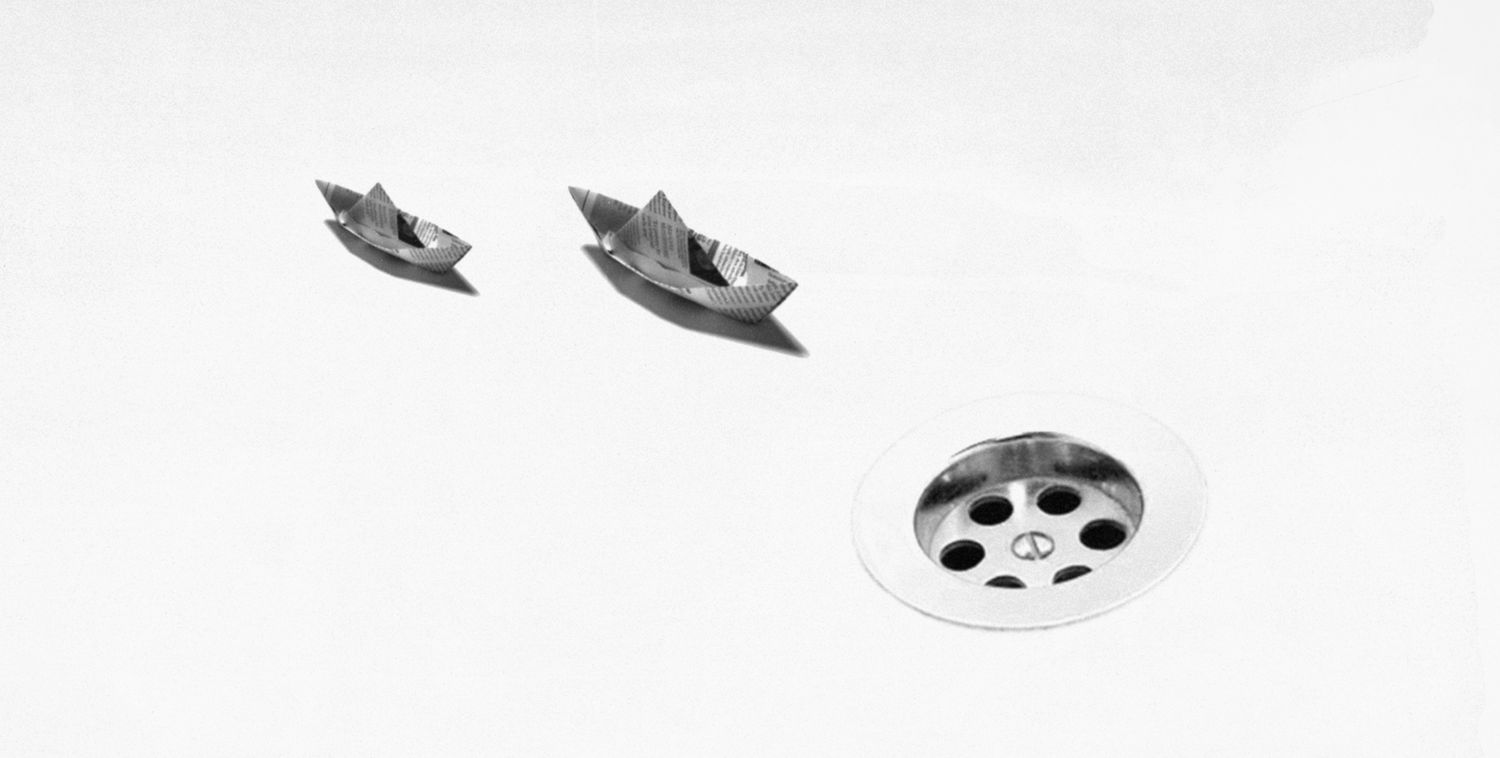حين أتت والدتي إلى عمّان من القاهرة، وبعد أشهر من وصولها، قالت لي يومًا: “ثمة صوت في أذني لا يغيب، مستمر طيلة الوقت، لا يمكنني أن أتخلص منه منذ أن أتيت إلى هنا! صوت أشبه ما يكون بزنّةٍ ما”.
نظرًا لأنني أسكن خارج عمّان، وتحيط ببيتي غابات لا يسمع لها صوت أغلب ساعات اليوم، فهمت شكواها، فأجبتها: “صوت يشبه حرف نون مستمر؟!”، أجابتني: “نعم!! هو كذلك!”
“إنه صوت الصمت يا أمي!”
***
في كتابها، صغير الحجم نسبيًا، The Streets are Talking to Me ، تشير الباحثة ماريا فريدريكا مالمستورم، إلى التحولات الصوتية للقاهرة، مباشرةً بعد 2013، باعتبار الصوت في القاهرة، هو نص مديني لها، كما هو العمران أيضًا نص مديني، يخضع بدوره لشكلٍ ما من علاقات القوة والهيمنة، فتقول: “اختلفت نوعية الصوت وأشكاله في القاهرة في العام 2013، بعد خلع الرئيس المصري محمد مرسي. كان النص الصوتي حينها يملؤه العنصر البشري، كان فضاءً عامًا مفتوحًا. لكن بعد أسابيع بدأت المساحة الصوتية للمدينة تختلف ويغلب عليها العنصر الآلي في مقابل إسكات الصوت البشري”.
تنبهنا ماريا -على ركاكة مقارباتها، عامةً في الكتاب- إلى مضامين سياسات الصوت المديني السياسية والاجتماعية، وكيف أن الصوت كان جزءًا من تشكيل الجماعات ورسم الحدود المكانية والمدينية لهم، وأن تحولات النسيج الصوتي ليست معزولة عن علاقات القوى، وتأثيراتها السياسية، وهو ما نحاول هنا إلقاء الضوء عليه.
صوت مقابل صوت
شخصيًا، أتذكر كيف كان الأمر يوم جمعة الغضب (28 يناير 2011)، كان ثمة نص صوتي يصاحب الثوار ويرسم حدود وجودهم وحركتهم في المدينة (القاهرة)، وفاعليتهم Agency، في مقابل نص صوتي آخر في الناحية المقابلة، من ميزان القوة والمواجهة في المدينة.
فالثوار يحيط بهم صوت التكبيرات الحارة من المساجد، وكذلك الصفير، والصراخ، أبواق الدراجات النارية، والطرق على أي جسد معدني (أعمدة الكهرباء، الأسوار الحديدية للحدائق والأسيجة، أو قضبان مسارات المترو، بل وحتى كانت هناك الأواني النحاسية والمعدنية أيضًا، من البيوت)، وكان لكل صوتٍ من هؤلاء دلالته ومساحته الحيزية، والأهم إعطاء معنى للحيز وعلاقاته وأشكالها مع الأحياء المجاورة (مواجهة، احتواء، أو غيره)، الأقرب لترسيمات الأمكنة المحررة.
بل أن كان للصوت حينها قدرته على التحكم في الأجساد البشرية حوله، وضبط حركتهم ومعناها وترميزاتها، والمسافات البينية، وتعريف الحيز الآمن من غيره.
أي أن تلك الأصوات كانت شكلًا من أشكال استعادة المدينة، بشكلٍ ما أو بآخر. في المقابل، كان ثمة نسيج صوتي لقوات الأمن، وهو متداخل إلا أنه منتظم برتابة حداثية آلية صلبة ومتتابعة (كما يصف إيريك هوبزباوم أصوات القرن الحادي والعشرين). يتكون من صفير سيارات الشرطة، إطلاق الرصاص، ضرب جنود الأمن المركزي الأرض بأرجلهم بانتظام جماعي رتيب، يصاحبه صرخة جماعية، وضربة على الدروع، في مشهد حربي بدائي، بقصد الحرب النفسية، مستفيدين من ارتدادات الصوت بين البنايات كان هذا النسيج لا يهدف إلى إنتاج مكان في ذاته، فقط، بقدر ما كان يكسر حدود المكان بإنتاج حالة نفسية خاضعة، ترسم حدود سيطرة السلطة في المواجهة.
كانت صفارات قوات الأمن تعمل على الدوام برغم غياب المواجهات، كان الغرض من ذلك استعراض قوة سماعية/صوتية، أحادية، تخلخل الفضاء العام والخاص، معًا..
كانت حركية النسيجين الصوتيين تحدد نطاقات المواجهة وتفاصيلها، فمثلًا زغاريد النساء من الشرفات، وتصفيقات البعض، كانت تظهر مع كل انسحاب لقوات الأمن في المواجهات، فنعرف حينها أن ثمة أرضًا جديدة في المدينة اكتسبناها، في المقابل كان صراخهن يعلو حين تشتد المواجهات، أو حينما يتراجع الثوار.
وفي داخل مساحة الثوار الصوتية، كان النداء بالصفير يعني التنبه لطارئٍ ما في مكانٍ ما يستدعي النفير له (كذلك كان الحال في اللجان الشعبية عند البيوت وفي الحارات والأحياء المختلفة).
كنّا نعي مساحاتنا ومناطق هيمنتنا في المواجهات بتكبيرات المساجد، فمتى علت تكبيرة من مسجد ما كان ذلك يعني تقدمنا على قوات الأمن، أو أن شهيدًا ما قد سقط. في الأمر سلوك أقرب ما يكون للسلوك الحيواني في تحديد وترسيم الأماكن والأقاليم والسلطة عليها؛ يُسمع زئير الأسد مثلًا، من حوالي 10 كليومترات، الهدف منه تحديد نطاق السيطرة، وكان التداخل بين كل تلك النصوص الصوتية هو تمثيل لعلاقاتنا مع المدينة.
في فترة انسحاب قوى وزارة الداخلية، وفتح السجون، كان أحد أهم أدوات الصراع النفسي وانتزاع الحيز المديني، هي صفارات الشرطة، فقد كانت سيارات الشرطة تتسلل إلى أطراف الأحياء السكنية، لتطلق صفاراتها ثم تلوذ بالفرار، فتشتت فرق اللجان الشعبية، ليبدو الأمر وكأنه محاولة اقتحام الحي من قبل قوات الشرطة التي تحضر في ذاكرة الناس حينها باعتبارها قوات قتل الثورة والثوار، والتمثيل بجثثهم، وإطلاق المجرمين من السجون!
لعل من أكثر الفترات كثافة من حيث حجم النص الصوتي ودلالتها، كانت فترات “حظر التجول”، كانت تلك الفرصة الأنسب للسلطة العسكرية لفرض نص صوتيٍ ما على المدينة، ليترسب في تجربة مدينية فريدة وهي حظر التجوال. فكانت صفارات قوات الأمن تعمل على الدوام برغم غياب المواجهات (أليس حظرًا عسكريًا للحركة!)، كان الغرض من ذلك استعراض قوة سماعية/صوتية، أحادية، تخلخل الفضاء العام والخاص، معًا، وتنقل سطوة القوة إلى البيوت والأجساد، باعتبارها المساحات الخاصة والشخصية.
غلبة صوتٍ على آخر، ليست فقط لأنه صوت أعلى فقط، لكنه صوت حركة اجتماعية واقتصادية وسياسية وهوياتية وجندرية وأكثر، تشتبك مع الأصوات الأخرى و/أو تتواطأ معها وتتداخل.
تلك كانت الحالة المتطرفة في القياس؛ الثورة، إلا أنها أيضًا فترة انفلات لسياسات الذاكرة والنسيان الصوتية، بما هي أولى أدوات السيطرة والهيمنة المكانية المدينية. والسياسات الصوتية فيها مفهومة بحكم المواجهة المباشرة. لكن في الأحوال العادية، للمدينة نص صوتي لا يقل مركزية عن النص المكاني، يخضع لما يخضع له اليومي المعاش في القاهرة من منظومة قوة وهيمنة.
فكما نستطيع قراءة سطوح الأمكنة والمساحات والفارغات والبنايات والعمران والشوارع، فكذلك العلاقات الصوتية والموسيقية في المدينة. فغلبة صوتٍ على آخر، ليست فقط لأنه صوت أعلى فقط، لكنه صوت حركة اجتماعية واقتصادية وسياسية وهوياتية وجندرية وأكثر، تشتبك مع الأصوات الأخرى و/أو تتواطأ معها وتتداخل.
من يسيطر على الصوت؟
بمناسبة الحديث عن الصوت، لنا هنا أن نشير إلى أن مركزية العين وتاريخها الثقافي يهيمنان على إدراكنا الحداثي، حتى أننا أغفلنا أن نموذج السجن (بانوبتيكون بانثام) الذي أسس به فوكو نظريته عن السلطة والهيمنة، لم يكن مجرد برج للمراقبة في وسط جسد السجن، يعكس حضور الرقابة والهيمنة والضبط، بالمعنى البصري الغائب، بل هو أيضًا شبكة من المواسير المعدنية الممتدة إلي الزنارين لنقل الأصوات وجمعها.
أهمل فوكو ومعاصروه جانب السمع هذا، لصالح استعارة بصرية للسلطة. لكن المدينة – أي مدينة، وليست القاهرة وحدها- بما هي بؤرة تمثيل الدولة، وتجسيد هيمنتها المؤسساتية والعمرانية، هي نص بصري وسماعي أيضًا، تنطبق على كلاهما كل علاقات السلطة والهيمنة.
للصوت أهميته في جسد المكان المديني، إذ يذكر مثلًا أن القدرة على تسجيل/تثبيت/احتفاظ/إماتة الصوت، كانت إحدى خواص الآلهة الثلاثة، بجانب: “الحرب” و”المجاعة”، وذلك بحسب الأسطورة الأوروبية القديمة (Gaelic Myth). وهذا التماهي السلطوي مع الآلهة، يمكننا ملاحظته في خطبة سابقة لأندريه جدانوف أحد مستشاري ستالين لشؤون الآداب والفنون في الحزب الحاكم، والذي ينسب إليه مذهب “الجدانوفية” المتشدد في الفنون و الآداب، يقول فيها، مشيرًا إلى الموسيقى:
“نحن نواجه تيارين من الموسيقى السوفيتية، أحدهما صحي وتقدمي، مبني على الدور الأساسي والضخم للإرث الكلاسيكي لصراع الطبقات، وتحديدًا المدرسة الروسية للموسيقى، وما فيها من مخزون فكري صادق وواقعي، نابع من الرباط العضوي بين الشعب وأصواته وموسيقاه. أما التيار الثاني فهو دخيل على الموسيقى السوفيتية، إذ ينبني على الرفض المغطى و المقنع بقناع من التجدد والإثارة و الإختلاف، ورفض خدمة الشعب برفض موسيقى الشعب، وذلك بتغذية أعمق نقاط الحس الفردي للجمالية”.
سرعان ما يدفع بنا هذا الاستدعاء إلى الخلط بين الصوت والموسيقى في المدينة، لكن لا بأس من بعض الاستباق، في البدء بالموسيقى والغناء لندرك الصوت، وموقعه من المدينة بما هي أرشيف المادي (العياني) والصوتي (السماعي). ولنتأمل شكلًا من العلاقة بين الموسيقى والسلطة في القاهرة..
سلطة الطمس والنسيان
الصراع بين نقابة الموسيقيين المصرية (يمثلها هاني شاكر بكل رمزيته الدولاتية والمؤسساتية والتاريخية، في الثقافة الرسمية) وبين مغنيّ المهرجانات (بكل رمزيتهم الاجتماعية والطبقية) هو صراع على الذاكرة السماعية للمدينة ومساحاتها ونصها، أي ما نتذكره سماعيًا من المدينة في فعلنا الجسدي اليومي المديني (المشي والمرور والمعايشة اليومية)، وكذلك النص الصوتي لها كبنية من العلاقات والمواقع التداولية.
بالحفر عاموديًا في استقطابات هذا الصراع ومبناه، يمكننا النظر إلى المدينة باعتبارها أرشيفنا المادي والجسدي اليومي، إلا أنها أيضًا أرشيفنا الصوتي.
الصراع هنا على الذاكرة، فسياسات الدولة المصرية في القاهرة لإزالة المعالم التاريخية لها وحتى الحالي منها (في حيي الأثير؛ “هليوبوليس”، أزيلت أشجار فاق عمرها الـ 150 عامًا، وتغيرت طرق ووُسعت، وتحول الحي إلى مجموعة من الجسور الكبرى، لتصبح التجربة المدينية هي حالة عبور ممتدة فقط، بحجة التطوير، وهو ما انعكس على النص الصوتي في الحي). ما يحدث هو هجمة على الذاكرة اليومية المعاشة، والأمر نفسه بشأن نصّ المدينة الصوتي، بعيدًا عن موقفنا التذوقي (الذائقة) منه.
سياسات الذاكرة والنسيان هنا تتحول إلى سياسات طمس وإظهار، بناءً على كل حساسيات التحيزات المختلفة والتقاطعية: الطبقة، الجندر، الحضارة، والسلطة، وغيرها.
إن مدننا بما هي أرشيفنا الحي عن ذاكرتنا وذكرياتنا اليومية المعاشة، هي المستهدفة بكل سياسات الدولة الحديثة ذات الطابع العسكري، وسياساتها الحيوية على/في الحيز المديني العام، والتي باتت ممتدة إلى الحيز الخاص أيضًا، بهدف إعادة تشكيل مخيالنا اليومي وعلاقتنا بكل أشكال وممارسات التعبير عن ذواتنا الفردية والجمعية..
لعلنا هنا نتذكر في الثمانينات أمرًا مشابهًا، حين صعد نجم “علي حميدة”، وأغنيته الشهيرة “لولاكي“، ليتصدى له نموذج لا يختلف كثيرًا عن نموذج هاني شاكر المسلح بكل أدوات التصنيف الطبقي والجندري والعنصري والسلطوي، وفي ظهره دولة معسكرة ومنظومة ثقافية لا تقبل التنوع، وهو الملحن المصري حلمي بكر، الذي قدم نفسه عرّاب الموسيقي والتلحين والغناء، وبابهم العالي، والذي لسوء حظ حميدة لم يمر من هذا الباب بشكل طقوسي يعلن من خلاله خضوعه للثقافة الرسمية الدولانية.
بكر في أحد البرامج الحوارية حينها، قال ما معناه: “دي مش أغنية، دي دوشة راعي غنم”، ما إضطر حميدة أن يرد الإهانة ومحمولاتها لصاحبها، فأجاب: “مالهم اللي بيرعوا غنم؟!”. لم يدرك حميدة حينها أنه بذلك إنما يواجه السلطة بشكل أدائي معلن، كاد يكون هذا سببًا في توقفه بعد تلك الأغنية، وانمحائه من الذاكرة الشعبية تقريبًا دونها.
لا تختلف تحيزات بكر التقاطعية تلك، ضد راعي الغنم، من حيث مبدأها عن تحيزات هاني شاكر تجاه “ويجز”، الذي وصفه بأنه خريج الجامعة الأمريكية في القاهرة، وهو ما يضمن له المرور من ضبطية هاني شاكر القضائية سليمًا، معافى، بل وأن نقيب الموسيقيين شرعنه.
الأمر هنا له جذوره، فسياسات النسيان هنا بطمس أصوات موسيقية وغنائية معينة في القاهرة، إنما هي إسكات للشوارع، وهي الخطاطة السمعية الطبقية. يمكننا تتبعها وأثرها الجدلي في الصحافة والمؤسسات السياسية والإعلامية حول “الضوضاء”. فهي تمثلات لمخاوف طبقية (الطبقة الوسطى، والوسطى العليا) من الطبقات الاجتماعية “عالية الصوت”.
هنا تمثل الضبطية القضائية الممنوحة لنقيب الموسيقيين، امتدادًا لمحاولات الدولة المستمرة لضبط الأصوات والأجساد، متمثلة في قوانين وتراخيص الباعة الجائلين وتنظيم نداءاتهم ومواعيد عملهم وكذا قوانين مكافحة التشرّد والتسوّل، وكل استهداف لتلك الطبقة ماديًا ورمزيًا، وليس جسديًا واقتصاديًا وحيزيًا فقط.
هنا ينكشف لنا من يملك حق تعريف حزمة من الأصوات على أنها ضوضاء أو أصوات رعاة غنم، وما يعنيه ذلك من سياسات الهيمنة على الحيز العام والخاص والوجود الزماني والمكاني.
في مبنى هذا الصراع نجد الشفاهة والكتابة بما هما سياسات ذاكراتية (ونسيانية)، تتوازى بين الكتابة الُممأسسة بالقوانين والإجراءات، والمؤسسة والعمل النقابي المنظم والموسيقى الممأسسة من خلال بنية أوبرالية وتوزيع موسيقي هرمي من أعلى لأسفل، تتحرك وكأنها البنية المؤسساتية للموسيقا والغناء العربي، وخلفها الثقافة الرسمية الدولاتية ونصيبها من كتابة التاريخ والثقافة الرسمية، بكل ما يعكسه موقع هاني شاكر، كبؤرة، في كل هذا النسيج.
في المقابل الشفاهة بما هي ممارسة مجتمعية أقل هيراركية ورأسية من ناحية المضمون والبناء والأداة والمعنى وشكل العلاقات واجتماعياتها، وهنا نجد موسيقى المهرجانات ومحمولاتها المجتمعية غير الرسمية، واعتمادها على تحويرات الصوت والآلة، وانتاج تعريف مغاير للضوضاء.
(الأمر يشبه كثيرًا موقف فناني الثقافة الرسمية للدولة والتيار الأساسي فيها من فيلم ريش (2020) الذي عرض في مهرجان، حيث تكررت الحجة أن تلك “الصور” ليست من مصر، وكأن لمصر صورة بصرية واحدة، ونص صوتي واحد).
مساحات هيمنة صوتية
في مشهد مديني آخر، من بعد 2014، تراكبت فيه السلطة والمدينة، وهو انتخابات الرئاسة والتصويت على الدستور، وكذلك البرلمان، حيث طغى نص صوتي تماهت معه الدولة، ليُقدم بشكلٍ أدائي معبرًا عن المدينة والسلطة المركزية فيها: الدولة، وجرى تعريف الجسد المديني، الدولاني، والطبقي، حينها بطقوس رقص مبتذل.
طغى على أغلب تلك المشاهد الانتخابية صوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وأغنيته بشرة خير، وأيضًا أغنية تسلم الأيادي، حسين الجسمي له فرادة موقع Positionality تمنحه الحق في تقديم نص صوتي دولاني لفاعلية المواطنة المصرية من بعد 2013.
أغنية “تسلم الأيادي”، وهي التي انتشرت بعد فض اعتصام “رابعة العدوية” (2013)، ويمتد فيها الامتنان للـ”أيادي”، وإن كان مرتبطًا بمذبحة، إلى دور “المؤسّسة العسكرية” في الثورة منذ بدايتها 2011، ما ضمّ أحداثاً بعينها مثل: مجلس الوزراء، الحرس الجمهوري، رابعة، ماسبيرو، مجلس الوزراء، وزارة الدفاع وغيرها.
المضمون الأدائي والخطابي في هذا النص الصوتي والموسيقي، إنما يهدف إلى ترسيم مساحة الهيمنة للمؤسسة العسكرية على المساحات المدينية والأجساد التي بها، وفي القلب منها المقرات الانتخابية، بما هي استحضار للقوة السياسية، وفي القلب منها مفهوم الدولة الذكر الألفا، الخاضعة بدورها لذكر ألفا.
لا يمكننا، حينها، بحال من الأحوال فصل السياسات التعبيرية الجسدية (الحركية: كالرقص أمام اللجان الانتخابية) عن التاريخ الجسدي للسياسات الحيوية التي صاحبت الأحداث السياسية التي تدخل فيها الجيش منذ 2011، وأن كل التعابير الحركية الراقصة، إنما هي تعابير دائرية حول مركز الذكر الألفا، حيث تتجسد فيه -بالمعنى الجسدي- الدولة، وحوله تدور باقي الأجساد الأدنى، بكل توزيعاتها الجندرية والاقتصادية والسياسية والطبقية، كل ذلك يحمله النص الصوتي/الغنائي.
في الذاكرة الصوتية نفسها للقاهرة وأمام طقوس الانتخابات، انتشرت أغنية “بشرة خير” لنفس الفنان. والأغنية تقوم على “نفي” رمزي، للأنثى في هذا الـ”خير” أو حتى الـ”تبشير” به. وهو ما نراه من طمسٍ لها في الدور السياسي والاجتماعي المتخيّل في خطاب الأغنية، إذ تقول: “قوم نادي ع الصعيدي، وابن اخوك البورسعيدي، والشباب الاسكندراني، اللمه دي لمة رجال”، مايحدث هو ترسيم للحير الدولاتي States Territory من خلال أجساد الذكور فقط، ومنحها حصرًا دور الفاعلية، فالوطن والانتخاب هو “لمة رجال”.
بالنهاية يمكننا القول أن مدننا بما هي أرشيفنا الحي عن ذاكرتنا وذكرياتنا اليومية المعاشة، هي المستهدفة بكل سياسات الدولة الحديثة ذات الطابع العسكري، وسياساتها الحيوية على/في الحيز المديني العام، والتي باتت ممتدة إلى الحيز الخاص أيضًا، بهدف إعادة تشكيل مخيالنا اليومي وعلاقتنا بكل أشكال وممارسات التعبير عن ذواتنا الفردية والجمعية.