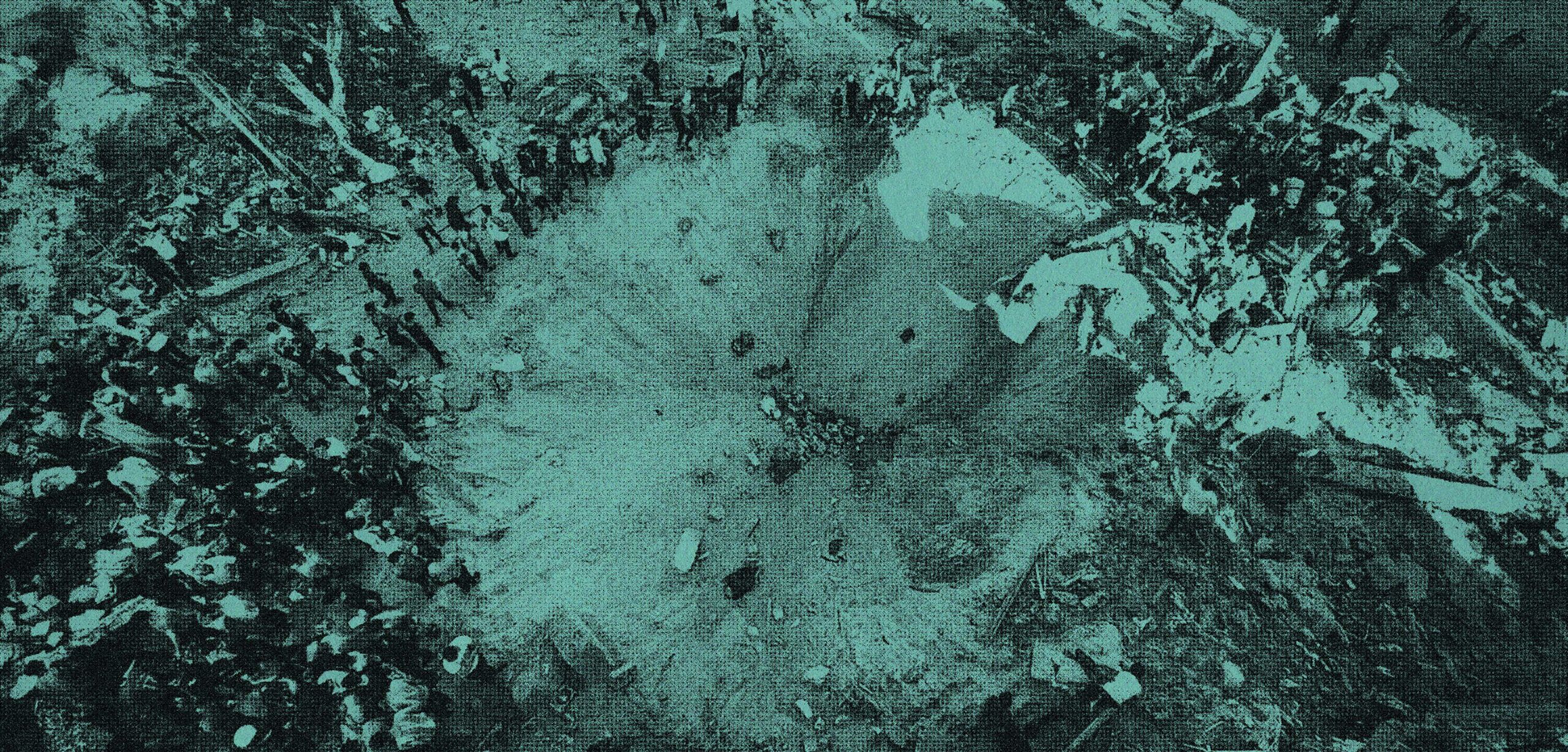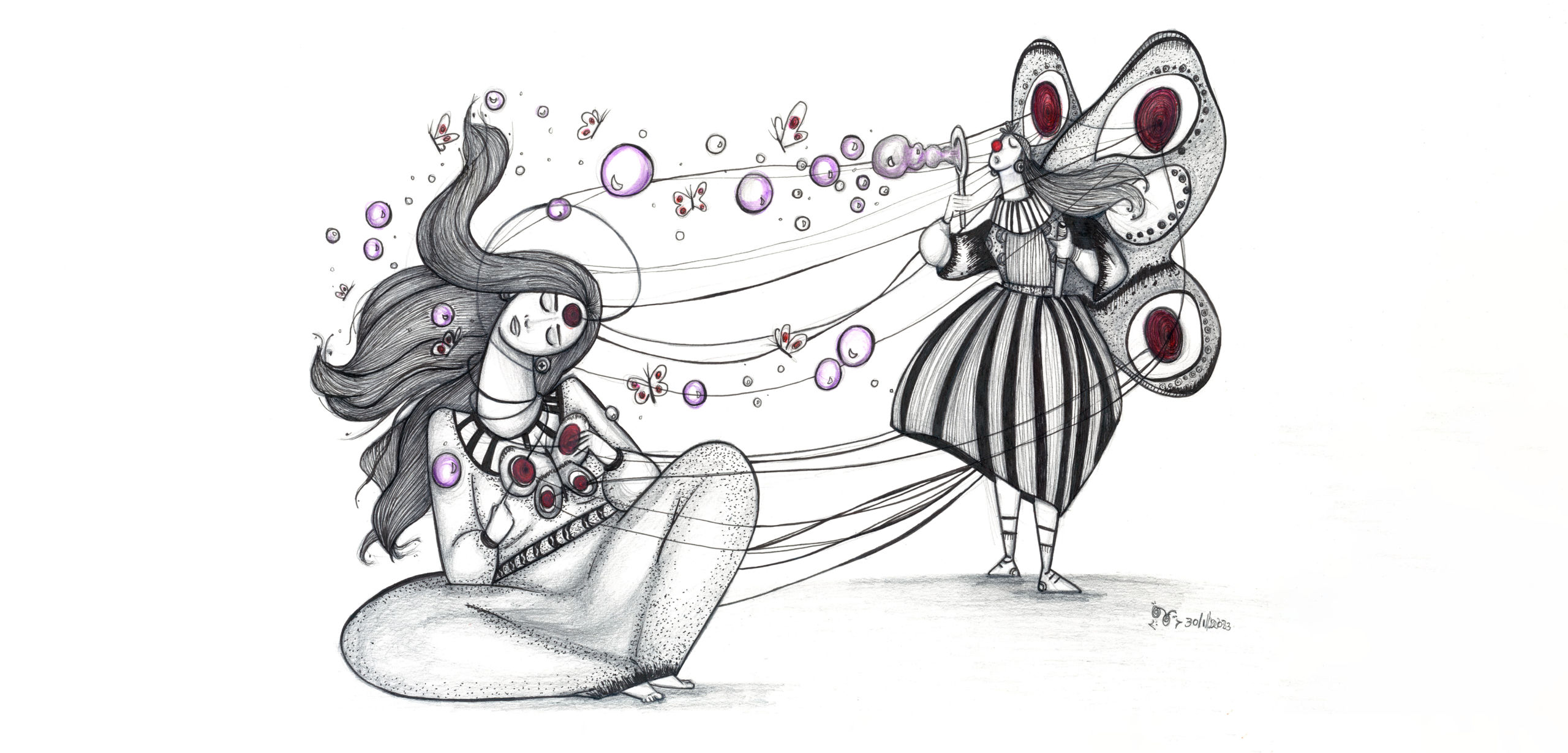أكتوبر 2017، كنّا ثلاثة، جاء كلٌّ منّا إلى تونس محتمياً من وطنٍ كشّر أنيابه يريد أن يفترسنا، أو هكذا ظننا. أحدنا صوفيٌ قلقٌ كانت كل مسببّات السعادة قد غادرته، يحاول أن ينطق شعراً فلا يأتي بشيء سوى تأوّهات في ليل الغُربة الطويل. الآخر، أنا، جئت غراً -ولا أزال- من سواني تاجوراء لا أعرف إلا نخيلها وبرتقالها، ولم أفهم بعد أنّ عليّ الدخول في ألفِ معركة قبل أن أتمكّن من الحديث في أمورٍ لا أفقهها. الأخير صاحب الجملة التي اتخذها الأولان هزوًاً؛ “أنا سعيد بمجرّد مرور الوقت”. كان هادئا كأنّه جاء من بلدٍ أخرى ليست بلادنا، ولم يعش حروباً عشناها، وكأنّ لسانه ومعيشته ومأكله ليست مثلنا.
كنّا ثلاثتنا، نتشارك المسكن، نستيقظ أنا والأول باكراً نجهّز أنفسنا لمعركة يومٍ جديدٍ في بلدٍ ظلّت عيونِ أولاده تطردنا منه. صاحبي التعيس كان يعارك ذاك البلد قبلي، يخرج ليأتي إلينا بالمونة، خبز وكرواسون وبيض وماء وما قد نحتاجه في يومنا، أنا أطرق الباب على ثالثنا لأوقظه ومن ثم أنصرف لأعدّ لهم وجبة الفطور.
ويحدث، في الغالب، أن يأتي صاحبي الشاعر المتأوّه في نفس اللحظة التي يخرج فيها الرجل السعيد بمجرّد مرور الوقت من غرفته يدندن أحياناً، يلقي شعراً أحياناً أخرى، مليئاً بالحياة دائماً، ننظر إليه نحن الاثنان بشيءٍ من الحَسَد، نشتمه فيضحك حتى يأنَس صباحنا التعيس.
عندما ننتهي من الفطور يجلس إلى كلٍ منّا سائلاً “هل أنتَ سعيد؟”، لا نجيبه، فالصمت يكفي لمعرفة الإجابة، هو أيضاً لا يبحث عن إجابتيْنا، يخبرنا “أنا سعيد بمجرّد مرور الوقت”. ننفجر ضاحكين. صاحبي التعيس وأنا، نكيل له شتائم أخرى فيظل هادئاً مبتسماً، يشرب قهوته التي أعددتها ويعود إلى كونه الذي جاء منه، يلقي شعراً، يغنّي؛ وهو لا يدرِ، أننا من وراء ظهره، كنّا نظن أنّ وراء هذا القناع السعيد، إنسان في منتهى البؤس. ننجح في الترفيه عن نفسيْنا، ولكن نتجاهل في خضمِّ اليوم سؤاله الوجودي.
قبل ذلِك السؤال وقبل تلك الجملة التي أظنني لن أنساها أبداً، قبلهما بعامٍ وصيْف كنتُ غارقا في مشروع أدبيٍ ظننته أعظَم ما كتبت، سميّته “تاجر الأوهام”، قصص سوداوية في شكلِ رواية، أو رواية سوداوية في شكلِ قصص، ورغم بؤس الحياة آنذاك وضيق ذات اليد وخروجي من حربٍ أهلية حطَّمت أحلامي وأحلام جيلي، غير قادرٍ على بناءِ مستقبلٍ يمكنني فيه أن أبصر النور، كنتُ أكتب ذلك المشروع بشغفٍ لم أشهد له مثيلاً، أنشره في حلقات عبر مدوّنتي الشخصية فيلاقي ما يلاقي من استحسانِ قارئ أو ثلاثة، أنتهي من جزءٍ فأهرع إلى نشره في المدوّنة، وبين الكتابة والنّشر وما يتلوهما تتغيّر مشاعري تجاه ما كتبته.
لم يكن لي ملاذٌ من هذا العالم الذي رأيته ظالماً، ومن هذا البلد الذي رأيته شرساً، سوى الكتابة. كنتُ أصاحبُ شخصيّاتي وأتتبع مسار حيواتهم، وأغيب عن عالمي كأنني مدمنٌ لمخدّرٍ ما. كانت الكتابة إدماني في ذلك العام، إدماني الذي نجّاني من تبعات الحرب ..
كنتُ أؤمن، بأنّني الكاتب المهضوم حقّه في بلدي، وبأنّ النّاس حولي لا يقدرون الإبداع الذي أشكّله؛ ولهذا، كنت في تعاسة عظيمة بعد كل جزء أنشره، أغرق في كآبتي وأصحبها معي أينما حللت، لا تنفكّ منّي حتى أعود إلى الكتابة مجدداً.
في ذلك العام، لم يكن لي ملاذٌ من هذا العالم الذي رأيته ظالماً، ومن هذا البلد الذي رأيته شرساً، لم يكن لي ملاذٌ سوى الكتابة. كنتُ أصاحبُ شخصيّاتي وأتتبع مسار حيواتهم، وأغيب عن عالمي كأنني مدمنٌ لمخدّرٍ ما. كانت الكتابة إدماني في ذلك العام، إدماني الذي نجّاني من تبعات الحرب. كنتُ أضحكُ لنكتة تقولها شخصية ما، أنبهرُ بالقصّة أثناء كتابتها، أرى خيالي في المرآة فيعجبني كما فعل نرجس من قبل.
أحياناً، ولشدّة تعلّقي بذلك المشروع، كنتُ أبكي -فرحًا- عندما أقفل القصّة بأسلوب وجدّته -كما كنتُ أفكّر- عبقرياً لا غيْر، وأعرف وقتها، أعرف حقاً، وفي تلك اللحظات السريعة، بأنني أسعدُ إنسانٍ في هذا الكوكب، وأصيرُ ممتنّاً بأنني اخترتُ الكتابة.
في تلك الأيام، ورغم انتمائي لأسرة لم تمر بعوائق مادية، كنتُ أعيش شيئاً من الفقر، مقتنعاً أنّ عليّ أن أجد طريقي وحدي. لم أفاتح أحداً من عائلتي بموضوع الكتابة، لا يعرفون عن تلك “الهواية” شيئاً رغم كل الدلائل المحيطة بي من كتبٍ وأوراق. كنتُ أظنني عصامياً، ولهذا بقي أمر الكتابة سراً داخل العائلة.
كنتُ أرتدي جاكيت من الجلد الصناعي اشترته لي حبيبتي، بينما أعمَل كاتباً للمحتوى داخل شركة دعاية كان صاحبها قد حوّلها إلى سوقٍ للعبيد، كان المرتّب الذي أتقاضاه في العمل عشر ساعاتٍ يومياً كحدٍ أدنى بالكاد يشتري لي قهوتي وسجائري ويتبقى منه القليل. لم تكن ظروف العمل هناك جيّدة البتّة، ولكن، بعد قضاء كل ذلك الوقت ورغم عودتي منهكاً إلى البيت، أعود إلى غرفتي لأنعزل عن العالم بكتابة مشروعي الذي ألفته وألِفني، ولكن ورغم أنّ الكتابة كانت أنيسي الوحيد، كان النشر عدواً لي.
في 2013، وفي الثانية والعشرين من العمر، وبكل غرور الشباب، انتهيتُ من مشروعٍ روائيٍ عن جندي من جنود العقيد الراحل معمّر القذافي في الحرب الأهلية الأولى في 2011. جاهدتُ كثيراً لنشر ذلك المشروع، في البدء بدا الأمر سهلاً، تحصلّت على فرصة لنشره في دار نشرٍ محليّة اسمها “الروّاد”، قَبِل الناشر النّص، لكن وبعد دخول البلد في حرب أهلية ثانية في صيف 2014، هذه المرّة بين حلفاء الأمس، اختفى الناشر عن البلد وانقطع اتصالي به حتى أيقنتُ أنّ الرواية لن تُنشَر عنده.
لم أفكّر في خياري الثاني، وهو نشر الكتاب في وزارة الثقافة، فقد كرهتها وكرهت التعامل معها بعد توقيع عقدٍ لنشر مجموعة قصصية -من أدبِ الهواة، كما أصنّفها الآن- ولم تخرج المجموعة للضوء أبدًا. حاولت التواصل مع دور محليّة أخرى لكن باءت محاولاتي بالفشل، فاتجهتُ إلى نشر الرواية في العالم العربي.
أرسلتُ ذلك المخطوط لكل دور النشر التي أعرفها: الدار العربية للعلوم ناشرون، الجمل، الشروق، ودور نشرٍ مصرية ولبنانية وخليجية نسيتُ أسماءها، في العادة لم يكن يصلني أي رد، وعندما يصلني تعتذر الدار عن النشر. دار واحدة قبلت نشر الكتاب، ولكن جاءتني بشروطٍ لم آلفها، طلبت حذف مقاطع كبيرة داخل الرواية لأنّها لم تعجب خطّها التحريري وطلبت مبلغ 1000 دولار لنشر العمل، ألف دولار، مبلغ لم يحلم به شاب في الرابعة والعشرين مثلي.
أصابني الإحباط الثاني، وفي لحظة عجيبة من ابتسامات القدر، تحصّلت في 2016 على فرصة لنشرها عربيا في دار “ملهمون” بالإمارات العربية المتحدة، لكن لم يلبث أن ضاع ذلك الحلم، لأسباب لا حاجة لذكرها. هناك فقط.. رأيتُ أنّ السعادة، في الكتابة أحياناً، تعني التخلّي عن الحلم. تزامن ذلك على أيةِ حال مع انشغالي بالعمل وكتابة مشروعي الذي لا مثيل له.
الآن، وعندما يذكرني “فيسبوك” بمنشوراتي السابقة في الفترة بين 2012 و2017، أجدُ فتى محبطاً متعجّلاً يودّ الظهور بأي طريقة كانت، فتًى ينقلب مزاجه بين الفرحة بكتابة قصّة جديدة وبين وعده وتهديده “للقراء” الخياليين بترك الكتابة.
أعرف الأسباب التي جعلته يقول ذلك، كان فتًى يصرخُ في الفراغ الأزرق ظانّاً أنّ الوقت سيمّر، دون أن يلمس تلك السعادة التي يحلم بها بعد أن يمسكَ بكتابه الأول، أجدُ نفسي محاطاً بمشاعر متضاربة: الأول هو السخرية من أفكاره ومن شعوره بالاستحقاق رغم قلة خبرته في الحياة، الثاني هو الإعجاب بمدى إيمانه بنفسه وملاحقته المستمرّة لشغفٍ لا يرى فيه غيره إضافةً لحياته، بل واستعداده للتضحية بوظيفة مستقرة في مجال عمله مهندسًا “قد الدنيا” من أجل مطاردة ذلك الحلم، الثالث هو الشفقة، لأنني أعرف ما كان يمرّ به، أعرف كيف كان يحسّ بالضّبط، أشفقُ عليه لأنّه لم يستوعب الدرس بعد، وربما لن يفعل، الرابع هو الامتنان، الامتنان أنّه لم يستوعب الدرس وأنّه استمرّ وأنّه أخطأ مرات عديدة في الطريق وتعلّم من تلك الأخطاء.
عشتُ في 2017 مع سيّد السعادة وسيّد التعاسة أشهراً أربعة، كان كل منهما يجذبني إلى شخصيته وفلسفته وأفكاره. ربما كان كل منهما -نظراً لفرق السنّ بيني وبينهما- يجذبني إليه محاولاً تشكيل شيء منه فيْ، فأنا لازلتُ في عينيْهما طفلاً لم يفقه درس الحياة بعد.
كانا على حق، استخدم معي سيّد التعاسة وصفته لمكافحة ظلم الحياة، كان يرى أن نلتفت إلى توافه الأمور، نعطيها حجماً أكبر منها، بذلك، نتغلّب على التفكير في أعظمها، تلك التي تأتي بالكآبة، نصحني ألف مرّة أن أترك الكتابة جانباً، أن أبقي عليها هوايةً لا غير، لم يؤمن وهو الكاتب المتمرّس أكثر منّي، بأنّ عليَّ أن أعتمِدَ عليها مصدراً للرزق، حذّرني من أن أصبِح “كاتباً محترفاً” ونصحني بالعودة إلى العمل مهندسًا. كان واقعياً أكثر مما أحتمِل، كان عقلي ينجذب إليْه، رغم كل الأحلام التي تخيّلتها. سيد السعادة على النقيض، كان حالماً مثلي، ينصتُ إلى سيّد التعاسة وهو ينصحني، يتركه يتحدث، وبعد أن يختفي، يأخذ منّي سيجارة ويتحدّث معي بهدوء شاعري، يخبرني ألّا ألتفت إلى كلامه، وأنّه يفضّل أن يعيش كاتباً معدماً على العودة إلى عملٍ لا يحبّه.
أحياناً كنتُ لا أجد في يومي وقتًا إلا لتذوّق خبزي اليومي، ورغم كل الجهد والتعب وتزامن ذلك مع الرعب العالمي والحرب على طرابلس وشهر الصيف الحارق وانقطاع الكهرباء، رغم كل الحزن الذي هاجمني من خسارة عم وخال بكوفيد 19، ورغم آلام الظهر وآلام العقل الذي يرى رصيدي المصرفي ينخفض دون زيادة، رغم كل ذلك، كنتُ سعيداً داخل عالمي الذي أنشأته مع الأيام
أنا، الغرّ، كنتُ أعيش وسط زوبعة، فقد تورّطت بخطبة حبيبتي ريما قبل ذلك بعامٍ، وكان عليّ أن أنظر إلى المستقبل، ولهذا، وعند أوّل فرصة عملٍ حقيقيةٍ وجدتها قررت أن أرتاح من الكتابة وألتفت إلى المستقبل، ولكن بعد تسوية: أن أشتغل في مجالٍ قريبٍ من الكتابة، وهو التحرير والنشر، وجاءت الفرصة الذهبية في منصّة ليبيةٍ ستشكّل بعد ذلك وعيي بعالمٍ لم أعهده.
في بداية 2018 كنتُ قد بدأت العمل في تلك المنصّة، وفي بداية ذلك العالم توقّفت عن كتابة مشروعي “الأعظم”، حاولتُ كتابة رواية مّا وبعد أن أنهيتها، وضعتها جانباً ببرودٍ لم أعهده. التفتُّ إلى المال، وكان مالاً وفيراً والحمد لله، أعطيتُ تلك المنصّة كامل وقتي وتركيزي، ولم أكن أجلس للكتابة إلا في القليل النادر، كنتُ أظنّ أنّ عقدة سعادتي ستحّل بالتأكيد، إذ لم أعد أعرّف نفسي كاتباً بل محرراً. كان العمل في التحرير تجربة جديدة عليّ، فتحت أمامي حلّ مشكلة كتاباتي التي أنشرها على مدوّنتي: هي كتابة خام، لم تدخل العملية التحريرية، أغلب تلك القصص والمقالات لم أقرأها أبداً، كنتُ أكتبها، أفتح المدوّنة، أنسخ النّص دون قراءة حرفٍ منه، ألصقه في المدوّنة وأنشره. أمّا عملية التحرير في مشروعي الجديد، كانت لا تقلّ أهميّة عن الكتابة والنشر. كانت تلك العمليّة المفتاح الناقص في فتحِ بابِ الحلم، ولكنّي تركتُ المفتاح في جيبي وتركتُ كلّ مشروعٍ أدبيٍ جديد محفوظاً في الدرج.
في نهاية 2018، جاءتني فكرة رواية جديدة، رواية محفوفة بالمخاطر، حسبتها ستشكّل مرحلة جديدة في حياتي الأدبية، حاولتُ معها مرّة، ولكن، لأنّ العمل يأتي أولاً، لم أعطها طاقتي كاملة، فاستعصت الكتابة عليّ، كانت تؤدّبني بطريقتها الخاصة، تسخرُ منّي ومن ملابسي الجديدة واهتماماتي الجديدة، تسخرُ من مالي ومن حياتي التي رأتها مترفة وقررت أن تقاطعني.
في 2019، وبعد أن تقدّمت كثيراً في مسيرتي المهنية، كانت تلك السعادة التي تأتيني أثناء عملية الكتابة قد غادرتني تماماً، ربما لأنّ كل ما كنتُ أكتبه هو خطط، رسائل وتقارير العمل، كنتُ أستغّل تلك “الموهبة” بطريقة، لم ترغب هي، بأن تُستغَّل بها. ولهذا، وبعد عامٍ طويل من العمل الجاد، جاءت المحرقة في ديسمبر، وجدتني بعيداً عن الحلم الذي ضحيّت بسنوات تعليمي الأكاديمية من أجله، ولهذا، قررت في لحظة وعي هامّة، أن أضحّي أيضاً بالمال من أجله.
لازلتُ أذكر كل تلك الأيام في 2018 و2019 وأنا أشتكي لحبيبتي -التي أصبحت وقتها زوجتي- من توقّفي عن الكتابة، فتذكّرني بكل الوعود التي قطعتها وكل الفرص التي حلمتُ بإتيانها إلي، وعندما جاءت، وجدتُ واقعها مختلفاً. عندما أخبرها بأنّ لا وقت للكتابة وبأنني أحتاج للعزلة من العالم للعودة، تذكّرني بأنني وعندما جاءتني تلك الفرصة صحبة سيد التعاسة وسيد السعادة، لم أرَ في تلك الفرصة والعطلة مدفوعة الثمن من العمل أيّ شيء وظللت أشتكي منها، وعندما أخبرها بأنّ العمل أصبح أثقل من ذي قبل عليّ، تذكّرني بكل المميزات التي حلمتُ بها في عملي المثالي، وكان عملي ذاك يعدّ أقرب إلى المثالية.
أخبرها أنّني سأسعد بنشر كتابي الأول، تخبرني أن أفعل، ولم يمضِ إلا وقت قليل حتى فعلتُ ذلك، فخرجت مجموعة “دم أزرق” القصصية على حسابي الشخصي بعد محاولات لنشرها مع دور نشرٍ عربيةٍ عدّة. فرحتُ قليلاً، لكن كان هناك نقصان في الأمر، شيء في أعماقي يخبرني بأنّ ما أفعله هو محاولة الهروب من الحقيقة، وهي أنني لن أصبح كاتباً حتى أعيد تعلّم الكتابة.
العام 2020، وبالتزامن مع دخول العالم في عطلة طويلة الأمد بسبب جائحة كورونا، كنتُ بلا عمل، لكن كنتُ أعيش على ما ادخرته من مال بالإضافة إلى عمل زوجتي. كنتُ قد حاولتُ مع نهاية 2019 العودة إلى المشروع الذي جاءني في نهاية 2018 لكن كان المشروع مقفلاً. كان البطل يسخر منّي لأنني أردتُ السخرية منه.
في أحدِ تلك الأيام التي يفتحُ فيها الله أبواب رحمته السماوية لعباده، جاءتني الرواية بفكرة جديدة، أخبرني البطل بأن أتعلّم الخَبز، كان هذا شرطه في قبولي ضيفاً على حياته، وكان ذلك، ولأيام لم تنقطع أبداً. كنتُ أداوم اليوم كلّه، مع كل الوقت الذي أملكه في العالم، بين الخبز والكتابة، أحياناً كنتُ لا أجد في يومي وقتًا إلا لتذوّق خبزي اليومي، ورغم كل الجهد والتعب وتزامن ذلك مع الرعب العالمي والحرب على طرابلس وشهر الصيف الحارق وانقطاع الكهرباء، رغم كل الحزن الذي هاجمني من خسارة عم وخال لكوفيد 19، ورغم آلام الظهر وآلام العقل الذي يرى رصيدي المصرفي ينخفض دون زيادة، رغم كل ذلك، كنتُ سعيداً داخل عالمي الذي أنشأته مع الأيام.
سعيداً باستيقاظي في الخامسة صباحاً لعجن خبزٍ يحتاج لنصف يوم ليجهز، سعيداً بالإفطار باكراً وشرب قهوتي وتدخين سجائري والكتابة لساعات طويلة، سعيداً بما كان يسرّه لي بطل الرواية، الخال ميلاد الأسطى، كنتُ أخيراً مستعدا لكتابة رواية حقيقية، جمّعت كل خبراتي السابقة بالإضافة إلى الخبرة الجديدة التي علّمنيها الخبز: الصبر، الوصفة السحرية للسعادة أثناء الكتابة، وفي غضون أشهر قليلة، خرج خبز الرواية من الفرن ساخناً.
ورغم كل ما حدث بعد الجائزة، من المميزات والعيوب، الفرص والتحديّات، الأيام السعيدة والأيام التعيسة، أيقنتُ أمراً واحداً، أنني لا أصلح إلا كاتباً، وأنني وحتى أثناء الكتابة، عليَّ التعامل مع التعاسة التي تأتي بها، خصوصاً عندما يقفل عليك النّص نفسه، ستغضب، وسينتابك قلقٌ رهيب عندما لا تقدر على كتابة حرفٍ واحدٍ مما تريد كتابته ..
ولأول مرّة في حياتي بعد ذلك، أنزع قبّعة الكاتب وأرتدي قبّعة المحرر، وأجلس لتحرير عملي بصرامة لم أعتدها، وعندما ارتحتُ إليها، سلّمتها لمن وجدتُ فيه الرأي السديد. ولم تمضِ سوى أسابيع قليلة حتى جاءني الردّ بالموافقة، وهذه المرّة من دارٍ عربية في طريقها إلى الشهرة، كنتُ قد قرأتُ بعض أعمالها وأعجبتُ بها، وكان ما كان، أن نُشِرت “خبز على طاولة الخال ميلاد” في يونيو 2021، وقد كانت الشهور التي توسّطت يوم تسليم الرواية ويوم نشرها مليئة بالعمل على مشاريع اتسّمت بالنضج الشخصي، وبمعرفتي أنّ صورة “الكاتب العبقري المهضوم حقّه” لا تناسبني، وبأنّ عليّ العمل مطوّلاً، وألا أتوقّف عن التعلم. صارت شخصيّتي على ما يبدو أكثر اتزاناً.
في نهاية 2020 وفي 2021 وبداية 2022 بأكملها، لم أتوقّف عن الكتابة والنشر، كنتُ في كل تجرّبة صحفية أو أدبية جديدة سعيداً ومتحمّساً بأنني وجدتُ المشروع الأفضل، المقالة التي لم يكتبها أحد من قبل ولن يكتبها أحد بعدي، نشرتُ في مواقع عربية وأمريكية باللغتيْن العربية والإنجليزية، صرتُ منضبطاً أكثر، صرتُ ما حذّرني منه سيد التعاسة، دخلتُ عالم “احتراف الكتابة”، وكان للكتابة هذه المرّة عائدها المادي، ولكن أهمّ من ذلك، جاءت برضايْ عن النّفس، واتضاح رؤيتي واتساعها، وتركي لما كان يدمنه الفتى الصغير من مسببّات الكآبة – مع القليل من النَكَد حسب رأي ريما زوجتي، وكان ما حدث في مايو 2022. حازت “خبز على طاولة الخال ميلاد” على الجائزة العالمية للرواية العربية، جائزة كنتُ أحلم بها لأكون صادقاً، ولكن قبل ذلك بشهر ونصف، كنتُ قد استلمتُ جائزتي الحقيقية وهي أن أمسك كتابي بيدي، كتابي الذي أتعبني وأتعبته.
أثناء الإعلان عن الجائزة كنتُ في الطائرة متّجها من تونس إلى أبوظبي، كان انترنت الطائرة ضعيفاً لا يسمح إلا بقراءة الرسائل النصيّة عبر واتساب، وكنتُ وريما على اتصال بأخيها الذي كان يتابع حفل توزيع الجوائز، وعندما وصلنا الخبر منه، شعرتُ بسعادة عارمة، لكنّها سعادة لم تدم طويلاً، فقد حدث ما حدث بعدها من هجوم شرسٍ على الرواية وعلى شخصي في ليبيا، أمر قلب “السعادة” إلى “تعاسة” حقيقية. بعضُ الأحلام عندما تأتي، تأتي حارقة لليد التي تحاول نيْلها. ربما، هذه هي الحياة، لا سعادة فيها خالصة ولا تعاسة خالصة.
ورغم كل ما حدث بعد الجائزة، من المميزات والعيوب، الفرص والتحديّات، الأيام السعيدة والأيام التعيسة، أيقنتُ أمراً واحداً، أنني لا أصلح إلا كاتباً، وأنني وحتى أثناء الكتابة، عليَّ التعامل مع التعاسة التي تأتي بها، خصوصاً عندما يقفل عليك النّص نفسه، ستغضب، وسينتابك قلقٌ رهيب عندما لا تقدر على كتابة حرفٍ واحدٍ مما تريد كتابته، لا تبتئس، عليك البحث عن ما يريده منك النص كتابته، ستجد نفسك عندها لا تتوقف عن الكتابة، وكلما اقتربت من النهاية أكثر تزداد حماستك، تعرف وقتها أنّك تكتبُ نصًا تحبه ويحبّك، نصاً سيجعلك سعيداً في لحظات كتابته وسيكافئك بكل ما لديه.
قد يغضبك النصّ نفسه عند تحريرك له، وقد تكرهه بعد نشره، وقد لا تجد له مكانا تنشره فيه فتقرر إما وضعه في الدرج أو نشره في موقعك الشخصي، ولكن الأهم، أنّك استمتعت بكتابته، تعبت أثناء كتابته، لم يأتيك سهلاً، أجهدت نفسك فيه، آلمك ظهرك، نسيتَ عقارب الساعة أثناء كتابته، تركتَ سيجارة مشتعلة أو اضطررت لشرب قهوتك باردة بسببه، اعتزلتَ عن الوقت الطيّب مع العائلة والأصدقاء، قد ترى النصّ بعد نشره مقامرة لم تأتِ لك بأي قرش، ولكن لا بأس، ما دمتَ ستكتب غيره.
الآن، أعيدُ سؤال سيّد السعادة عليّ: “هل أنتَ سعيد؟” فأجيب:
وأنا أكتب، أشعر بالسعادة بمجرّد مرور الوقت.