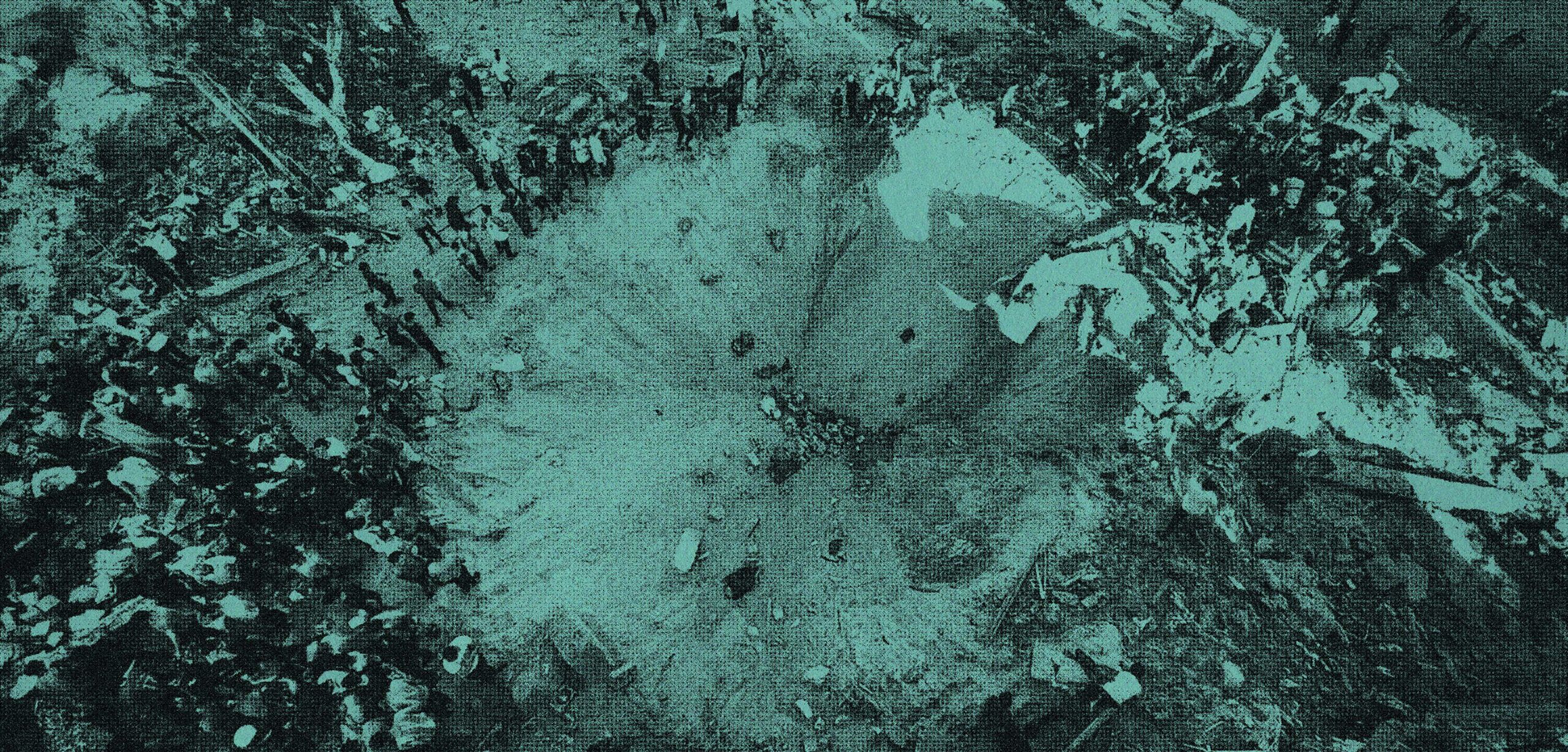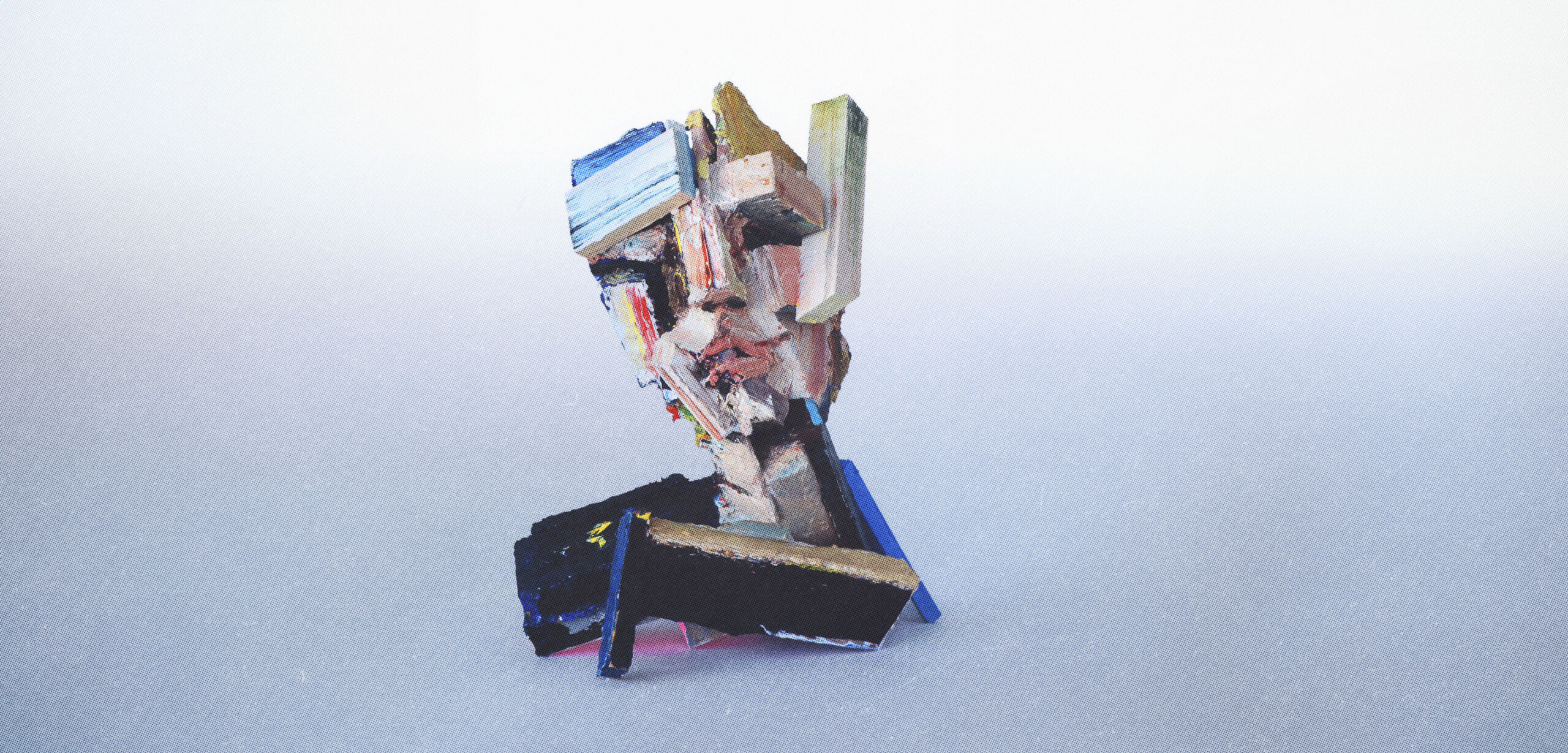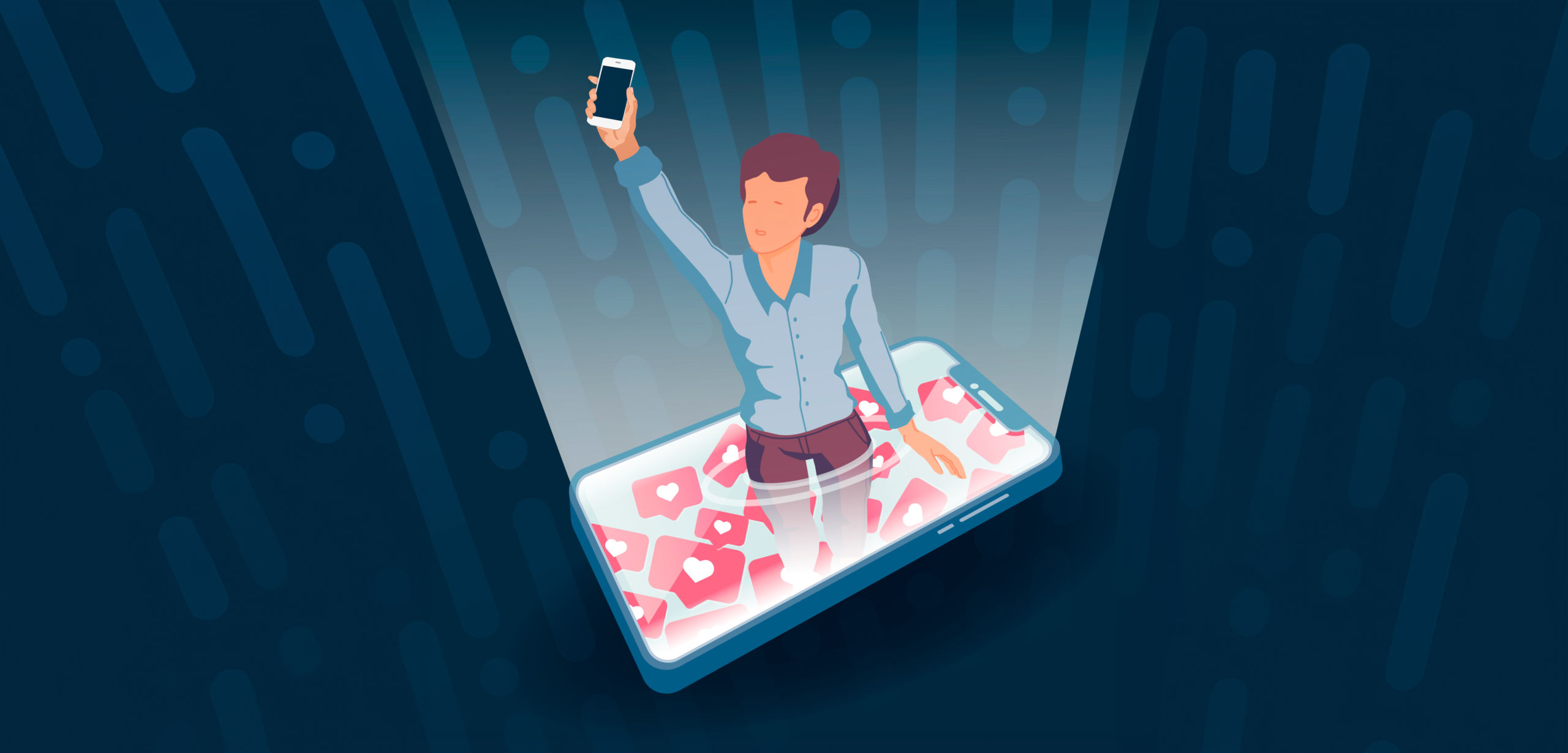كتبتُ كلمة “المكان” في أعلى الصفحة لأكتب عنه. أشعر بفراغٍ يشبه وحشًا يستلقي في داخلي دون أن يغفو. أوّل ما تصوّر في ذهني جملة “فاقد الشيء لا يعطيه”. ثمّ رحتُ أفكّر في الجملة خلال أيّامي التي تمرّ مثل قطارٍ طويلٍ يأخذ من جسدي سكّةً ويقلّ الركّاب عليه ذهابًا وإيابًا، وشعرتُ حقيقةً أن فاقد الشيء، لا يعرف كيفيّة التحدّث عنه.
حينما لا نملك الشيء أصلًا، نحاول أن نتحدّث عنه من خلال ما تشكّله خيالاتنا وتصوّراتنا وربّما رغباتنا. وبالتالي لا يمكن لنا أن نحسم أبدًا مدى واقعية هذا الحديث أو مدى صلته بالشيء، شكله، كينونته وملامحه. قد نقترب من الصورة الحقيقية كثيرًا وقد نبتعد كل البعد.
بيد أنّه عندما نفقد الشيء، لا نعرف كيف نتحدّث عنه، أو نتخوّف من ذكره لما قد يسبّبه ذلك من ألمٍ أو حنين أو الاثنين معًا. غير أن هذا كلّه لا يعني أننا لا نفكّر في هذا الشيء، حتى أنه قد يصبح هاجسًا في أحسن الحالات، وهوسًا في أسوئها.
*
كبرتُ في مكانٍ دون أن أعي أنني في الحقيقة فقدته قبل أن أولد. اكتشفت مع الوقت أن حقيقة التواجد في أي مكان لا تعني بالضرورة امتلاكه أو معرفته عندما لا تتسّم الظروف بالطبيعيّة. فتسود محاولات بناء فضاءاتٍ آمنة تشبهنا في داخل المكان، آملين بالتواجد والصمود فيه بأقلّ أضرار ممكنة.
أحدّق فيما أكتب. شعرتُ بأنّ الأفكار التي تستولي على هذا النّص مبهمةٌ جدًّا، لكنني حقًا لا أعرف كيفية التحدّث عن مكان أفقده يوميًّا. في كل يوم يمرّ، يصبحُ هذا المكان شبحًا مُحلّقًا يجوب أرجاء ذهني، يتشكّل تارةً في ذكرياتٍ سعيدةٍ قليلة وكثيرةٍ مريرة، وتارةً في خيالاتٍ لا وجود لها على أرض الواقع، بل لها وقعٌ يشبه الاطمئنان.
في أحد الأيام الثقيلة تلك، أنهيتُ عملي الساعة العاشرة مساءً وهممتُ بالمشي نحو المكان الذي أسكنُ فيه، والذي لم يكن بيتي قطّ. ففي برلين، وفي أحيانٍ كثيرة، ما أن يبدأ المرء بالشعور بالراحة في مكانٍ ما، وبعد أن يستنفد طاقته كلّها في بناء علاقةٍ مع المكان، يتوجّب عليه الخروج منه والبحث عن مكانٍ جديد علّه يصبح بيتًا. إذ أن شّركات السّكن في برلين تسعى إلى تجديد الشّقق الرّخيصة، لتجعلَ منها مرادًا صعب المنال.
مشيتُ وأنا أشعر بالجوع، لكنّ الجوّ لم يكُن باردًا كما هو متوقّع رغم أنّ فصل الشّتاء قد وصل منذ حين. قرّرت أن أشتري طعامًا من أحد المحلّات العربيّة في الشّارع، إذ أنّ هذه إمكانيّةٌ واردة، وتمكّن المرء من الشعور بشيءٍ من الألفة. لكن ولسوء الحظ، ورغم من أنّ القانون ينصّ على أن تُغلق المطاعم أبوابها في تمام الحادية عشرة، وجدتُها جميعَها مغلقة. لعنتُ حظّي والقانون والأحوال كلّها، ولعنتُ جوعي الذي يأكلني من الداخل مثل ذكرى حزينة لا تنفكّ تترك ذهني وشأنه، وتواصل الطرق على أبوابه.
كان الشّارع الذي يسمّى بشارع العرب خاليًا من جميع المخلوقات، وليس فقط من العرب. وقبل أن أتّخذ الشارع الداخليّ المؤدّي إلى مكان السّكن طريقًا، رأيت كشكًا صغيرًا يُباع فيه طعامٌ، ولم تكن تلك المرّة الأولى التي أراه، بل كانت المرّة الأولى التّي فكّرت أن أتوقّف عنده، فتوجّه نظري قبل قدميّ إلى هناك.
اقتربتُ وخاطبتُ الشاب بالألمانية: مساء الخير، أريد ساندويش حلّومي. ووقفتُ أنتظر. ولأنّ جوعي كالذكرى تلك، يشغلُني عن حواسي كلّها، لم أستمع في البداية إلى الموسيقى التي شغّلها الشاب. وإذ بموّالٍ عراقيّ حزين يصدح من داخل الكشك. رجّحتُ أنه صوت سعدون جابر.
سألني بالألمانية: أتريدينه مع كلّ الإضافات؟
فأجبتُ بالعربيّة: بدون بصل وبندورة. فانطلقت ابتسامةٌ جميلةٌ ملأت وجه الشاب وقال: لا تواخذيني فكّرتك ألمانيّة، من وين حضرتك؟ فقلت: من فلسطين، وأنت؟
– أنا من الجولان، بس من قرية مهجّرة، وكبرت في القنيطرة من الجهة اللي مش محتلّة. بتعرفي؟ الفلسطينيين والجولانيين أقرب ناس على بعض. نفس الوجع.
رحنا نتحدّث قليلًا ريثما ينتهي الشابُ من تحضير طعامي ليسدّ جوعي الذي نسيته. فأنا أشعرُ دائمًا بالحنين في هذه المواقف، دون أن أعرف وجهته بالضّبط.
سمعتُ صوتًا يأتي من الخلف قائلًا ببهجةٍ شديدة: ولك هاي من فلسطينيّة الـ 48، سامع لهجتها؟
فالتفتتُ لأجد شابّين في مقتبل عمريهما، مبتسمَين.
– من وين انت من فلسطين؟ سأل أحدهما.
– من جبل الكرمل، وانتو؟
– إحنا الثنين لوابنة، يعني من لوبية، بس أنا خلقت في مخيم اليرموك في سوريا، وصديقي في مخيم عين الحلوة في لبنان. لوبية جنب طبريا، بتجنّن طبريا، حكالي عنها جدّي.
– مزبوط، ولوبية بتجنّن، مرة رحت لهناك في مسيرة العودة وخيّمت مع صحابي.
– يعني انت بتروحي مسيرات وهيك؟ والله إنك بنت بلاد حقيقيّة! أنا والله إذا بصير واصل على فلسطين فش حدا ممكن يطلّعني منها.
لم يقبل أحدٌ منهم أن أدفع ثمن الساندويشة، قائلين: ولا ممكن، هذا المحل محلّك، بتنوّريه وبتشرفيه وقت ما بتيجي. وعدتُ أنا أدراجي نحو البيت وغصّةٌ تجلسُ في قلبي وتتمدّد فيه وتأخذ منه مسندًا، لكن مع تلك الغصّة انبعث دفءٌ غمر قلبي من الخارج.
*
لم يحدث معي شيءٌ كهذا منذ أن انتقلتُ إلى برلين. أشعر بالراحة في دوائر قليلةٍ هنا، ولا أشعر بالأمان أبدًا. لكنّ هذا الموقف أعادني إلى السؤال الأول، عن فقداننا للشيء، أو عن عدم امتلاكنا له، ورحتُ أفكّر، من يعرف فلسطين بشكلٍ أكبر؟ ومن يفقدها أكثر؟ هل من يسكنُ في أراضي ال48، والذين يشكّلون الأقليّة هناك، يعرفونها أكثر؟ فهم في معظم الأحيان لا يتحدّثون لغتهم من أجل أن يكونوا ويعيشوا، ويسعون إلى بناء مساحات داخليّةٍ آمنة ليشعروا بأنّهم يملكون المكان. لكنّنا في الواقع لا نملك شيئًا.
حتى أن العمران بعد الهدم لا يشبه فلسطين التي اعتدنا أن نعرفها، فمثلًا تُبنى المكاتب الحديثة ذات الطابع الأوروبيّ على أنقاض البيوت المهدّمة في وادي الصليب في حيفا. فتصبح أوروبا التي أسكنُ، تسكنُ حيفا وتشوّهها. ثمّ أن اختيار مساحات الأمان تلك، تشبه تفضيل اختيار النار التي تحرق الأخضر فقط، على اختيار النّار التي تحرق الأخضر واليابس. فنعيشُ في اليابس حالمين بشجرةٍ خضراء وحيدة تخرج من تعرّجات الأرض لتظلّل بؤسنا السّعيد.
أم أنّ من وُلدَ من الفلسطينيين في مكانٍ خارج فلسطين، لأهلٍ هُجّروا أو هُجّرَ أهلُهم، يعرف فلسطين بشكلٍ أكبر؟ فلا يمكن محو ذاكرة شخصٍ عن مكانٍ يعتبره بيتًا، حتى وإن رآه لآخر مرةٍ حين كان طفلًا. حيث أن هذه الصورة الحقيقية في ذاكرة طفلٍ، تنتقل عبر الأجيال لتصبح صورةً في أذهان أطفالٍ آخرين، يكبرون معها، ويحلمون برؤيتها، والتي ربّما قد تكون أقرب إلى الأصل، لكنّها لا تمتّ للخراب الذي يعلو المكان، وإن كان عمرانًا، بِصِلة.
وماذا عن الفقدان؟ هل يشترط الفقدان انعدام الصلة المباشرة بالشيء أو المكان؟ أم أن الصّلة التي تتشكّل في الأذهان البعيدة فقط قد تحفظهما؟
*
أنا لا أملك إجابات، لكنني أملك الكثير من الأسئلة. ثمّ أنني، وكثيرين غيري، لم نملك مكانًا يومًا، ولم نشعر بأنّنا نعيش في ظروفٍ طبيعية في أي لحظة من حياتنا، وهذا ليس عدلًا. لكنّ العدل لم يعُد سؤالًا يشغل العامّة. تُداس كرامات الناس وانتماءاتها ومشاعرها وأماكنها وأفكارها يوميًّا. فمن أنا لأتساءل عن وجود العدل أو عدمه؟
عدتُ إلى ذلك المكان الذي يترنّحُ فوق حانةٍ مغلقة الأبواب، أغلقتُ باب المكان الذي يُدعى غرفتي المؤقتة، ورحتُ أتصفّح المواقع باحثةً عن مكانٍ لعلّه يصبح يومًا ما بيتًا، أجلسُ فيه وأسمح لتساؤلاتي وخيالاتي ورغباتي وحتّى أمنياتي، أن تنطلق دون أن أحاسبها أو أضعها على رفوفٍ ليأكلها العطب والغبار.