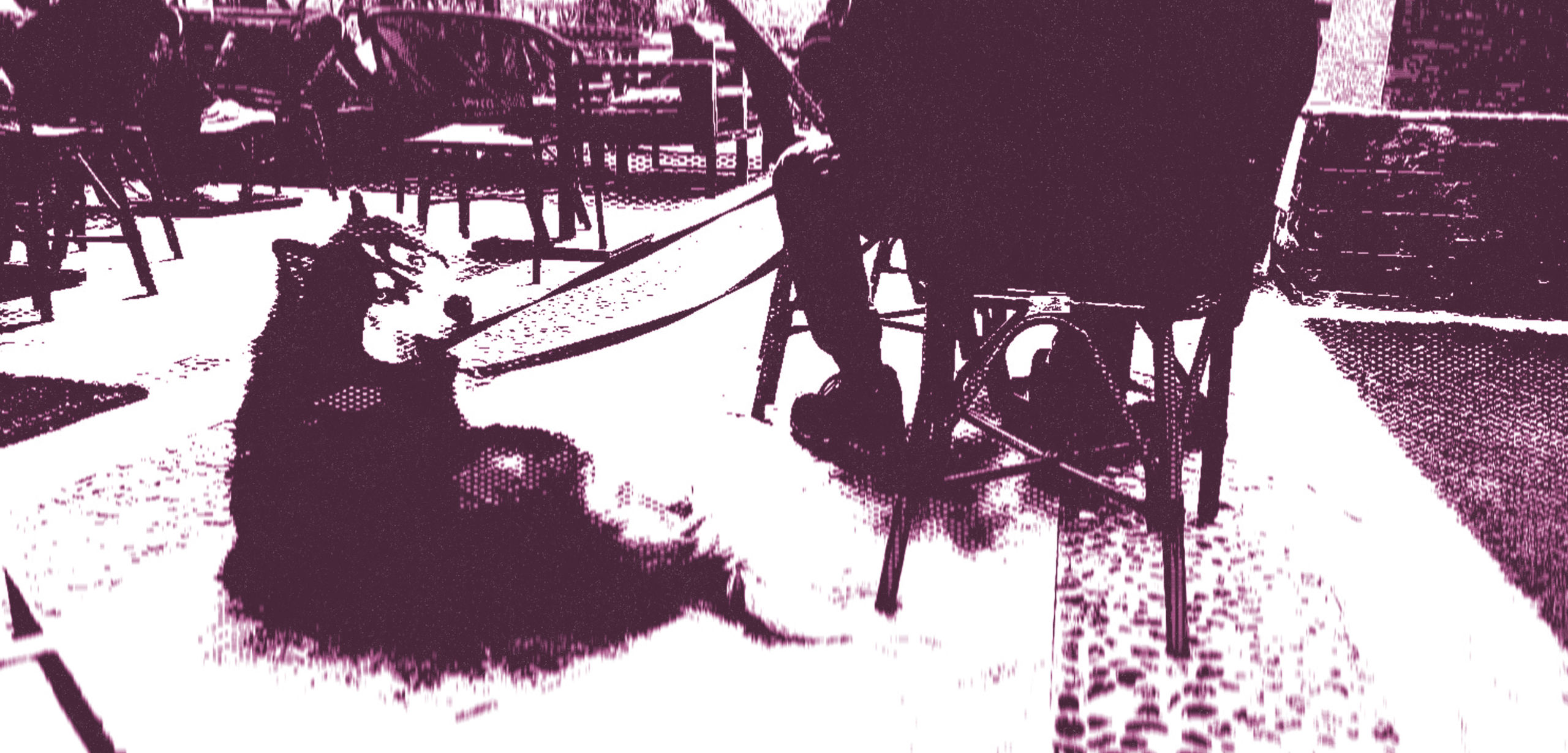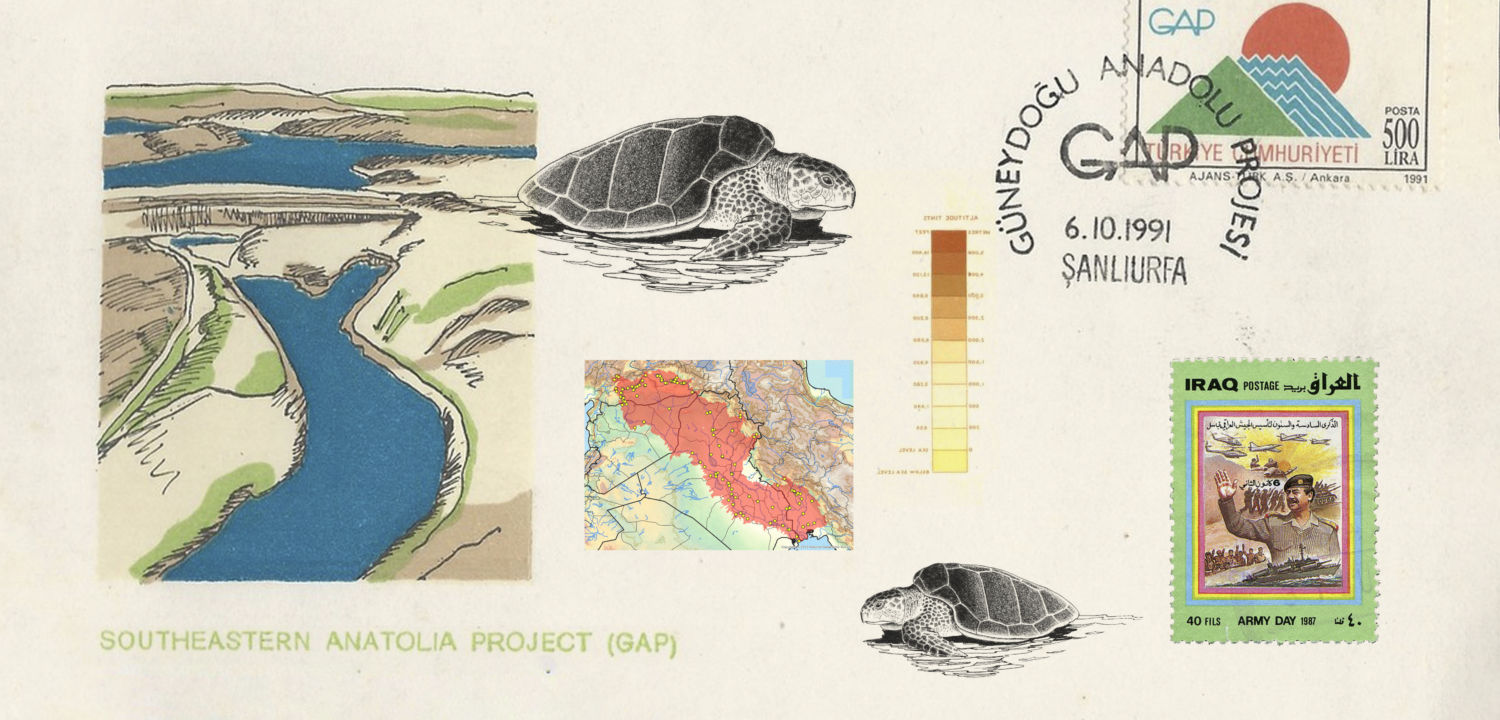كانت المدينة تُعرف بحمامها الذي يعلو فوق سماء أربعة مليون نسمة، عدا ذلك هناك أسماءٌ وصفاتٌ عديدة رافقتها، البعض يُسمّي تلك المنطقة الشعبية الكبيرة بمدينة الثورة سابقًا أو مدينة الصدر حاليًا (شرق بغداد)، والبعض يعرفها من وجوه ساكنيها وصخبهم وأبوابهم المفتوحة وأطفالهم الذين يلعبون في أزقتها كرة القدم بلا توقف.
أغلب سكانها فقراءٌ أو تحت خط الفقر، ووسط أحوالهم المادية المتعثرة يتشاركون مُتعًا قليلة، أبرزها تربية الحمام فوق أسطح المنازل، من خلال بناء مساكن خشبية –في معظمها– يسمونها أبراجًا. قررتُ العودة للمدينة التي شهدت على طفولتي، بعد 24 عامًا، لتصوير أول حبٍ شغوف لمسته في حياتي.
لغةٌ للطمأنينة
أنتمي لإحدى العائلات المولوعة بتربية الحمام. فأعمامي كانوا يربونه فوق سطح منزلنا حيث كنا نتشارك السكن تحت سقف واحدٍ معًا. وأذكر أني كنت ولدًا يراقب بدهشةٍ شديدة علاقة أعمامي بالحمام وعنايتهم له وخوفهم عليه وكأنه أحد أولادهم.
كنت أستغرب من طريقة تمييزهم لطيورهم وهي في السماء رغم أن كل شخصٍ من الممكن أن يمتلك أكثر من 150 طير حمام، إلا أنهم يميزونها جيدًا ويقضون معظم اوقات فراغهم معها.
أذكر أنهم كانوا يصعدون إلى سطح المنزل من الصباح الباكر قبل العمل ويركضون مسرعين للاطمئنان عليها فور عودتهم. لكن أكثر ما علق في مخيلتي هي طريقة تقليدهم لهديل الحمام نفسه، وكأن هناك لغةٌ يتشاركونها معها، لغةٌ لا تخضع لقواعد اللغة التي نعرفها ولا يمكن أن تتعلمها في أي مدرسةٍ وهي لغة الاطمئنان لشيء ما.
تلك المتعة والاطمئنان كانا قد انتقلا إليّ في صغري، حيث كنتُ أصعد إلى السطح لأشاهد، بعيونٍ منبهرة، الحمام الذي يطير من بيتنا والحمام الذي يطير من أسطح جيراننا وأسطح جيران جيراننا، كنت أرى الحمام يتماهى فيما بينه ليشكلّ لوحةً سريالية جميلة فوق سماء المدينة التي تضحك لهم رغم كل البؤس الذي كان يحيط بها.
وصمةُ تربية الحمام
استعادتي لتلك الفترة من طفولتي جعلتني أفكر في بدايات علاقتي بالصورة والكادر، حيث أتذكر زياراتي رفقة أعمامي لسوق بيع الطيور، والرغبة التي كانت تسيطر عليّ وقتها: امتلاك أكثر من عين حتى أستطيع متابعة تفاصيل وتحركات ذلك العالم المُبهر.
ذلك السوق كان بمثابة عالم سحري، رأيت فيه طيورًا لا أعرف لها اسمًا ولم أسمع بها من قبل، خاصةً أننا كنّا في حالة حصار ولم تكُن من حولنا أيّة حديقة حيوان أو ما يُماثلها. عالمٌ غريب ومُلون بالنسبة للطفل الذي كنته. والسوق لم يكُن معرضًا للطيور فقط، بل لأنواع “المطيرجية”، أي أصحابها الذين يربّون الطيور، فهنالك من يعرض طيوره بسعرٍ مُغري وآخر يبيع بصمت لأنه يثق بحُكم زبائنه والكثير من المشاهد الباقية في جزءٍ دافئٍ من الذاكرة.
وللمطيرجية في الخيال الجمعي العراقي سمعةٌ سيئة، وهنالك كمٌ من القصص التقليدية عن الخلافات الأزلية مع جيرانه بسبب أوساخ الحمام وقطع الخشب التي يرميها على الحمام في السماء واحتلال الحمام لحديقة الجيران والأصوات التي تطلقها الطيور. زِِد على ذلك أن تلك التجمّعات السكانية كان، ولازال، يسودها طابعٌ ديني يدفع النّاس لرفض استقرار المطيرجية على الأسطح فتنكشف أسطح البيوت الأخرى عليهم مما يُعيق حركة النساء والعائلات. فضلًا عن الشجارات بين المطيرجية فيما بينهم بسبب طيرٍ ضلّ الطريق إلى قفص صاحبه والكثير من القصص التي تنتمي إلى الفولكلور أكثر مما تنتمي إلى الواقع. لكن حتى في التراث، فقد أفتى العديد من الفقهاء بعدم جواز شهادة مربي الحمام “لسبيل اللعب بها” في الإسلام.
في أواخر التسعينات انتقلتُ مع عائلتي من المدينة لمنطقةٍ البلديات التي تبعد عن مدينة الصدر حوالي 12 كلم، وظلّ عشقُ أعمامي للحمام وكل التفاصيل من حوله يُطارد مخيلتي، بل كان أغلب عالم طفولتي، فتجدني أكتبُ عنه في درس التعبير تارةً وأقصّ قصصه على أصدقائي الجُدد في الحي تارةً أخرى.
هذا العشق الذي كاد أن يفقد أحد أعمامي حياته بسببه عام 2008، حيث أن المدينة كانت في حالة حرب، وشوارعها مشتعلة بين الأمريكان وجيش المهدي، الأمر الذي دفع بأغلب سكان المدينة للنزوح لمناطق مجاورة أكثر أمانًا تاركين بيوتهم وأبراج الحمام.
رغم هذا الحال إلاّ أن قلوب المطيرجية بقيت مُعلقةً بأبراجهم، حيث يُمكن للطير أن يفقد حياته إذا لم يشرب أو يأكل لمدة ثلاثة أيام. فكان أعمامي يذهبون فجرا للمدينة متسللين بين الأزقة تحت رصاص الأمريكان ليطعموا الحمام ويزيلوا الشوق الذي بداخلهم لها. ثم يعودون ويكررون تلك الزيارات كل يومين أو ثلاثة أيام، إلى أن صوّب قناصٌ أمريكي، في إحدى المرات، بندقيته صوب رأس عمي وأطلق رصاصته التي أخطأت رأس عمي بمسافةِ سنتمترات.
من بعد هذه الحادثة لا أذكر سوى لوم أبي لعمي وبقية إخوته، بالإضافة لخوف جدتي وبقية أفراد العائلة من هذا الولع الذي وصل لمنطقةٍ خطرة. وكان ذلك حدثًا فارقًا في مخيّلتي الناشئة، حيث أن تربية الحمام وعالم المطيرجية كانت مرتبطةً عندي بالحرية، لكن أن يصل الأمر لحد أن يفقد الإنسان حياته… عمومًا، تجاهل أعمامي خوف العائلة وواصلوا زيارة الحمام بالسرّ حتى انتهت المعركة بين الطرفين.
وبعد انتهاء الحرب انتقلت عائلة جدي للعيش في مناطق متفرقة خارج أسوار مدينة الصدر، وبسبب ضغوطات مجتمع تلك المناطق والتي ترتكز إلى تصوّر العراقيين عن سمعة المطيرجية السيئة، دُفِعَ أعمامي لترك هوايتهم بابتعادهم عن مرابع الصِبا. كل المطيرجية الذين تركوا المدينة حملوا غصتها التي تقول “لا سماء تحضنُ هواكم بعد سمائي.”
الهروب من الأرض
ومرّت السنين، أصبحتُ شابًا ونسيتُ قصص المطيرجية والحمام، ولم تخطر في بالي وأنا أخطو في عالم التصوير، حتى اليوم الذي رافقتُ فيه صديقًا لسوق الطيور، وكان نفس السوق الذي أبهرني وأشبع جزءًا من فضول حديقة الحيوان المفقودة. وبالصدفة كنتُ أحمل معي كاميرتي الجديدة، ودون تفكير وجدتُ نفسي أصوّر الناس والطيور والأقفاص وأيدي الباعة والزبائن التي تتناوبُ على السجائر والسبحات وتقليب أفراخ الحمام وهي تُمسكها من وسطها نافِشةً ريشها وألوانه.
من السوق اتجهتُ مباشرةً نحو بيت عمّي الذي رافقته في طفولتي إلى ذلك السوق، كنت متحمّسًا لأريه الصور. ابتسمَ وهو يقلّب في الكاميرا وفاجأه أن أحد أفراد العائلة أبدى اهتمامًا بالطيور. وضعَ الكاميرا جانبًا ودعاني إلى سطح بيته، لأتفاجأ بدوري برائحةٍ مميزة.. اكتشفتُ بعدها بثوانٍ أنها لطعام الطيور، ثم رأيتُ الأبراج والشبكة.. كان عمي يربي حمامًا في السر.
بعيدًا عن أنظار الجميع، حتى إخوانه الذين كانوا يتشاركون معه تربية الحمام سابقًا، لكن لم يتشارك أولاده معه الشغف وأيضا باقي أبناء عمومتي الذي ولدوا بعد 1990. لم يملك أيٌ منهم أي حبٍ أو رغبة بتربية الحمام.
فاض الحنين إلى طفولةٍ كان يُظلّلُها طيران الحمام، واختلطت ذكريات المدينة بالحرب، أردتُ أن أصوره لعلّي استعيد شيئًا من تلك الأيام. تحمّستُ كطفلٍ لطالما أدهشه الحمام برقته وبفرض محبته في قلوب الرجال. توالت إمكانيات الصور التي يُمكنني تحقيقها بالكاميرا في هذا العالم. وأردتُ أن أردّ له الجميل، أصور ذلك الريش الفخور بألوانه الأنيقة وأن أوثّق هندسة الأبراج التي تختلف من مطيرجي لآخر.
والأهم، أردتُ أن أصوّر المطيرجية، بطل القصة الذي يتحدى عادات مجتمعه ويتبعُ شغفه حتى رصاصة القناص. طلبتُ من عمي أن أصوره في سطح منزله، وافق في البداية ثم رفض بعد فترة أن يظهر وجهه.. بسبب الخوف الذي حمله من ذكريات المدينة القديمة. وانتبهتُ هنا إلى ثقل العادات والسمعة التي لم أكن أفهمها بشكلٍ جيّد في طفولتي. لكنه أخبرني بعد حديثٍ مُطوّل، وكأنّه يمنحني دليلًا لعالم المطيرجية يُناقِض رأي المجتمع ويمنع من التعميم، فالتعميم صفة الجهلاء:
هنالك مطيرجي سيءٌ جدًا وبلا أخلاق، وهنالك مطيرجي خلوق ومؤدب، وهنالك مطيرجي غني، وهنالك مطيرجي فقير، وهنالك مطيرجي كان ضابط في الجيش ثم تقاعد وتفرّغ، هنالك مطيرجي طبيب.
توالت زيارتي لسوق الغزل و سوق الكسرة وهي أسواقٌ مختصة في بيع الحمام. هناك تجد أفرادًا من جميع فئات الشعب العراقي، بمختلف الطبقات والأعمار، فلا يمكنك تمييز دينهم ولا انتمائهم ولا مستواهم المعيشي، فكل هذه الاختلافات تمحى. وهنالك شيئًا مشتركًا واحدًا يجمعهم وهو حبهم للحمام الذي ينسيهم هموم الدنيا والواقع المرير، فتجد بعد انتهائهم من التجول في أسواق الحمام يجلسون في مقهى مخصص لتربية الحمام.
وهذا المقهى ينظم مسابقات يشترك فيها المطيرجية لإبراز قدرات الحمام الذي يربونه، حيث تنصّ قواعد المسابقة على أن يُطلق كل مطيرجي أقوى حماماته من خارج المدينة وينتظر الجميع في نقطةٍ وصولٍ مُعيّنة، ومن تصل حماماته أولاً وبأكبر عددٍ هو من يفوز. ومن خلال زيارتي للمقهى وجدت صورةً للحمام الذي حصل على المركز الأول في المسابقة الأخيرة، وكانت لشخص اسمه عادل العصبجي. وحين سألت أحد أعمامي الذي تركوا تربية الحمام عن عادل العصبجي، أخبرني أنه صديقٌ ومعرفة قديمة، وأنه يذهب إليه بفترات متقطعة ليستعيد جزءًا من فردوس الماضي.
وذهبت معه إلى سطح عادل. خلال زيارتي وجدته يملك منزلًا يتكون من ٤ طوابق، اثنان منها لعائلته واثنان منها للحمام. كان عادل يُكرّس جزءًا كبيرًا من يومه للعناية بالحمام. أقفاصٌ مرتبّة وعشرات الحمامات داخلها، والعديد من أكياس الأكل مكومةٌ بأوانيها تنتظر التوزيع. رأيتٌ في عيون عادل نفس اللّمعة التي ألِفتها في عيون أعمامي وهُم يتابعون حركة الحمام في السماء أو يتفقدون أحوالهم في القفص.
وعندما بدأت تطير، رأيتُ كيف يستعجل الطير شروق الشمس كفرصةٍ وحيدة في الحرية. يُغادر القفص ليطير بعيدًا، ثم يعود وكأن خيطًا لا مرئيًا يجرّه نحو القفص، وفي تلك الفسحة بين الانعتاق والعودة يجدُ راعيها حريته من عيون النّاس وألسنتهم ومن واقعه وصعوبته. ينعتقُ المطيرجي مع طيوره، تصيبه متلازمةٌ لطالما طاردت البشر: الهروب من الأرض وجاذبيتها. في ذلك السطح، وخلف عدسة كاميرتي هذه المرّة، رأيتُ/سمعتُ لغة الطمأنينة التي يتكلمها المطيرجية مرةً أخرى.