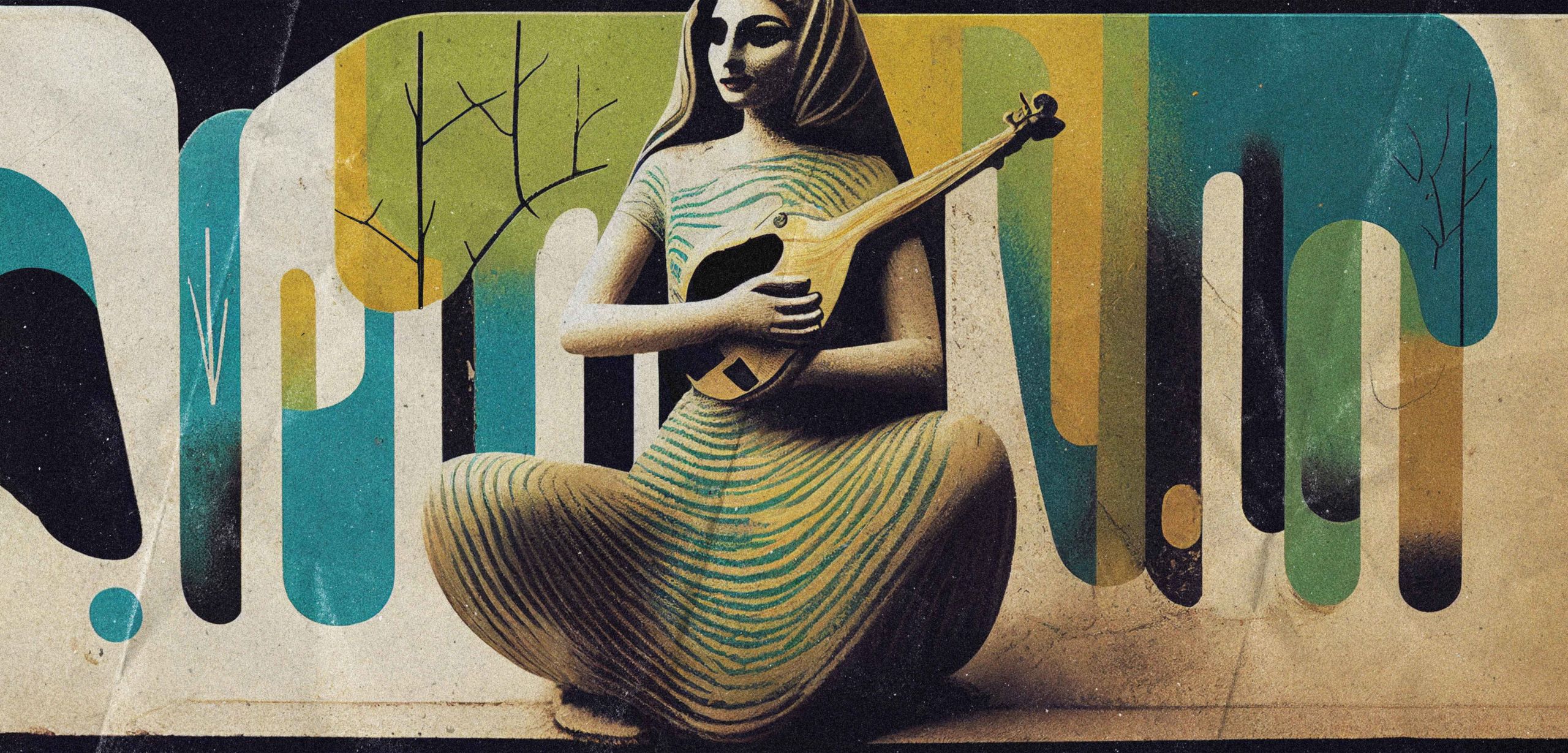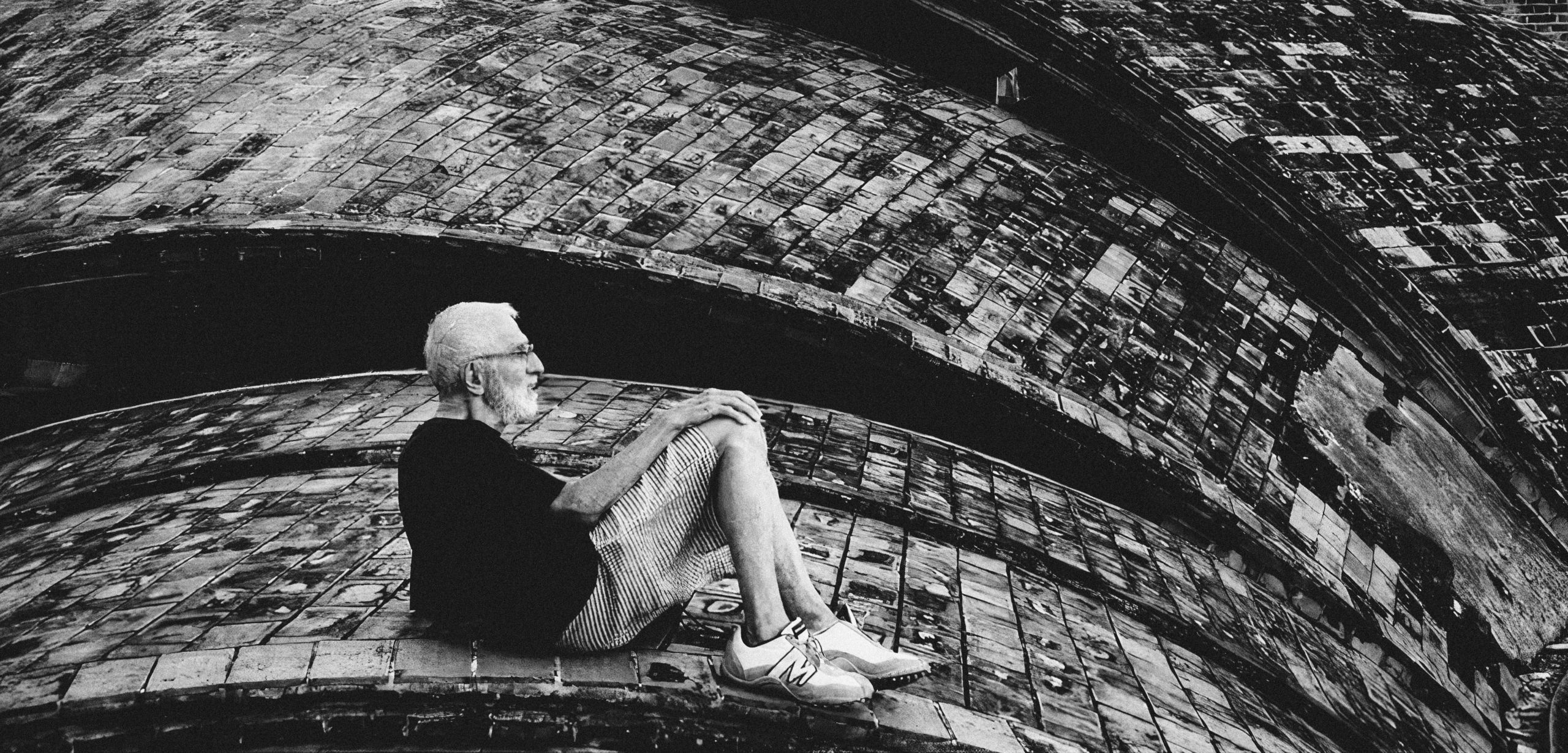بتأثّر بالغ، تابَع الملك الحسين بن طلال في الثاني من كانون الأول/ يناير 1992، قصيدة محمد مهدي الجواهري “يا أيّها الملك الأجلّ مكانة”، بل كانت عيناه تلتمع بدمعٍ يعبّر عن مدى الرضا والزهو بكل كلمة يلقيها الشاعر العراقي في مبنى البرلمان القديم بالعاصمة الأردنية.
القصيدة مثّلت أهمّ مديح ناله ملك الأردن خلال فترة حكمه التي تجاوزت الستّة والأربعين عاماً، ليس لما تضمّنته من بلاغة ومعنى، أو لمكانة قائلها بما قدّمه من تجديد في عمود الشعر العربي وحسب، بل لأنها أتت في لحظة عاش خلالها الممدوح مقاطعةً عربية وغربية بسبب موقفه من حرب الخليج الثانية، وكان للشعر وقبله هتافات الشارع الأردني المؤيدة للانحياز إلى صدام حسين، دورهما في تعويض خسارة سياسية ثقيلة.
بعد أقلّ من ستّة أشهر، لحّن جمال سلامة بعضاً من أبياتها لتؤديها صوفيا صادق، في حفل احتضنه قصر الثقافة في عمّان، في مفارقة تحمل دلالاتها بقصيدة لشاعر من العراق، وألحان لموسيقيّ من مصر، وأداء بصوت مطربة من تونس لتكون العلامة الأبرز في تاريخ الغناء الأردني، رغم أن أردنيًا واحدًا لم يشارك في صناعتها، وكأنها تعبير مكثّف عن واقع هذه الأغنية التي لا يزال هناك تساؤلات حرجة عديدة حول تعريفها وتطوّرها ومآلاتها إلى اليوم.
الإذاعة ووحدة الضفتين
ينتمي الملك حسين (1935- 1999) إلى أول جيل من أسلافه الهاشميين القادمين من الحجاز ولدوا في عمّان، وسعى جدّه من خلال مرافقته له أن يحتكّ بمحيطه ويمتلك قدراً من ثقافة وعادات المكان الذي نشأ فيه، ما أهّله أيضاً لاكتساب لكنةٍ تقترب من لهجة عشائر البلقاء (المحيطة بالعاصمة) بشكل كبير، وهي جميعها سمات تغاير ما تربّى عليه الملك عبد الله الأول (1882 – 1951) الذي قدِم إلى شرق الأردن عام 1921 ليؤسس إمارة فيها، وظلّ يحلم أن تضم جميع أجزاء سوريا، إلى أن تحوّلت الإمارة رسمياً إلى المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار/ مايو 1946، بل إنه طرح في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه مشروع “سوريا الكبرى” تحت حكمه في سياق اعتراضه على استقلال سوريا، لكن جامعة الدول العربية رفضته آنذاك.
هذه وقفة تاريخية ضرورية لاستيعاب نظرة الجدّ تجاه الأردن كدولة وشعب، إذ رآه جزءاً من جغرافيا أوسع وانتماء أشمل، وبالتالي لم يبد اهتماماً بموضوع الأغنية الوطنية، خاصة أنه أُغتيل بعد فترة قليلة على فقده الأمل حيال “حلمه” السوري؛ في 29 تموز/ يوليو 1951 عند مدخل المسجد الأقصى. يضاف إلى ذلك، ما عُرف عن الملك عبد الله الأول من نزعة محافظة إذ لا يُسجّل في عهده احتفاء مهما كان شكله بالموسيقى والغناء وسواها من الفنون.
المسألة الأهمّ تتصل بالإذاعة في تلك الفترة التاريخية، بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات السيادية في الدول العربية بعد مرحلة الاستقلال، عبّرت عن الخطّ السياسي لكلّ دولة، وانحيازاتها ومواقفها في لحظة تحوّل عالمية شهدت تراجع القوى الاستعمارية الأوروبية، وبدء الحرب الباردة مع صعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، حيث ورِث الأردن بعد النكبة سنة 1948، الإذاعة التي أسّسها الانتداب البريطاني في القدس عام 1936، وكانت تُعرف بـ”راديو رام الله” بعد انتقالها إليها سنة 1948، قبل أن تُنشأ محطّة إذاعية في جبل الحسين بعمّان عام 1956، ونتنقل لاحقاً إلى منطقة أمّ الحيران في العاصمة نفسها، ومع الإذاعة ستنشأ فرقة تابعة لها، إلى جانب فرقة موسيقات الجيش.
وبذلك، لا يستقيم الحديث عن الأغنية الوطنية إلا بوجود إذاعةٍ سيكون لها دورها البارز في تكريس مشروع الوحدة الوليد (أُعلنت الوحدة بين الأردن والأراضي الفلسطينية التي لم تُحتل عام 1948 ’الضفة الغربية‘ في 24 نيسان/ أبريل 1950)، لتتوالى الأحداث سريعة باغتيال عبد الله، ثم استلام ابنه طلال الحكم أقلّ من سنة لتتمّ تنحيته، ليتسلّم الحفيد المُلك رسمياً سنة 1953، لتبرز السنوات اللاحقة مدى الاهتمام بالتعبير عن رؤية النظام في صيغته الوحدوية.
ورِث الأردن بعد النكبة سنة 1948، الإذاعة التي أسّسها الانتداب البريطاني في القدس عام 1936، وكانت تُعرف بـ”راديو رام الله” بعد انتقالها إليها سنة 1948، قبل أن تُنشأ محطّة إذاعية في جبل الحسين بعمّان عام 1956، ونتنقل لاحقاً إلى منطقة أمّ الحيران في العاصمة نفسها
رواياتٌ عديدة عن رعاية رسمية مباشرة، في إنتاج الأغنيات التي ستبثّها الإذاعة منذ الخمسينيات، وشكّلت ذات البعد الوطني قرابة 75% منها، بحسب دراسة بعنوان “الأغنية الوطنية في سبعين عاماً، 1956 – 2016″ لنضال عبيدات. وقد حظيت الأغاني التي تنتجها الإذاعة باهتمام شخصيات مثل هزاع المجالي الذي تولّى رئاسة الحكومة مرتين بين عاميْ 1955 و1960 (أغتيل في مبنى رئاسة الوزراء سنة 1960)، ووصفي التل الذي عمل مديراً للتوجيه الوطني الإعلامي عام 1955، والمدير العام للإذاعة عام 1959، قبل أن يشكّل خمس حكومات خلال عقد الستينيات (اغتيل في القاهرة في سنة 1971)، ليتسلّم بعده منصب مدير الإذاعة صلاح أبو زيد حتى عام 1963 حيث عيّن مديراً عاماً دائرة التوجيه والأنباء ثمّ وزيراً للإعلام.
سعت هذه الشخصيات الثلاث، بدرجات متفاوتة، إلى البحث عن أغنية تعبّر عن قيم ومعاني جديدة، ترتبط بالوطن ورايته والمدن في الضفتين وتحتفي بالقرية والأرض وشمس وسماء الوطن وبحره وأعياده وعمّاله وفلاّحيه، وروح العمل والبناء، بالاعتماد على شعراء وكتّاب عمل بعضهم في الإذاعة منذ تأسيسها ومنهم رشيد زيد الكيلاني وأيوب طه وغيرهما، وتُقدَّم على الربابة والشبابة والطبلة غالباً بألحان تقترب من البادية – قبل استخدام آلات التخت الشرقي بعد ذلك- على يد موسيقيين ومغنين من أمثال: توفيق النمري وجميل العاص وبعدهم إسماعيل خضر ومحمد وهيب وخضر عزام وصبري محمود وإلياس عوالي وعايدة شاهين وآخرين.
بحثٌ آمن فيه أصحاب القرار الذي أرادوا أن يؤسّسوا أغنية وطنية، حيث لا تزال تروى حادثة كيف كان يتابع هزاع المجالي بنفسه جلسات إعداد أغنية بعنوان “وين على باب الله”، ليقرّر حينها أن يستبدل كلماتها لتصبح “وين على رام الله”، في توظيف للبلدة التي كانت واحدة من أهم المصايف الأردنية حينئذ، لتغنيها نوال عجاوي (سلوى العاص لاحقاً) بألحان زوجها جميل العاص، وتكاد تكون الأغنية الوحيدة التي يعاد توزيعها بنسخ متعدّدة على يد فنانين وفرق موسيقية إلى اليوم، لما حملته الأغنية من دلالات بعد احتلال الضفة (الشطر العربي من المملكة) عام 1967.
مواجهة الأنظمة الاشتراكية العربية
برز في مطلع الستينيات توجّه لدى القائمين على الإذاعة يقوم على استقطاب مغنين عرب لتأدية أغانٍ وطنية، كان في مقدمتهم هيام يونس ودلال الشمالي من لبنان، وكانت الأبرز سميرة توفيق (والدتها سورية ووالدها مالطي وتحمل الجنسية اللبنانية)، التي ارتبط اسمها بالفتاة البدوية والغجرية في عدد من الأفلام المصرية والسورية واللبنانية خلال السبعينيات، بموازاة تأديتها العديد من الأغاني الوطنية والتراثية الأردنية في عهد الإذاعة وكذلك التلفزيون (تأسس عام 1968)، حيث لا تزال تعبّر عن صورة المرأة الفاتنة لدى الأردنيين في تلك الفترة، وكان كثيراً منهم يعتقد أنها ترسل “غمزة” عينها لكلّ واحد من الساهرين أمام الشاشة.
وفي رواية أخرى تتصل بأهمية الإذاعة لدى السلطة، استعادت سلوى العاص في حديث إلى صحيفة “الدستور” الأردنية، واقعة حدثت بعد معركة الكرامة عام 1968، حيث طرق رجال الشرطة باب منزلها ليبلغوها بأن رئيس الوزراء وصفي التل يطلب زوجها جميل العاص، وحين وصل مكتبه أسمعه التلّ أغنية سجلّها بصوته لصعوبة كلماتها النبطية، وطلب منه ان يضع لها لحناً على وزن أغنية: على الروزنا، وقد حضَر تسجيل الأغنية حينها قائد الجيش حابس المجالي.
الأغنية الوطنية مثلها مثل التعليق السياسي اليومي، الذي كان يُتلى بعد نشرات الأخبار الرئيسية في تلك المرحلة، تمثلان أهمّ أدوات التعبئة والتحشيد الشعبي في مواجهة خطابات الأنظمة الاشتراكية العربية؛ مصر وسوريا والعراق (بعد سقوط النظام الملكي فيها عام 1958)، التي كانت تندّد بسياسات النظام الأردني المتحالف مع الغرب. كانت الأغاني الوطنية تُذاع بعد نشرة أخبار الثانية ظهراً وبعدها يومياً.
خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft
بين الطقطوقة والفصحى
الحديث المتواتر عن جهود رسمية برزت في نهاية الخمسينيات والستينيات من أجل حفظ التراث الأردني عبر تدوين الأغاني وإنتاج عشرات منها بـ”صبغة وطنية”، لا يصمد في واقع يكاد يعاكس هذه الفكرة حيث يلاحظ أن تلك المساعي لم تحفظ إلا النزر اليسير من التراث الغنائي، ولم يصان ويرمّم السواد الأعظم مما تمّ تسجيله، وهو ما يشير إلى أن التوظيف السياسي الآني طغى على معظم النتاجات الأولى التي أُعدت على عجل عند النظر في كلماتها أو ألحانها البسيطة جداً، وبات الكثير منها نسياً منسياً.
في دراسة عبيدات، المذكورة سابقاً، يتبيّن أن جميع ما تمّ تلحينه تحت مسمّى الأغنية الوطنية حتى السبعينيات (شهد هذا العقد تلحين قصائد سعيد عقل وحيدر محمود)، جاء في قالب الطقطوقة وبتركيب نصّي وإيقاعي ولحني بسيط، ولم تستخدم التحويلات المقامية إلا بشكل محدود في بعض ما قدّمه جميل العاص مثلاً، مع تطوّر متنامٍ في الإيقاع، لذلك اتسمت تلك الأغنية ببطء نغمها ورتابته ما ساهم في تراجعها وعدم قدرتها على الاستمرار والصمود، ليس بسبب غيابها عن البثّ الإذاعي فقط.
تكاد تشكّل هذه المادة غالبية ما أنتج من أغاني وطنية التي وثقّت الدراسة السابقة حوالي ستمائة أغنية تعود أقدّمها إلى عام 1955 وأحدثها إلى منتصف العقد الماضي، يمكن تعداد بعضها ونسبتها لمن غنّاها: “خيمة كبيرة عالية” لسميرة توفيق، و”يا نسل الأشراف” لسماهر، و”صامد على خط النار” لمحمد وهيب، و”يا ابن الأوطان” لإلياس عوالي، و”عمّان هلالك طالع” و”أردننا يا جنة الوجود” لصبري محمود، و”بيرق الوطن رفرف على رؤوس النشامى” لسلوى العاص، و”أجلك ما نهتم أردنا يا غالي” لسهام الصفدي، و”أنا جندي على الحدود” لشفيق وحيد، وغيرها.
منذ نهاية السبعينيات، صعدت موجة الأغنية الوطنية التي اتكأت معظمها على قصائد فصيحة، مع تنوّع أكبر نسبياً في ألحانها وظهور مقدّمات وفواصل موسيقية، وإيقاعات أكثر حداثة، كما في أغنيات “عمّان في القلب” من ألحان الأخوين الرحباني عن قصيدة لسعيد عقل، الذي كتب أيضاً “أردن أرض العزم” ولحّنها محمد عبد الوهاب وأدّت كلاهما فيروز، و”يا جيشنا يا عربي” من ألحان السوري شاكر بريخان وتأليف حيدر محمود الذي كتَب كذلك “عمّان أرخت جدائلها” وغنّتها نجاة الصغيرة من ألحان جميل العاص الذي سطا فيه على لحن “فاتت جنبنا” لعبد الوهاب!
منذ نهاية السبعينيات، صعدت موجة الأغنية الوطنية التي اتكأت معظمها على قصائد فصيحة، مع تنوّع أكبر نسبياً في ألحانها وظهور مقدّمات وفواصل موسيقية، وإيقاعات أكثر حداثة
الانزياح نحو اللغة الفصيحة بقصائد كتبها أردنيون وغير أردنيين يؤشر على صعوبة دراسة تطوّر الأغنية الوطنية، كما هو الحال في واقع الأغنية الأردنية عموماً، بمعزل عن سياق تشابكها مع محيطها العربي، يضاف إليه نزوع ملحّني الأغنية الفصيحة إلى قوالب الغناء العربي التقليدي في صياغة نغمهم، لكن صنّاع هذا الشكل من الأغنية فشلوا في توطينها محلياً بحيث لم نشهد امتداداً لها على يد كتّاب ومؤدين وملحنين أردنيين.
وفي الوقت نفسه، فإن الأغنية التي ُكتبت باللهجة الدارجة (البدوية والفلاحية في الأردن) واعتمدت على جزء كبير منها على أغانٍ وتراويد شعبية، لم ينجح روّادها غالباً في بعث التراث وإحيائه برؤية فنية معاصرة. مع الإشارة إلى أن هذه الخلاصة تحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص في كامل المدونة الغنائية الأردنية.
إلى عقد التسعينيات، هيمنت الأغنية الفصيحة إلى حد كبير على وسائل الإعلام المحليّة، مع الانتقال إلى التلفزيون الذي تأسّس نهاية الستينيات واحتل مكانته بعد نحو عقدٍ، بموازاة تراجع الاهتمام الرسمي بإنتاج الأغاني الوطنية، ذات المرجعية التراثية، لأسباب عديدة منها زوال الضغوط السياسية على النظام مع تغيّر طبيعة الأنظمة العربية المجاورة، وفي مقدّمتها النظام الناصري، كما أن ذائقة الملك حسين ربما لعبت دوراً مع ميله إلى تلحين قصائد فصيحة وإبدائه الإعجاب أكثر من مرة بأصوات مثل فيروز وماجدة الرومي.
تقاطعت تلك الذائقة مع غياب أية مشروع رسمي جادّ للتعامل مع التراث بشكل عام، حيث الإصرار على التعامل معه بصورة سطحية ومشوّهة، متلاعَباً في عناصره وطُرق توظيفه السياسي في كرنفالات وفعاليات رثّة، بعيداً عن المؤسّسية والعمل الاحترافي الذي يضع الموروث غير المادّي على طاولة الدرس والبحث والتنقيب المعرفي، في سبيل تقديمه فنياً بصيغة حديثة ومتطورة.
عهد جديد!
لكن تتبّع الأغنية الوطنية في الألفية الثالثة يستدعي الوقوف عند جملة تحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية، تتصدّرها سياسات التخاصية التي اتبعها الأردن منذ تبنيّه برنامج التصحيح الاقتصادي تحت إشراف “صندوق النقد الدولي” عام 1989 وما تسبّبه من تشوّهات بالغة في الاقتصاد دون أن يحقق أهدافه الحقيقية بتخفيض العجز في الميزانية، ثم توقيع معاهد “وادي عربة عام 1988 وما ألحقته من خسائر استراتيجية نتيجة عدم قيام دولة فلسطينية حتى اليوم في ظلّ صعود لليمين الإسرائيلي، ناهيك عن الخسارات الاقتصادية في المياه و”اتفاقية الغاز” مع إسرائيل وغيرهما.
وليس بعيداً عن السياسة، فإن النخبة التي أفرزتها هذه السياسات، أفرغت الدولة الأردنية من كلّ أُطرها الحزبية والمدنية والاجتماعية، وسط استمرار عمليات الخصخصة التي انتهت بهيمنة الأمن على مؤسسات الدولة، لتفقد هيبتها وفعاليتها وإنتاجيتها، متحالفة مع رجال الأعمال الجُدد الذين تعنيهم حرية الأسواق فقط غير مكترثين (الأمن ورجال الأعمال) بقطاعات عديدة أهمّها الثقافة، بل يمكن تحميلها مسؤولية أردأ النتاجات في الأغنية تحديداً، تلك التي دعمتها مؤسسات الدولة والإذاعات الرسمية التي يتبع بعضها للجيش والأمن، والإذاعات الأهلية والجامعات وشركات الاتصالات وحتى مطاعم الوجبات السريعة.
تجدر المقارنة بين العهد الجديد والعهود السابقة، إذ بدا الملك عبد الله الثاني غريباً عن هذا المشهد، بالنظر إلى نشأته في بريطانيا بلا إلمام بالثقافة العربية، حيث تسرد روايات عديدة عدم تذوّقه القصائد والأغاني الأردنية، لكن مؤسسة الحكم سارت إلى تكريس سياساتها في ما بعد، من خلال تكثيف حضور الملك الجديد لحفلات لمغنين يؤدون أغنية وطنية يُظهر تفاعله معها.
خلال أكثر من عقدين، دُعمت أغنية “وطنية” بمضامين ركيكة وألحان ضعيفة، وأُهدرت عليها مبالغ طائلة من المال العام، التي طاولها النقد على صفحات الجرائد الأردنية مثل أغانٍ تضمّنت عبارات عنيفة من قبيل: “نقلع العين إن لدّت تلانا” (العين التي تنظر إلينا)، و”اللي يعادي أردنا نخلي عظامه تتطقطق”، وأُنتجت “أغنيات” لا حصر لها في مديح المؤسسة العسكرية والأمنية، كانت تبثّها الإذاعات من الصباح الباكر؛ مراراً وتكراراً، دون إغفال وجود حالات فردية جسّدها فنانون قدّموا أغاني وطنية خرجت على سائد العهد الجديد، منهم مكادي نحاس ونداء شرارة وأيمن تيسير.
الأصوات التي استنكرت ما روّجته أجهزة النظام من رداءة، كانت تقارنها دوماً بنماذج من الأغنية الوطنية أكثر جمالاً ورقّة قُدّمت في زمن الحروب وظروف عصيبة عاشها الأردن، خلافاً للحظة الراهنة حيث زالت هذه التهديدات. غير أن الحاجة إلى العنف الرمزي وإيجاد عدوّ متخيّل، وتعزيز ذاتٍ وطنية متورّمة بنزعات شوفينية، لا يمكن تناولها بمنأى عن محاولات السلطة، ونخبتها الجديدة، عن تعويض عجزها المتفاقم في إدارة شؤون البلاد، حيث تجاوز الدين العام 54 مليار دولار مطلع العام الحالي، وبلغت نسبة الفقر 24% وفق الإحصائيات الرسمية، بينما يظهر تقرير “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، بأن عدد الفقراء في الأردن حوالي 3.980 مليون شخص (زهاء 35% من السكان).
الأصوات التي استنكرت ما روّجته أجهزة النظام من رداءة، كانت تقارنها دوماً بنماذج من الأغنية الوطنية أكثر جمالاً ورقّة قُدّمت في زمن الحروب وظروف عصيبة عاشها الأردن، خلافاً للحظة الراهنة حيث زالت هذه التهديدات
معادلة تعويضية نجد مثلها في بلدان عربية أخرى، حيث يجري تصدير فائض من الوطنية “المبتذلة” للتستّر على الكوارث الاقتصادية، متزامناً مع الإخفاق المتواصل لوصفات الإصلاح المتبعة، في ظلّ مزيد من هيمنة واحتكارٍ للفضاء العام ومنه الأغنية، التي يمكن وضعها في إطار العنف الرمزي الذي تمارسه السلطة من خلال إثارة الغرائز البدائية وتكريس نمط من الإذعان لها، والدعوة إلى العنف بشكل مستتر ضدّ الآخر وكلّ ما هو مختلف، لخلق حالة يصدقها قول أحمد شوقي “قد تعيش النفوس على الضيم حتى/ لترى في الضيم أنها لا تضام”.
رجوعاً إلى جوهر الموضوع، فإن تسيّد شكلٍ واحد عُرف بالأغنية الوطنية على تاريخ الغناء في الأردن الحديث، وارتباط هذه الأغنية بدورة استهلاك سريعة جداً بحيث لا تحتفظ الذاكرة الشعبية بعشرين أغنية منها من أكثر من ألفين تمّ إنتاجها، والتراجع المستمر بمضامينها وبنيتها اللحنية، يجعل مسألة تطويرها مرهونة باستقلالها عن المنظومة التي تتحكّم بصناعتها.
هل ما زلنا نحتاج الأغنية الوطنية في الأردن، وفي البلدان العربي عموماً؟ سؤال لا يُطرح اعتباطاً حين نجد دولاً متقدمة ليس لديها سوى نشيدها الوطني وبضع أغانٍ ترتبط بمحطّات تاريخية من انتصار أو مقاومة، لأن هذه الدول تُحكم بدستور يقونن علاقة مجتمعاتها بالمكان الذي تعيش فيه والسلطة التي تحكمها، فلم يعد يتطلب المكان تعريفاً أو تخييلاً أو إثبات محبة له، كما باتت هذه الدول أيضاً تنظر بريبة إلى الافتخار بوطنها وأمتها نأياً أن يُفهم كنوع من العنصرية والكراهية تجاه الأوطان والأمم الأخرى.
أما في بلادنا، فتبدو الأغنية الوطنية تعويضاً عن اختلال تلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ظلّ انتهاك الدستور وتجاوزه، وكذلك تعويضاً عن هزائم وانكسارات لا تزال جروحها مفتوحة، ما يخلق تصوّرات متوّهمة ومبالغاً فيها عن الأوطان!