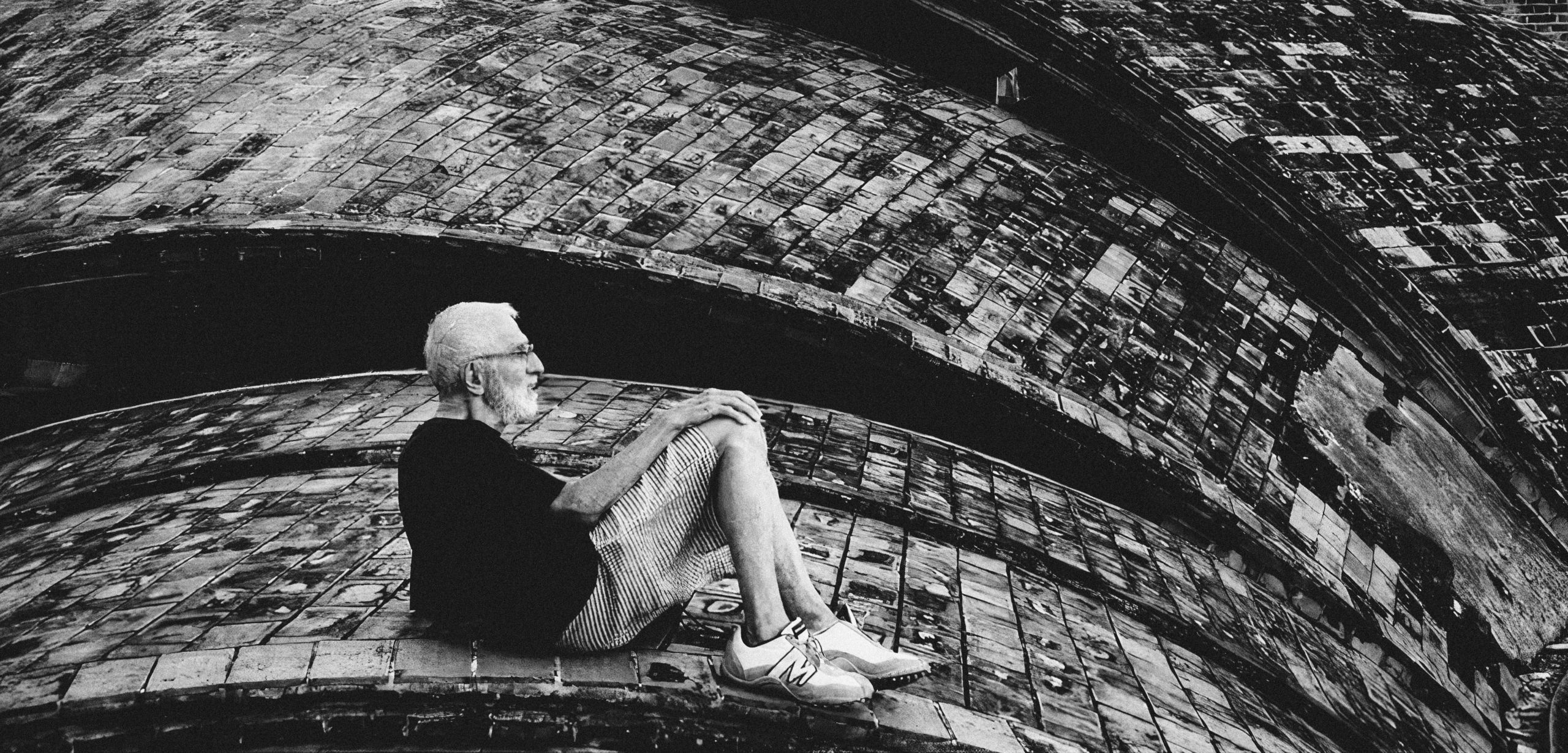نختبر منذ السابع من أكتوبر طيفًا واسعًا من المشاعر الإنسانية. كان بعضنا عند قمة الفرح قبل أن يهوى إلى أغوار اليأس. عرفنا الألم والعجز والغضب. وسط كل هذا تلوح أحيانًا شرارات الأمل. نتلمسها في أي بادرة صمود أو تضامن، يراها البعض في ما تحرزه عناصر “كتائب القسام” من نجاحات في استهداف آليات الجيش الإسرائيلي وجنوده.
لم تُثر الصور والمشاهد المتداولة يوم السابع من أكتوبر حماستي قدر ما أشعلت حذري تجاه ما ستحمله الأيام التالية. كان المتوقع أن تبالغ إسرائيل في هجومها المضاد من أجل غاية نعرف الآن أنها مستحيلة: محو يوم “السابع من أكتوبر” من الذاكرة، محو آثاره على الواقع الإسرائيلي نفسه، وإزالة تداعياته المتوقعة على النظام العالمي.
الصورة الفارقة، بالنسبة لي، في هذا اليوم كانت حشود الناس وهي تعتلي مدرعة إسرائيلية، وتجوب بها شوارع غزة وسط تهليل الجماهير وعلامات النصر. كأنني كنت أبحث عن دعم شعبي للعملية، كأن شرعيتها لتصبح “منقوصة” لولا هذا الدعم.
أعتقد أن بحثي عن ذلك المُكون الشعبي/الجماهيري لأي فعل، يرجع إلى تأثير ثورة يناير 2011 بشكل خاص. حينها خرج الشعب من “المجاز” إلى “الواقع”. كنا قبلها مجرد “سكان” أو “تعداد”، مواد لسياسات السلطة وتأثيراتها. الثورة؛ كلحظة مقاومة، جعلتني “أرى الشعب” إن جاز التعبير.
في “مجتمع الفرجة”، بتعبير جي ديبور، يتحول كل شيء إلى “مشهد” مهما بلغت درجة فظاعته. نشهد على مدار الساعة وقائع إبادة جماعية معلنة. صرنا متفرجين أمام التدفق المتسارع لآلاف الصور والمشاهد التي تنقل المأساة بكل ما فيها من وحشية وقسوة.
لكن الأخطر من الخدر والسُبات الناجمين عن التشبع من استهلاك الصور، هو تحول المقاومة نفسها إلى “مشهد“، وتحولنا، نحن، إلى مُشجعين. ومهما كان المشهد ملهمًا، ومهما صارت درجة حماستنا، فإن المقاومة بحاجة إلينا في العالم الواقعي.
العنف كمقدمة للسياسة
في تناوله تاريخ العنف السياسي مع نهايات القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة، يوضح المؤرخ البريطاني إريك هوبزباوم أن جماعات مثل فتح، وحماس، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وحزب الله، ونمور التاميل، وحزب العمال الكردستاني تمتعت بدعم جماهيري خلافًا لجماعات البلقان الأوروبية، وكانت تعتمد من أنصارها على دعم واسع ومصدر دائم للتجنيد.
يقول هوبزباوم إن “هذه المجموعات لم تتخذ من أعمال الإرهاب الفردية أسلوبًا أساسيًا إلا بوصفها الرد المتاح الوحيد على طغيان القوة العسكرية للدولة المحتلة، كما في فلسطين”.
المفارقة في حديث هوبزباوم لها أكثر من وجه. فهو يصف أعمال الجماعات والفصائل الفلسطينية بـ “الإرهاب” لا “المقاومة”. وفي الوقت نفسه يرى الإرهاب المزعوم مبررًا بالدعم الشعبي وانعدام الحلول الأخرى.
لا تعنينا هنا المسميات التي يمكن للخطاب الغربي إطلاقها على المقاومة الفلسطينية، وإنما طبيعة العلاقة المعقدة بين فعل المقاومة المسلحة العنيفة والدعم الشعبي الجماهيري.
إذا كانت الطبيعة التدخلية لسلطة الدولة في شؤون وتفاصيل الحياة اليومية تهدف إلى التنظيم والسيطرة، فإن الاحتلال يتدخل في حياة الفلسطينيين من أجل “الإعاقة” التي يفرضها على المدن والقرى المحتلة. “إنه يتدخل في الحياة كلها وفي الموت كله” كما يقول الكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي. وغايته أن تبقى المدن والقرى الفلسطينية كما هي، منسية، وعالقة في الماضي.
لذلك لم يبدأ التاريخ يوم السابع من أكتوبر. وأي خطاب يتجاهل حقيقة الاحتلال لن يتمكن من تقديم “الحقيقة” مهما حاول ذلك. يديم الاحتلال “حالة الاستثناء”، بتعبير المفكر الإيطالي جورجيو أجامبين. يعيش الفلسطينيون تحت حالة طوارئ دائمة لا نهاية لها. اعتياد الناس العيش تحت حالة الطوارئ الدائمة “يختزل حياتهم إلى وظيفتها البيولوجية فقط، ويفقدها بذلك ليس بُعدها الاجتماعي والسياسي فحسب، وإنما الإنساني والعاطفي أيضًا”، كما يوضح أجامبين.
في تلك الحالة يصبح العنف مقدمة للسياسة وليس لاغيًا لها أو مُصادِرًا لرأي الجماهير. لأن الفرد الفلسطيني يعيش في ظل استباحة شاملة لكافة حقوقه الاجتماعية والسياسية. ولا يتمكن من التفاوض حول شروط عيش أكثر عدالة ومساواة. كأن المقاومة العنيفة في تلك الحالة تخلق “الشعب” بدلا من أن تقصيه.
أما استخدام العنف ضد حكومة قمعية أو سلطة الدولة فمسألة أخرى.
أمام القانون “الدولي”
هناك اختلاف واضح بين استخدام القوة في النضال ضد سلطة الدولة الحاكمة، واستخدامها في حالة مناهضة الاستعمار. ربما ظلت شرعية الثورة ضد الحكومات القمعية محل جدل قانوني سياسي مستمر. إلا أن القانون الدولي يمنح حركات التحرر الوطني الحق في النضال المسلح.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 3070 لسنة 1973 وفي الفقرة الثانية أعادت تأكيدها على حق الشعوب في النضال ضد الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي “بكافة الوسائل الممكنة” بما فيها المسلح.
تشير نويل هيجينز، أستاذ القانون الدولي والباحثة المتخصصة في دراسات حروب التحرر الوطني، إلى أن كلًا من قرار الجمعية العامة 3070 عام 1973 والصليب الأحمر، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 قد “اعتبر حروب حركات التحرر الوطني نزاعًا دوليًا، حيث عُد هذا التصنيف بمثابة خطوة كبيرة في تاريخ تطور قواعد استخدام القوة في حروب حركات التحرر الوطني”.
ترتبط المقاومة الفلسطينية في المخيلة الليبرالية الغربية بحركات اليسار المتطرف في الستينيات والسبعينيات. وربما تفيد التصنيفات والمواد القانونية في بيان الاختلافات بين المقاومة الفلسطينية وغيرها من الحركات المسلحة أو الانفصالية حول العالم، مما يترتب عليه دعم أوسع للقضية الفلسطينية. ويمكنها أيضًا أن ترد على مزاعم الخطاب الإسرائيلي ومحاولته تشبيه حماس بداعش، أو استحضار النازية كتهمة إيديولوجية جاهزة ..
في كتابها “تنظيم استخدام القوة في حروب حركات التحرر الوطني: الحاجة إلى نظام جديد”، توضح هيجينز أن ممارسات الدول يجب أن تؤخذ بالحسبان بالقدر ذاته عند نقاش مسألة استخدام القوة من قبل الشعوب، فعلى الرغم من أهمية الإطار القانوني الناظم لقواعد استخدام القوة في خدمة شرعية النزاع المسلح لحروب حركات التحرر الوطني فإنه من الضروري عدم الاكتفاء بالأدوات القانونية.
تعتبر هيجينز اعتراف الحكومات بالحركات التحررية -كونها الممثل الشرعي للشعوب- دليلًا على اعتراف الدول بعدالة قضية حروب حركات التحرر الوطني وبقانونية استخدامها للقوة.
ربما يبدو الجدل القانوني بلا جدوى، لأنه حتى لو استوفت الحالة الفلسطينية كافة الشروط من أجل أن تنطبق عليها بنود اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها المضافة، أي اعتبار الكفاح الفلسطيني المسلح نزاعًا دوليًا وما يتطلبه من الاعتراف بدولة فلسطين، فإننا قد شاهدنا كيف تُنتهك القوانين الدولية وقواعد الحرب من قبل إسرائيل، وعجزًا تامًا للأمم المتحدة مماثلًا لإخفاق عصبة الأمم قديمًا. ورأينا في مجلس الأمن الفيتو الأمريكي وهو يحول دون إصدار قرار وقف إطلاق النار.
جيش التحرير الوطني في المكسيك (Zapatistas). تنشر وفق رخصة المشاع الإبداعي
الإبادة.. القانون الجديد
يوضح الصحفي البريطاني جوناثان كوك أن تجاوز قيود القانون الدولي (مجموعة القوانين التي كُرِّست في أعقاب الحرب العالمية الثانية) من أهم الأسباب وراء دعم بريطانيا والغرب لإسرائيل. الفائدة التي يراها الغرب تكمن في الحصار الإسرائيلي لغزة، حيث تُعيد إسرائيل تعريف قواعد الحرب، فالقانون الدولي “يتطور من خلال الانتهاكات”. مما يسمح لبقية الدول بهامش تجاوزات أكبر في قادم الأيام، “فالفعل المحظور يصير مباحًا إذا فعله عدد كاف من البلدان”. وإسرائيل هي رأس الحربة في تلك الإباحة المطلوبة.
يوضح كوك أننا تجاوزنا مستوى “العقاب الجماعي” لنصل إلى حيّز “الإبادة”، “بلاغيًا وواقعيًا”.. “ورغم ذلك، لا شيء في الغرب سوى الهتاف لإسرائيل”، وأقصى ما قيل كان كلمات من قبيل “ضبط النفس” و”التناسب في الرد”، وهي “المصطلحات المراوغة التي يستخدمونها عادة لإخفاء دعمهم لخرق القانون”.
متى أصبحت مقاومة الطغيانية العسكرية إرهابًا، وقد قيدت القوانين الدولية الصراع المسلح بثلاث أشكال وهي الأنظمة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، تنطبق كلها على الحالة الفلسطينية؟
قد يرى البعض أن الجدل القانوني يخص الغرب ولا ينبغي أن يشغلنا. ترتبط المقاومة الفلسطينية في المخيلة الليبرالية الغربية بحركات اليسار المتطرف في الستينيات والسبعينيات. وربما تفيد التصنيفات والمواد القانونية في بيان الاختلافات بين المقاومة الفلسطينية وغيرها من الحركات المسلحة أو الانفصالية حول العالم، مما يترتب عليه دعم أوسع للقضية الفلسطينية. ويمكنها أيضًا أن ترد على مزاعم الخطاب الإسرائيلي ومحاولته تشبيه حماس بداعش، أو استحضار النازية كتهمة إيديولوجية جاهزة. الاغتيالات مثلا، كفعل إرهابي في الأصل، ممارسة إسرائيلية بامتياز. وقائمة من اغتالتهم إسرائيل طويلة وممتدة.
عن الشك والكفر
ربما ما يشغلني كمصري هو طبيعة العلاقة بين منظمة حماس وبقية حركات الإسلام السياسي، وذلك في ضوء التجربة المصرية المريرة مع التنظيمات الإسلامية في سيناء والصدام الدموي بين الجيش والإخوان بعد يوليو 2013.
ولا يتعلق الأمر بالإيديولوجيا أو حتى البحث عن مصادر التمويل -الذي يخضع لاعتبارات سياسية إقليمية- وإنما هو القلق الدائم من تديين الصراع، الأمر الذي يعني تأبيده، فلا يمكن لدين أن يُلغي دينًا آخر. وكذلك القلق من الشعبوية التي تُعيد بقايا الخطاب القومي البلاغي، و تستعيض عن الصراع السياسي وتوازنات القوى بالشعارات الجوفاء الرنانة.
لكن في مواجهة الشك في “حماس” أو اليقين المفرط بها، هناك “كفر” أكبر ينمو في نفوس الأجيال التي يتشكل وعيها وسط الإبادة القائمة في غزة الآن. كفر ويأس بكافة القيم والأفكار الإنسانية، بالسياسة والقانون الدولي وحقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة. غضب من العالم أجمع. من قلب هذا اليأس تتجلى “القوة” كمنطق أوحد. ربما يفقد هذا الجيل “العربي” إيمانه بكافة الاتجاهات الفكرية ولا يرى إلا “القوة”. الطبيعة ذات الظفر والناب، كما يقال.
لا يمكن أن تفوق فصائل المقاومة، من حيث العتاد والتجهيزات والتكنولوجيا، الآلة العسكرية الجهنمية المدعومة من الامبراطورية الأمريكية والتحالف الأوروبي. الرأسمالية الكوكبية في خدمة إسرائيل. من زاوية أخرى، فإن الخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي من أفراد وآليات على أيدي كتائب القسام قد تكون كفيلة بانسحابه والاتفاق على وقف إطلاق النار. لكنه يمضي في وحشيته المسعورة للتغطية على الفشل الاستراتيجي، ومرجئًا للمحاسبة السياسية التي قد تواجهها حكومة نتنياهو، ومستغلًا التأييد الأمريكي الأوروبي الأعمى في خلق أزمة ديموغرافية متفاقمة داخل القطاع تُعجل بمخططات التهجير.
أمامنا جيش يقتل الأطفال والنساء بدوام كامل أملًا في كسب بعض الوقت. أمامنا صراع لا يمكن حسمه بالقانون ولا بقوة السلاح وحدها.. فما العمل؟
حماس.. تكتيكات مختلفة
أول بازل حصلت عليها وأنا صغير كانت على شكل مقاتل نينجا ملثم يحمل سيفًا. كانت عبارة عن قطعة بلاستيكية مربعة مقسمة إلى مربعات صغيرة، وتظل تحرك المربعات وتعيد ترتيبها حتى تتكون الصورة داخل الإطار.
أحببت البازل وصورة محارب النينجا، وكنت أريها للأقارب وكل من يأتي لزيارتنا. حين رآها خالي قال: “لعبة جميلة.. عارف مين كمان بيلبس كده في الحقيقة ؟”
رددت متلهفًا: “مين ؟”
أجاب: “حماس”. وكانت المرة الأولى التي سمعت فيها الكلمة. كنا في النصف الأول من التسعينيات. وشرح خالي من هم “حماس” وماذا يفعلون. خالي محامٍ؛ عمل في السعودية لسنوات، وانتمى للإخوان في فترة مبكرة من حياته.
وفي أولى سنوات الجامعة، اغتيل الشيخ أحمد ياسين، مرشد حماس الروحي. وأعقب ذلك عدة وقفات ومظاهرات في الجامعات المصرية. كان طلاب الإخوان يوزعون ملصقات ونشرات. يومها، أعطاني أحدهم استيكر عليه صورة “أحمد ياسين” ومكتوب عليه: “القعيد الذي حرك العالم وأحيا أمة”. وفي الأسفل: “آخر كلماته: أملي أن يرضى الله عني”. لصقت الاستيكر على الدولاب في غرفتي أنا وأخي، ولا يزال هناك حتى الآن.
تراوحت آرائي حول حماس بين الميل والنفور. كان الانحياز إلى “حماس” في فترة صدامها مع “فتح”، عقب الفوز في الانتخابات عام 2006، مقياسًا عندي للحكم على مدى رجاحة رأي الفرد. غضبت من الروائي الكبير جمال الغيطاني (1945- 2015) عقب تأييده حركة “فتح” في لقاء تليفزيوني، واصفًا حماس بأنها ترتكب جرائم ضد ممثلي السلطة الفلسطينية.
تحول الانحياز بعد ذلك إلى نفور في أعقاب تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر. أي أني خلعت عليهم العداء الإيديولوجي الموجه للإسلام السياسي. ومع تصاعد موجة الإرهاب بعد أحداث يونيو 2013 وما تلاها، أضرت التنظيمات الإرهابية المتنامية بصورة حماس وبقية فصائل المقاومة ذات التوجه الإسلامي. خلقت تلك التنظيمات فائضا من التوجس، لا زال البعض يُعاني منه حتى الآن.
توضح الباحثة ليلى سورا، مؤلفة كتاب “سياسة “حماس” الخارجية: الأيديولوجيا، اتخاذ القرار والصدارة السياسية”، أن البعض في العالم الفلسطيني والعربي ربما صاروا “أشد ميلاً إلى حماس بعد الحرب منهم قبلها”.
وتعزو سورا ذلك إلى قدرة حماس منذ بداية الحرب على صياغة “استراتيجية إعلامية متعمدة شددت على دور غزة المركزي في الكفاح الفلسطيني”، و”قدرتها على التواصل مع الخارج”. ورغم قطع الإنترنت، والقصف العنيف، وتدمير أبنية الاتصالات التحتية في القطاع كله، فإن حماس نحجت في استمرار” بث معلومات من ميدان المعركة”، ونفي المزاعم الإسرائيلية عن استعمال المستشفيات دروعاً بشرية، “والمحافظة على بعض التأثير في تغطية الإعلام العالمي أخبار الحرب”.
في عام 2018، استفادت قيادات حماس أثناء تنظيمها مسيرات العودة قرب الحواجز الحدودية بين غزة وإسرائيل من “تظاهرات عشرات آلاف الغزاويين الأسبوعية على الحدود احتجاجاً على الحصار، وأطلقت الصواريخ والبالونات المشتعلة على إسرائيل”. ونتج عن هذا الضغط عقد إسرائيل “سلسلة اتفاقات أجازت بموجبها فتح معابر حدودية فتحاً محدوداً، وزيادة تمويل قطر رواتب الموظفين”، كما تبين الباحثة.
وتضيف: “ولم يحل هذا دون تشكيك شطر كبير من الفلسطينيين في “حماس”، واتهامها باستعمال مسيرات العودة في سبيل حرف الانتباه عن الانتقادات المتعاظمة لنظامها، والتوسل بالقوة إلى حماية مصالحها الخاصة في غزة”.
توضح سورا أن يحيى السنوار انتهز الفرصة في 2021 لمعالجة مسألة مصداقية “حماس”. فحين شنت إسرائيل حملة قمع قاسية على الفلسطينيين المحتجين على طرد المقيمين منهم من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، أطلقت “كتائب القسام” آلاف الصواريخ على أشدود وعسقلان والقدس وتل أبيب. فانتفض، عفوياً وتضامناً، مع فلسطينيي القدس، آلاف من فلسطينيي 1948 في مدن كثيرة بالداخل. وكانت الانتفاضة والتضامن ذريعة “حماس” إلى نسج روابط بالفلسطينيين خارج غزة، و”الاضطلاع بدور حامي المدينة المقدسة”.
وتلاحظ الباحثة أن انفتاح قيادات “حماس” المتعاظم على الفلسطينيين خارج غزة تزامن مع تطبيع البحرين والمغرب والإمارات العربية علاقاتها بإسرائيل، وتوقيع اتفاقات أبراهام برعاية الولايات المتحدة.
أي أنه في مواجهة إحجام الدول العربية بعدها عن الدفاع عن القضية، وما اعتبره الفلسطينيون وقتها “خيانة صريحة“، رفعت “حماس” في غزة “لواء الدفاع عن الضفة والقدس“.
عن المقاومة والشعب والإنسان الجديد
دفعتني أسابيع حرب الإبادة إلى قراءة بعض مما يمكن تسميته “أدبيات المقاومة”، ومحاولة معرفة تصورات مفكري وفلاسفة اليسار الغربي، بتوجهاته المتعددة، حول سؤال المقاومة وسبل التحرر الوطني من الاستعمار.
في القلب من تلك الأدبيات يواجهنا سؤال “العنف الثوري”. وعلى الرغم من أن الحالة الفلسطينية تزداد تعقيدًا كل يوم، فإنني أدرك الآن التماثل الكبير بين معظم الأفكار والأطروحات حول الاستعمار منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وبين نموذج الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.
في مقدمته لكتاب فرانز فانون “معذبو الأرض“، يتحدث جان بول سارتر عن عار الاستعمار الأوروبي، وعن “السكان الأصليين” ومعنى العنف وغايته. يقول سارتر إن الذعر في نفس المستعمَرين المضطهدين لا ينبع فقط من أساليب الاستعمار القمعية، وإنما من الخوف الذي تثيره اندفاعات الغضب الرهيبة و”تلك الرغبة في القتل التي تصعد من أعماق قلوبهم”. ويوضح أن تلك الرغبة ليست عنفهم هم، وإنما هي عنف المستعمرين الأوروبيين، “وقد انقلب واشتد وأصبح يمزقهم”. ويضيف: “نحن من بعيد نعد حربه انتصارًا للتوحش ولكن هذه الحرب تؤدي بذاتها إلى تحرير المقاتل”.
يوضح فانون أن العنف الجامح ضد الاستعمار يعيد تشكيل الإنسان. فالاستعمار يريد تجريد السكان الأصليين من إنسانيتهم، ويتكلم عنهم بنفس اللغة المستخدمة في وصف الحيوانات.
من يقرأ فانون يلاحظ مركزية مفهوم الشعب وحضوره في غالبية صفحات كتبه، ربما لأنه وإن كان يتكلم عن “ثورة مسلحة عنيفة”، فهو يؤكد على الانطلاق الجماهيري العفوي، ويركز على العلاقة بين القيادات الحزبية التنظيمية و الجماهير، وبين النخب المدينية والفلاحين، ومواقع البرجوازية والطبقات الكادحة في النضال، ودور الحزب والتنظيم ..
من يقرأ فانون يلاحظ مركزية مفهوم الشعب وحضوره في غالبية صفحات الكتاب، ربما لأنه وإن كان يتكلم عن “ثورة مسلحة عنيفة”، فهو يؤكد على الانطلاق الجماهيري العفوي، ويركز على العلاقة بين القيادات الحزبية التنظيمية و الجماهير، وبين النخب المدينية والفلاحين، ومواقع البرجوازية والطبقات الكادحة في النضال، ودور الحزب والتنظيم.
وحتى مع فيلسوف مثل الإيطالي أنطونيو نيغري، الذي يدرس مع مايكل هاردت في كتابهما “الجمهور“، شكلًا مختلفًا من المقاومات المسلحة ممثلًا في ما يُعرف بـ “حروب العصابات”، فإنه يؤكد على أن فكرة “الشعب” قد “أدت دورا رئيسيًا في نماذج الجيش الشعبي” أثناء فترات نشوء الثورات والمقاومات الحديثة، وفي”شرعنة استخدام العنف”.
ورغم رغبته في طرح تصور بديل لا يعتمد على شرعنة سلطة الشعب العليا لأنها تخدم/تبرر في النهاية شرعية السلطة الحاكمة، فإنه يؤكد على مباديء أو معايير ثلاثة مرشدة في تنظيمات المقاومة. أهمها هو تفعيل “الديمقراطية والحرية دائما كمبدأين مرشدين في عملية تطور الأشكال التنظيمية للمقاومة”.
في شهادة أنطوان لينيه، قائد الجناح العسكري لمنظمة اليسار البروليتاري الفرنسي (التي تأسست عام 1968 وحلت نفسها عام 1974)، نلمح رؤية هامة حول طبيعة الإيديولوجيا المتطرفة والعسكرة العقلية لقادة التنظيم وعلاقتهما بقرار اللجوء إلى العنف. نجح لينيه ورفاقه في عدم الوقوع في فخ ممارسة الاغتيال، وهو قرار لم يكن مبنيًا على” مبادئ أخلاقية”، “فقد كانوا يرون أن قرار القتل تصدره الجماهير لا هيئة تدعي تمثيلها”، كما يوضح الباحث والأكاديمي المصري توفيق اكليمندس في مقاله عن كتاب “الإرهاب والديمقراطية” بمجلة “عالم الكتاب” المصرية، يناير 2015.
رأى لينيه أيضا أن التجربة الثورية في “فيتنام” “أثبتت أن الثورة لا تنجح إلا بعد حرب قاسية وطويلة لا بعد عمليات اغتيال وإن تعددت، ولا بعد انتفاضة قصيرة، وقرار الحرب تتخذه الجماهير”.
هنا قد يبدو “الإرهاب” مصطلحًا تقنيًا، مجرد وصف أدائي/ معجمي. يفتتح اكليمندس مقاله قائلًا: “هذا كتاب منسي، لأنه يتناول ظاهرة ولى زمانها المنظمات الإرهابية الأوروبية المنتمية لأقصى اليسار المتطرف“.
مقاتلات في الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام. تنشر وفق رخصة المشاع الإبداعي
الجسد الفلسطيني.. هدف مستحيل
في مقالهما “إسرائيل تخسر هذه الحرب” يقول توني كارون ودانيل ليفي: “يحب السياسيون الغربيون ووسائل الإعلام الغربية تخيل «حماس» جماعة عدمية على غرار «داعش» تحتجز المجتمع الفلسطيني كرهينة، لكن «حماس»، في الواقع، حركة سياسية متعددة الأوجه تمتد جذورها في نسيج المجتمع الفلسطيني وتطلعاته الوطنية. إنها تجسّد اعتقادًا، أكّدته بحزم عقود من الخبرة الفلسطينية، بأن المقاومة المسلحة أمر جوهري في مشروع التحرير الفلسطيني بسبب فشل عملية أوسلو وعداء خصمها المستعصي. نما نفوذها وشعبيتها مع استمرار إسرائيل وحلفائها في إحباط عملية السلام وغيرها من استراتيجيات اللاعنف التي تسعى لتحرير الفلسطينيين”.
لكن في ضوء الإبادة الجماعية الواقعة الآن، ربما تتخذ الأصوات الإسرائيلية من فكرة الدعم الشعبي والالتفاف الجماهيري مبررًا للعقاب الجماعي، وطرحها في سياق الرد على تهم الإبادة والتطهير العرقي. الحجة التي تدحضها حقيقة أن غالبية الضحايا في غزة هم من الأطفال. أكثر من ثمانية آلاف طفل. لا يصوت الأطفال في الانتخابات ولا يقدرون على توفير الدعم اللوجيستي أو حتى المعنوي لأي عنصر أو فصيل. لكن حرب إسرائيل حرب حيوية إن جاز التعبير. فمشكلتها مع وجود الجسد الفلسطيني نفسه. وهي غاية تجعل من الانتصار الإسرائيلي المنتظر مفهومًا مستحيلًا.
يحذر عدد متزايد من محللي المؤسسات الاستراتيجيين من أن إسرائيل قد تخسر هذه الحرب ضد الفلسطينيين، رغم “العنف الكارثي الذي شنته منذ الهجوم عليها بقيادة حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي“. وفي رأيي أن الخسارة تتمثل في غايتها المستحيلة؛ محو الجسد الفلسطيني ومحو ذاكرة العالم.
عنف ونتائج
يقيم الكاتب والمؤرخ وأستاذ العلوم السياسية نورمان فنكلشتين تناظرًا تاريخيًا بين عملية حماس في السابع من أكتوبر والتمرد ضد العبودية ممثلًا في الأمريكي نات تيرنر (1800- 1831) ومن بعده جون براون (1800- 1859)، حتى انتفاضة جيتو وارسو ضد النازية.
قاد تيرنر ثورة السود ضد العبودية في أمريكا خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر. كان تيرنر يجيد القراءة والكتابة، يقرأ الإنجيل ويؤم رفاقه في الصلاة. أصدر تيرنر أمرًا إلى رفاقه بقتل أي رجل أبيض يقابلوه في ثورتهم. تم قمع التمرد وشنت ميليشيات البيض حملات انتقامية واسعة وأصدرت أحكام بالإعدام. وصدر بعدها قانون حظر تعليم السود والعبيد.
مستلهمًا تيرنر، شرع جون براون في النضال ضد العبودية حتى حكم عليه بالخيانة وأُعدم شنقًا. يقول فنكلشتين إن براون اعتبر بطلًا ورمزًا للتحرر بعدها بعامين فقط حين كان الجنود في جيش الاتحاد يهتفون باسمه في سنوات الحرب الأهلية. تتغير النظرة التاريخية إلى الأفراد، فمن كان متعصبًا بالأمس يُمكن النظر إليه الآن بوصفه بطلًا.
أما انتفاضة جيتو وارسو فإنها أسفرت عن دمار نازي موسع للمدينة.
وكما يرى فنكلشتين، فإن حالة حماس تتماثل مع الحالات السابقة. فلا يمكن الحكم عليها بالنظر إلى ما جلبته من نتائج مدمرة، لأن العنف كان هو السبيل الوحيد الممكن في جميعها. لهذا فإنه من المستحيل إدانة تيرنر وبراون رغم الوحشية، كما إنه من المستحيل إدانة حماس لأن أهل غزة يعيشون في حصار دائم داخل معسكرات اعتقال، ولم يكن أمامهم سوى الانزواء حتى الموت.
يتخذ فنكلشتين من مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 مارس عام 2018 ، دليلًا على فشل المقاومة السلمية وتكتيكات اللاعنف في غزة. ويؤكد إنه كان من المشجعين للمسيرات والمتفائلين بإمكانيات العصيان المدني، وتواصل بالفعل مع قيادات من حماس. لكن النتائج كانت كارثية؛ إذ أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على المسعفين والصحفيين والمتظاهرين السلميين من أطفال ونساء وذوي الإعاقة. ويوضح فنكلشتين أن المقاومة السلمية وأفعال الاحتجاج الرمزية تحتاج إلى توافر عدة عوامل حتى تحقق النتائج الفعالة. فهي منوطة بالقدرة على التأثير على المجتمع الدولي ودفعه إلى التدخل، والأهم أن فاعليتها تتوقف على مدى العنف الذي يمكن أن يصل إليه القامع.
نهاية الادعاءات
في منتصف هذا الشهر، صرحت الروائية الهندية المرموقة أرونداتي روي أثناء تسلمها جائزة “بي غوفيندا بيلاي” بأن الموت والصمت هما كل يمكننا فعلًا.
تقول روي في كلمتها المستنكرة: “يبدو أن الشيء الأخلاقي الوحيد الذي يمكن للمدنيين الفلسطينيين أن يفعلوه هو الموت. الشيء القانوني الوحيد الذي يمكن لبقيتنا فعله هو مشاهدتهم يموتون، وأن نصمت. إذا لم نفعل ذلك، فإننا نخاطر بالمنح الدراسية والهبات ومكافآت المحاضرات وبسبل عيشنا”.
تتحدث روي عن “فقد البوصلة الأخلاقية”، وعن نهاية كل ادعاء بمرحلة ما بعد الاستعمار والتعدّدية الثقافية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تضيف: “لقد انتهى أي ادعاء بحرية التعبير أو الأخلاق العامة. إنّها “الحرب” التي يقول المحامون والباحثون في القانون الدولي إنها تستوفي جميع المعايير القانونية للإبادة الجماعية، حيث قدم مرتكبوها أنفسهم كضحايا، وصوّر المستعمرون الذين يديرون دولة الفصل العنصري أنفسهم على أنهم مضطهدون. وأي تشكيك في ذلك يعني اتهامك بأنك معادٍ السامية”.
ليست غاية السطور السابقة التدليل على “صدقية حماس“، أو التسليم بأن الصمت والموت هما القوانين الوحيدة بالفعل، بل التساؤل: هل عنفنا قادر حقًا على تحريرنا؟
مسارات مسدودة
في كتاب “الاحتجاج الشعبي في فلسطين: المستقبل المجهول للمقاومة غير المسلحة” يتتبع الباحثان “مروان درويش” و”أندرو ريغبي” مسار المقاومة الشعبية في فلسطين خلال خمسة وعشرين عامًا، منذ أواخر الثمانينيات. أي من لحظات الأمل في قدرة المقاومة المدنية السلمية على تحرير فلسطين. ويبحثان أسباب فشلها في تسجيل أي تقدم ملموس اتجاه تحقيق هدفها الأساسي في إنهاء الاحتلال.
يُعرف الباحثان المقاومة المدنية/ الشعبية بأنها “أسلوب لتحدي خصوم لا يتورعون عن استخدام العنف. ويقوم بها مدنيون يلجأون إلى الاستخدام الثابت لأساليب هي بطبيعتها في الغالب غير عنيفة وغير مسلحة (وغير عسكرية) في سبيل تحقيق أهداف تلقى توافقًا واسعًا داخل المجتمع”.
يورد الكتاب أمثلة من عصر ما قبل النكبة مثل إضراب عام 1936، ثم النكبة وهزيمة 1967 والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة، وفترة تمجيد الكفاح المسلح وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. ويتناول الانتفاضة الأولى ومراحل تصعيدها وأبعادها الاستراتيجية وصولا إلى اتفاقية أوسلو، حتى الانتفاضة الثانية وبناء جدار الفصل العنصري.
في الفصل الرابع المعنون: “تجدد المقاومة الشعبية 2002- 2013″، عرض لعدة أمثلة على المقاومة الهجومية التي تجدد بفعل الجدار والتوسع الاستيطاني، ومنها التظاهرات والاحتجاجات ورشق الحجارة و”النزهة النسائية في نبع النبي الصالح” و”نموذج المعصرة” وإغلاق شارع 443 ومقاطعة البضائع الإسرائيلية و”لجان حراسة القرى”.
أشعر أنني قريب للغاية من أنقاض الحرب والأشلاء والدماء، وفي نفس الوقت بعيد للغاية. فقدت القدرة على تحديد موقعي. حجم التضحيات لا يمكن استيعابه. ربما هناك لحظات لا ينفع التفكير فيها من خلال ثنائية الحياة /الموت ..
يحاول الباحثان أثناء تحليلهما ربط أسباب فشل الانتفاضة الأولى بمدى القدرة على “التأثير في الضمير الجماعيّ للمجتمع الإسرائيليّ”؛ وهو أحد الأهداف التي يدعو إليها قسمٌ كبيرٌ من منظّري “المقاومة غير العنفية” لحركات الاحتجاج السلميّ والمدنيّ. فخلال السنوات الثلاثة الأولى الأكثر سلمية كان “تحريك المجتمع الإسرائيلي” ممكنًا، وكلما زاد الجنوح إلى العنف قلت تلك الإمكانية.
أما عن “التحديات” التي تواجهها المقاومة الشعبية فإن أهمها هو الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وعدم تحولها إلى حركة جماهيرية، نتيجة اقتصارها على مواجهات واحتجاجات تظهر كردة فعل على تهديدات فورية لأسلوب عيش الناس وأرزاقهم جرّاء بناء الجدار وتعديات المستعمرات المتواصلة على الأراضي الفلسطينية.
وأما المتطلبات التي تحقق استدامة المقاومة الشعبية غير العنيفة كما يراها الباحثان فهي: شعور عام بالتضامن لدى السكان الخاضعين للاحتلال والصمود المنظم والدعم الخارجي. (أي مجموعة العوامل التي يرى فنكلشتين أنها لا تتوافر في حالة غزة).
يثير الكاتبان نقطة جدلية تتعلق بالمساعدات والإغاثات الدولية، فهي حسب رأيهما تسهم في إدامة الاحتلال حيث تعفي مؤسسات الإغاثة إسرائيل من مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين. كما أن تلك المؤسسات يجب أن تتخلى عن الحيادية وأن تتحول الإغاثة لدعم الصمود.
في خاتمة الكتاب يُلخص الكاتبان حالة قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي كبير، ويستعرضان الوضع الإنساني القاسي الذي يعيشه الفلسطينيون هناك.
يقترح الكاتبان ما يسميانه “سيناريو الأمل”، أي أن تصبح الكلفة المالية والإنسانية والدبلوماسية التي تتحملها إسرائيل عبئًا متزايدًا. ويصبح عنف الاحتلال ظاهرًا بشكل واسع للمهتمين حول العالم مما يدفع القادة السياسيون من داعمي الاحتلال إلى الضغط على إسرائيل.
جعلت الحرب الدائرة الآن غالبية مقترحات الكتاب غير صالحة، أو بالأدق، حققت قدرًا كبيرا من الآمال والتطلعات، خاصة المتعلقة بتعرية إسرائيل دوليًا وتحريك المجتمع الإسرائيلي، لكن بوسائل مختلفة. كما أنها أعادت طرح التساؤل النقدي حول جدوى المقاومة الشعبية في مواجهة دولة استعمار استيطاني، كما يوضح الباحث الفلسطيني أحمد عزالدين أسعد، والذي يتساءل في نقده للكتاب:
“أليس من المنطق أن تكون المقاومة الفلسطينية بنيوية تهدف إلى تفكيك المنظومة الاستعمارية؟“
تدريبات للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) . تنشر وفق رخصة المشاع الإبداعي
تضامن عمالي.. هل يؤثر؟
أؤمن أن لكل نضال جانبه الأقل فرجة وشهرة من المظاهرات الحاشدة وفيديوهات القنص والكمائن. ويتمثل في الإضرابات والاحتجاجات العمالية.
تمخض عن حرب الإبادة تضامن عمالي عظيم. أعاقت تحركات في أستراليا شحن الأسلحة المتجه إلى إسرائيل. وسبق أن أعاقت الحركات العمالية الداعمة لفلسطين عمليات شحن الأسلحة من موانئ مختلفة في الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وبلجيكا والدنمارك.
وإلى جانب تضامن عمال الموانئ، أعلن الاتحاد الدولي لعمال السيارات، أحد أكبر الاتحادات العمّالية وأقواها في أميركا الشمالية، عن انضمامه إلى النداء العالمي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزّة. يوضح المدير الإقليمي للاتحاد، براندون مانسيلا، أن «الحركة العمّالية لن تكون قادرة على تحقيق الأهداف التي حدّدتها للعدالة الاجتماعية وعدالة العمّال والعدالة الاقتصادية، إذا غضّت الطرف عمّا يحدث في جميع أنحاء العالم.. من معارضة الفاشية في الحرب العالمية الثانية، إلى التعبئة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحرب الكونترا في نيكاراغوا، دافعت نقابة عمّال السيّارات المتّحدين باستمرار عن العدالة”.
يقترح الاتحاد الاميركي خطّة عمل: «سيقوم مجلسنا التنفيذي الدولي بتشكيل فريق عامل معني بإعادة دراسة عادلة لتاريخ إسرائيل وفلسطين، والروابط الاقتصادية لاتحادنا بالصراع، وتخفيف الاستثمارات، واستكشاف كيفية تحقيق انتقال عادل للعمّال الأميركيين من الحرب إلى السلام».
لن يعود كما كان
نأمل في أن يتغير العالم. والعالم يتغير الآن بالفعل. ونحن ندرك ذلك لكننا لا نقدر على الثمن. كنا نعلم من قبل أن العالم مكان قاس وموحش. أن “الجحيم يساوي قسوة بني آدم” كما يقول فؤاد حداد. لكننا لم نتخيل هول الألم الذي يعانيه الناس في غزة. وأن هذا القطاع الساحلي الصغير أخذ على عاتقه حلم التغيير. لا نضمن كذلك أن التغيير سيكون إلى الأفضل، لكن العالم بالتأكيد لن يعود كما كان.
أشعر أنني قريب للغاية من أنقاض الحرب والأشلاء والدماء، وفي نفس الوقت بعيد للغاية. فقدت القدرة على تحديد موقعي. حجم التضحيات لا يمكن استيعابه. ربما هناك لحظات لا ينفع التفكير فيها من خلال ثنائية الحياة /الموت.
أفكر أن مفهوم المقاومة نفسه في الحالة الفلسطينية لا يمكن تناوله فقط من منظور ثنائية العنف /اللاعنف. وأن هذه الحرب لا يمكن حصرها في حرب بين عالم الرجل الأبيض ضد الملونين. إن عمال الموانئ في سيدني أكثر قرباً لغزة والقدس من بعض العرب في دول الجوار أو دول الخليج. وحول العالم الآن، هناك متظاهرون بيض ويهود، أمريكان وأوروبيون، يحتجون ضد حكوماتهم، ويطالبون بوقف إطلاق النار.
أفكر في شاب اسمه توم هرندال، ناشط سلام، قتل برصاصة قناص إسرائيلي منذ 19 عاما، أثناء محاولته إنقاذ طفلين في رفح الفلسطينية. وأتذكر دوما اسم راشيل كوري،، ناشطة سلام أمريكية، شابة شقراء قتلتها جرافة إسرائيلية كانت بصدد هدم منزل فلسطيني في قطاع غزة.
كان العالم فاتحًا ذراعيه أمام كوري وهرندال، واعدًا بالإمكانيات والامتيازات التي تتوفر للإنسان “الأبيض“. لكنهما أدارا ظهرهما لذلك العالم، و نظرا صوب عالم جديد. ربما سيشعران بالسلام الآن إن علما أن عالمهما الجديد في طور التكوين.
رغم الألم.. كيف نستفيد من النصر؟
ثمة انتصار في المقاومة كأنه صفة قارة بها، لا تتبدل مهما كانت النتائج. ولو قدر لنا أن نتعلم شيئا من التاريخ العالمي للمقاومة لكان هذا اليقين كافيًا. لكنه يقين لا يحمينا من هول المأساة، ومن الإدراك المؤلم للخسائر الفادحة. يشير سارتر، بكلمات أيقونية إلى تلك اللحظة تحديدًا، إلى لحظة الخسارات الفظيعة أثناء النضال من قلب الفقر والبؤس ضد الغنى والتسليح القوي، حين لا يهم ساعتها انتظار انتصارات نهائية من عدمها.
يقول سارتر: “إن جيش الاستعمار يصبح كاسرًا، فهو يقوم بعمليات تطهير ويشن حملات انتقامية ويقتل النساء والأطفال والمناضل يعرف ذلك: إن هذا الإنسان الجديد يبدأ حياته من نهايتها. إنه يعد نفسه ميتًا بالقوة.. إن هذا الميت بالقوة قد فقد زوجته وأبنائه. لقد بلغ من فرط رؤيته لاحتضار الآخرين أنه لا يريد أن يعيش بقدر ما يريد أن ينتصر. غيره سيستفيد من النصر لا هو. لقد سئم هو. لكن هذه السآمة هي مصدر شجاعة لا تصدق. نحن نجد إنسانيتنا سابقة على الموت والبأس، أما هو فيجدها بعد العذاب وبعد الموت“.
هل عنفنا قادر حقا على تحريرنا؟
كان هذا السؤال شاغلي الأول طوال كتابة هذه السطور. الآن، أفكر: كيف يمكن أن نستفيد حقًا من نصرٍ، وإن طال انتظاره، فهو آت حتمًا، لا ريب في ذلك.
إلا أن الخط الفاصل بين النصر المرتقب والهزيمة المخزية يبدو واهيًا. وهنا أفكر في لحظة قادمة ستفرض علينا، كمصريين، دورًا مغايرا للمشاهدة والصمت، دورًا مصيريًا. حينها سنحتاج أن نكون جمهورًا مقاومًا لا مشاهدًا.
لكن، كما يقال، هذه قصة أخرى.